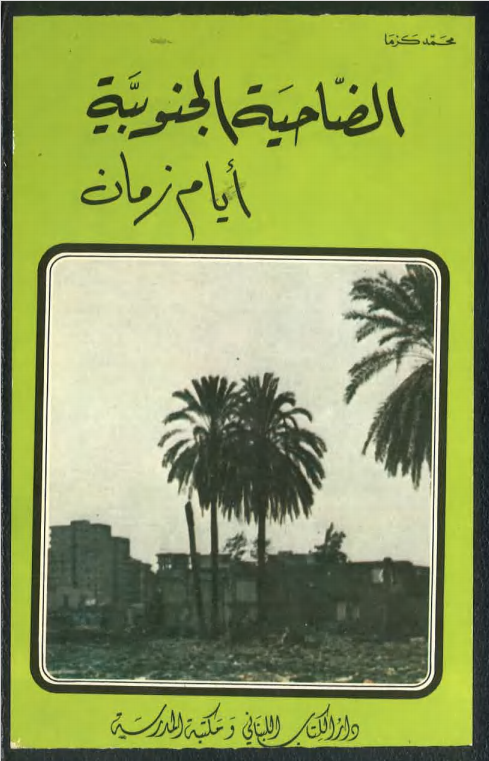
محمد أبي سمرا *
في كتابه “الضاحية الجنوبية أيام زمان”، كتب “محمد كزما” أن ساحل المتن الجنوبي في طفولته غداة الحرب العالمية الأولى كان “سهلاً فسيحاً أخضر، بيوته قليلة متفرقة بين البساتين وأشجار النخيل ورباعات الصبير بين حرج صنوبر بيروت شمالاً ونهر الغدير في صحراء زيتون الشويفات جنوباً”.
لكن هذا السهل الساحلي الأخضر، كانت فيه قرى عمرانها بلدي، محلي وريفي: برج البراجنة، الشياح- الغبيري، وحارة حريك. وهي نشأت عن حركة هجرات متعاقبة من قرى جبلية إلى المنخفضات والسهول للعمل والإقامة فيها، منذ القرن السادس عشر.
وفي شهادة خليل الفغالي- المولود حسب بطاقة هويته في برج البراجنة، حي المريجة، عام1934، أو في عام1931، حسب ما جاء على باطن خزانة الثياب الخشبية في بيتهم العائلي القديم، وفق مدونات والده الأستاذ “أنطون” المتوفي سنة 2015- أن ساحل المتن الجنوبي الذي صار يسمى ضاحية بيروت الجنوبية نهاية ستينات القرن العشرين، كان يُعرف بـ”ساحل النصارى“، أقله منذ عهد نظام متصرفية جبل لبنان (1860-1914). ووردت هذه التسمية في وثيقة رسمية تعود إلى عهد آخر المتصرفين (الحكام) على جبل لبنان، أوهانس قيومجيان باشا، وتنص على أمر المتصرف تعيين الأمير حارث فارس شهاب مديراً لـ”ساحل النصارى”. وعثر الفغالي على الوثيقة سنة 1958،عندما كان موظفاً في جهاز الأمن العام اللبناني، في أحد أقبية قصر آخر الأمراء الشهابيين، بشير الثالث، في حارة البطم المتاخمة لبلدة “الحدث” القريبة من “حارة حريك”. والقصر تُراثي شُيد سنة 1697، وتحدّرَ بالإرث إلى الأمير “فريد حارث شهاب” (1908-1985) مدير الأمن العام اللبناني (1948-1958) فباعه سنة 1964 للسفارة الإسبانية في لبنان. وفي الجولة الأخيرة من الحروب اللبنانية، قُتِل سنة 1989 بقصف مدفعي في القصر إياه الأديب اللبناني “توفيق يوسف عواد” الذي كان سفيراً سابقاً للبنان في إسبانيا، وقتل معه زوج ابنته، السفير الإسباني في لبنان.
وتعبر تسمية “ساحل النصارى” عن واقعة ديموغرافية بطيئة طويلة الأمد، حيث توطن المسيحيون فيه، منذ ما قبل الحروب الطائفية الدرزية- النصرانية (1840-1860) في جبل لبنان، وفيما هم ينشؤون مزارع ساحلية تحولت لقرى زراعية وتجمعات سكانية. لكن دولة لبنان الكبير في عام 1920، غيبت هذه التسمية تدريجياً، واستبدلتها بتسمية إدارية محايدة: ساحل المتن الجنوبي الذي توسعت قراه الزراعية. أما كثافة موجات المهاجرين الريفيين من جنوب لبنان والبقاع الشمالي إلى مناطق سكنية قريبة من العاصمة، فقلصت الاجتماع الريفي وحاصرته في تلك القرى الساحلية منذ مطالع خمسينات القرن العشرين، وحولتها ضواحيَ سكنية لبيروت. وفي أواسط ثمانينات القرن نفسه، أخذت تغيب عن القرى أسماؤها تلك، فشملتها كلها تسمية “الضاحية” التي نُزعت عنها كل صفة وإضافة، عندما شرع “حزب الله” في إنشاء ما سماه “المربع الأمني” في البلدة الأكثف سكناً مسيحياً في ساحل المتن الجنوبي: حارة حريك التي أُخليت من مسيحييها تماماً بالخوف والتهجير القسري. وهذا ما أصاب مسيحيي الضاحية الجنوبية كلها.
وتؤكد شهادات متقاطعة إقامة عائلات شيعية وتوطنها في برج البراجنة، قبل وِفادة فلاحين ومزارعين مسيحيين موارنة إلى السهل الساحلي. لكن السبق الشيعي في التوطن هذا يظل ضعيف الوزن والتأثير والدلالة في مجرى التحولات العريضة التي أصابت مجتمع جبل لبنان الدرزي- المسيحي. ذلك لأن العامل الأساس في تلك التحولات منذ القرن السادس عشر، كان قوة الحراك الاجتماعي المسيحي، جبلاً وساحلاً، ومن شمال لبنان إلى جنوبه.
ويُرجح خليل الفغالي أن أقدم تجمع مسيحي نشأ على أطراف برج البراجنة، سُمي الليلكي. وهي مزرعة ذُكرت في كتاب إبراهيم بك الأسود “تنوير الأذهان في تاريخ لبنان”. لكن أسماء كثيرة، كتحويطة الغدير والمريجة وبئر العبد وصفير والمعلم والمعمورة والرادوف والجاموس وحي ماضي وحي الأبيض، كانت تسميات أحياء أو نواحٍ أو مزارع غير مستقلة إدارياً وبلدياً وسكانياً، بل تابعة إما لبرج البراجنة الشيعية أو لحارة حريك القرية المسيحية الأكبر في ساحل المتن الجنوبي.
آل الأبيض وآل المقداد:
وفي سنوات الحرب العالمية الأولى (1914-1918) تكاثر الهاربون من التجنيد الإجباري التركي، والمهاجرون إلى مصر والأميركيتين، والمشردون هرباً من الجوع والقلة والقحط في ديارهم، بحثاً عن سبب للعيش في ديار قريبة (سوريا وفلسطين).
وفي روايته سيرة آل الأبيض العائلية، ذكر ميشال الأبيض (ولد سنة 1930) أن والده إلياس، المولود مطلع القرن العشرين في “فالوغا” بأعالي المتن، اصطحبه من موطنه هذا رجلٌ من آل الدكاش (كبرى عائلات حارة حريك وأقدمها توطناً فيها) كان يصطاف مع عائلته في فالوغا، وشغله في كرخانة حرير في الحارة بُعيّد الحرب الأولى. وبعد مدة قصيرة اشترى عامل الكرخانة الشاب قطعة أرض صغيرة، على طرف بساتين حارة حريك الخالية من السكان، فأخذ يزرعها وأنشأ فيها كوخاً لإقامته. وسرعان ما استقدم زوجته وبِكرَ أولاده من فالوغا فأنجب أبناءً سبعة، منهم الراوي. ثم استقدم إلى موطنه الجديد إخوته الثلاثة مع أبنائهم الذين راح عددهم يتزايد. هكذا نشأت “ديرة” زراعية عائلية. وساعدت آل الأبيض المسيحيين كثرتهم (نحو 50 رجلاً) ليكونوا ما يشبه حامية محلية للتصدي لـ”الغرباء الطارئين على حارة حريك”.
والغرباء الذين تَكتمَ الأبيض عن تسميتهم، أفصح عنهم رستم المقداد (ولد سنة 1944 في حي آل المقداد على طرف حارة حريك): هم طلائع عشيرة آل المقداد وآل عواد والخنسا الشيعة الذين بدأوا ينزلون مطالعَ عشرينات القرن العشرين من جرود جبيل، إلى الطرف الشمالي لكل من برج البراجنة وحارة حريك. وراحت تنشب مناوشات بين آل الأبيض وآل المقداد. وحسب رستم: “كان آل الأبيض بطاشين لا يرحمون”، ولم يتكتم رستم على أنه كان من المعدن نفسه: “شيخ شباب” عشائري في حي عشيرته على طرف حارة حريك، غير بعيد من “ديرة” آل الأبيض العائلية.
الزيتون والمطار وحي السلم:
كانت كروم الزيتون تملأ صحراء الشويفات التي كانت تنبسط مترامية جنوب ساحل المتن الجنوبي. كل كرم زيتون في الصحراء كان له اسمه، وفيه منطرة، وهي بناء بدائي صغير يأوي إليه وينام فيه ناطور يشرف على الكرم. ومن أسماء تلك المنطرات: الزغل، المراح، ضهر الريحان… وجل السلم (سُمي لاحقاً حي السلم، ومن أحياء العمران العشوائي).
وفي منتصف أربعينات القرن العشرين كانت صحراء الشويفات تحوي حوالى 53 ألفاً و600 شجرة زيتون، وفق إحصاء لجنة المالكين التي أوكِلت إلى نواطير كرومهم إحصاءها. وكان في صحراء الشويفات 34 معصرة زينون، تعمل على الطريقة التقليدية القديمة. وكان في الصحراء 12 ألفاً و500 شجرة خروب صندلي.
وكان المسيحيون من أفضل البنائين في القرى الساحلية. فبنوا كنيسة برج البراجنة سنة 1929، وشيدوا قصور آل سرسق الأرستقراطيين في الأشرفية. والحمضيات ازدهرت زراعتها في بساتين الساحل بعد انهيار أعمال الحرير واقتلاع أشجار التوت، بالتزامن مع البدء في إنشاء مطار بيروت الجديد في الشويفات سنة 1949. وفي هذه السنة وصلت الكهرباء إلى القرى الساحلية.
لكن “الدليل” الذي أصدرته بلدية المريجة والليلكي وتحويطة الغدير سنة 2018، ذكر أن “شركة كهرباء لبنان زودت تحويطة الغدير بالكهرباء سنة 1941، لسحب مياه الآبار بالمضخات. واستملكت الحكومة اللبنانية مليون متر مربع من مساحة تحويطة الغدير في نهاية الأربعينات، لإنشاء مطار بيروت الدولي الجديد عليها في صحراء الشويفات وكروم زيتونها. وأدى المشروع إلى طمر الينابيع والآبار والنواعير والبرك.
فلسطينيون.. وأنطون سعادة:
كان مدرس خليل الفغالي في المريجة شاباً فلسطينياً يدعى إيليا الفار، وهو من نازحي “نكبة” 1948 الكثيرين. هؤلاء، خاصة المسيحيين منهم، كانوا متعلمين في معظمهم، ويُجيدون اللغة الإنكليزية، فأشاعوها في البيئة المحلية التي كانت الفرنسية لغة التعليم في مدارسها. لكن الفلسطينيين المسيحيين سرعان ما هاجروا، بعدما حرمتهم فلسطينيتهم من الحصول على أعمال مناسبة، فيما تمكن أصحاب المهن والحرف منهم، كالنجارين والحدادين والخياطين والعمال الزراعيين، من تحصيل معاشهم. أما إسكندر الفار، شقيق مدرس الفغالي، فبدل اسم عائلته إلى حبيب، ليتمكن من العمل في صيدلية بساحل المتن الجنوبي.
هؤلاء، خاصة المسيحيين منهم، كانوا متعلمين في معظمهم، ويُجيدون اللغة الإنكليزية، فأشاعوها في البيئة المحلية التي كانت الفرنسية لغة التعليم في مدارسها. لكن الفلسطينيين المسيحيين سرعان ما هاجروا، بعدما حرمتهم فلسطينيتهم من الحصول على أعمال مناسبة، فيما تمكن أصحاب المهن والحرف منهم، كالنجارين والحدادين والخياطين والعمال الزراعيين، من تحصيل معاشهم. أما إسكندر الفار، شقيق مدرس الفغالي، فبدل اسم عائلته إلى حبيب، ليتمكن من العمل في صيدلية بساحل المتن الجنوبي.
وفي عنوان “صورة شخصية عن قرب لأنطون سعادة”، نقل موقع “ديوان العرب” الإلكتروني في 22 يوليو/ تموز 2022) ما رواه المثقف الفلسطيني هشام شرابي (1927-2005)- عندما كان طالباً ومحازباً قومياً سورياً في جامعة بيروت الأميركية أواخر الأربعينات- عن استقباله زعيم حزبه أنطون سعادة، لحظة عودته من أميركا الشمالية عام 1947 إلى مطار بيروت، أي سنتين وبضعة أشهر قبل إعدامه في العاصمة اللبنانية، بعد محاولته الانقلابية الفاشلة على نظام الحكم اللبناني، انطلاقاً من ساحل المتن الجنوبي.
وأضاف شرابي: “نزل سعادة سلم الطائرة ولوح بيده لألوف من القوميين السوريين الذين أتوا لاستقباله من أنحاء لبنان كافة ومن فلسطين وشرق الأردن والشام. ومشى يحيط به أعضاء المجلس الأعلى والمسؤولون في حزبه. وبعد مغادرته المطار ألقى خطابه من بيت المُحازب نعمة ثابت”. والبيت لا يزال قائماً قرب مستديرة المطار القديمة. وتحول مقراً للسفارة الجزائرية، ثم لبلدية الغبيري بعد سيطرة “حزب الله” على ضاحية بيروت الجنوبية.
أما خليل الفغالي فروى مشهدياً زيارة الزعيم، لاحقاً، منزل خليل السباعي في برج البراجنة: جموع من أهالي البرج والمريجة المزارعين يتراكضون في الحقول ليصلوا إلى بيت السباعي. فخبر وصوله انتشر بين الأهالي الذين سمع الراوي بعضهم يقول: “جاي الزعيم تبع القومية، جاي الزعيم”، فركض هو مع الراكضين لرؤيته. وقف سعادة على شرفة بيت خليل السباعي مطلاً على مستقبليه المُحتشدين في الأسفل، بشراويلهم وطرابيشهم، وبينهم شبان وفتيان وأولاد ونسوة من الأهالي الفلاحين في معظمهم. وسرعان ما علا التصفيق ما إن بدأ الزعيم خطبته، فأخذ العرق يسيل على وجهه. شاب التفت إلى آخر قائلاً: هل فهمت ما يقول الزعيم؟ لا، لا والله، جاوبه الشاب الآخر. فسأله الأول: لماذا تصفق إذن؟ فقال الثاني: كلهم يصفقون، فلماذا لا أصفق معهم؟!
المخيم الفلسطيني وحي المقداد:
عقب حرب 1948 العربية- الإسرائيلية في فلسطين (النكبة) أُنشئ مخيم اللاجئين الفلسطينيين الأكبر بـ”ييروت” في الشمال الغربي من برج البراجنة، وحاذى أطراف حارة حريك الجنوبية، وكانت أغلبية سكانها من المسيحيين. أما حي آل المقداد العشائري الشيعي فكان قد نشأ على طرف حارة حريك الشمالي الغربي لجهة الغبيري، وراح يتوسع تدريجياً منذ مطالع العشرينات.
يصعب تخيل نشوء هذين التجمعين السكنيين المسلمين، على طرفي ضيعة حارة حريك المسيحية من دون إثارتهما مخاوف أكثرية سكانها المسيحيين، وإشعارهم بالقلق والحصار في مجتمع ودولة ركيزة تكونهما جماعات أهلية، وقِوام اجتماعهما السياسي هويات متنازعة تنشأ عن هجرات تلك الجماعات وتوطنها في حيز جغرافي، وعن عوامل أخرى أساسية تتصل بالإرث الثقافي والديني والعرقي وأشكال التنظيم الاجتماعي، وبالنزاع على الأرض والحدود والتصدر والسلطان.
وروى رستم المقداد أن أوائل المهاجرين من عشيرته بنوا “تخاشيب” وغرف إسمنتية في كرم زيتون تشارك رجال من العشيرة على شرائه سنة 1930، فوزعوه قطعاً في ما بينهم، وأخذوا يبنون عليها مساكن إسمنتية عشوائية من غرفة أو اثنتين، لإقامتهم الدائمة على مثال السكن القرابي العشائري. وتزايد عدد الغرف، تلاصقت وتكوكبت في الحي الناشئ والمتمدد في الأراضي المجاورة.
وقبل نشوء مخيم البرج الفلسطيني، كانت طفرة البناء غير المنظم قد انتقلت طلائعها من الحي العشائري إلى شاطئ الأوزاعي والجناح، حيث كان أبو طعان المقداد، صاحب محطة المقداد للمحروقات على طريق المطار، هو البادئ في ذلك الانتقال.
وأدى توسع حي المقداد على طرف حارة حريك الشمالي إلى تجاور مساكنه وتداخلها مع بيوت السكان “الأصليين” وأملاكهم. وفي أواسط الأربعينات- حسب رستم المقداد- تفاقم تناسل الثارات العشائرية بين أجباب عشيرته ورجالها على تخوم كل من الحارة وبرج البراجنة. كانت بواعث الثارات نزاعات عشائرية أبرز أسبابها إقدام رجال وشبان من هذا الجب أو ذاك على خطف نساء وفتيات من أجباب أخرى، والزواج منهن رغماً عن أهلهن، فتوسعت الثارات وأخذ رجال من العشيرة يترصد بعضهم بعضاً ويتكامنون مسلحين بالمسدسات والبنادق فيطلقون منها في المنطقة نيران ثاراتهم.
والمحلة التي سُميت المشرفية- بعدما أنشأ رجل من آل مشرفية الدروز محطة محروقات على طريق صيدا القديمة، لناحية حارة حريك، شهدت كثرة من كمائن الثأر وإطلاق النار، فروعت الأهالي من السكان “الأصليين”، وتنادى وجوه من عائلاتهم، مسيحيين ومسلمين إلى الاجتماع. قـرَ رأي المجتمعين على كتابة عريضة تطلب العمل على ترحيل آل المقداد من حيهم العشائري. وحسب ميشال الأبيض، ما إن وصلت العريضة إلى بلدية برج البراجنة، حتى قام رئيس مجلسها البلدي (أبو عزة السباعي) والوجه الأبرز نفوذاً في آل عمار (حسين درويش عمار، والد النائب محمود عمار، لاحقاً) بتمزيقها قائلين: “آل المقداد سند لنا- نحن المسلمين الشيعة- مهما تقلبت الأحوال والظروف”.
ورستم المقداد استهل روايته مُعتداً بانتسابه وأهله إلى الساحل، لا إلى الجرد: “نحن مقيمون هنا أباً عن جد.

فجدتي وجدي مدفونان هنا في مقبرة الطيونة”. لكن جدة رستم لأمه هي ابنة عائلة الحاج من السكان “الأصليين” الشيعة في حارة حريك والشياح. وفي شبابه عمل والد رستم في أملاكهم الزراعية فلاحاً، قبل زواجه من إحدى بناتهم، وإنجابه منها 18 ولداً. وكانت نسوة العشيرة يبعن حليب البقر الذي يجمعونه لتسويقه في بيروت. وظلت تربية الأبقار حاضرة في الحي ولدى كثرة من أهالي حارة حريك من المزارعين حتى مطالع السبعينات مع بقايا من نمط الحياة الزراعية.
علمانية عربية وتكفير شيعي:
روت “ليلى الحاج المبيض” سيرة آل الحاج الشيعة في الغبيري التي ولدت فيها سنة 1943 ووالداها وجدّاها من قبلها. وتستهل السيرة بإطلالتها من نافذة حنينها الأليم إلى صور طفولتها في مرابع ذاك السهل الساحلي الأخضر، محاولة تخليصها من المحو والنسيان، وغرسها في مواضعها الزائلة، لتعالج “انطفاء الفرح في عينيها حين تتذكر كيف انقلب الدهر، فخسر (السهل) بهاءَهُ، وانتصر الإسمنتُ (عليه وصيره) ضاحية رمادية عنيفة ومُعنفة، شاهداً على قهر من لجأ إليه (…) من سهل بقاعي فقير مهمل، أو من جنوب معتدى عليه (من إسرائيل)، فوجدَ (فيه أولئك اللاجئون) ملاذاً”. ومثل هذه النبرة المتأسية على زمن ملون، عائلي هانئ وأليف، بتره الإسمنت الرمادي، تتكرر في مواضع كثيرة من الكتاب.
وليلى الراوية من جيل توطن آل الحاج الرابع في الغبيري. وهي بما يشبه ملامة ذاتها بلغة ابنتها كاتبة الكتاب- والأرجح لغة قريبتها الكاتبة ومحررة “دار الجديد”، رشا الأمير (رباب سليم) الشقيقة والتوأم، الحياتي والثقافي، لـ”لقمان سليم” (1962-2 فبراير/ شباط 2021) الشائع والمشتبه أن “حزب الله” اغتاله.
وتشكل سيرة النائب في البرلمان اللبناني عبدالله الحاج (1899-1975) محور الكتاب. وهو علماني عربي التطلعات مذ كان طالباً في الجامعة الأميركية في بيروت، إلى جانب دعوته إلى التحرر. وظل يدعو جهاراً إلى العلمانية في بيئته الأهلية التقليدية المحافظة.
ويروي محمد كزما أن دعوة الحاج تلك “أثارت حفيظة رجال الدين في بيئته (الغبيري)، فشنوا حملات تحريض ضده وعلى أستاذه محمد الزين. وفي نهار جمعة من عام 1921، وصل فجأة رجل الدين والمجتهد الشيعي الكبير السيد عبد الحسين شرف الدين- ولد في العراق وأقام فيه 32 سنة وتوفي في صور سنة 1957- إلى جامع الغبيري” القريب من منزل آل الحاج، و”ألقى خطبة في المصلين” من الأهالي، علماً أن شرف الدين “نادراً ما كان يغادر مدينته صور” في جبل عامل. ومما جاء في خطبته: “أتعلمون ما هي العلمانية؟ إنها تتعارض مع الأديان السماوية كلها، وخاصة الدين الإسلامي. إنها الكفر بعينه! ومن هو رئيس دعاتها الملقب بالمستر زين؟ إنه مُنحرف. ومن هو هذا المدعو عبدالله الحاج؟ إنه أيضا مُنحرف. ومثلهم كل من يمشي تحت علمهما ويتقبل مبادئهما. لذلك أقول لكم حاربوهم. فمن يحاربهم يخدم الإسلام، ويغنم أجر الدنيا والآخرة”.
ومسجد الغبيري الذي منه أعلن شرف الدين “تكفير” العلمانيين، أذاع منه “حزب الله” بيانه التأسيسي إلى “أمة المستضعفين (الخمينية) في الأرض” سنة 1985، أي بعد 64 سنة على خطبة رجل الدين الشيعي الصوري العاملي، شرف الدين. وإضافة إلى غضبه من علمانيي أبناء العائلات الشيعية المتعلمين، الأرجح أن غارة التكفيرية تصّدر عن غضبه من عزوف أبناء العائلات الدينية الشيعية العاملية عن طلب علوم الدين في النجف آنذاك. وذلك عندما كان أبناءُ كبار علماء الدين الشيعة العامليين- منهم جد عبدالله الحاج لأمه، ووالد “المستر زين” أستاذه في الجامعة الأميركية، والعلامة محسن الأمين- يعزفُون عن التعليم الديني ويُقبلون على التعليم المدني. وهم كانوا، حسبما نقل “وضاح شرارة” عنهم، يعزفون في العقد الثالث من القرن العشرين عن عالم النجف الباعث على “النفور”: “يعد لبس الأحذية المعروفة (…) فسقاً وخلاعة لا تليق بطالب العلم الديني (…) ومن هذا القبيل تناول الطعام بالملعقة. أما استعمال الشوكة والسكين فمن الكفر. وكان مجتمع النجف هذا يحسب قراءة الصحف والكتب الحديثة، والاختلاط بشعراء مثل الشيخ علي الشرقي النجفي، زندقة”.
شيوعية عائلية ومزارع:
في صالون بيته الجديد بمنصورية المتن التي تهجر إليها من حارة حريك في الثمانينات، روى “ميخائيل عون” (1935-2019) سير بعض الشيوعيين الذين نزلوا وأقاموا على أطراف حارة حريك في البساتين وتوطنو فيها، منذ مطالع ثلاثينات القرن العشرين:
- حنا الزرقا، كان من طلائعهم قبل والد الراوي ميخائيل عون. وعمل في مطبعة، ووفد من منطقة جزين. وعلى هدْيِه وطريقه نشأ أولاده، فانتموا إلى حزبه الشيوعي.
- جان عبود، وفد من قرية عين كفاع في بلاد جبيل إلى الحارة، قبل انتقاله وعائلته إلى بلدة الحدث القريبة. وأولاده بدورهم انتموا إلى حزب والدهم.
- سركيس سعادة، جاء في الأربعينات من قرية جاج في بلاد جبيل أيضا، وعمل دهانا في الحارة وانتمى إلى الحزب الشيوعي، فتبعه أبناؤه.
- داود الأسمر، كان جنديا في الجيش اللبناني. وفي مطلع الخمسينات وفد من قرية كفرحونة القريبة من جزين، فتزوج امرأة من عائلة سليم الشيعية في حارة حريك، وكان شيوعيا في خلية سرية في الجيش اللبناني، قبل تقاعده من الخدمة العسكرية.
- إسبر البيطار (1925-1993) وكان من أعضاء الخلية الشيوعية السرية في الجيش. وفد مع أخيه مطلع الخمسينات، قادمين من بلدة عندقت العكارية الشمالية. أخوه الشيوعي تزوج من شقيقة ميخائيل عون.
- علي غربية، طبيب شيعي وزوج حورية غربية، وابنه الطبيب أحمد غربية. وفد غربية الأب من النبطية مطلع ستينات القرن العشرين، وشيد بناية إلى جانب بناية شيدها ميخائيل عون وأهله في حارة حريك.
- الخلية النسائية، انضوت فيها زوجات الشيوعيين وبناتهم. ومنهم نوال سعادة، وحورية غربية، وسلوى الأسمر التي حصلت على دكتوراه في الطب من إحدى جامعات الاتحاد السوفياتي.
تُبين هذه الشذرات من سير شيوعيي حارة حريك أن القوة البدنية والعضلية كانت من شيمهم، إلى جانب تحدرهم من عائلات فقيرة في أرياف مسيحية طرفية. ونزلوا جميعاً في بساتينها الزراعية. وكانت الروابط العائلية والأسرية المباشرة نواة لحمتهم. إضافة إلى أن الأبناء كانوا يرثون عقيدتهم وانتماءهم الحزبي عن آبائهم.
* كاتب وروائي لبناني
المصدر: موقع المجلة
