(الحرية أولاً) ينشر حصرياً الكتاب المفقود «في الفكر السياسي» بجزئيه، للمفكرين “الأربعة الكبار”، وهذه الحلقة الخامسة عشرة من الجزء الثاني– بعنوان: (تداعي النظام البرلماني)..
بقلم الأستاذ “الياس مرقص”

تداعي النظام البرلماني
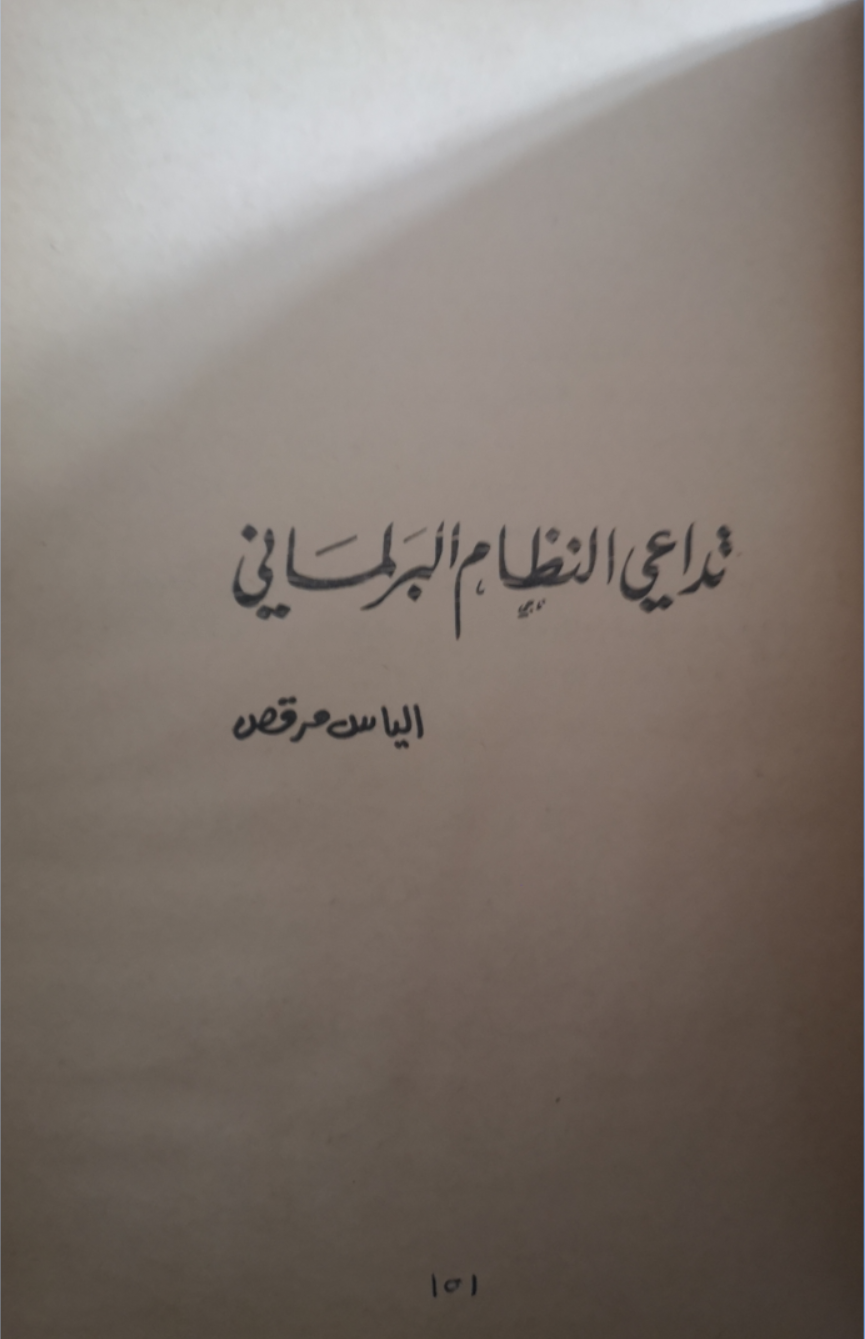
هل النظام البرلماني نظام عامل شامل يصلح لجميع البلدان والمجتمعات? هل هو النظام الأمثل الذي تسير إليه الإنسانية كافة?
إن القرائن الأولى تشير إلى غير ذلك. فمن المعروف أن دولاً عديدة، في الغرب والشرق، قد ابتعدت عن البرلمانية وأخذت تبحث عن أشكال جديدة للسلطة التشريعية. ويتضح ذلك بشكل خاص بالنسبة لشعوب آسيا وافريقيا التي انعتقت حديثاً من النير الاستعماري ولا تزال تُقارع الاستعمار وتعمل على تثبيت دعائم التحرر السياسي والاقتصادي.
ولكن ربما قيل أن هذا التحول هو حادث عرضي محدود أملته بعض الاعتبارات الجزئية والمؤقتة. فما هي حقيقة الامر؟ وماذا يجب أن يكون موقف هذه الشعوب من النظام البرلماني؟
علينا أن نعرف بأن كثيراً من الأفكار الخاطئة مازالت شائعة حول هذا الموضوع . ولعل أكثر هذه الافكار انتشاراً الرأي القائل ان البرلمانية هي النظام «الطبيعي» الذي يصبو إليه كل مجتمع. فالبرلمانية هي الديمقراطية، والديمقراطية هي البرلمانية !..
ولا بد أن نلاحظ أن دولاً ذات أنظمة مختلفة- بل معظم دول العالم- تنادي بالديمقراطية: بريطانيا والولايات المتحدة، الصين والاتحاد السوفياتي يوغوسلافيا واندونيسيا، الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية كوبا. ولكن ما 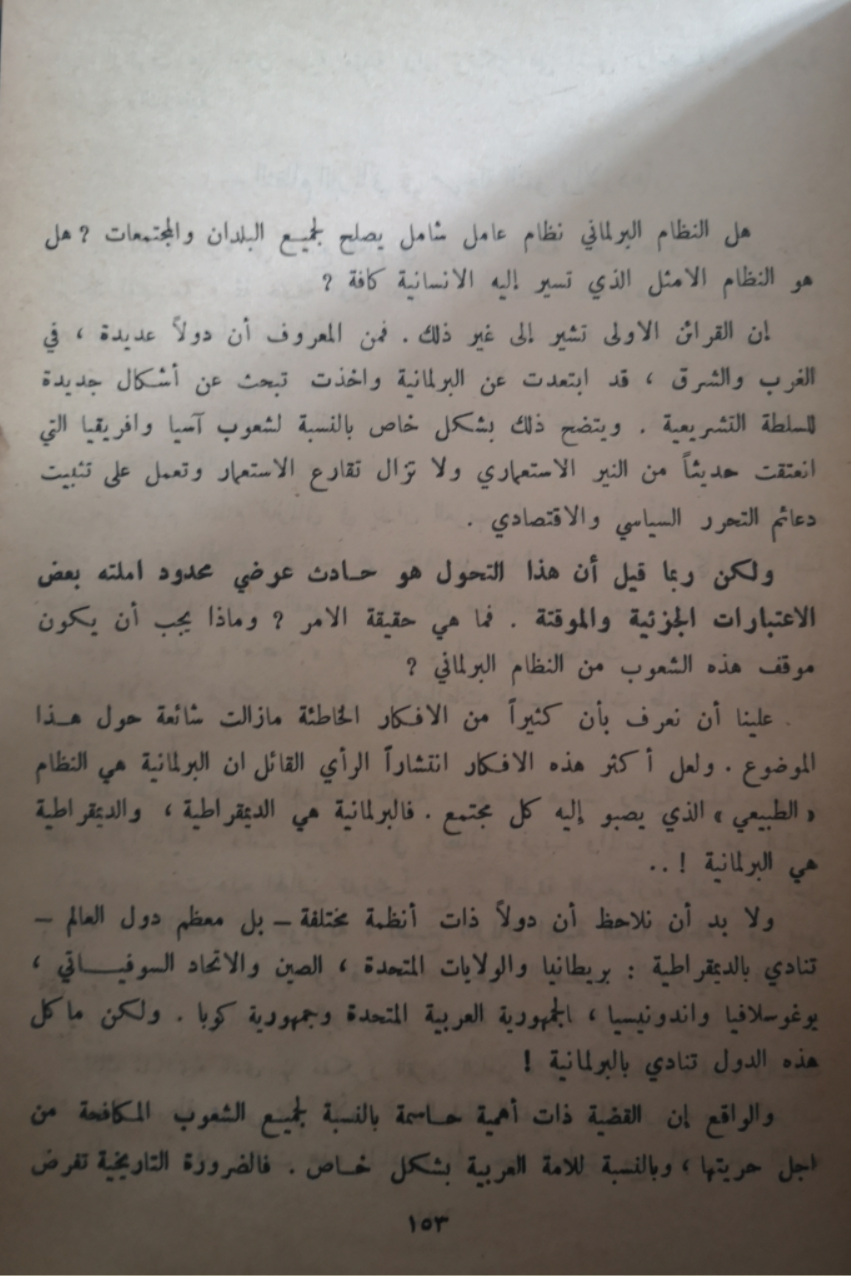 كل هذه الدول تنادي بالبرلمانية !
كل هذه الدول تنادي بالبرلمانية !
والواقع إن القضية ذات أهمية حاسمة بالنسبة لجميع الشعوب المكافحة من أجل حريتها، وبالنسبة للأمة العربية بشكل خاص. فالضرورة التاريخية تفرض علينا الوقوف على أرض صُلبة متينة وأن ترتكز على أسس راسخة من الوجهة النظرية والتاريخية.
1- النظام البرلماني في مرحلة النمو والازدهار
إذا ألقينا نظرة على وضع العالم في المرحلة الراهنة وعلى التطور التاريخي خلال المرحلة المنصرمة، ثمة حقيقة أولى تظهر لنا واضحة ساطعة وهي أن النظام البرلماني ليس نظاماً عاماً شاملاً. إنما هو نظام محدود في المكان والزمان. فهو لا يشمل- ولم يشمل في يومٍ من الأيام- إلا عدداً- وعدداً ضئيلاً- من المجتمعات. ليس النظام البرلماني نظاماً «أزلياً» وُجد مع المجتمع الإنساني، بل هو خاضع لقانون النشوء والتطور.
يعود قيام النظام البرلماني في بلدان الغرب إلى قرنين أو أقل. وخلال هذه الفترة، لم تبقَ المجالس البرلمانية على حالها بل تبدلت خصائصها، كما تبدلت أيضاً صلاحياتها وتطور دورها الفعلي. وقد كان هذا التطور في بعض البلدان (كبريطانيا والسويد) سلمياً «متصلاً» لم تتخلله ثورات أو انقطاعات. بينما خضع في البلدان الأخرى لهزات عنيفة بل ولانقطاعات دامت سنوات طويلة (كإيطاليا وألمانيا..).
لقد ظهرت المجالس البرلمانية الحديثة- بوصفها هيئات وطنية تمثيلية- على أثر ظهور الرأسمالية. ونمت بنموها، في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وعدد من البلدان الأخرى. ونمت هذه المجالس تدريجياً مع نمو الطبقة البرجوازية ونضالها من أجل السلطة. وبانتصار البرجوازية، أصبح البرلمان الهيئة العليا للسلطة. فهو يسن القوانين ويسهر على تطبيقها ويراقب نشاط الجهاز التنفيذي والإداري. فالوزراء مسؤولون أمام البرلمان. والبرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة تقريباً.
تلك المبادئ نادى بها مفكرو القرن الثامن عشر: السلطات منفصلة والسلطة التشريعية منوطة بمجلس ممثلي الأمة، والسلطة التنفيذية والإدارية خاضعة لإشراف هذا المجلس، وقد انتقلت هذه المبادئ إلى حيز التطبيق مع إنجاز الثورة البرجوازية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
ولا ريب أن انتصار النظام البرلماني يُشكل تقدماً تاريخياً كبيراً بالنسبة للعصور الوسطى. ولا ريب أن هذا الانتصار لم يكن متفقاً مع مصالح طبقية معينة- الطبقة البرجوازية- فحسب، بل مع مصلحة المجتمع الجديد برمته- المجتمع البرجوازي الحديث-.
لقد كان قيام النظام البرلماني انعكاساً ونتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أصابت المجتمعات الغربية مع انحطاط الإقطاعية. فهو تعبير عن زوال التجزئة الإقليمية نتيجة نمو العلاقات الاقتصادية ونشوء التكامل الاقتصادي والسوق القومية المشتركة. وانتصاره يرمز إلى نشوء الدول القومية الحديثة باعتبارها الإطار «الطبيعي» والمجال «المعقول» للنشاط الاقتصادي والصراع الاجتماعي.
ويمكن القول فيما يخص هذه المجتمعات الغربية أن نشوء البرلمانية وانتصارها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بظهور الأمم بالمعنى «الحديث» «الغربي»، وبمبدأ سيادة الأمة. فالبرلمان يُمثل الأمة، وسيادة البرلمان هي سيادة الأمة. لقد حل مبدأ سيادة البرلمان المنبثق عن الأمة محل سيادة ملوك «الحق الإلهي».
ولم يكن النظام البرلماني مجرد انعكاس سلبي لانتصار الطبقة البرجوازية والعلاقات الاجتماعية. بل كان أكثر من ذلك بكثير. كان أداة فعالة وسلاحاً ناجعاً بيد هذه الطبقة البرجوازية ساعدها في بناء وتنمية هذه العلاقات الاجتماعية كما ساعدها في تنمية ثروتها الاقتصادية وتوطيد حكمها السياسي.
وكانت الطبقة البرجوازية- الطبقة الثالثة كما سميت في فرنسا- تمارس الحكم باسم «الأمة». فلم يكن التناقض بينها وبين الشعب الكادح تناقضاً أساسياً بادئ الأمر. وسرعان ما تحولت الأمور. وظهرت «الطبقة الرابعة»- العمال وغير المالكين- كقوة مستقلة لها مصالحها ومطالبها.
وبقي البرلمان احتكاراً بيد الطبقة البرجوازية، وتجلى هنا بشكل صريح في حرمان الطبقات الفقيرة من حق التصويت والترشيح، الذي ظل معلقاً على شرط الثروة المادية ومحصوراً في نطاق الفئات المالكة من السكان.
وشهد القرن التاسع عشر صراعاً اجتماعياً حاداً في بلدان أوروبا الغربية. فقد خاضت الطبقات الكادحة نضالاً واسعاً من أجل حقوقها السياسية والاقتصادية. واضطرت الطبقة الحاكمة إلى التراجع. وانتصر مبدأ التصويت العام. فأصبح الانتخاب حقاً شاملاً مستقلاً عن الفوارق الاقتصادية.
2- انحطاط النظام البرلماني وأسبابه
إن التقدم الجديد الذي حصل باتجاه الدمقراطية قد نتج بالدرجة الأولى عن نمو الطبقة العاملة، نموها العددي والتنظيمي والسياسي. إلا أن هذا التقدم لم يكن حاسماً. فهو لم يقضِ على سلطة الطبقة المالكة ولم يؤدِ إلى إشراك الطبقة الكادحة في السلطة الفعلية ولم يُفضِ إلى استبدال نظام اجتماعي بنظام اجتماعي آخر.
فبالرغم من أن البرلمان أصبح قائماً على مبدأ التصويت العام، ظلت السلطة بيد طبقة معينة من السكان. إذ أن هذه الطبقة تتمتع بامتيازات فعلية واقعية: الثروة ووسائل الدعاية الضخمة والصلات والنفوذ والخبرة والثقافة.
والمعروف أن دخول ممثلي العمال إلى برلمانات أوروبا الغربية لم يحُد من سلطة الطبقة الحاكمة، بل اضطرها فقط إلى تبني أشكال جديدة وأساليب أكثر مرونة.
بل أكثر من ذلك.
في الوقت الذي كان فيه النضال الاجتماعي يدفع البرلمانية باتجاه ديمقراطي، نشأت «عوامل» أخرى كانت تدفع السلطة باتجاه معاكس.
وفي طليعة هذه العوامل، تطور البنية الاقتصادية للنظام الرأسمالي. ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر. نشأت ونمت المؤسسات الاحتكارية الكبرى (الكارتيل والتروست واتحادات الرأسمال الصناعي والمصرفي…) فتحولت الرأسمالية الفردية القائمة على المزاحمة الحرة إلى رأسمالية احتكارية يوجهها عدد من الشركات الضخمة. وكان لا بد أن يؤثر هذا التطور على النظام البرلماني فيحُد من دور البرلمان. إن مجرد وجود الاحتكارات يعطيها قوة كبرى تتخطى الميدان الاقتصادي.
والعامل الثاني، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعامل الأول، سَعي الدول الرأسمالية الغربية للاستيلاء على بلدان آسيا وافريقيا، واقتسام العالم فيما بينها. والمعروف أن هذه الدول قد اتجهت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلى بسط نفوذها على بعض «الدول الكبرى» المستقلة: الامبراطورية العثمانية والامبراطورية الصينية…
وبنتيجة هذين العاملين حدث تحول آخر: نمو الدولة وتبدل دورها. فالدولة لم تعد حارساً للنظام القائم وقوة تضمن «نشاط الدوافع الاقتصادية»،- کما أرادها مفكرو القرن الثامن عشر-. بل هي أداة فعالة تدعم الرأسمالية في الداخل بقوى متزايدة وتوجهها في الخارج من أجل السيطرة على المستعمرات ومناطق النفوذ. هذا الدور الجديد- إلى حدٍ ما على الاقل- يؤدي إلى نمو الجهاز الإداري والعسكري للدولة الرأسمالية- الاستعمارية.
وفي هذه الظروف التي تتميز بنمو الاحتكارات الرأسمالية وتفاقم الصراع من أجل المستعمرات ومناطق النفوذ ونمو أجهزة الدولة، بدأ تقلُص الدور الفعلي للبرلمان وانحطاط النظام البرلماني…
فالبرلمان عاجز عن الاضطلاع بدور توجيهي. وبالرغم من الشركات الضخمة قد أرسلت ممثليها الكثيرين لاحتلال مقاعد المجالس النيابية، إلا انها لا ترغب في وضع الأمور تحت إشراف هذه المجالس. بل هي تتجه بصورة مُطردة إلى وضع هذه المجالس تحت إشرافها وإشراف الدولة، اي تحت إشراف أجهزة القيادة السياسية والاقتصادية.
في سنة ١٩١٤، وافقت البرلمانات الاوروبية على إعلان الحرب… ولكن الحرب قد بُحثت وتقررت خارج هذه البرلمانات: في دوائر الدبلوماسية السرية وفي هيئات الأركان العامة للجيوش الاستعمارية، وفي غرف إدارة الشركات الكبرى…
3- الثورة الروسية والجدال بين لينين وكاوتسكي
وفي إطار الحرب الاستعمارية المروعة، قامت الثورة الروسية… وانفتح النقاش في صفوف حركة العمال الأوروبية حول الديمقراطية والبرلمانية.
لقد كان “كاوتسكى” و”فاندر فيلد” وزعماء الأممية الثانية بشكل عام يؤمنون إيماناً راسخاً بمزايا النظام البرلماني ويعتبرونه دواءً عميم النفع قادراً على معالجة المشاكل الاجتماعية وتحقيق التحول الاشتراكي المنشود. كانوا يرفعون البرلمانية إلى مستوى المؤسسات العالمية الشاملة والحتمية. فهي في نظرهم كسب اجتماعي ذو قيمة مطلقة وشكل لتنظيم المجتمع لا غنى عنه في سير الإنسانية نحو مستقبل أفضل. وكانوا يضعون البرلمانية فوق كل اعتبار، فوق الاشتراكية. فهم عند اللزوم يتخلوّن عن الاشتراكية وعن الثورة. ولكنهم لا يتخلوّن أبداً عن النظام البرلماني! فالديمقراطية هي قانون الأكثرية… والأكثرية البرلمانية المُمَثلة لأكثرية الشعب هي الحاكم الأعلى والمَلكُ الجديد.
لقد كان لويس الرابع عشر يقول : الدولة أنا . أما الآن، فالأكثرية البرلمانية تستطيع أن تقول بفخر: الدولة أنا !
وفي ٧ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۱۷ انتصرت الثورة الاشتراكية في بتروغراد وموسكو. وامتدت إلى جميع أنحاء روسيا ولم تقم هذه الثورة بإرادة برلمان أو أكثرية برلمانية.
وانتُخبتْ جمعية تأسيسية وفق مبدأ التصويت العام. ولم توافق الجمعية على الثورة، لم يوافق على نقل السلطة إلى أيدي مجالس السوفييت.
فصرف لينين هذا «البرلمان» في ٥ كانون الثاني/ يناير ۱۹۱۸ اي بعد الثورة بشهرين.
ووضع دستور الدولة الجديدة في صيف ۱۹۱۸. فنص على ما يلي:
أولاً- تتم الانتخابات وفق مبدأ التصويت العام لجميع الناخبين.
ثانياً- الناخبون هم الشغيلة (والجنود والبحارة)، ويُحرم من حق التصويت والترشيح جميع الذين يستثمرون «عمل الغير»، جميع الذين «لهم مورد غير مورد عملهم الشخصي»، أي كبار ملاكي الأرض، والبرجوازية الصناعية والتجارية، والكولاك (الفلاحون الميسورون)، وكل الذين يستخدمون يداً عاملة، بما فيهم الفلاح أو الحرفي الذي يستخدم أجيراً أو مساعداً. ويُضاف إلى هذه القائمة رجال الأكليروس وأعضاء البوليس سابقاً وأفراد الأسرة المالكة. وهذا يعني أن حق الانتخاب يشمل العمال والفلاحين الكادحين وبشكل عام «شغيلة المدن والارياف».
ثالثاً- يجري الانتخاب على درجتين بالنسبة للعمال (المدن) وعلى ثلاث درجات بالنسبة للفلاحين (القرى).
رابعاً- يتم الانتخاب حسب مبدأ التصويت العلني (نظام رفع اليد).
خامساً- السلطة بيد المؤتمر العام لمجالس سوفييت روسيا (أي مجلس السوفييت الأعلى). ويضم هذا المجلس مندوبي المجالس المحلية في المدن والقرى.
سادساً- ينتخب شغيلة المدن ممثلاً عن كل ٢٥ ألف نسمة. وينتخب شغيلة القرى ممثلاً عن كل ١٢٥ ألف.
فالدستور السوفييتي الأول لم يُحقق «الديمقراطية المتعارف عليها». بل وضع عدة قيود أساسية لهذه الديمقراطية يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط:
1- استثناء قسم من السكان من حق التصويت والترشيح (يقدر بـ ١٤٪ من السكان).
2- اقرار مبدأ التفاوت بين الفلاحين وشغيلة المدن. وهذا التفاوت كبير جداً إذ يبلغ واحد على خمسة، مع العلم بأن سكان القرى كانوا يشكلون حوالي ٪۸۰ من مجموع السكان.
3- نبذ مبدأ الاقتراع السري وإقرار مبدأ التصويت العلني (برفع اليد).
ولقد شن كارل كاوتسكي زعيم الحزب الاشتراكي الألماني حملة شعواء على هذا النظام. واتهم لينين «بالقضاء على الديمقراطية» بقضائه على الجمعية التأسيسية وقال إن لينين والبولشفيك لم ينادوا بحل هذه الجمعية إلا بعد خذلانهم فيها. واحتج بشكل خاص على حرمان صغار أرباب العمل من حق الانتخاب. ويمكننا أن نُلخص تفكير كاوتسكي في المحاكمة التالية: بما أن الكادحين هم أكثرية والمستثمرين المستغلين هم أقلية، وبما أن الأقلية في النظام البرلماني الحديث تُطيع الأكثرية وتخضع لها، فلا داعي لحرمانها من الحقوق، ولا داعي للحد من الديمقراطية والقضاء عليها.
ويستطرد كاوتسكي فيقول: «إن نظاماً يعتمد على تأييد الجماهير لن يستخدم العنف إلا للدفاع عن الديمقراطية، لا لإزالتها. وهو يرتكب انتحاراً فيما إذا أراد القضاء على قاعدته الأمينة، وهي مبدأ التصويت العام، المصدر العميق لسلطة معنوية قوية» (راجع كراس كاوتسكي: دكتاتورية البروليتاريا).
ورد لينين في كتابه المعروف «الثورة البروليتارية والمرتد كاوتسكي». فسَخرَ من فكرة «الديمقراطية الخالصة» واتهم كاوتسكي باتباع طريقة استنتاجية تجريدية في محاكمته. وأكد «أن الديمقراطية البرجوازية… ديمقراطية ضيقة مبتورة، كاذبة ولئيمة، إنها فردوس للأغنياء وخدعة للفقراء».
يتساءل كاوتسكي: ما هي فائدة الدكتاتورية طالما أننا حائزون على الأكثرية وطالما أن الأقلية تُطيع وتخضع. فيرد لينين متهكماً: المستثمَر ليس مساويا للمستثمِر. لقد نجحت الثورة في روسيا. ولكن الاستثمار لا يُقضى عليه دفعة واحدة. ثمة فوارق كثيرة تبقى بين الناس حتى بعد الثورة بكثير. فالمستثمِرون يتمتعون بمزايا عديدة: المال وبعض الأملاك المنقولة، والصلات، والعادات التنظيمية والإدارية، ومعرفة «أسرار» الإدارة (تقاليدها وأساليبها ووسائلها وإمكانياتها)، والثقافة والتعليم، والتعاطف مع السلك الفني والدعم الدولي. بل من المحتمل أن يسير قسم من الكادحين مع الرأسماليين ضد الثورة..
فالقضية ليست قضية علاقة مجردة بين الأكثرية والأقلية وليست مسألة قوى انتخابية وبرلمانية. إن طرح المسألة على هذا الشكل تضليل للشعب وخدمة لأعدائه. أما الجمعية التأسيسية فهي شعار كبار الملاكين الروس والمتدخلين الأجانب. أما شعار العمال والكادحين فهو حكم السوفييت. والتنظيم السوفيتي للسلطة أرقى بكثير من جميع الأنظمة البرلمانية.
لقد أراد لبنين لمجالس السوفييت أن تكون أقرب للشعب من البرلمان. أرادها أن تكون نوعاً من الحكم المباشر والموجه نحو هدف: بناء الاشتراكية. إلا أنه أكد أيضاً أن الطريق السوفييتى ليس الزامياً لجميع الشعوب.
إلا أنه أكد أيضاً أن الطريق السوفييتى ليس الزامياً لجميع الشعوب. والطريق السلمي (والبرلماني) ممكن في بعض الظروف. فالقضية رهن الظروف ولكن الخط العام لتفكير لينين كان بلا ريب: الثورة المُسلحة والحرب الأهلية ومجالس السوفييت.
وقد تطلب الطريق الروسي قيوداً عديدة على الديمقراطية سجلها دستور ۱۹۱۸ وكرسها من جديد دستور عام ١٩٢٤. ودامت المرحلة الانتقالية عشرين عاماً تقريباً. وُبنيت علاقات انتاج اشتراكية في الاتحاد السوفياتي.
وأعلن دستور ١٩٣٦ انتهاء المرحلة الانتقالية فَعَرّف بوضوح حقوق وواجبات المواطنين وألغى الفوارق الانتخابية بين سكان المدينة والريف، ومنح حق التصويت لجميع المواطنين بلا استثناء، وألغى علنية الاقتراع فأصبح التصويت عاماً ومتساوياً وسرياً ومباشراً.
ولكن في الوقت الذي تبنى فيه الاتحاد السوفياتي الدستور الديمقراطي للنظام الاشتراكي، بلغت التجاوزات والمخالفات الفعلية حداً لا مثيل له (۱۹۳۷- ۱۹۳۸) تلك مشكلة تخرج عن نطاق هذا البحث.
أما كاوتسكي والاشتراكيون الألمان الذين تخلوا عن الثورة حباً بالديمقراطية وتمسكاً بالنظام البرلماني، فلم يبنوا علاقات إنتاج اشتراكية. ولم يحافظوا على النظام البرلماني. وسقطت الديموقراطية في ألمانيا في عام ١٩٣٣.
**** **** ****
في عام ۱۹۱۸، قُضي على النظام البرلماني في روسيا «قبل ظهوره».
وفي عام ۱۹۲۲، انتصرت الفاشستية في إيطاليا. ثم انتصرت في ألمانيا عام ۱۹۳۳. وقوي الاتجاه إلى الفاشستية في معظم بلدان أوروبا.
فالأزمة التي يعانيها النظام البرلماني ليست عَرَضية طارئة نجمت عن أهواء بعض «المنحرفين» إنها أزمة أساسية عميقة تستمد جذورها من تطور المجتمع الرأسمالي نفسه ومن أزمته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
لقد انفتحت الأزمة مع الحرب العالمية الأولى، وتوسعت وتعمقت بعد الحرب. وفي سنة ۱۹۲۹، أصيب الاقتصاد الرأسمالي بهزة عنيفة. وغدا من الواضح أن النظام الرأسمالي لم يعد كما كان قبل خمسين عاماً. فالأزمة الاقتصادية لأعوام (۱۹۲۹-۱۹۳۳) أكثر عمقاً وأوسع شمولاً وأطول مدى وأشد فتكاً من الأزمات الدورية المألوفة. وبعد فترة قصيرة من النمو والازدهار (۱۹۳۳- ۱۹۳۷)، هبط الإنتاج وازدادت البطالة من جديد (۱۹۳۸- ۱۹۳۹). و«حُلت» الأزمة بالحرب العالمية الثانية.
وأسفرت الحرب عن تبدلات جذرية… وعادت الحياة البرلمانية إلى إيطاليا وألمانيا بعد انقطاع طويل. وحدثت تبدلات تقدمية في تركيب معظم برلمانات أوروبا. فهل يصبح البرلمان أداة التحول الاجتماعي? هل يتجاوز النظام البرلماني نفسه؟
سرعان ما حدثت الردة !.. ولسنا هنا في مجال تحليل أسباب هذه الردة ولكن لا بد لنا من الإشارة إلى أن القوى التي كان مفروضاً فيها أن تطرح السؤال: هل يصبح البرلمان أداة التحول? تجنبت طرح هذا السؤال وتبين أن أزمة النظام البرلماني لم تنتهِ. بل هي آخذة في الاتساع والتعمق.
٤ – حدود النظام البرلماني
فالحكم بيد جهاز الدولة والاحتكارات. والاتجاهات البيروقراطية تنمو يوماً بعد يوم في جميع الميادين. بل وأخذت الحكومة «تغزو» ميدان التشريع أيضاً. فمنذ عام ١٩٤٨، مُنحت الحكومة في فرنسا حق إصدار مراسيم لها صفة القانون.
هذا يقودنا إلى بحث صلاحيات الدولة في الحقل التشريعي.
يقوم النظام البرلماني مبدئياً على أن السلطة التشريعية- السلطة الأولى- هي بيد البرلمان: فهو الذي يُصدر القوانين وهو الذي يراقب الحكومة المسؤولة عن تنفيذ هذه القوانين. ولكن أليس للحكومة حقوق وصلاحيات في الحقل التشريعي؟
– ليس للحكومة في هذا الحقل حقوق وصلاحيات فحسب، بل إنها في الواقع تسيطر عليه، رغم العوائق التي يقيمها القانون بوجه هــذه السيطرة.
أولاً: الدولة تكاد تحتكر المبادهة في حقل التشريع. فمعظم القوانين التي صدرت في فرنسا وبريطانيا مثلاً قد هيأتها الحكومة وصاغتها وقدمتها للبرلمان.
ثانياً: إن المراسيم الاشتراعية والأوامر التنظيمية التي تصدرها الحكومة والسلطة الإدارية الخارجة عن نطاق البرلمان والمستقلة عنه تزداد أهمية يوماً بعد يوم. والجدير بالذكر أن جميع الإصلاحات التي أنجزت في فرنسا في عهد حكومة الجبهة الشعبية (١٩٣٦- ١٩٣٧) كانت مراسيم اشتراعية.
ثالثاً: في عدد من بلدان أوروبا (كبريطانيا مثلا) يطبق مبدأ «انتداب السلطة التشريعية»… وبموجب هذا المبدأ، يتخلى البرلمان عملياً عن الكثير من صلاحياته.
تلك هي صلاحيات «السلطة التنفيذية» في الحقل التشريعي. تلك هي بعض حدود النظام البرلماني، بعض حدوده الرسمية المكرسة في القانون.
ولكن ثمة جانب أخطر هو الجانب الواقعي العملي… إذ أن الفرق شاسع بين القانون والواقع.
فالبرلمان مبدئياً هو السلطة العليا والحكومة تنبثق عنه ومسؤولة أمامه. ولكن السلطة الفعلية هي في الواقع بيد الحكومة والإدارة العليا والاحتكارات الاقتصادية.
مبدئياً قاعة البرلمان هي مركز ثقل النشاط السياسي.
ولكن هذا المركز قد انتقل في الواقع من قاعة البرلمان إلى أروقة البرلمان ومكاتب الإدارة الحكومية.
مبدئياً يتمتع النواب بحرية نقاش غير محدودة، ولكن في الواقع هذه الحرية محدودة. والبرلمانات تطبق «طريقة الاستعجال» في بحث بعض القضايا السياسية وبعض مشاريع القوانين.
مبدئياً البرلمان هو السلطة العليا التي تشرف على كل حياة البلاد. ولكن الواقع أن الدولة هي التي توجه الاقتصاد بواسطة مراسيم وأوامر تتخذها بدون استشارة البرلمان وبواسطة «تعليمات خاصة» تصدرها للمصارف الكبرى وعن طريق المباحثات السرية مع ممثلي الدوائر الاقتصادية، وقد أصبح تدخل الدولة الدائم والشامل الشرط الطبيعي لسير الجهاز الاقتصادي والاجتماعي.
مبدئياً البرلمان هو المرجع الأعلى الذي يشرف على القضايا السياسة الحيوية- كمسألة الحرب مثلاً- وله وحدهُ حق الفصل في مثل هذه الأمور. ولكن واقع النهج العملي الذي تسلكه الدول «الديمقراطية» غير ذلك. إن العدوان الثلاثي على مصر لم يُبحث في برلمانات باريس ولندن. وكان مفاجأة لها. لقد هُيء العدوان ضمن حلقة ضيقة… والحُجة أن حملة السويس لم تكن (حرباً) بل كانت فقط عملاً «بوليسياً تأديبياً»!!
إن الدوائر الاستعمارية تتمتع بأكثرية برلمانية مضمونة… ومع ذلك فهي لا تُشرك البرلمان في مثل هذه «الطبخات». إن نظام عمل البرلمانات- حتى الموالية المطواعة- لا يتفق مع مقتضيات القرصنة الاستعمارية في عصر تحرر الشعوب. بل من الضروري بالنسبة لهذه الدوائر إبعاد الرأي العام الداخلي والدولي عن المشاكل الأساسية، وتضليله وتخديره.
وإليكم ما قاله بهذا الشأن أحد الكتاب الفرنسيين:
«إن مبدأ السرية الذي يحكم المشروعات الاقتصادية الرأسمالية يحكم أيضاً شؤون الدولة. وبالكاد تقوم الحكومات باطلاع البرلمان من حين لآخر. والملاحظ أن البرلمان نفسه لم يفتح قط نقاشاً حاسماً حول المشاكل الأساسية كمشكلة السكن والعلاقة بين الأسعار والأجور. إنها ديمقراطية غريبة لا تتفضل بأن تشرح للشعب مشاكل حياته وصحته. والنقاش العلني ينحصر في مشاحنات تقليدية ما زالت تغذي الانتخابات منذ قرن، في حين أن المشاكل الحقيقية للدولة الحديثة لا تناقش بل ولا تطرح، إنما تبقى من امتياز بعض ذوي الاختصاص ولا يعمد الحكام إلى «قول الحقيقة الشعب» الا في الأزمات الخطيرة. وكثيراً ما يكون ذلك بعد فوات الأوان.. ». (جان- ماري دومناك: « الدعاية السياسية»).
**** **** **** **** ****
في الوقت الذي كانت فيه الدول الغربية تُدير ظهرها للديمقراطية البرلمانية، في هذا الوقت بالذات أخذت تبذل ما بوسعها لإقناع شعوب الشرق بفوائد النظام البرلماني… ولا يستطيع أحد القول إنها قد أصابت النجاح في مساعيها هذه. فقد نهجت الثورات الوطنية الكبرى طرقاً أخرى تتفق مع ظروفها وحاجاتها. وهذا ما تلاحظه في تجارب الثورات الصينية والأندونيسية والعربية.
5 – الـثــورة الصينيـــة
الصين لم تعرف النظام البرلماني في ظل الاستعمار والإقطاعية. ولم يناضل الشعب الصيني من أجل النظام البرلماني بل ناضل من أجل التحرر الوطني والاجتماعي…
واتجهت الثورة الصينية إلى شكل جديد للحكم يقوم على «المؤتمرات الشعبية» (أو المجالس الشعبية). فقد أعلن ماوتسي تونغ أن نظام الصين هو «دكتاتورية الديمقراطية الشعبية». ونص «البرنامج المشترك للاجتماع السياسي الاستشاري للصين الشعبية» على «أن المؤتمرات الشعبية والحكومات الشعبية في جميع المستويات (الناحية والمدينة والقضاء والمحافظة والدولة) هي هيئات ممارسة سلطة الدولة من قبل الشعب». كما جاء ايضاً في القانون الأساسي للحكومة الشعبية المركزية «إن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي حكومة نظام المؤتمر الشعبي القائم على مبدأ المركزية الديمقراطية».
وبالاستناد إلى هذه المبادئ وإلى دراسة اوضاع الصين الراهنة في ظل «دكتاتورية الديمقراطية الشعبية» وتطورها خلال السنوات الأولى من الثورة وبالاعتماد على تجربة الانتخابات في الاتحاد السوفياتي، أقرت الحكومة الشعبية المركزية في عام ١٩٥٣ القانون الانتخابي لجمهورية الصين الشعبية. وينص القانون على ما يلي:
أولاً: يتم الانتحاب على درجات. فنواب المؤتمر الشعبي لعموم الصين وكذلك نواب المؤتمرات الشعبية في مستوى المقاطعة والقضاء والمدينة المقسومة إلى دوائر يُنتخبون من قبل المؤتمرات الشعبية في المستوى الأدنى. أما نواب المؤتمر الشعبي في الناحية أو البلدة أو المدينة غير المقسومة إلى دوائر فيُنتخبون من قبل الناخبين مباشرة (المادة ٣).
ثانياً: التصويت سري وعلني. فانتخاب نواب المؤتمر الشعبي في المستويات الدنيا يتم برفع اليد أو بالاقتراع السري. أما انتخاب المؤتمر الشعبي في المستويات العليا فيجري بالاقتراع السري فقط (المادة ٥٥).
ثالثاً: حرمان بعض الفئات من حق التصويت والترشيح. «عناصر طبقة ملاكي الأرض الذين لم يُسوَ وضعهم القانوني بعد، وأعداء الثورة الذين حُرموا من الحقوق السياسية بموجب القانون، وغيرهم من الذين حُرموا من هذه الحقوق (المادة ٥). والجدير بالذكر أن هذه القائمة أضيق من مثيلتها في الدستور السوفييتي الأول. هذا يعود إلى اختلاف النظامين السياسيين واختلاف التوزيع الطبقي للقوى الصديقة والقوى العدوة في الثورتين الروسية والصينية.
رابعاً: إقرار مبدأ التفاوت بين العمال والفلاحين على غرار الثورة الروسية. وعلى هذا الأساس، فعدد النواب الذين تنتخبهم المقاطعة إلى المؤتمر الشعبي لعموم الصين يكون على أساس نائب واحد لكل ۸۰۰ ألف شخص. أما عدد النواب المُنتخبين من قبل المدينة التابعة مباشرة لسلطة الحكومة المركزية ومن قبل المدينة الصناعية التي يزيد سكانها عن ٥٠٠ ألف والتابعة مباشرة لسلطة حكومة المقاطعة فيكون على أساس واحد لكل ١٠٠ الف شخص (المادة۲۰). ويُراعى المبدأ نفسه في انتخاب المؤتمر الشعبي على مستوى المقاطعة والمدينة والقضاء.
والجدير بالذكر أن التفاوت بين الريف والمدينة (نسبة واحد على ثمانية) أكبر منه في الاتحاد السوفيتي (واحد على خمسة) ويبرر «تنغ سياو بنغ» هذا المبدأ على النحو التالي:
«المدن هي مراكز سياسية واقتصادية وثقافية. إنها مراكز تجمُّع العمال والصناعات. فالإجراء الذي ينص على أن عدد الأشخاص الذين يمثلهم كل نائب مختلف بين المدينة والمنطقة الريفية يعبر في الواقع عن الدور القائد للطبقة العاملة في الدولة، كما يشير في الوقت نفسه إلى تقدم بلادنا نحو التصنيع. فهو يتفق كلياً مع النظام السياسي ومع الشروط الراهنة لبلادنا وهو ضروري وصحيح تماماً».
إذن يمكننا القول أن الصين الشعبية، شأنها شأن الاتحاد السوفياتي في المرحلة الانتقالية (١٩عام)، لم تنبذ النظام البرلماني فقط، بل فرضت أيضاً عدداً من القيود على الديمقراطية المرعية الاجراء في بلدان أخرى. إن الصين الشعبية تنادي بالديمقراطية، ولكنها ترفض البرلمانية.. لقد اتخذت من الإجراءات القانونية ما تعتبره ضرورياً لمرحلتها الانتقالية. إن هدف الصين بناء مجتمع اشتراكي. وهي تلجأ إلى الوسائل التي تعتبرها ناجعة لتحقيق غايتها.
6 – الـثـورة الأندونيسيـة
سلكت أندونيسيا طريقاً معقداً فيه الكثير من «التلمسات» والانعطافات. ومرد ذلك إلى ظروف هذه البلاد وظروف نضالها الوطني.
ثلاثة آلاف جزيرة تختلف من حيث الحجم والكثافة والأصل العرقي ومستوى التطور الاقتصادي والثقافي… عانت الاستغلال والاستعباد مئات السنين ولم تتحرر من النير الاستعماري إلا بعد معركة طويلة وشاقـة.
في ۱۷ آب/ أغسطس ١٩٤٥، أعلنت الجمهورية وانتُخب سوكارنو رئيساً لها. ولم يُلق الاستعمار السلاح، بل عمد إلى المكر والخداع. وشجع الحركات الانفصالية معلناً «استقلال» بورنيو وبالي وجزر سيليب. ثم لجأ إلى العدوان السافر، وأقام حكومات موالية في شرقي سومطرة وغربي جاوا. وعملت القوات الهولندية إلى «استرجاع» المناطق الأخرى واعتقلت الحكومة الوطنية المركزية (أواخر عام ١٩٤٨)… إلا أن المقاومة الشعبية العارمة اضطرت المُعتدين إلى التراجع، وفازت أندونيسيا باستقلالها.
وعملَ الشعب الأندونيسي على بناء وحدته الوطنية، بينما أخذت الدول الاستعمارية والقوى الرجعية تشجع «النظام الفيديرالي» وتدير الحركات الانفصالية.
لقد تبنت أندونيسيا في عام ١٩٤٥ وفي خضم الثورة الوطنية دستوراً رئاسياً يجمع رئيس الجمهورية سلطات واسعة ويحصر النشاط السياسي والحزبي «في حدود المصلحة القومية». واعتُبر هذا الدستور بادئ الأمر دستور مرحلة انتقالية قصيرة.
وتبنت الجمعية التأسيسية المنتخبة دستوراً جديداً، أباح تشكيل الأحزاب دون قيد وأقر النظام البرلماني الغربي. فأصبح الوزراء مسؤولين أمام البرلمان.
ولم ينقذ النظام البرلماني أندونيسيا من المتاعب. بل زاد مشاكلها. وتعرضت البلاد لحملات عنيفة من الخارج والداخل. وقامت الحركات الانفصالية من جديد وكانت هذه القوى تتستر بشعارات «الديمقراطية» و«عدم تقييد الحريات» ومحاربة «البيروقراطية والمركزية والدكتاتورية».
فنزل سوكارنو إلى الميدان من جديد. وأعلن أن الحملات ضد «المركزية» و«البيروقراطية» و«أساليب الحكم الدكتاتوري» قد أساءت كثيراً لأندونيسيا وطالب بتغيير الاتجاه معلناً ان الديمقراطية التي اقتبستها أندونيسيا ديمقراطية مستوردة لا تتفق مع روح الشعب. وطلب الرجوع إلى مبادىء الثورة: شعب واحد- وطن واحد- لغة واحدة.
دعا سوكارنو إلى انتهاج طريق إندونيسي خاص، طريق الديمقراطية الأندونيسية الموجهة… وذلك بالعودة إلى دستور ١٩٤٥ الديمقراطي الرئاسي.
وتقرر أن تجري الانتخابات الجديدة في هذا العام وفق قانون جديد للانتخابات. وبعد صدور قانون جديد للأحزاب.
واجتمعت الجمعية التأسيسية لتقر العودة إلى دستور ١٩٤٥. ولكن الخلاف بين الأحزاب عرقل صدور القرار…
ولم تجد اندونيسيا حلاً لقضية التقدم الاجتماعي ولقضية الديمقراطية. وما زالت تتلمس طريقها.
7 – الثــورة العربيـــة
خاض الشعب العربي في كافة أقطاره نضالاً طويلاً ضد الاستعمار والرجعية. وكانت أهداف هذا النضال الاستقلال والوحدة. ولم يكن «النظام البرلماني» مطلباً أساسيا من مطالب الحركة الوطنية. بل كان «في أحسن الحالات» نتاجاً- ونتاجاً ثانوياً- في المعركة بين الشعب العربي والاستعمار.
في مصر: ولد البرلمان في عام ١٩٢٤، وكان من ثمار ثورة ۱۹۱۹. ولكنه بقي عاجزاً عن تحقيق ما ينشده الشعب من تحرر سياسي واجتماعي..
وبينما كان الشعب المصري يقاسي أبشع أنواع الاستغلال والاضطهاد، كانت القوى الرجعية تحاول إظهار مصر بمظهر «المملكة الديمقراطية البرلمانية» على غرار بلجيكا أو هولندا أو السويد.. (۲۰) مليون فلاح محرومون من كل شيء وسجون ملأى بالأحرار، وملك فاجر يعبث بكرامة البلاد من جهة.. و«برلمان مثالي» من جهة أخرى !!. محاولة تضليل واسعة النطاق تستند على السياسة التقليدية التي انتهجها العرش منذ القرن التاسع عشر والرامية إلى إخراج مصر من أحضان القومية العربية وجعلها «بلداً من أوروبا»..
ذلك لم يكن رأي شعب مصر، ولم يكن رأي جيش مصر الذي قضى على هذه السياسة عندما نهض في سنة ۱۸۸۲ بقيادة أحمد عرابي، ثم نهض من جديد في سنة ١٩٥٢ بقيادة جمال عبد الناصر ثائراً لكرامة الشعب المصري ومدافعاً عن عروبته.
فالبرلمان لم يُحقق لشعب مصر العربي أهدافه الوطنية والاجتماعية… لقد كُتب جل تاريخ مصر خارج البرلمان. ويمكننا القول إن البرلمان المنتخب من قبل الشعب كان أقل تمثيلاً لهذا الشعب من هيئة «غير منتخبة»: الجيش وضباطه الأحرار.
هذا ما نلاحظه ايضاً في تاريخ سوريا.
فالمعروف أن «أصحاب النفوذ والمصالح» كانوا أسياد البرلمان. بل وسيطرت فيه أحياناً اكثرية مشبوهة عملت لمشاريع استعمارية. أما الانتخابات فكانت تشهد تدخل جهات أجنبية وتكتلات غير مبدئية ولا أخلاقية. وقد ثبت في عام ١٩٥٦ وفي أوج معركة العروبة ضد العدوان الاستعماري أن عدداً من الجواسيس المأجورين كانوا يجلسون منذ سنوات على مقاعد البرلمان ليطعنوا الشعب الذي منحهم ثقته..
ليس البرلمان هو الذي حقق انتصارات الشعب الكبرى. وليس البرلمان عبأ الشعب في المعارك الكبرى، بل القوى الواعية في الجيش والقوى الواعية في الشعب. في سورية كما في مصر، لم يكن البرلمان «المنتخب من قبل الشعب» ممثلاً أميناً صادقاً لهذا الشعب. فقد اثبت ضعفه في المعارك كما أثبت عجزه الكامل في حقل الإصلاح الداخلي.
وهذه الحقائق ثبتت أيضاً في تجربة العراق ولبنان ومعظم الاقطار العربية. فإن تجربة الوطن العربي من الخليج إلى المحيط، تدل على أن الأحداث العربية الكبرى قد وقعت خارج البرلمان.. صنعتها قوى خارجة عن البرلمان. ولم يكن لها في كثير من الأحيان صلة بالبرلمان والقوى الممثلة فيه.
إن تاريخ الثورة العربية.. ثورة ٢٣ يوليو/ تموز، ثورة الجزائر، ثورة ١٤ تموز الخ.. قد كتب خارج البرلمانات.
**** **** **** **** **** **** ****
8 – الخـــــلاصـــة
من هذه الدراسة لتطور النظام البرلماني ولأوضاعه الراهنة، ومن هذه اللمحة السريعة عن تجربة الشعوب الشرقية، يمكننا أن نستخلص النتائج التالية:
1- ليس النظام البرلماني نظاماً عاماً شاملاً، إنه نظام تاريخي خاضع للنشوء والتطور والزوال. ولا يجوز الحكم عليه بمعزل عن الظروف والأوضاع المحيطة به، ظروف الزمان والمكان، ظروف البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة والثقافية.
2- لقد نشأ النظام البرلماني مع نشوء الرأسمالية وتطور بتطورها. وبلغ أوجهُ مع أوج الرأسمالية الغربية (۱۸۸۰- ١٩١٤) وسيطرتها على العالم. ولكن في تلك الفترة نفسها ظهرت العوامل التي سوف تؤدى إلى انحطاط النظام البرلماني: تحوّل الرأسمالية الحرة إلى رأسمالية احتكارية، نمو جهاز الدولة الإداري والعسكري.
3- بدأ انحطاط النظام البرلماني على أثر الحرب العالمية الأولى مع انحطاط الرأسمالية والاستعمار. إذ عمدت الطبقات الحاكمة في الغرب إلى حل مشاكلها الداخلية والخارجية بالقضاء على النظام البرلماني (ايطاليا، ألمانيا..) أو الحد منه (البلدان الاخرى).
4- ازدادت أزمة البرلمانية عمقاً واتساعاً بعد الحرب العالمية الثانية مع تفاقم أزمة النظام الاستعماري وتحرر عدد كبير من شعوب آسيا وأفريقيا. وهذا يَظهر بشكل خاص في فرنسا. إذ أصبحت أزمة الاستعمار الفرنسي في الخارج- حرب الهند الصينية ثم حرب الجزائر.. الخ- العامل الرئيسي الأول في سياسة فرنسا الداخلية. وأدت إلى انحطاط النظام البرلماني أولاً (الغاء مبدأ التمثيل النسي)، ثم إلى سقوط «الجمهورية الرابعة».
5- في الصراع المحتدم بين الاستعمار والشعوب، يلجأ الاستعمار بشكل متزايد إلى تضييق البرلمانية أو القضاء عليها، سواء في الأقطار الاستعمارية نفسها في البلدان السائرة في فلكها.. وهو في الوقت نفسه، يبذل مساعيه لخداع الشعوب المُتحررة بفضائل النظام البرلماني، ويعمد أحياناً إلى انشاء «برلمانات» في المستعمرات. (سياسة انكلترا في أفريقيا، سياسة ديغول في الجزائر).. ويجمع أسلوب «الانتخابات» مع أسلوب البطش والإرهاب.
6- إن معظم بلدان آسيا وأفريقيا التي تحررت من نير الاستعمار تبتعد عن النظام البرلماني الغربي، وتسلك طرقاً أخرى باحثة عن تنظيم جديد للسلطة وأشكال جديدة للديمقراطية: الصين، أندونيسيا، الجمهورية العربية المتحدة.
وهي في سلوكها هذا السبيل، تعتمد على معطيات تاريخ الحركة الوطنية في بلادها وعلى حاجاتها الراهنة. فالنضال السياسي ضد الاستعمار وقوى التجزئة والانقسام وضرورات التصنيع السريع والتنمية الاقتصادية تحتاج إلى تمركز السلطة وإلى التخطيط الشامل للطاقات البشرية والاقتصادية.
7- إن ازمة النظام البرلماني ليست حدثاً عارضاً أو موقتاً أو محدوداً. إنها حقيقة عامة لها قيمة القانون الموضوعي. وابتعاد المجتمع العربي عن هذا النظام ليس بدعة فرضها نفر من الناس، وليس محض «تجربة» أو «محاولة» كما يتصور البعض.
إنما هو تحول أساسي تفرضه أوضاع الشعب العربي ونضال القومية العربية وحاجات البناء الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. كما يتفق أيضاً مع قوانين التاريخ الموضوعية.
8- إن زوال النظام البرلماني لا يعني حتماً زوال الديمقراطية. بل يعني الانتقال إلى ديمقراطية أسمى وأوسع وأعمق، بطرق شاقة ومتعرجة تختلف من بلد لآخر(1).
***** ***** *****
ملاحظات إضافية
1- التجربة الهندية تجربة برلمانية. إلا أن هذه التجربة هي «الاستثناء الذي يثبت صحة القاعدة العامة». فهي تقوم في مجتمع ذي تركيب بشري وطبقي خاص. وإن للدور الفذ الذي يلعبه شخص “نهرو” سمة تتعارض مع البرلمانية التقليدية.
ولا يمكن أن نعتبر التجربة الهندية تجربة رائدة. ذلك لأن تقدم الهند في الحقلين الاجتماعي والاقتصادي تقدم بطيء، رغم نوايا “نهرو” واتجاهاته التقدمية. وإن أهم ما كسبته الهند من الحضارة الحديثة هو انخفاض نسبة الوفيات، وهذا يخلق ضغطاً ديموغرافيا (سكانياً) متزايداً، الأمر الذي يُهدد الهند بانخفاض جديد في مستوى معيشة الشعب، إذا لم تتعاظم معدلات الإنماء الاقتصادي.
ولقد أشرنا إلى دور “نهرو” الشخصي، وإن غياب “نهرو” عن المسرح السياسي يمكن أن يكون عاملاً من عوامل تغيّر توزيع القوى السياسية وبالتالي تغيّر طريق التطور السلمي والبرلماني.
2- لقد انتخبت الجزائر الثورية مجلساً تمثيلياً مركزياً. ولكن نظام الحزب الواحد والدور الذي يلعبه هذا الحزب وطريقة الترشيح للمجلس المذكور تعني بشكل واضح أننا لا نواجه في التجربة الجزائرية نظاماً برلمانياً، إنما نواجه نظاماً ديمقراطياً ثوريا أرقى، يُشكل المجلس التمثيلي إحدى وسائله الأساسية. وإن مؤتمر الحزب هو الذي سيقرر شكل الحكم مستوحياً ميثاق الثورة الجزائرية الذي نبذ المفهوم التقليدي البرلماني للديمقراطية.
3- إن ظاهرة «فردية الحكم»، ونقصد اتخاذ الحكم طابعاً فردياً (أديناور، ديغول) هي مرحلة جديدة في تداعي النظام البرلماني، تُرافق بداية الثورة الصناعية الثانية. وتتمثل هذه الثورة في التقدم المتسارع للعلم واستخدام الأجهزة الإلكترونية في الانتاج وتحقيق أوتوماتيكية (آلية) العمل. إن متطلبات الثورة الصناعية الثانية تتخطى طاقات الرأسماليين وطاقات الشركات والاحتكارات الرأسمالية وتستلزم توسع تدخل الدولة في عملية الانتاج.
إن تدخل الدولة في الاقتصاد الرأسمالي ظاهرة قديمة تعود إلى نصف قرن. ولكن تلك هي المرة الأولى التي يبلغ فيها تدخل الدولة مثل هذا المدى، ويتخذ طابعاً توجيهياً وإلى حد ما تخطيطياً.
فالدولة الرأسمالية، في عصر الثورة الصناعية الجديدة والتسابق العلمي والاقتصادي، هي وحدها تستطيع أن تتولى تمويل مشروعات الطاقة النووية وغزو الفضاء، وهي مضطرة أن تقوم ببتر الأجزاء الفاسدة أو المُعرقلة في الجسم الرأسمالي وأن تتخذ الخطوات اللازمة الجريئة في ميدان الإنتاج، وهي التي تستطيع أن توجه عملية الالتقاء مع الرأسماليات الأخرى، وإنشاء مجموعات اقتصادية تتخطى حدود الوطن (كالسوق الاوروبية).
وفي هذه الحال، فإن الدولة، باعتبارها الممثلة للرأسمالية القومية ككل ولمصلحة التطور الرأسمالي القومي تتغلب كلياً على البرلمان، باعتباره حلبة تَطاحُن الرأسماليات الخاصة.
– البرلمان لا يزول ولا يُحذف. ولكنه يتداعى وكأنه يسير في طريق الانقراض-.
وتتمثل «الدولة» في الرئيس والجهاز الإداري المحيط به.
فالديغوليـة ليست وليـدة عبقريـة الجنرال ديغول بقدر ما هي وليـدة تطور موضوعي للرأسمالية الفرنسية.- إن «عبقرية» ديغول تكمن في أنه فهم هذا التطور، وأعلن أنه يسعى إلى بقاء الديغولية بعد وفاة ديغول-. وهذا ما يجب أن يفهمه التقدميون في فرنسا وأوروبا الغربية، وأن يبحثوا عن سُبل جديدة للتطور وعن أشكال جديدة للديمقراطية، إذا ما أرادوا أن يقضوا على الحكم الفردي وأن يفتحوا سُبلاً جديدة للتاريخ.
4- في سورية:
إن مجلس كانون (كانون الأول ١٩٦١) هو نموذج لما تردّى إليه النظام البرلماني البرجوازي. إن انحطاط النظام البرلماني في سورية ليس نتيجة لقُصر نظر الرجعيين، ولعدم استماعهم إلى نصائح أصدقائهم «التقدميين» من أعداء «الوحدة الدكتاتورية»، بقدر ما هو نتيجة البنيان الاجتماعي- الاقتصادي- السياسي للمجتمع. فالنظام البرلماني في سورية وفي غيرها من بلاد الشرق، فضلاً عن العيوب العامة للنظام البرلماني (التفاوت الطبقي وعدم التكافؤ في وسائل الدعاية الانتخابية وغيرها من وسائل الضغط)، يتصف بعيوب أخرى تنجم عن رواسب البنيان الإقطاعي والقبلي التي تَسِم المعركة الانتخابية بطابع العصبيات العشائرية والطائفية والمحلية وتخلق هوة بين الشعب وبين البرلمان الذي انتخبه «هـذا» الشعب. وإن هذا التناقض يجد «حلـّه»- المؤقت- في الانقلاب العسكري. فالبرلمان اليميني والانقلاب العسكري شبه- اليساري هما حلقتان متكاملتان في أزمة الحكم في سورية البرجوازية- الإقطاعية، القبلية.
5- البرلمانية لا تعني فقط وجود «برلمان» (أي مجلس تشريعي). إنما هي نظام كامل يقوم على توزيع السُلطات الثلاث، وتعدد الأحزاب، و«اللعبة البرلمانية»، ورئيس جمهورية لا يحكم… برلمان يتناقش ولا يفعل. ومن الغباء أن يتصور النائب أن مناقشاته مع زملائه هي التي تقرر سير التطور وأن كل ما يحدث خارج جدران قاعة البرلمان لا قيمة له. هذا ما أسماه “إنجلز” مرض «الغباء البرلماني».
وليس الثوريون العرب من أصحاب هذا الغباء، وهم سوف يعملون لديمقراطية تتمثل في مجالس شعبية متنوعة على النطاق القومي والإقليمي والمحلي، وعلى نطاق مشروعات الإنتاج، ديمقراطية تلعب فيها النقابات والهيئات الشعبية الأخرى دوراً كبيراً فعالاً، ويلعب فيها التنظيم السياسي الثوري دور القائد. وإن ديمقراطية التنظيم السياسي القيادي هي من أهم أسس وضمانات ديمقراطية الدولة الاشتراكية.
6- وبهذه المناسبة، لا بد أن نقول كلمة عن فكرة الاستفتاء الشعبي المباشر، إذ أن هذه الفكرة مطروحة في سورية منذ عام تقريباً.
إن أنصاف المثقفين «الديمقراطيين» الذين جعلوا من أنفسهم حُراساً للرأسمالية والرجعية والذين يشعرون بانفصالهم عن الشعب، يحملون على فكرة الاستفتاء ويُلصقون بها تُهم الديماغوجية والبونابرتية… إلا أنهم يجهلون أو يتجاهلون الاستفتاء التشريعي referendum الذي أقره دستور الثورة الفرنسية في عام 1793، والذي ضَمنَ انتصار النظام الجمهوري على المَلكية في إيطاليا عام ١٩٤٥.
وقد فضح أحد أعضاء اللجنة السباعية الرجعية في سورية «خفايا» القضية، عندما أدلى في شهر حزيران/ يونيو ١٩٦٢ بتصريح لوكالة الصحافة الفرنسية قال فيه إن اللجنة المذكورة لا يمكن أن تقبل بالاستفتاء على قضايا الشعب الحيوية، وأن تقرير هذه القضايا يجب أن يكون محصوراً في البرلمان المنتخب…
وكما أن أشكال النضال لا يمكن أن تكون أشكالاً محددة تحديداً مطلقاً، بل تمليها اعتبارات «الفائدة والمُلاءمة» على حد تعبير لينين، كذلك فإن أشكال الديمقراطية لا يمكن أن تكون أشكالاً الزامية واحدة في جميع الظروف.
إن تجارب الثورات الشعبية الكبرى تدل على أن الثورة لا يمكن أن تتقيد بالديمقراطية الشكلية والمطلقة. إنما تسير نحو هدف محدد، بالوسائل المؤدية للهدف.
شباط/ فبراير ١٩٦٣ الياس مرقص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش:
(۱) نشر هذا البحث في جريدة الجماهير الدمشقية، تموز/ يوليو 1959.
……………………………………………………….
يتبع.. الحلقة السادسة عشرة بعنوان: (العالم الثالث والثورة الدائمة).. بقلم الأستاذ “الياس مرقص”
