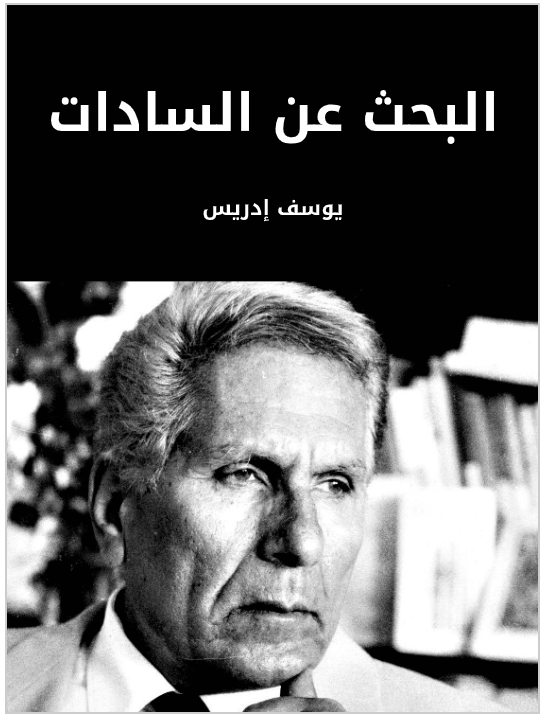
يقول د. إدريس: «وحين قرأتُ مذكرات محمد إبراهيم كامل، وجدتُ أن مصر قد أُضيرت ضررًا هائلًا بمُبادَرة السلام وباتفاقياتِ كامب ديفيد، وأن كُنهَ هذا الضررِ وأبعادَه شيء لا يُمكِن معرفته إلا بالرجوع إلى مذكرات الرجل الذي شَهِد تلك المُفاوَضات من داخل المعسكر الساداتي نفسه».
يَضمُّ كتاب البحث عن السادات مجموعةَ المقالات التي كتبها «يوسف إدريس» في مجلة «القبس» الكويتية، والتي تتناول وجهةَ نظره في «أنور السادات»، بعد توقيعه «معاهدة السلام» مع «إسرائيل»، وما تَرتَّب عليها من نتائج، مُستنِدًا إلى مذكراتِ «محمد إبراهيم كامل» وزير خارجية مُفاوَضات كامب ديفيد، ومذكراتِ السياسي الأمريكي «كيسنجر»، ومُسلِّطًا الضوء على إدارة «السادات» وسياساته؛ بدايةً من انقلاب «١٥ أيار/ مايو» الذي أطاح بكل ما تَبقَّى من رجال «عبدالناصر» وسياسته، وحتى سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتَّبعها «السادات»، وما تَرتَّب عليها من آثارٍ اجتماعية واقتصادية.. كما تَطرَّق «يوسف إدريس» إلى مشاعره تجاه «مُبادَرة القدس» بين التفاؤل والإحباط، وغيرها من القضايا التي اقترنَت بتلك المرحلة، في مُحاوَلة لمعرفةِ حقيقةِ ما جرى.
ونقدم أدناه الفصلين الأخيرين من الكتاب مع الخاتمة كنموذج على سلوك العمالة والخيانة الساداتية المتأصلة به,
تراجيديا السياسة: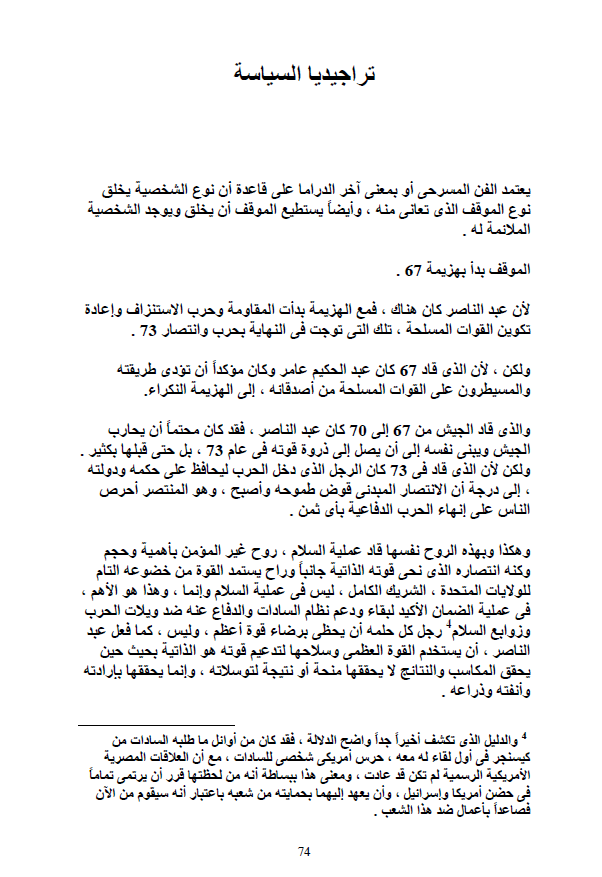
يعتمد الفن المسرحي، أو بمعنًى آخر الدراما، على قاعدة أنَّ نوع الشخصية يخلق نوع الموقف الذي تُعاني منه، وأيضًا يستطيع الموقف أن يخلق ويوجد الشخصية المُلائمة له.
الموقف بدأ بهزيمة ٦٧؛ لأن عبد الناصر كان هناك؛ فمع الهزيمة بدأت المقاومة وحرب الاستنزاف وإعادة تكوين القوات المسلحة، تلك التي تُوِّجت في النهاية بحرب وانتصار ٧٣.
ولكن لأن الذي قاد ٦٧ كان عبد الحكيم عامر، وكان مؤكَّدًا أن تؤدي طريقته والمُسيطرين على القوات المسلحة من أصدقائه إلى الهزيمة النكراء.
والذي قاد الجيش من ٦٧ إلى ٧٠ كان عبد الناصر؛ فقد كان مُحتَّمًا أن يُحارب الجيش ويبني نفسه إلى أن يصل إلى ذروة قوته في عام ٧٣، بل حتى قبلها بكثير، ولكن لأن الذي قاد في ٧٣ كان الرجل الذي دخل الحرب ليُحافظ على حكمه ودولته، إلى درجة أن الانتصار المبدئي قوَّض طموحه وأصبح، وهو المنتصر، أحرص الناس على إنهاء الحرب الدفاعية بأي ثمن.
وهكذا وبهذه الروح نفسها قاد عملية السلام، روح غير المؤمن بأهمية وحجم وكُنه انتصاره الذي نحَّى قوته الذاتية جانبًا، وراح يستمدُّ القوة من خضوعه التام للولايات المتحدة، الشريك الكامل، ليس في عملية السلام، وإنما، وهذا هو الأهم، في عملية الضمان الأكيد لبقاء ودعم نظام السادات والدفاع عنه ضد ويلات الحرب وزوابع السلام.(1) رجل كل حُلمه أن يحظى برضاء قوة أعظم، وليس كما فعل عبد الناصر أن يستخدم القوة العظمى وسلاحها لتدعيم قوته هو الذاتية، بحيث حين يُحقِّق المكاسب والنتائج لا يُحقِّقها منحة أو نتيجة لتوسُّلاته، وإنما يُحقِّقها بإرادته وأنَفته وذراعه.
الشخصية تخلق الموقف، والموقف يخلق الشخصية.
وثورة ٥٢ خلقت جمال عبدالناصر خلقًا ليعود يقودها، ولو لم تكن ثورة، ولو كانت إصلاحًا أو حركة استقلال لخلقت محمد نجيب أو غيره.
ورغم الهزائم التي مُنِي بها عبد الناصر عسكريًّا، فقد كانت هزائم عسكرية فقط، ونتائجها دائمًا كانت قوة للثورة.
في الخرطوم عقب الهزيمة كان العرب أقوى ألف مرة من موقفهم عام ٥٦ عقب انتصار، وحتى في موقفهم عام ٧٣ بعد الأسابيع الأولى من الانتصار، وحين بدأت شخصية السادات تتدخَّل لتخلق من الموقف المُنتصِر موقفًا مرعوبًا مُنقسِمًا مُهدِّدًا بضعف قادم أكثر.
ولو كان شخص آخر غير السادات لتغيَّرت نتيجة الحرب.
ولو كان شخص آخر غيره دخل معركة السلام لاختلفت النتيجة أيضًا.
وهكذا كان من المستحيل على الرجل الذي أعلن بيان ثورة يوليو وفي جيبه تذكرة السينما، يُثبِت بها أنه لم يَثُر ولم يشترك، كان من المستحيل على رجل كهذا إلا أن يدخل حرب ٧٣ حين تولَّى؛ خوفًا من التذمر الشعبي الهائل نتيجة لحالة اللاسلم واللاحرب.
خوفًا من المصير وعوامل أخرى ستكشف عنها الأيام حتمًا، دخل الحرب.
وخوفًا على المصير أنهاها وبسرعة البرق.
وللإبقاء على بقايا البقايا من نتائج الحرب، وبإرادة خائفة ملهوفة، دخل خيمة السلام أو بالأصح سردابه.
وماذا تنتظر من خائف يتلمَّس طريقه في ظلام سرداب السلام إلا أن يتخبَّط؟ ومع كل خطوة يتنازل خوفًا من عفاريت الظلام، وانعدام ثقة كامل في الشعب الذي به حارَب وبه انتصر، واعتمادًا على الممسك بيده من كيسنجر إلى كارتر وليس اعتمادًا أبدًا على نور الواقع والحقيقة الذي يملأ الدنيا، نور الإيمان بالقضية والشعب، ذلك النور الذي أطفأه في نفسه حين قَبِل العودة للجيش بثمن أن يكون مع الملك ضد القضية وضد الجيش.
رجل كهذا لا بد إذا تمكَّن وحكم، وصوَّر الأمر لنفسه على أنه حارَب، وأنه عليه مثلما كان إله الحرب، أن يُمثِّل دور ملاك السلام، مُمثِّل مُهرِّج، الاستراحات اشتكت من نوبات راحته حتى قُتِل وهو يُدبِّر لأيامٍ قادمة يقضيها مُسترخيًا في وادي الراحة، يستريح وكأن جهده في ارتداء البدلة البروسي العسكرية الفاخرة وجلوسه الساعات يُراقِب «جيشه» في زهو طالب الكلية العسكرية المُراهق لدى خروجه من الكلية بلبس الفسحة.
رجل جاءته ثورة، لم يعمل عملًا واحدًا من أجل تنظيمها، وجاءته الثورة بحكم لم يكن يحلم أن يصبح أحد دعاماته، وحين وجد في الحكم خطورة ومسئولية العمل السياسي ركنَ نفسه بنفسه حتى جاءته الرئاسة من حيث لا يعلم ولا يدري، واصطدم بأناس كانوا أخيَب المتآمرين عليه؛ فقد بادروا واستقالوا وسلَّموا أسلحتهم قبل المعركة، وحين جرَّب أن يُراوِغ الشعب وعقد معاهدة مع الروس لم يكن يعلم لها معنًى، وأخذ الشعب المعركة جدًّا، وخيَّره بين الحرب أو السقوط، غمَّى عينَيه وحارَب، وبجيش عبد الناصر وفوزي انتصر. محظوظًا انتصر، مثلما محظوظًا حكم، ومحظوظًا أصبح غلاف التايمز والنيوزويك والدير شبيجل، والوجه الدائم في أي تليفزيون غربي، هو الذي أرسل صورة له- وهو ضابط- يطلب عملًا كمُمثِّل. محظوظًا أجلسه كيسنجر كما يقول فوق حجره، ورعته وكالات الأنباء الصهيونية وأرضعته ما لم يحلم به من لبن المجد والشهرة، وجعلت له في الخافقَين مجد أباطرة إيران، ويونيفورم كيتل وروميل، وشوارب أعظم من شوارب هتلر، وأنواع من الملابس جعلته من العشرة المختارين للأناقة والرشاقة. رجل كان يُمضي بين أيدي مُدلِّكه الخاص أكثر بكثير مما يُمضيه في أي اجتماعات سياسية، حتى إنه اصطحب ذلك المُدلِّك إلى كامب ديفيد، وكان وقته مع المُدلِّك أضعاف أضعاف وقته مع الوفد المصري أو حتى مع الوفود الأخرى. رجل في نفس الوقت الذي كان يُنادي بنفسه زعيمًا لثورة وتنظيم الضباط الأحرار ضد الملك، كان أروع من مائة ملك وخديوي يحيا، في الوقت الذي يجهر بسيادة القانون يخرق القانون، ابتداءً من إنجاح ابنه إلى دكتوراه زوجته إلى توفيق وعثمان وعصمت وعائلة كبيرة فعلًا، ولكنها عائلة غيلان تنطلق في كل اتجاه تغشُّ وتسرق وتقتل وتضرب وتنهب، وكبيرها بنفس الدف واللكمة يضرب، وبقسوة عصمت على رشاد يخنق أي مُعارض، ومن أقصى الأقباط إلى أقصى المسلمين ومن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ومن فتحي رضوان ذي السبعين إلى عمر التلمساني المقترب من الثمانين إلى شباب المسلمين في الثامنة عشرة يخنق ويسجن ويضرب، وبأفحش الألفاظ ينهال علنًا وأمام العالم سبًّا على الناس جميعًا من برجنيف إلى الخميني، ومن القذافي إلى الأمراء والملوك. رجل لم يُنادِ أحدًا بكلمة الصديق إلا مُعلمه كيسنجر، ويُسمِّي رجلًا وطنيًّا مسلمًا فاضلًا كعمر التلمساني ﺑ «الكلب»، بينما يُسمِّي المُجرم بيجن بأخيه وصديقه الوفي. رجل من المال العام يزهو بأن يبني قريته ويُزوِّد بيوتها بالماء الساخن، وفي نفس الوقت يعيب على هيكل أنه يستخدم في منزله ذلك الماء وأنه يفطر في رمضان. رجل أطارت ضربات الحظ المتتالية التي صادفته منذ أن قامت الثورة حكم الإنسان السوي فيه على الأمور، وأطلقت العنان للسفه.
أجل، يفعل هذا كله، ويفعل هذا كله أمام الناس أجمعين؛ بمعنى أن كل ما ذكرته آنفًا جرى أمام الدنيا والعالم وليس في حجراتٍ مُغلِقة. ألا نفترض إذَن أن يكون ما جرى في الحجرات المُغلَقة هو أدهى وأمرَّ؟ وإذا كان هذا هو الجزء الذي ظهر لنا، أو بالأصح أظهره هو لنا، فيا لهول ذلك الجزء الخفي الذي- إلى الآن- لم يظهر، وتصرفات هذه شأنها تمتدُّ من التصرفات اليومية إلى تصرفاتٍ مسرحها العالم والدنيا عليها شاهدة، تصرفات أعطت النور الأخضر لطبقة بأكملها من المُجرِمين واللصوص وقطَّاع الطُّرق أن يُصيبها الصرع، وتمضي تنهش وتلهف وتُسجِّل ثروات فلكية في أعوام، بل في شهور، بحيث يمتلك ابنٌ واحد لعصمت، واحد من الخمسة عشر ابنًا والخمس زوجات، ٥٩ مليون جنيه أسهُمًا، وملايين الجنيهات والدولارات سائلة، وتليفونات وعربات وقصور. كيف يتسنَّى لشقيق رئيس جمهورية في عالم اليوم أن يمتلك مالًا وعقارات تُساوي إلى الآن مائة وثلاثين مليونًا من الجنيهات، في زمن لم يتجاوز الخمس سنوات، وبادئة من حضيض الحضيض؟! وكل ما يفعله الشقيق الرئيس من عقاب أن «يمنع» أخاه وأبناءه من «دخول» الميناء، ويثبت أن هذا المنع كان لخوفه على حياتهم وليس زجرًا لهم أو إظهارًا لعين أو نظرة حمراء مانعة.
وهل نفصل سرقة مجوهرات أو قصور أو اغتيال أرض دير وضرب شريك بالرصاص وسكوت كبير العائلة؟ هل يمكن فصل هذا عن الجرائم على النطاق القومي؟
وهل الذي يُبيح للفاسدين أموال الدولة والشعب يتعفَّف أن يبيع حقوق بلاده كلها مُقابل جائزة لنوبل، أو صورة على غلاف، أو مزارع في كاليفورنيا؟
الخيانة مرتبةٌ أعلى:
إذا أخذنا خطًّا أفقيًّا وجعلناه مِقياسنا، وأطلقنا منه خطوطًا كشعاعات الشمس بحيث تُغطي المائة والثمانين درجةً التي تُشكِّل زاوية الخط الأفقي، وإذا رسمنا منحنًى لتصرفات السادات بدءًا من ميلاده حتى مَصرعه، وضمَّنَّاه كل ما كان يُقدِم عليه من تصرفات تبدأ من غرفة نومه الخاصة إلى أكبر منابر العالم وأوسعها حيث شهودها بالملايين، فإننا سنلمح قاسمًا مشتركًا واحدًا بين هذه التصرفات جميعها؛ ذلك هو: الانعدام التام لمراجعة يقوم بها الضمير أو وقفة لتبين موضع القدم، أو- في النهاية- أي انتباه أو اهتمام بما قد يقوله الناس عن صاحب ذلك التصرف أو قائل ذلك القول أو الأخذ بذلك الموقف.
وإذا لم ينهَ الإنسان نفسه بنفسه، أو لم ينهَه ضميره، أو زوجه، أو صديقه، أو جاره، وإذا لم يهتم هو حتى لو كان الناهي أقرب المُقرَّبين؛ فما هي القوة التي ستمنع ذلك المُخطئ أن يرتكب ذلك الخطأ؟ ومن يقف حائلًا بين صاحب ذلك الوجه المكشوف الذي لا يهمُّه أحد، وبين الإقدام على فعل أي شيء أو قول أي شيء أو اتخاذ أي موقف؟
إن الضمير والتعقُّل والآخرين هي الوسائل التي منحها الله سبحانه لعباده ليُقيِّموا بها أنفُسهم ويُقيِّموا أفعالهم ويحكموا بها على أنفسهم وعلى الآخرين.
فإذا انعدمت تلك تمامًا، فماذا يمنع المخطئ أن يُخطئ، والمسيء أن يُسيء، والشريف حتى أن يسرق، والمواطن أن يُفرِّط أو يخون؟
خوف الله سبحانه. قد يقول قائل: ولكن الخوف من الله لا يتأتَّى إلا لمالك لضمير أو لعقل أو لمُشيرٍ أمين؛ فإذا انتفى هذا كله لم يعد بين ذلك الشخص وبين القيام بأحطِّ الأعمال حائل.
ولهذا، فالمانع الوحيد الذي كان يحول بين الرجل وبين العمل الخبيث هو عامل واحد ليس هناك غيره؛ الخوف، الخوف الجشع على النفس والذات والثروة والسلطات، الخوف أن يؤدي هذا العمل إلى الخطر على النفس أو الحياة. وسدًّا لهذه الثغرة اتخذ السادات لنفسه واحدًا من أكفأ أجهزة الحراسة الخاصة، دُرِّب تدريبًا شاقًّا ودقيقًا في الولايات المتحدة، بل كان فيه بعض الأمريكيين المُكلَّفين بأدوار أخطر من أن يُعهَد بها لغيرهم.
ومُحتميًا بهذا الخندق البشري راح السادات من مَكمنه ومأمنه يُطلِق النار والتصرفات والأخطاء في كل اتجاه.
وفي مكمنه هذا ومأمنه يعبد الله إذا عبده عن خوف، ويُقنع نفسه أنه ما دامت العلاقة بينه وبين الله عامرة، فلا يهمُّ أبدًا كيف وإلى أي مدًى تكون علاقته بالناس.
ونسي أن علاقة العبد بالله سبحانه ليست علاقةً خاصة، إنما هي علاقة تعمر أو تخرب بكمِّ ونوع علاقة الإنسان ببني الإنسان من حوله، بحيث حين يظلمهم، هم عبيد الله، تنتفي علاقته السوية بالله، ويُحاسبه الله دنيا وآخرة حساب الظالم.
وقد حاسَب الله السادات حساب الظالم.
وقبل يوم الساعة حلَّت ساعته، وأفتح الجرائد كلها وأقرأ ما تزدحم به المحاكم وألسنة الناس وصفحات الكُتاب من صورٍ مُروِّعة لحقبة السادات وأفعاله؛ كتاب يكفي لإدخال صانعيه ولو كانوا بالملايين إلى سراديب جهنم، فما بالك وهذا كله من تدبير وصنع نفس بشرية واحدة رَكِبها الشيطان.
كان حريًّا بظروف كظروف العرب ومصر قبل ٧٣ أن تخلق- لو تركت الظروف والمواقف وحدها- قائدًا جديرًا بالمرحلة جدارة المرحلة به.
ولكن المسائل لم تتمَّ بالتلقاء وبقانون الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح. كان من حظنا التعس أن تتجمَّع الوساوس على عبد الناصر بحيث تُحتِّم عليه أن يختار أقل زملائه ورفاق ٢٣ تموز/ يوليو قدرة على قيادة الحقبة التالية؛ خوفًا من أن يختار الرجل القوي المناسب فتُسوِّل له نفسه- للخليفة المختار- أن ينقلب على قائد الثورة.
ولهذا اختار نائبًا له إنسانًا لا يمكن أن يرضى به أحد رئيسًا.
اختار المُهرِّج ليترحَّم الناس على جديته هو، الساذج ليترحَّم الناس على حِذقه، المحبَّ للظهور ليترحَّم الناس على تواضعه وتقشُّفه أقل الناس إيمانًا بالمساواة والاشتراكية ليترحَّم الناس على القائد الشعبي الاشتراكي.
والقاعدة الذهبية أن الحاكم الضعيف يصبح أكثر الطغاة رعونة وخوفًا من الرجال الأقوياء والشعب القوي، وحتى الرأي الحصيف.
وجاء هذا الاختيار الذي مهَّدت له أطرافٌ عربية وأوعزت به الاستخبارات الأمريكية عن طريق مُستشاريها، الذين كان يحتلُّ بعضهم أمكنةً قريبة جدًّا من صانع القرار، عبد الناصر، جاء هذا الاختيار بردًا وسلامًا على الغرب بزعامة أمريكا.
ولعلمهم بمدى قلة شعبيته وهوان شأنه، تولَّوا حقنه بفيتامينات التأييد والوعود، وربما التلويح أنه حتى لو دخل الحرب فلن يخسرها.
وكان عند ظنهم.
ففي أقل من أربع سنوات كان اتجاه مصر الثوري قد صُفِّي تمامًا لمصلحة أمريكا، ومن معاداة الاستعمار إلى التسليم الكامل بالتبعية له.
وعجَّلت الحرب بعجلة التحويل.
وما كادت تنتهي حتى كانت البقية الباقية من آثار الثورة قد التهمها الانفتاح، وأتت عليها القروض، ونهبها اللصوص.
وحتى كانت إسرائيل قد تحوَّلت من ألدِّ الأعداء إلى الشريكة في المفاوضات والسلام المُتهافت المُستسلم.
والأشقاء والحلفاء العرب قد أصبحوا ألدَّ الأعداء.
والقطاع العام، ابن الثورة البكر، أصبح ابن الحرام المنبوذ.
والطهارة الثورية وقد توارت خجلًا من زحف الدنس والرشوة والدعارة.
وأفقنا جميعًا لنجد مصر قد دحرجها السادات وعصابته إلى مُستنقَع «مجاري»، لا مكان لرجل نظيف أو عمل نظيف أو تصرُّفٍ سويٍّ فيه.
وما كانت كامب ديفيد، وما جرى منذ مبادرة التهامي والسادات ومفاوضات ديان، تهامي في الغرب، وكيسنجر والسادات في أسوان، وغيرهم وغيرهم، إلا الامتداد الطبيعي لسياسةٍ اقتصادية، حرب على الشعب، وسياسة حرب على كل ما يمتُّ إلى الوطن ومبادئه. وبنفس أساليب عصابة النهب والحكم وسمسرة التليفونات والأوتوبيسات واللحوم الفاسدة والمخدرات، قنع القائمون عليها بفتات موائد بيجن وبن أليسار وفايسمان وشامير وبورج.
وعلى مائدة تضم السفَّاحين في ناحية، ومُجرمي الحرب والمشاركين في صنع هزيمة الثغرة من ناحية، والطامعين في فلسطين والعرب من ناحية، والمسلمين بكل ما يستر العورات أمام المصريين والعرب من ناحية، اجتمع اللصُّ والطابور الخامس والمستعدُّ لبيع أهله ليظفر بالكرسي.
اجتمعوا- هكذا قالوا- ليتفاوضوا.
وقبل أن يبحث إنسان عن كُنه مفاوضات وجدية مفاوضات، فإن نظرةً واحدة لماهية المُتفاوِضين كافية- دون أي شيء آخر- لإدراك النتائج.
نتائج لا ترقى حتى لمستوى الخيانة.
فالخيانة دائمًا بمقابل يحصل عليه الخائن من الطرف الآخر؛ فإذا كان إطلاق سراح أيدي الطرف الآخر لينهب بلده ويُدمِّر حلفاءه ومعسكره؛ أي يُضيف من عنده لمكاسب الجانب الآخر، فإننا أمام نوع من الخيانة لم يحدث من بيتان أو سينجمان ري، أو أي عميل يُفاوض حتى أولئك الذين صنعوا منه عميلًا.
ولأن هذا قد حدث، وتمَّت بالدخول في سراديب كامب ديفيد أغرب وأعجب مفاوضات حدثت في التاريخ، فقد كان رد الشعب على ما حدث هو أيضًا أغرب وأعجب رد لشعب على مُفاوِض.
وحادث المِنصَّة سيبقى دائمًا من عجائب التاريخ السبع؛ لأن ما سبقه وأدَّى إليه سيبقى دائمًا مثلًا للتفريط في حقوق أي شعب، عجيبة هو الآخر، فريدة بين ما يحفل به التاريخ من عجائب.
وهو حادثٌ جرى حتى قبل أن تعرف أو تُحلِّل كل التفاصيل، أو يرفع الغطاء عن كل مُستنقَعات الخيانة.
فما بالك حين يحدث في القريب العاجل هذا؟
ويردُّ على كل مُناصِر لكامب ديفيد التي كانت، وكل كامب ديفيد في طريقها للحدوث، وكل المرحلة الكامب ديفيدية المقبلة، يردُّ عليها بإفحام لا يقلُّ عما حدث في ٦ تشرين الأول/ أكتوبر عام ١٩٨١م.
أيها المُتشدِّقون المُحاولون خداع التاريخ والناس، لا أقول لكم العاقلُ من اتَّعظ.
فالإجهاز على المُذنِبين في محاكمة لم تستغرق دقائق وشاملة بالنفاذ لم يَعظكم.
وعليكم- كلما جاءت لكامب ديفيد سيرة- أن تُبادروا بحفر خنادق عميقة الغور.
وآه لو علمتم أنها مهما غارت بكم وغُوِّرتم في أعماقها فإن يد العدالة ستُطبِق عليكم.
ليس فقط لكامب ديفيد.
وإنما لأبشع جريمة ارتُكبت في حق شعبنا على مدى تاريخه.
جريمة تجريده من ثورته، وحقوقه، واشتراكيَّته، وسلاحه، وأشقَّائه، وتاريخه، وتركه عريانًا يرتجف بين الذئاب.

استعِدُّوا.
خاتمة:
بدأت سؤالي بموقف السادات، وهل كان خيانة أم تفريطًا لحد أقصى درجات الخيانة.
وها نحن ذا نصل سويًّا لأن نُدرِك أن ليس السادات وحده وإنما كل من ارتكز بوجوده على وجود السادات، وزيَّن بمعسول كلامه وصمت شيطانه الأخرس طريق الموافقة والانزلاق.
ويا لكارثة الهول حين تصبح الخيانة مرتبةً أعلى مما كان وما جرى من وقائع عشر سنوات من حكم مصر، ستُكلِّف شعبنا مائة عام لإصلاح ما عن عمد وسبق إصرار وترصُّد خرَّبته.
ذلك لأننا لن نُصلِّح فقط أخطاءً أو نُحاكِم جرائم ومُجرِمين، وإنما لا بد أن نُغيِّر «عصرًا» بأكمله لعصرٍ آخر؛ فبالأمس حين كان الاستعمار لا يزال في مراحله العسكرية البدائية الأولى، كنا نعرف أننا انتقلنا من عصرٍ كنَّا فيه مُستقلِّين إلى عصرٍ أصبحنا فيه مُحتلين، كنا نعرف هذا برؤيتنا لجنود ومواقع ومعسكرات جيش الاحتلال.
أما ما حدث لنا خلال السنوات العشرة الماضية، وانتقالنا إلى العصر الذي نحن فيه الآن، فليس هناك دليل على الهاوية التي نحن فيها يُمكننا أن نلمسه أو نراه رأيَ العين، وما حدث ويحدث في لبنان الآن ممكن أن تُطمَس معالمه، وقد طُمست أو بدأ طمسها بلجنة كاهان وخروج إسرائيل «ديمقراطية» تمامًا من مذبحة لم يجرؤ هولاكو أو هتلر على القيام بمثلها، ومشكلة لبنان الوطن لها ألف حل في الظاهر، وكذلك الكِيان الفلسطيني المرتبط مع الأردن، أو بالأصح، المقيد مع الأردن في قيد لا يعرف فيه أحد مَن المسجون ومن السجَّان، ومصر مقاطعة عربيًّا، وقد تزول المقاطعة. باختصار، كل «آثار العُدوان» الظاهرية ممكن أن تُزال.
ويا للكارثة حين تزول؛ ذلك أنها سوف تزول من أمام الأعيُن فقط، أما في الحقيقة فإن تمكُّن مَن أسميناهم الأعداء في مستهلِّ هذا البحث، تمكُّنهم منا سيصل إلى النخاع، وهناك ألف سادات جاهز، وألف كامب ديفيد مطروحة. وأكاد لولا الحياء أن أقول إننا في واقع أمرنا في حالة «انفتاح» كامل أمام الشريك الكامل والجار الكامل وكل كامل، ومنفتحون وسوف ننفتح أكثر دون أن ندري، والأصابع تعبث بنا دون أن ندري.
أوَحَسِبتم أن الانهيار في سوق الكويت من صنعِ الصدفة، أو أن الحرب الإيرانية العراقية نفسها تحدَّدت في لحظة مزاجية إرادية من هذا الطرف أو ذاك، أو أن نهايتها لا تبدو في الأفق لأنها مستحيلة النهاية؛ أم إن هذه الحرب نفسها لها أوثق العلاقات بانهيار سوق المال في الكويت، وأوثق العلاقات بانهيار أسعار البترول، وغرق الأوابك في الأوبك؟
ليس ما ألقيناه سوى خيط ضوء واحد على أصبع رهيبة واحدة، اندكَّت في صدورنا وخرجت من ظهرنا ولكن جسدنا كله مُخترَق، والخناجر تعمل فيه من كل اتجاه.
ولا نستطيع أن نصرخ ونقول: النجدة.
فلمن نقول؟
لن ينجدنا أحد- في هذا العالم المُخيف- إلا أنفُسنا كعرب.
فنحن غريقٌ يستغيث بغريق.
فهل يستطيع غريق أن ينجد غريقًا؟
نعم يستطيع.
واستطاعته تبدأ بأن يُدرك- حتى لو كان واقفًا على ما يتصوَّر أنه الشاطئ- أنه هو الآخر غريق يغرق.
أقول ربما لو أدركنا، أول ما نُدرك، أننا كلنا نغرق، وأن لا أحد، حتى صاحب الملايين المُودَعة في مصارف سويسرا أو أمريكا، أو العقار في الريفييرا، لا أحد حتى هؤلاء «الأغنياء» الذين يتصورون أنهم أغنياء، بينما ثرواتهم كلها في قبضة من باستطاعته أن يحرمهم منها بقرار، مجرد قرار.
أم تقولون مستحيل؛ فقوانين تلك البلاد لا تسمح؛ نفس البلاد التي جمَّدت بقوانينها أموال إيران وقبلها مصر.
لا قوانين أيها السادة الغَرقى.
هو قانونٌ واحد فقط، قانون البحر العاصف الذي لا يرحم.
وهكذا لو أدركنا أننا كلنا- مرةً أخرى كلنا- غرقى ونغرق أو حتمًا سنغرق، إذا بقينا على هذا الحال، ربما، مرةً أخرى أقول ربما، لو أدركنا هذا أمكننا لو تشابكت أيدينا، مُجرَّد تتشابك أيدينا، أن نصنع بأجسادنا المتحدة كتلةً تطفو، وحتمًا تطفو إذا تشابكت، فسيعمل حينذاك قانون العلم وليس قانون العاصفة والبحر الأعوج.
العلم الذي يقول: كلما كبر الحجم زادت القدرة على الطفو.
فلنكبر حجمًا لنعيش.
فلنتشابك لنكبر حجمًا.
فلنكفَّ أن نستغيث؛ فالمُغيث هو نحن أيضًا.
يا مُغيث أغِثنا.
………….
هامش:
(1). والدليل الذي تكشَّف أخيرًا جدًّا واضح الدلالة؛ فقد كان من أوائل ما طلبه السادات من كيسنجر في أول لقاء معه حرسٌ أمريكي شخصي للسادات، مع أن العلاقات المصرية الأمريكية الرسمية لم تكن قد عادت؛ ومعنى هذا ببساطة أنه من لحظتها قرَّر أن يرتمي تمامًا في حضن أمريكا وإسرائيل، وأن يعهد إليهما بحمايته من شعبه باعتبار أنه سيقوم من الآن فصاعدًا بأعمال ضد هذا الشعب.
