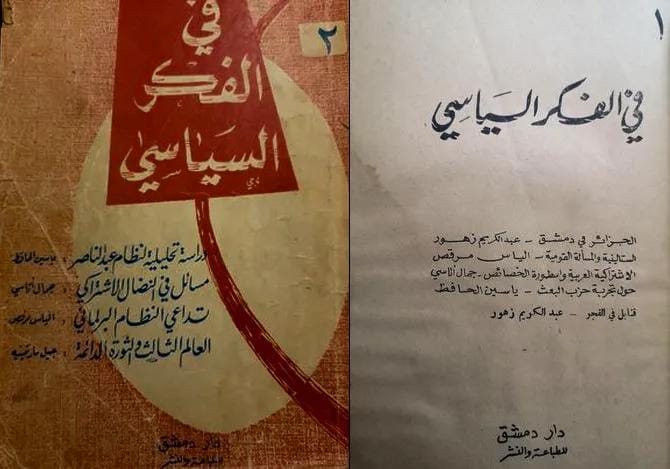
(الحرية أولاً) ينشر حصرياً الكتاب المفقود «في الفكر السياسي» بجزئيه، للمفكرين “الأربعة الكبار”، وهذه الحلقة السابعة من الجزء الثاني– بعنوان: (إيديولوجية الثورة).. بقلم الأستاذ “ياسين الحافظ”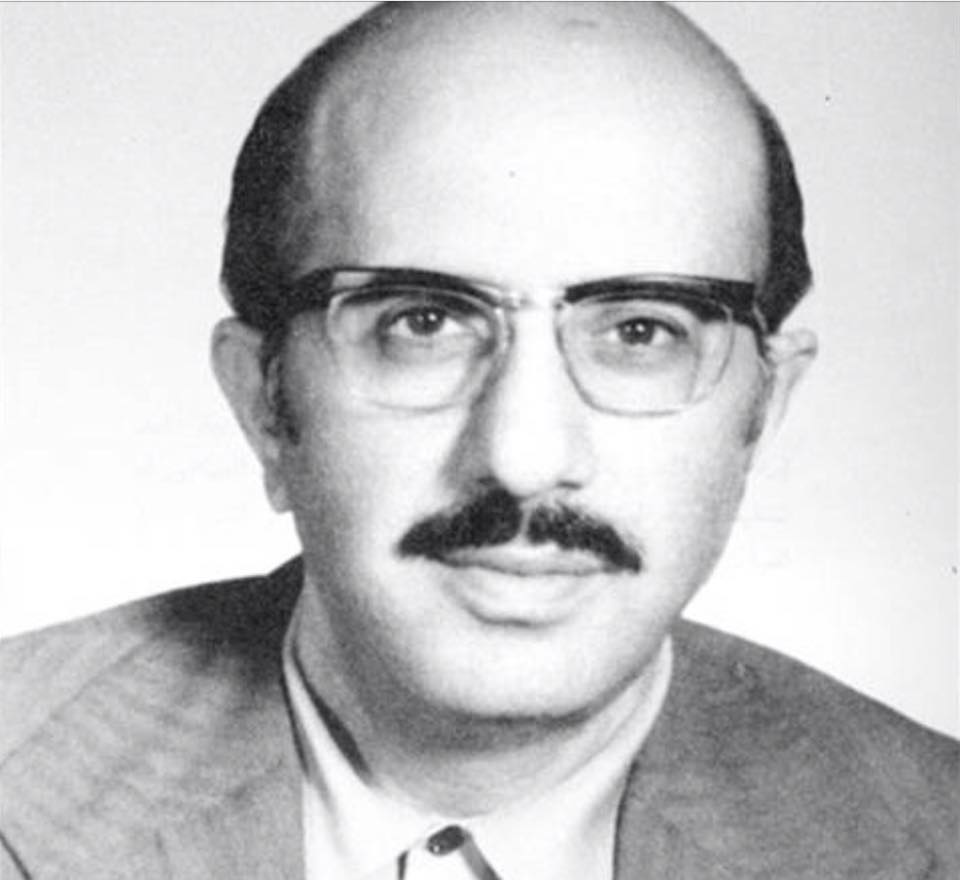
(6)
إيديولوجيــة الثـورة
قلنا قبل قليل أن ثورة ٢٣ تموز/ يوليو لعام ٩٥٢ في القطر المصري ثورة تجريبية، أي ثورة بلا نظرية. إلا أن هذه الثورة كانت تملك- منذ البدء- قناعات فكرية.. هذه القناعات يمكن أن نطلق عليها- مع قليل من التحفظ- كلمة: 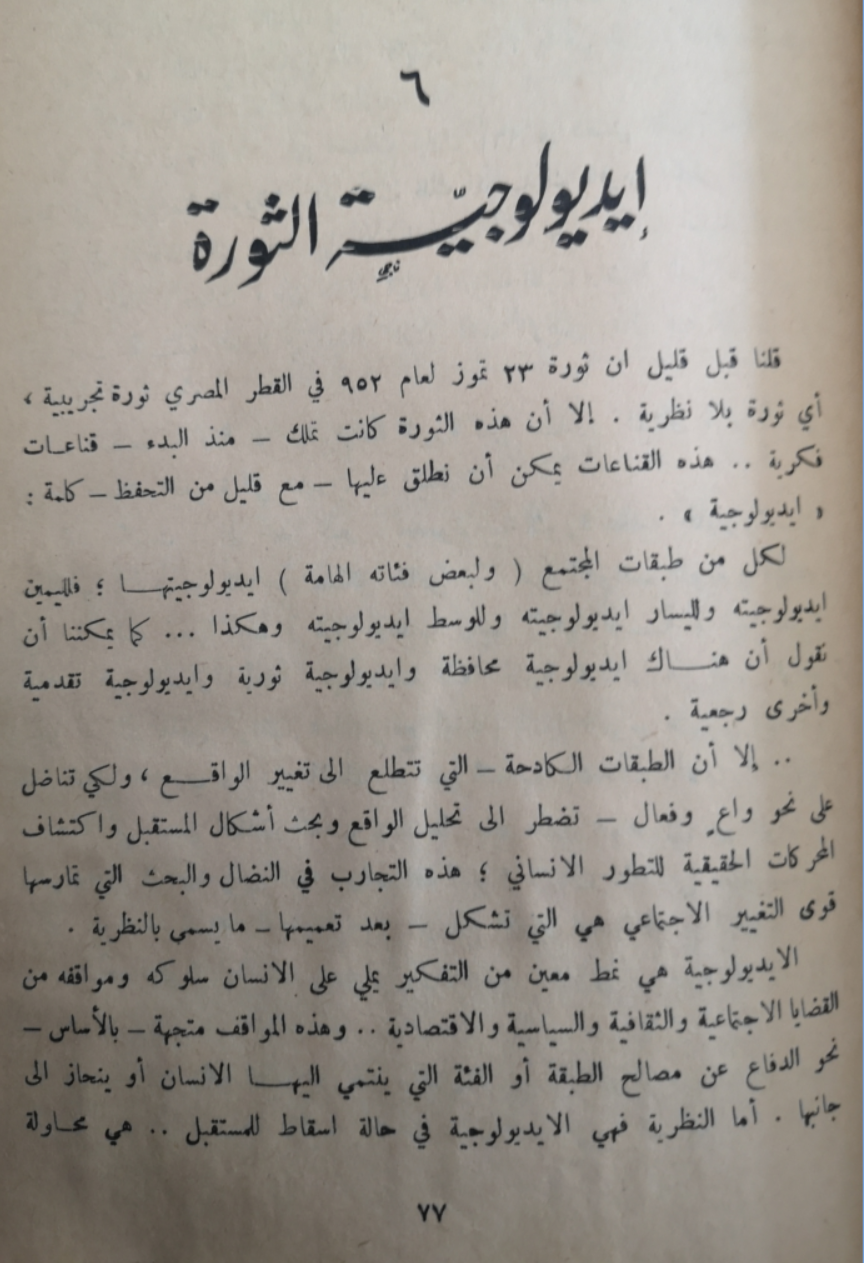 «إيديولوجية».
«إيديولوجية».
لكل من طبقات المجتمع (ولبعض فئاته الهامة) أيديولوجيتها؛ فلليمين أيديولوجيته واليسار أيديولوجيته وللوسط أيديولوجيته وهكذا… كما يمكننا أن تقول أن هناك إيديولوجية محافظة وإيديولوجية ثورية وإيديولوجية تقدمية وأخرى رجعية.
.. إلا أن الطبقات الكادحة- التي تتطلع إلى تغيير الواقع، ولكي تناضل على نحو واع وفعال- تضطر إلى تحليل الواقع وبحث أشكال المستقبل واكتشاف المحركات الحقيقية للتطور الإنساني؛ هذه التجارب في النضال والبحث التي تمارسها قوى التغيير الاجتماعي هي التي تشكل- بعد تعميمها- ما يسمي بالنظرية.
الإيديولوجية هي نمط معين من التفكير يملي على الإنسان سلوكه ومواقفه من القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.. وهذه المواقف متجهة- بالأساس- نحو الدفاع عن مصالح الطبقة أو الفئة التي ينتمي إليها الإنسان أو ينحاز إلى جانها. أما النظرية فهي الإيديولوجية في حالة إسقاط للمستقبل.. هي محاولة لاستشفاف سير التطور بغية التأثير به بصورة إيجابية وواعية وفعالة.
بعد هذا الاستطراد التمهيدي.. يحق لنا أن نتساءل: ما هي إيديولوجية الثورة? ما هو الطابع الأساسي لهذه الإيديولوجية؟ ما هي جوانب القوة والضعف فيها؟ كيف بدأت.. وكيف تطورت ؟
لا بد أن ننوه أولاً أن أحدات أيلول/ سبتمبر 1961 في دمشق كانت نقطة تحول هامة في إيديولوجية الثورة. لقد كانت تلك الأحداث ناقوس الخطر الذي نبه الثورة إلى الأخطاء التي وقعت بها والأخطار التي تُحيق بها. وكانت النتيجة المباشرة والعملية لتلك الأحداث، أن حاولت الثورة صياغة نظرية واضحة للعمل السياسي، وقد تمثلت هذه المحاولة في الميثاق الذي أعلنه الرئيس جمال عبد الناصر في مساء 21/5/1962.
لذا سنتحدث أولاً عن إيديولوجية الثورة قبل صدور الميثاق، ثم نتحدث عن الاتجاهات الجديدة التي تبلورت فى الميثاق.
لقد عكست- إلى حدٍ كبير- إيديولوجية الثورة عقلية الجماهير ونفسيتها ومطامحها (وجماهير الفلاحين بشكل خاص). فيها الجوانب القوية في الجماهير وفيها جوانب ضعفها أيضاً؛ فيها أوهامها وفيها زخمها أيضاً، فيها عفوية الجماهير وفيها إصرارها أيضاً، فيها رغبة عميقة حارة للإفلات من أسر الواقع وفيها إدراك غامض لجوانب هذا الواقع أيضاً؛ يختلط الجموح الثوري فيها مع طيبة الفلاح المصري ونواياه المسالمة؛ تلعن التقاليد والعادات والأطر الاجتماعية الموروثة التي تهيض انطلاق الشعب ويشدها حنين خفي نحوها في نفس الوقت؛ تؤمن بالعلم إلا أن صدى السحر والخرافة لايزال الغلاف الخارجي لمنطقها. وبكلمة.. يتردد في هذه الإيديولوجية الرّجْع الأخير لعقلية الفلاح المصري.
لقد أدركت الثورة منذ البدء ضرورة التغيير الجذري.. ضرورة الإسراع في العمل، يقول عبد الناصر:
«ولقد تخلفنا عن عصر البخار وعصر الكهرباء، وهذا هو عصر الذرة وعصر الفضاء يطالعنا بالاحتمالات الرحبة الفسيحة… فاذا لم تكن حركة التقدم سريعة متلاحقة فإن تخلفنا سيكون مروعاً.. ».
هذا الإدراك لضرورة طيّ مسافات التخلف في أقصر مدة زمنية ممكنة، الذي وضع مسألة التغيير الجذري للمجتمع كهدف مباشر للثورة.. إلا أن رغبة الوصول إلى التغيير الجذري- حسب أوهام الثورة- سارت عبر طريق يلفه الضباب، يقول عبد الناصر:
«إن ما هو أكثر أهمية من التغيير نفسه أن يحدث هذا التغيير الجذري الكبير بطريقة سلمية… ».
ولهذا السبب أعلنت الثورة أنها تؤمن بـ«التعاون الطبقي» بـ«التعايش السلمي» داخل الوطن الواحد بين سائر الطبقات. وكانت هذه الإيديولوجية الفجة الساذجة، التي تخطاها التطور الفكري للحركات الاشتراكية وأثبتت التجارب النضالية عقمها، كانت مثل هذه الإيديولوجية هي الأب الروحي الذي أنجب الطرح السياسي المسمى بالاتحاد القومي.
يفلسف الرئيس عبد الناصر الاتحاد القومي بقوله:
«إن الاتحاد القومي ليس حزباً، وإنما هو وطن بأكمله داخل إطار واحد، يتساوى الجميع على صعيده، وذلك لكي يصنع سلمياً تطوره الكبير، ويحقق أهداف ثورته التي لا بد من تحقيقها. الاتحاد القومي وسيلة لكي تتفاهم الطبقات وتتراضى بدل أن تتصارع ..».
إن وضع العواطف فوق الحقيقة والواقع ومحاولة «صنع التطور الكبير» عن طريق النوايا الطيبة والنصح، لم يجد فتيلاً مع الرجعية، لأن الصراع الطبقي أمر واقعي يفرض نفسه على الحياة، إنه منطق الأشياء والطبيعة، فالتطور الكبير لا يمكن أن يُصنع إلا بدون الرجعية وضد مصالحها أيضاً؛ وكانت النتيجة المحتومة هذه «العواطف» تباطؤ التطور من جهة وإبقاء الثورة في خطر يترصدها من جهة أخرى، لأن الدعوة للتعايش الطبقي تعني عملياً وقف النضال الشعبي والثوري ضد الرجعية، فجرى فعلاً تجميد النهوض الشعبي وتكليس المبادرة الشعبية.
إن وهم التعايش الطبقي والتفاهم الطبقي دعا الثورة إلى اعتبار الدولة كقوة فوق الطبقات كحَكم بين الطبقات. يقول الرئيس جمال عبد الناصر:
«تحمي الدولة كل طبقة من الأخرى وكل صاحب مصلحة من صاحب المصلحة الأخرى.. وهي التي تجعل التوافق كاملاً بين جميع المصالح وبين جميع الطبقات في نفس الوقت ..».
حقاً إن اعتبار الدولة قوة وسيطة بين الطبقات، قوة حيادية فوقها بعد أن كانت أداة بيد الإقطاع والرأسمال الاحتكاري يعتبر خطوة إيجابية هامة إلى أمام؛ كما أن وضع الدولة في موضع الحَكم بين الطبقات يعبر عن حالة التوازن التي تعيشها. إلا أن حالة كهذه لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. إن الثورة في معاناتها الحقيقية للواقع وفي تصميمها الحازم على متابعة العمل لإحداث التغيير الجذري وجدت نفسها مُجبرة على تحدي مصالح الطبقات الأقوى ومدعوة بالنتيجة لضرب هذه المصالح. وبما أن المعارك قد جرت في جو جمَّدت فيه الثورة النهوض الشعبي وكلست المبادرة الشعبية، فقد استطاعت الرجعية أن تضرب الثورة في نقطة ضعفها.. في دمشق.
هذا الارتطام العنيف بالواقع قد حطم أيضاً اسطورة التعاون الطبقي وفضح خرق وتهافت فكرة «التعايش الطبقي» و«الاشتراكية التعاونية» (أي الاشتراكية القائمة على تعاون الطبقات).
إن ما هو خطير وأساسي في أخطاء الثورة قد نبع عن الوهم التالي: إمكانية صنع التقدم عن طريق تجنب الصراع الطبقي. لقد تعلمت الثورة بالتجربة المُرة القاسية أن مثل هذه الموضوعة مناقضة للواقع الاجتماعي الملموس ومغايِرة لمنطق الحوادث. وإذا جعلت الثورة مثل هذا الدرس منطلقاً لنضالها العملي ستتغلب حتماً- إذا لم يعاجلها العدو بضربة مميتة قبل أن تكمل حماية ظهرها- على جميع مظاهر الخطأ والضعف والتردد التي لازمت سير تطور الثورة.
هذا جانب من الموضوع، أما الجانب الآخر- وهو الأساسي فيه- فهو أن الثورة، وقد اجتازت مرحلة الكفاح السلبي إلى مرحلة البناء الإيجابي للاشتراكية سترى نفسها عاجزة عن النهوض بهذه المهمة- على نحوٍ سريع وجدي- إذا لم تلتزم سياسة طبقية، وذلك باعتمادها على الجماهير لكي تتولى مسؤولية التخطيط والبناء والرقابة والحماية. إن القلة البيروقراطية ستشوه الاشتراكية وتسلبها مضمونها الإنساني؛ لأن نضال الجماهير الشعبية هو وحده الذي ينمي الجانب الإنساني من الاشتراكية. إن الاشتراكية لا يمكن أن تتحقق وتتطور إلا مع الجماهير الشعبية وبالاعتماد على مُبادهتها والثقة بها.
لقد بلغت الثورة مفترق الطرق. وقد كانت احداث دمشق في أيلول/ سبتمبر 1961 إيذاناً بذلك، ولولا موقف الرجولة الذي اتخذه عبد الناصر لامتد الوباء الرجعي إلى القاهرة. لم يعد أمام الثورة سوى ثلاث احتمالات: (۱) إما أن تعاجلها الرجعية- وهي في عزلة عن الجماهير- بضربة مميتة قاضية. (٢) وإما أن تطوقها البيروقراطية بسور صيني مغلق يجمدها في منتصف الطريق ويمنع انطلاقها وتطورها، فتبني مجتمعاً هجيناً مشوهاً راكداً خالياً من الاصالة فاقداً للقيم. (٣) وإما أن تتحول كلياً وبلا تردد إلى الالتزام الإيجابي بالجماهير الشعبية.
لقد كان في إعلان الميثاق الوطني للثورة مساء 21/5/1962 ما يشير- من حيث المبدأ-إلى أن الثورة قد اختارت طريق الجماهير: لقد جددت كارثة الانفصال النبض الشعبي للثورة، ولقد انعكس هذا النبض بصورة واضحة (وان كانت غير كاملة) في الميثاق.
لسنا ها هنا بصدد تقديم دراسة مفصلة عن الميثاق، بل سنكتفي بإلقاء نظرة عاجلة عامة عليه، ثم نورد بعض الملاحظات حول الاتجاهات الجديدة والهامة فيه:
1- بالرغم من أن الميثاق موجه- بشكل عام- لرسم الخط الأساسي لسير التطور في القطر المصري في المستقبل القريب (وخلال السنوات الثمانية على وجه التحديد)، إلا أنه قد توجه أيضاً إلى تجربة السنوات العشر الماضية بالنقد والتحليل. فالميثاق- إلى حدٍ كبير نقد مباشر وغير مباشر لتلك الفترة. وكانت منطلقات هذا النقد يسارية تغلفها رغبة أكيدة بالتجديد. لقد تناول النقد الذي حواه الميثاق جوانب الخطأ في الواقع المصري وجوانب الضعف في التجربة الماضية، إلا أن هذا النقد جاء وفق أسلوب إيجابي وعام، لذا كان ينقصه المزيد من الجرأة التي تعري الخطأ من جذوره وتحلل- بتفصيل- الظروف التي ولدته. وإن أسلوب كهذا في النقد هو الذي يمكن أن يهيئ- على نحو أكمل- وسائل إصلاح هذا الخطأ وتصفية أسبابه.
وبالإضافة إلى ذلك، يلخص الميثاق على نحو علمي أيضاً معطيات التجربة الماضية، وعلى ضوء كل ذلك يرسم آفاق التطور في القطر المصري.
ويمكن القول- بشكل عام وتقريبي- أن الميثاق يشكل نقطة انطلاق صحيحة وبداية سليمة.
2- يشير الميثاق إلى أن «الاشتراكية العلمية هي الصيغة الملائمة لإيجاد المنهج الصحيح للتقدم»، إلا أن الميثاق في تحليله للعديد من القضايا لم يلتزم بدقة المنطق الاشتراكي العلمي، ولعلّ أحد الاسباب في ذلك تعود إلى أن الميثاق لم يضع حدوداً واضحة بين إيديولوجية الثورة من جهة وبين أهدافها المرحلية من جهة أخرى. هذا الخلط بين التطلعات البعيدة وبين الأهداف المرحلية يخلق نوعاً من الانتهازية الفكرية- إذا صح التعبير- لأنه يخلق التباساً تستخدمه بقايا البورجوازية لكي تدافع عن مواقعها المنهارة، إذ تُصوِّر الأهداف المرحلية التي رسمها الميثاق وكأنها خاتمة المطاف في تطور الثورة، لذا فإن الميثاق بحاجة إلى تحديد ووضوح وإلى حزم فكري وإيديولوجي.
3- بالرغم من أن كامل وسائل التمويل وثمانين بالمئة من وسائل الإنتاج قد أصبحت ضمن نطاق الملكية العامة للشعب، إلا أن البرنامج الذي حدده الميثاق لإكمال التحويل الاشتراكي في مجمل القطاعات غير شامل من جهة وبطيء من جهة أخرى. ففي السنوات الثماني القادمة في رأينا يجب أن تتم ثورة زراعية (لا إصلاح زراعي فحسب) وفق شعار «الأرض لمن يزرعها»، وأن تنفذ هذه الثورة بواسطة الفلاحين- لا البيروقراطية-. كما يجب اتمام تحويل جميع وسائل الإنتاج إلى ملكية الشعب، وتأميم التجارتين الخارجية والداخلية بالإضافة إلى تأميم وسائل الخدمات الهامة والكبيرة والمباني.
إنه نوع من «التهريب» الإيديولوجي أن يصطنع الميثاق تقسيم الرأسمال إلى رأسمال مستغل وآخر غير مستغل، وملكية مستغلة وأخرى تؤدي دورها الإيجابي في بناء الاقتصاد، لكي تبرر خطة الدولة في سيرها «السلحفائي»، في التحويل الاشتراكي خلال المرحلة المقبلة. فالمُلكية إذا تعدّت حدود الاستعمال المباشر والشخصي لا بد ان تكون مستغلة؛ ومهما كانت الرقعة التي يمارس فيها الرأسمال نشاطه ضيقة أو نسبة المردود الذي يعطيه منخفضة فإن هذا لا يمحو عنه تلك الصفة إذا كنا نعتبر العمل الإنساني المصدر الوحيد للقيمة. فالليل قد يكون أسحم وقد يكون أغبش أيضاً.. إلا أننا لا يمكن إلا أن نسميه ليلاً في كلا الحالين. لقد كان ممكناً تبرير خطة الدولة وفق أسلوب آخر، كأن يقال مثلاً إن السير المرحلي للتحويل الاشتراكي يقتضي التعاون إلى أقصى حد مع البورجوازية الصغيرة وبقايا البورجوازية الوطنية خلال المرحلة القادمة، أما أن يُسدي الميثاق النصح للقطاع الخاص (دون تحديد دقيق للمضمون الطبقي لهذه الكلمة) وأن يطالبه بأن «يجدد نفسه وبأن يشق بعمله طريقاً من الجهد الخلاق لا يعتمد كما كان في الماضي على الاستغلال الطفيلي» فإننا نرى فيه قفزاً فوق الخصائص الثابتة والمُطلقة للرأسمال بصورة عامة وللرأسمال في البلدان المتخلفة بصورة خاصة، كما نرى فيه- تبعاً لذلك- حواراً رومانتيكياً مع أصم أبكم لا يمكن أن يتحسس سوى مصالحه المباشرة الاكيدة.. إن في هذا النصح بقايا العقل البورجوازي الصغير في منطق الثورة.
4- لقد رسم الميثاق الأفق النظري الصحيح لإقامة ديمقراطية شعبية تستطيع فيها الجماهير العاملة أن تلعب الدور الرئيسي في تطوير الثورة وحمايتها:
آ- لقد فضح الميثاق بروح ثورية ونظرة علمية الديمقراطية البورجوازية الإقطاعية، لقد أمسك الميثاق بحقيقة علمية لا تقبل الجدل، وهي: «إن النظام السياسي في بلد من البلدان ليس إلا انعكاساً مباشراً للأوضاع الاقتصادية السائدة فيه وتعبيراً دقيقاً للمصالح المتحكمة في هذه الأوضاع الاقتصادية». إن هذه الحقيقة هي وحدها المنطلق الثوري والعلمي لموقف سياسي سليم من أنظمة الحكم التقليدية. إن هذه الحقيقة هي التي أتاحت للثورة أيضاً: «فضح التزييف المروع في ديمقراطية الرجعية التي حكمت باسم التحالف بين الإقطاع ورأس المال المستغل»، وهي التي ستمكّن الثورة من أن «ترسم من الواقع وبالتجربة وتطلعاً إلى الأمل معالم ديمقراطية الشعب العامل كله».
ب- نوهنا في مكان آخر من هذا البحث بخُرافة التعايش الطبقي التي حطمتها أحداث أيلول/ سبتمبر 1961 في دمشق. لقد كانت هذه الخُرافة عائقاً جدياً أمام بناء ديمقراطية شعبية؛ إلا أن الثورة إذ تعلمت بالتجربة المباشرة خَرقَ هذه الموضوعة، جاء الميثاق ليعلن أن الصراع الطبقي حقيقة ملموسة تعيش في الواقع وتعانيها الجماهير يومياً. إن مثل هذه الموضوعة ستساعد الثورة على التخلص بصورة جدية ونهائية من الرجعية؛ والخلاص من الرجعية خطوة لا بد منها لبناء ديمقراطية شعبية؛ يؤكد الميثاق:
« .. ان الصراع الحتمي والطبيعي بين الطبقات لا يمكن تجاهله وإنكاره، وإنما ينبغي حله سلمياً في اطار الوحدة الوطنية وعن طريق تذويب الفروق بين الطبقات. ولقد أثبتت التجربة التي صاحبت بدء العمل الثوري المنظم أنه من المحتم أن تأخذ الثورة على عاتقها تصفية الرجعية وتجريدها من جميع أسلحتها ومنعها من أي محاولة للعودة إلى السيطرة على الحكم وتسخير جهاز الدولة لخدمة مصالحها. إن ضراوة الصراع الطبقي ودمويته والأخطار الهائلة التي يمكن أن تحدث نتيجة لذلك هي في الواقع من صنع الرجعية التي لا تريد التنازل عن احتكاراتها وعن مراكزها الممتازة والتي تُواصل منها استغلال الجماهير. إن الرجعية تملك وسائل المقاومة, تملك سلطة الدولة، فإذا انتُزعت منها لجأت إلى سلطة المال، فإذا انتُزع منها لجأت إلى حليفها الطبيعي وهو الاستعمار.. إن الرجعية تتصادم في مصالحها مع مصالح مجموع الشعب بحكم احتكارها لثروته، ولهذا فإن سلمية الصراع الطبقي لا يمكن أن تتحقق إلا بتجريد الرجعية أولاً وقبل كل شيء من جميع أسلحتها… وعند هذا لا بد أن ينفتح المجال للتفاعل الديمقراطي بين قوى الشعب العاملة. الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية..(1)».
وفي مكان آخر من الميثاق تحذير قوي من الرجعية:
«من الواجب ألا يستقر في أذهاننا أن الرجعية قد تم الخلاص منها إلى الأبد، إن الرجعية مازالت تملك من المؤثرات المادية والفكرية ما قد يُغريها بالتصدي للتيار الثوري الجارف خصوصاً في اعتمادها على الفلول الرجعية في العالم العربي المسنودة من جانب قوى الاستعمار؛ إن اليقظة الثورية كفيلة تحت كل الظروف بسحق كل تسلل رجعي مهما كانت أساليبه ومهما كانت أساليب القوى المساعدة له.. ».
هذا الكلام صحيح من حيث المبدأ، إلا أن التطبيق العملي الجدي والصحيح للإيمان بالصراع الطبقي، يقضي أن تكون العناصر الكادحة المنظمة- لا المباحث- هي أداة الصراع مع الرجعية. إن أداة كهذه هي وحدها التي تملأ الصراع بمضمونه التقدمي والثوري.
ج- إن الثورة في كفاحها ضد الاستعمار عمدت إلى إلغاء حرية الطبقات والفئات الضالعة مع الاستعمار؛ إلا أن الثورة لم تكتفِ بإلغاء حرية الطبقات الرجعية فحسب بل ألغت حرية الجماهير الشعبية أيضاً. لقد حللنا في مكان آخر من هذا البحث أسباب هذه الظاهرة وكشفنا عن جذورها، إلا أننا نريد أن نضيف إلى ذلك السبب التالي، إن التناقضات الجزئية وغير المتنافية التي وُجدت بين قيادة الثورة وبين الجماهير العاملة قد استغلتها العناصر الوسطية وغير الثورية في قيادة الثورة لتحرُم الجماهير حريتها أيضاً. لم تستطع قيادة الثورة أن تميز بوضوح بين نوعين من التناقضات: تناقضات الثورة مع الرجعية وهي تناقضات أساسية متنافية (حسب تعبير ماوتسي تونغ) وتناقضات الثورة مع الجماهير الشعبية وهي تناقضات جزئية وودية.
إن هذا الخلط بين نوعين من التناقضات بالإضافة إلى التوجس المسبق من الجماهير هو الذي يفسر موقف الثورة.
إن الشعار الذي طرحته الثورة:
«إن الخبز للجميع مقدمة لا بدّ منها حتى تكون هناك الحرية للجميع ..»
… إن هذا الشعار وإن كان يعبر عن فهم جزئي ومشوه لطبيعة النضال التقدمي (الذي لا بد أن يكون جماهيرياً) إلا أنه يعبر في نفس الوقت عن التزام الثورة بمصلحة الجماهير أيضاً. ولهذا جاء التزام الثورة بالجماهير على شكل أبوي متعالِ، فكانت علاقات الثورة مع الجماهير علاقات «وصاية»، إن موقف الثورة من الجماهير، الملتزم بها والوصي عليها في نفس الوقت، لم يُتح خلق الجماهير المنظمة بل خلق الجماهير المتحمسة السديمية.. وجماهير في حالة كهذه لا يمكن أن تكون قاعدة متينة وفعالة للديمقراطية، لأن جوهر الديمقراطية مُستمَد من الإسهام الإيجابي لا من الموافقة السلبية، لذا فإن الإيمان بالديمقراطية الشعبية هو الشكل العملي للإيمان بالجماهير الشعبية المنظمة القائدة.
الحقيقة دائماً ثورية ودائماً أخلاقية، والديمقراطية هي التي تتيح للحقيقة التفتح؛ وإن غرس فكرات الديمقراطية الشعبية لا تتأتى وفق أسلوب مفاجئ يسقط من علٍ كمنحه من الحاكم عندما يقتنع أن الجماهير قد شبت عن الطوق، فالديمقراطية لا يمكن أن تؤجل؛ ولا توضع على الرف اليوم بزعم ممارستها غداً عند النضج، فالنضج السياسي وليد الممارسة الديمقراطية بالدرجة الأولى، فالديمقراطية اليوم هي أمر لا بد منه للديمقراطية غداً، لأن ممارسة الديمقراطية على نحو ناضج ومسؤول ومنضبط لا يمكن أن يتهيأ إلا بالممارسة الدائمة وبالمعاناة، فلكي نتعلم السباحة بعد سنة يجب أن نمارسها منذ اليوم.
لقد رسم الميثاق الأفق النظري الصحيح لممارسة مسؤولة للديمقراطية. يقول الميثاق:
«إن ممارسة النقد والنقد الذاتي يمنح العمل الوطني دائماً فرصة تصحيح الأوضاع وملاءمتها دائماً مع الأهداف الكبيرة للعمل، وأن أي محاولة لإخفاء الحقيقة أو تجاهلها يدفع ثمنها في النهاية نضال الشعب وجهده للوصول إلى التقدم…
إن حرية النقد البناء والنقد الذاتي الشجاع ضمانات ضرورية لسلامة البناء الوطني، ولكن ضرورتها أوجب في فترات التغيير المتلاحق خلال العمل الثوري. إن ممارسة الحرية على هذا النحو، ليست لازمة فقط لحماية العمل الوطني، ولكنها لازمة لتوسيع قاعدته وتوفير الضمان للذين يتصدون له، فممارسة الحرية على هذا النحو سوف تكون الطريق الفعال لتجنيد عناصر كثيرة قد تتردد في المشاركة في العمل الوطني، والحرية هي الوسيلة الوحيدة للقضاء على سلبيتها وتجنيدها اختيارياً لأهداف النضال. إن ممارسة الحرية بعد العملية الثورية الهائلة بإعادة توزيع الثروة الوطنية في تموز/ يوليو ١٩٦١ لا تشكل خطراً على أمن النضال الوطني، بل إنها صمام الأمان له، فإنها تخلق القوة الشعبية القادرة على الانقضاض على كل محاولة للتآمر والقيام بانتكاس يسلب الشعب ثمار نضاله، كذلك فإن ممارسة الحرية يخلق القيادات المتجددة للعمل الثوري ويوسع هذه القيادات ويدفعها دائماً إلى الأمام ويخلق قيادة من التفكير الجماعي القادر على صد نزعات التحكم الفردي، ومن ثم فهو يوفر للعمل الوطني ضمانات بعيدة المدى..».
د- قلنا- قبل قليل- إن التزام الثورة بالجماهير جاء على شكل أبوي متعالِ. لذا فإن الثورة، وإن استطاعت أن تنفُذ إلى أعماق الجماهير وتُحرك اكثرها جهلاً وتأخراً، الا أنها لم تتقدم بالجماهير إلى الخطوة الثورية الثانية (وهي الخطوة الإيجابية والأكثر صعوبة)، فبقيت- رغم تحركها- في حالتها الخام وفي وضع سديمي مبعثر، ولم تُحولها إلى جماهير ناضجة ومسؤولة ومنتظمة في تشكيل سياسي. إن الاستيعاب الحقيقي للتحرك الثوري يوجب صب قوى الجماهير العفوية في تنظيم يمنحها القوة والنضج معاً ويفتح أمامها- بالتالي- فرصة ممارسة قيادة فعلية للثورة.
إن الثورة التي اجتازت تجربة المراهقة الفكرية- كما يقول الميثاق- بعد معاناة حقيقية للواقع الملموس، وبعد أن باشرت مهمة البناء الاشتراكي، وبعد تجارب عشر سنين من الخطأ والصواب، أمسكت- نظرياً على الأقل- بجوهر العمل الثوري وبكلمة السر فيه، عندما أعلن الميثاق هذه الحقيقة: «الشعب قائد الثورة». ولكن لكي يكون لهذه الموضوعة مضمون عملي يجب ألا تكون تبريراً لعدم وجود الشعب المنظم، فلن يستطيع الشعب ممارسة قيادة فعلية للثورة وهو في وضع سديمي، فالشعب القائد هو- من الناحية العملية- طليعته المنظمة في إطار سياسي ثوري.
… وخلافاً لما كان يُقال في السابق، حيث يجري- حتى من الناحية النظرية- القفز من فوق جماهير الشعب، أو ينظر إليها كقوة منفعلة؛ جاء الميثاق معلناً تحولاً جديداً وجذرياً في نظرة الثورة إلى الجماهير:
«إن الثورة بالطبيعة عمل شعبي… إنها حركة شعب بأسره يستجمع قواه ليقوم باقتحام عنيف لكل العوائق والموانع التي تعترض طريق حياته.. وأن قيمة الثورة الحقيقة بمدى شعبيتها، بمدى ما تعبر به عن الجماهير الواسعة وبمدى ما تعبئه من قوى هذه الجماهير لإعادة صنع المستقبل، وبمدى ما يمكن أن توفره لهذه الجماهير من قدرة على فرض إرادتها على الحياة.. ».
«إن الديمقراطية هي الترجمة الصحيحة لكون الثورة عملاً شعبياً.. ».
5- البيروقراطية- كما ذكرنا في مكان آخر- عقاب على سوء تطبيق مبادىء الديمقراطية الاشتراكية، وهي في نفس الوقت علامة ضعف في الجسم الاشتراكي، فهل أدركت الثورة هذه الحقيقة؟ وهل انعكست هذه الحقيقة في الميثاق؟
لا بد أن ننوه أن مكافحة مخاطر البيروقراطية لا يمكن أن تتم إلا وفق أسلوب إيجابي، أي بواسطة تعميق الديمقراطية الاشتراكية وتوسيعها أولاً وأن تأخذ الجماهير الشعبية العاملة دورها الفعلي في قيادة المجتمع ثانياً. وكل حديث عن طريق آخر لعلاج هذه الظاهرة غير مجدِ وغير جدي معاً. ومع ذلك فإن مُجرد طرح القضية على بساط البحث- ولو نظرياً- يعتبر خطوة إلى أمام.
لقد تناول الميثاق موضوع البيروقراطية في معرض بحث مشاكل التطبيق الاشتراكي، وجاء فيه ما يلي:
«والقيادات الجديدة المتصدية لتحريك التطور الوطني قوة هائلة لا بد من حمايتها لتؤدي رسالتها الوطنية بالنجاح المطلوب..
وفي بعض الأحيان فإن هذه القيادات في حاجة إلى حمايتها من نفسها.
إن هذه القيادات قد تقع في خطأ توهم أن المشاكل الكبرى للتطوير الوطني تُحل خلال التعقيدات المكتبية والإدارية. إن هذه التعقيدات تضع أعباء جديدة على العمل الوطني دون أن تساعده.
إنها قادرة، لو تُركت لخطأ وهمها، أن تصبح طبقة عازلة تحوُل دون تدفق العمل الثوري وتُجمد وصول نتائجه عن الجماهير التي تحتاج إليه. إن اجهزة العمل الإداري ترتكب غلطة العمر إذا ما تصورت أن اجهزتها الكبيرة غاية في حد ذاتها. إن هذه الأجهزة ليست إلا وسائل لتنظيم الخدمة العامة وضمان وصولها على نحو سليم إلى الجماهير».
وفي مكان آخر من الميثاق جاء ما يلي:
«… والقيادات الجديدة لا بد لها أن تعي دورها الاجتماعي. وإن أخطر ما يمكن أن تتعرض له في هذه المرحلة هو أن تنحرف متصورة أنها تمثل طبقة جديدة حلت محل الطبقة القديمة وانتقلت إليها امتيازاتها.
إن قيادة المشروعات الكبرى في عملية التطوير، في حاجة أيضاً إلى أن تؤمن بأن الإسراف حتى وإن لم تتبعه استفادة شخصية هو نوع من الانحراف، فإنه إهدار لثروة الشعب التي هي وقود معركة التطوير.
والإسراف يشمل التضخم في مصاريف الإنتاج التي لا مبرر لها، كما أنه يشمل في الوقت ذاته عدم تقدير المسؤولية في دراسة المشروعات الجديدة، ويمتد إلى الإهمال في التنفيذ بدون اليقظة الواجبة لسلامة العمل.
إن تلك كلها من سمات مرحلة التغيرات الكبرى ومن أخطارها، ولكن السيطرة عليها والحد من تأثيرها ممكن بممارسة الحرية».
حقاً انه لأمر هام أن تطرح مشكلة البيروقراطية في مصر، ولولا التحول الحقيقي في بنيات المجتمع والتي تجري في اتجاه اشتراكي، لما كان ممكناً حتى الحديث العابر عن مثل تلك المشكلة.
إلا أن الميثاق بدلاً من أن يضع المسألة في إطارها الواقعي ويجوس في أبعادها ويُحدد معالمها ويُعلل وجودها ويفضح مخاطرها.. إن الميثاق بدلاً من أن يفعل ذلك مر عليها بسرعة وتحدث عنها باقتضاب فمستها بصورة سطحية، في حين أن مشكلة البيروقراطية في مصر من أكثر المشاكل تعقيداً ومن أكثرها إلحاحاً أيضاً.
إن هذه المعالجة الجانبية والجزئية للمشكلة، دون التصدي لها بصورة جبهية وجدية تُبين إلى أي مدى بلغ عمق النفوذ البيروقراطي وقوته في القطر المصري، كما تبين أيضاً أن المشكلة لم تُطرح في الميثاق على نحوٍ موازٍ لأهميتها وخطورتها وإلحاحها.
إن الميثاق بعد أن يتوجه بالإطراء إلى من أسماها بـ«القيادات الجديدة»، يتوجه إليها بالوعظ السطحي والنصح «المثالي» أيضاً، مع أن أسلوب كهذا قد ثبُت عجزه العملي من جهة، كما أنه من جهة ثانية «الغطاء السهل الذي تسَتَرَ به العجز عن التأثير في الواقع الاجتماعي وتنظيمه بطريقة إيجابية».
إن الأدوات الموضوعية في النضال ضد البيروقراطية هي الديمقراطية الاشتراكية والجماهير المنظمة. ولقد مس الميثاق هذه الحقيقة:
«إن سلطة المجالس الشعبية المنتخبة يجب أن تتأكد باستمرار فوق سلطة أجهزة الدولة التنفيذية، فذلك هو الوضع الطبيعي الذي ينظم سيادة الشعب ثم هو الكفيل بأن يظل الشعب دائماً قائد العمل الوطني، كما أنه الضمان الذي يحمي قوة الاندفاع الثوري من أن تتجمد في تعقيدات الأجهزة الإدارية أو التنفيذية بفعل الإهمال أو الانحراف. كذلك فإن الحكم المحلي يجب أن ينقل باستمرار وبإلحاح سلطة الدولة تدريجياً إلى أيدي السلطات الشعبية، فإنها أقدر على الإحساس بمشاكل الشعب وأقدر على حسمها».
بقيت كلمة أخيرة حول الميثاق: إنه خطوة هامة في الطريق نحو تلمُس الحقيقة الثورية، إلا أنه بحاجه لوضوحٍ وتحديدٍ وحزم.
إن ما هو أكثر أهمية من الميثاق الأدوات الموضوعية التي تنفذه. فهل تستطيع الثورة كسر الحصار البيروقراطي لتصل إلى أمها.. إلى الجماهير الشعبية؟
*** *** ***
هامش:
(1) من الملاحظ أن اصطلاحات الميثاق تعوزها الدقة، لأن الرأسمالية الوطنية قد ضُربت في تموز/ يوليو 1961 بصدور قوانين التأميم، ويبدو أن الميثاق يتحدث عن البورجوازية الصغيرة في حقلي الخدمات والتجارة الداخلية.
……………………………..
يتبع.. الحلقة الثامنة بعنوان: (النتيجـــة وملاحظة ختامية).. بقلم الأستاذ “ياسين الحافظ”
