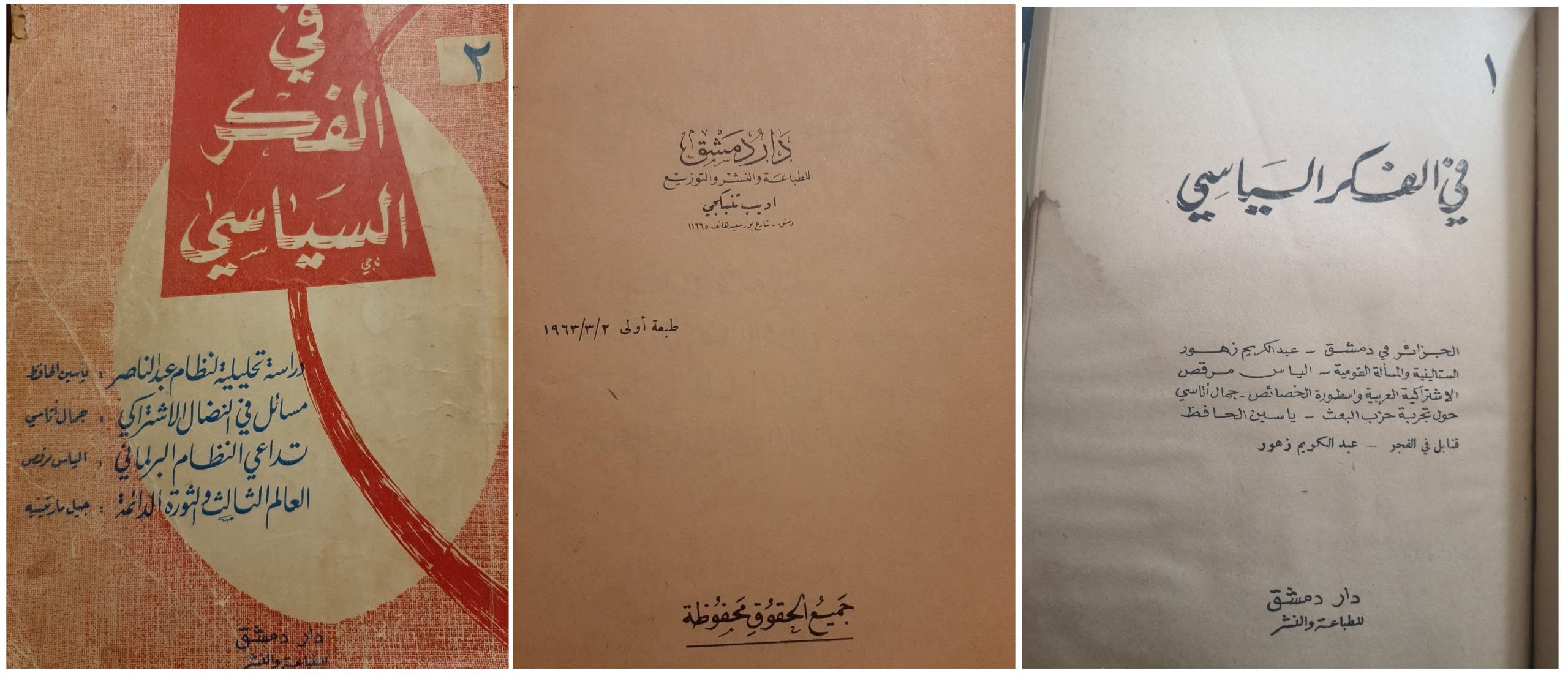
(الحرية أولاً) ينشر حصرياً الكتاب المفقود «في الفكر السياسي» بجزئيه، للمفكرين “الأربعة الكبار”، وهذه الحلقة السادسة من الجزء الثاني– بعنوان: (السمات السلبية للثورة).. بقلم الأستاذ “ياسين الحافظ”
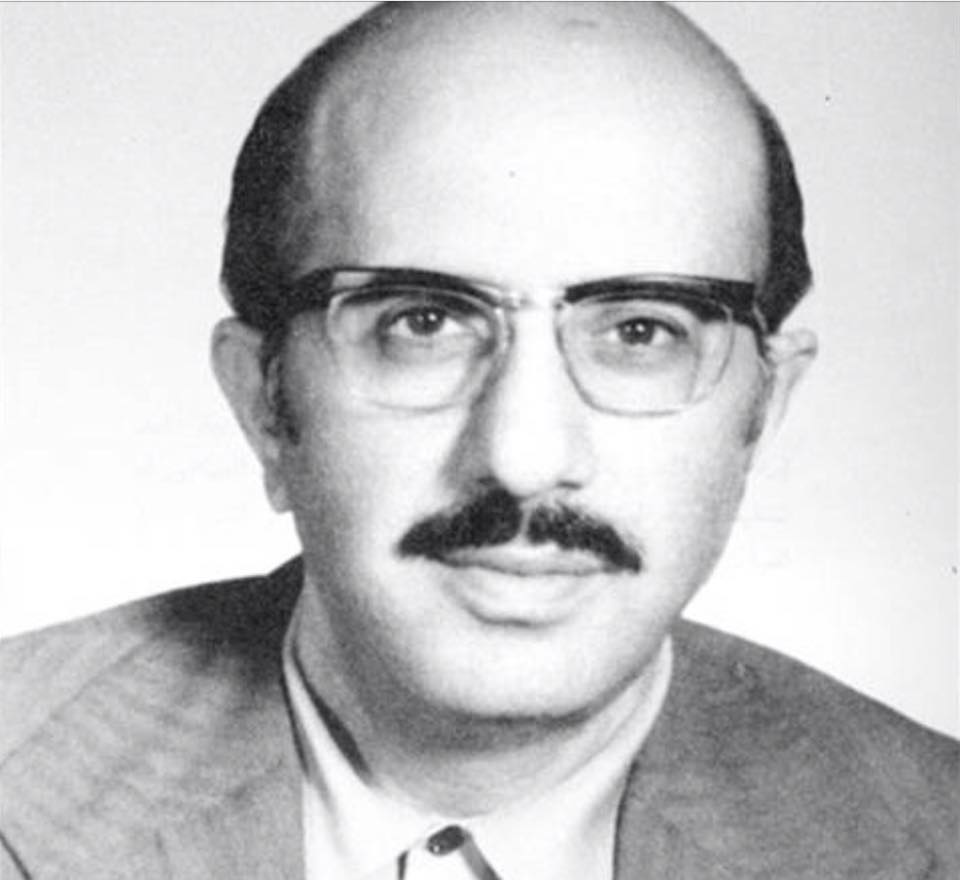
(5)
السمات السلبية للثورة
السمة السلبية الأولى للثورة هي أنها ثورة غير شعبية من حيث أداتها.
لقد كافح الشعب في مصر طويلاً، ونشأت أحزاب لعبت دورها في النضال، أفلست إفلاساً تاماً وتحولت إلى عقبة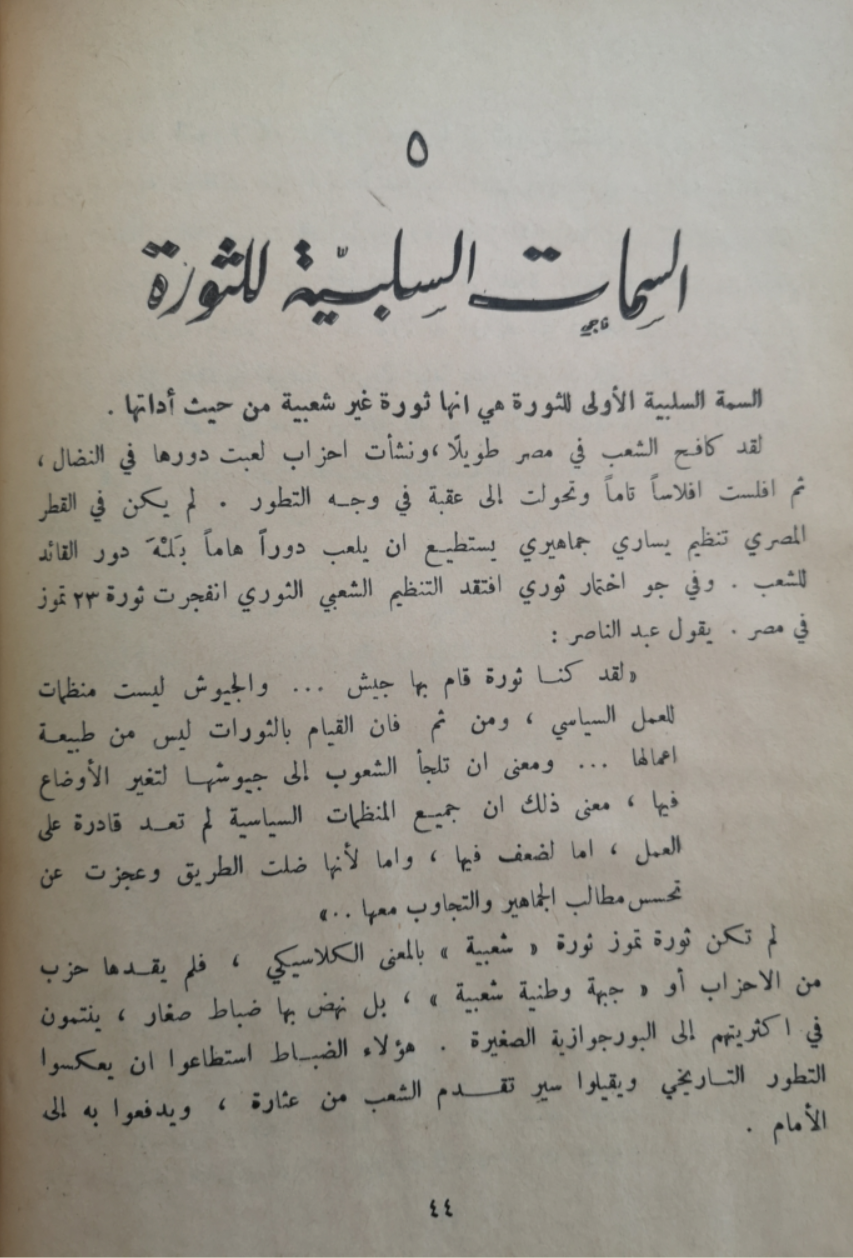 في وجـه التطور. لم يكن في القطر المصري تنظيم يساري جماهيري يستطيع أن يلعب دوراً هاماً بَلهْ دور القائد للشعب. وفي جو اختمار ثوري افتقد التنظيم الشعبي الثوري، انفجرت ثورة ٢٣ تموز/ يوليو في مصر. يقول عبد الناصر:
في وجـه التطور. لم يكن في القطر المصري تنظيم يساري جماهيري يستطيع أن يلعب دوراً هاماً بَلهْ دور القائد للشعب. وفي جو اختمار ثوري افتقد التنظيم الشعبي الثوري، انفجرت ثورة ٢٣ تموز/ يوليو في مصر. يقول عبد الناصر:
«لقد كنا ثورة قام بها جيش… والجيوش ليست منظمات للعمل السياسي، ومن ثم فان القيام بالثورات ليس من طبيعة ومعنى أن تلجأ الشعوب إلى جيوشها لتغير الأوضاع فيها، معنى ذلك أن جميع المنظمات السياسية لم تعد قادرة على العمل، إما لضعفٍ فيها، وإما لأنها ضلت الطريق وعجزت عن تحسس مطالب الجماهير والتجاوب معها.. ».
لم تكن ثورة تموز/ يوليو ثورة «شعبية» بالمعنى الكلاسيكي، فلم يقدها حزب من الاحزاب أو «جبهة وطنية شعبية»، بل نهض بها ضباط صغار، ينتمون إلى البورجوازية الصغيرة. هؤلاء الضباط استطاعوا أن يعكسوا التطور التاريخي ويقيلوا سير تقدم الشعب من عثاره، ويدفعوا به إلى الأمام.
إلا إن قولنا بأنها ثورة غير شعبية من حيث أداتها، لا يعني أنها من قبيل ما يسمى بـ «البوتش»، أي أنها ليست محاولة حلقه من المتآمرين أو المهووسين الأغبياء قامت نتيجة تجريد ذهني أو مغامرة حمقاء بعيدة عن المطامح الشعبة وعن الظروف الموضوعية للشعب في مصر… لا، لم تكن ثورة ۲۳ تموز/ يوليو كذلك، بل كانت وليد نضج ثوري افتقد التنظيم الشعبي الثوري الكلاسيكي، لقد كانت انفجاراً حتمياً اقتضاه سير التطور: لقد تفسخ الحكم وسقط في مستنقع الخيانة، وازداد الشعب سُخطاً ومرارة والأحزاب عجزاً وإفلاساً.. وكان لا بد لهذا المخاض من نتيجة، فالتاريخ لا يقف بانتظار الثورة الكلاسيكية. وتقدمَ الضباط الصغار، وكانت ثورة ٢٣ تموز/ يوليو التي استقبلتها الجماهير الشعبية بتأييد حماسي جارف، منذ اليوم الأول لوقوعها.
وإلى هذه السمة- أي لأن الثورة غير شعبية من حيث أداتها- يمكن أن تُنسب جميع المزالق والاخطار التي وقعت بها الثورة، وبهذه السمة يمكن أن تُفسر جميع الترددات والمساومات والمناورات والمهادنات التي اتبعتها.
إن الجماهير الشعبية هي التي تمنح التحرك التقدمي حزّمُه ومضاءه وزخمه، وهي التي تمنحه بنفس الوقت- ضمانة انتصاره الكامل والأكيد. ففي الجزائر- مثلاً- بدأت حركة الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي بالشعار التقليدي: الاستقلال، وما أن أمسكت الجماهير الشعبية دفة الثورة وتحملت مسؤولياتها، حتى تحول الكفاح إلى ثورة جذرية نسفت جميع بنيات المجتمع القديم ومن الجذور… وسارت بالثورة عدة مراحل وفتحت الطريق للتحويل الاشتراكي للمجتمع الجزائري.
عندما بدأ التحرك ليلة ٢٣ تموز/ يوليو 1952 كانت القضية الوطنية هي الحقيقة الوحيدة الماثلة أمام أنظار قادة ذلك التحرك. وحول قضية واضحة ومباشرة كهذه، يمكن أن تلتف جبهة عريضة تشمل جميع فئات الشعب (عدا الطبقات المرتبطة بالاستعمار) تبدأ بالعناصر القومية على الطراز الفاشي مارة عبر العناصر الدينية إلى إن تصل إلى الشيوعيين. وتلك هي فعلاً طبيعة التركيب الاجتماعي والفكري لجماعة (الضباط الأحرار). كانوا أشبه بجبهة معادية للاستعمار، ولم يكونوا قط ما يشبه «العصبة» أو «الحزب» الذي تنظمه ايديولوجية محددة. كان يجمعهم الرفض الحاسم والمطلق لمصر شبه المستعمرة، وإلى حد ما شبه الاقطاعية، إلا أن تشكيلهم كان يحوي ميولاً واتجاهات مختلفة: يمينيين ووسطيين ويساريين، إصلاحين وثوريين. هذا التباين في تكوين العناصر القيادية للثورة ، قد ترك آثاره على خطوات الثورة وعلى أساليب نضالها ومناهج عملها.
ومن الملاحظ أن قيادة الثورة- رغم الشوط الطويل الذي قطعته الثورة ورغم المراحل التي اجتازتها- قد بقيت، بشكل عام هي نفسها منذ قيام الثورة حتى اليوم. ومن الملاحظ أيضاً أن روح الصداقة استطاعت أن تحتفظ- على السطح- بمعظم العناصر القيادية للثورة رغم تنوع اتجاهاتهم وتناقضها. لذا فإن كل الجوانب السلبية التي لازمت خطوات الثورة وأعمالها هي وليدة تسوية التناقض الموجود داخل القيادة نفسها. صحيح أن الاتجاه التقدمي والثوري هو الذي يمسك بالزمام، إلا أن هذا الاتجاه نفسه لا ينجو من الضغط الدائم الذي تمارسه الأجنحة والتكتلات الأخرى، فهي لا تزال تلعب دوراً ملحوظاً في كبح الاندفاع الثوري وتأزيم التناقضات بين العناصر الثورية، وإبعاد الثورة عن الاتجاه الجماهيري بصورة خاصة.
ولأن الجماهير الشعبية لم تكن أداة الثورة، فقد نشأ توجس خفي في نفوس معظم قادة هذه الثورة تجاه الجماهير. يخيّل إليّ وكأن المحاكمة التي تدور في أذهان هؤلاء القادة تجري على النحو التالي: « مادام الشعب لم يصنع الثورة فلماذا نسلم له قيادها. وما دام لم ينهض بها فهل يؤتمن عليها?!»، تطلب الثورة من الجماهير الموافقة السلبية وترفض إسهامها الإيجابي. وهذا هو السبب الأساسي لفشل محاولات إيجاد تنظيم سياسي جماهيري جدي.
ما هي النتائج العملية التي نجمت عن هذه السمة:
- النتيجة الأولى لكون الثورة غير شعبية من حيث اداتها هي فشلها بإقامة ديمقراطية شعبية وثورية. إن الأساس الراسخ لكل ديمقراطية هو الإيمان العميق بالجماهير.. بحكمتها.. مبادرتها.. باقتدارها. إن هذا الإيمان هو روح الديمقراطية، وبدونه تبقى التنظيمات التي تزعم أنها ديمقراطية مجرد إطار شكلي خادع وكاذب. لقد نجحت الثورة بفضح زيف الديمقراطية- الرأسمالية المهزوزة والمبتورة والكاذبة، التي كانت ستاراً لإخفاء استغلالها وتأمين امتيازاتها من جهة وأداة لتنفيس السُخط الشعبي من جهة أخرى.
في مصر شبه الإقطاعية- شبه المستعمرة كانت السلطة بيد عملاء الاستعمار من الاقطاعيين والرأسماليين الاحتكاريين، لذا كانت «ديمقراطية!!» ما قبل الثورة «ملهاة مهينة» فعلاً، لأن تلك الطبقات، ما دامت تملك بيديها جميع أدوات التوجيه وما دامت تملك في كل الظروف القوة التي تفرض حماية مصالحها، لم يكن ليُضيرها أن تلعب لعبة «الديمقراطية» الكاذبة، مادامت هذه اللعبة أداة لامتصاص الغضب الشعبي من جهة وإسباغ الشرعية على حكمها وسيطرتها من جهة ثانية، وما دامت لا تتهدد جدياً المصالح الأساسية للرجعية.
إن النظام الإقطاعي- الاحتكاري عقبة كؤود أمام مبدأ الانتخاب نفسه، لذا بقيت الديمقراطية مجرد قشرة خارجية ليس لها جوهر ولا لباب. لم تُصنع الأحداث التاريخية قط في صناديق الانتخاب أو في البرلمانات، بل بالعكس لقد صُنع التاريخ بعيداً عنها وباتجاه مضاد ومعادٍ لها. إن البرلمانات في مصر- وفي البلدان المتخلفة بشكل عام- هي «البيت الذي ليس له نوافذ» كما يقول الفرنسيون، لذا كانت ندوة لأرستقراطية هزيلة جشعة متخلفة، نظراً لعدم وجود أسس اقتصادية واجتماعية لهذا الشكل من الديمقراطية. إلا أن الرجعية، قبل الثورة بخمسة أشهر، لم توفر حتى هذا النوع من الديمقراطية، لأنها- كعادتها في كل زمان ومكان- تحكم بصورة مباشرة في اللحظات الحرجة من حياتها.
إن احداث تموز/ يوليو 1952 في مصر دفعت بالتطور أشواطاً، تخطى ذلك الشكل المهترئ والمتخلف من الديمقراطية، لذا لم تكن المسألة المطروحة على الثورة هي العودة إليها، بل كانت إيجاد شكل جديد من التنظيم الديموقراطي لسلطة جماهير الشعب، كان مطلب الجماهير ديمقراطية أسلم وأمتن وأكثر جدية.. ديمقراطية تلجُم الرجعية وتكون تعبيراً جماعياً للمسؤولية الشعبية في نفس الوقت، إن مطامح الجماهير كانت تتجه إلى شكل جديد للديمقراطية أوسع وأعمق وأكثر جدوى، إلا أن الثورة اكتفت بمجرد الرفض للشكل القديم وأخذت تدور حول نفسها في حلقة مفرغة وهي تمضغ وتردد فكرات نقدية الديمقراطية البرلمانية، صحيحة من حيث المبدأ، إلا أنها تحولت مع الزمن إلى دعاوة ديماغوجية لستر فشل الثورة في بناء ديمقراطية شعبية جديدة.
لم تثق الثورة، ممثلة بقياداتها، بقدرة الجماهير على حمل عبء الثورة وتطويرها وحمايتها، لذا عجزت عن تلمُس كلمة السر في أزمة بناء ديمقراطية جديدة، وكلمة السر الإيمان بالجماهير، افتقاد هذا الإيمان هو الذي منع وسيمنع خلق أي شكل جدي للديمقراطية الشعبية.
إن انتهازية التقدمي أو الثوري تكمن- في الحقيقة- في أنه يُخفي في نفسه بعض الشك بالجماهير الشعبية، في أنه يُكن لها بعض الاحتقار، في أنه لا يثق بقدرتها على المحاكمة، في أنه لا يؤمن بمبادهتها الثورية؛ وتلك هي «عقدة» ثورة 23 تموز/ يوليو الأساسية.
وقد كان لفشل الثورة في إقامة ديمقراطية شعبية نتيجة هامة واضحة، وهي بروز الطابع الفردي للحكم. وإذا كانت الصفات الشخصية لعبد الناصر وما تتميز بها من ثورية وإيمان بالعروبة وحب عميق للشعب وإمكان للتطور وانفتاح على التيارات الإنسانية وفهم المواقع واستيعاب لروح العصر.. إذا كانت هذه الصفات قد أهلته للقيام بدور إيجابي في تاريخ تطور مصر وتطور الأمة العربية بعامة، إلا أن لهذه الظاهرة مظاهرها السلبية أيضاً، لأن مقتضيات النضال الثوري (الذي لا بد أن يكون شعبياً مُنظماً) أكبر وأعظم وأعمق وأشمل من أن ينهض بها فرد مهما امتلك من صفات إيجابية خارقة، لأن حكم الفرد، «وإن استشرف آفاقاً تقدمية وثورية، عاجز فعلاً عن تعبئة طاقات الجماهير تعبئة ثورية كاملة، كما أنه يعوّق انطلاقة الجماهير من أن تمضي بكل عنفوانها وزخمها نحو أهدافها القصوى البعيدة، وهو أخيراً الذي يحوّل عملية الثورة من زحف شعبي منظم مرصوص إلى غارة تحمل طابع المغامرة المهدَّدة دوماً بالتطويق والإبادة(1)».
حقاً إن عبد الناصر لم يقضِ على نظام ديموقراطي حقيقي سليم، بل قضى على مجرد واجهة كرتونية كاذبة للديموقراطية تخفي طغيان الإقطاع واحتكار رأس المال.. حقاً إن مناخ ثورة انفجرت على شكل انقلاب عسكري لا بد أن تؤدي موضوعياً وحتمياً إلى مثل هذه النتيجة، أي إلى بروز الطابع الفردي في الحكم. إلا أن تحول الانقلاب إلى ثورة، بل إلى ثورة دائمة شقت الطريق للتطور الاشتراكي، هذا التحول لا بد أن يطرح بإلحاح تبديل هذا الطابع الاستثنائي والمتخلف للحكم (مع اعترافنا بأن حكم عبد الناصر الفردي قد لعب من الناحية الموضوعية دوراً إيجابياً وثورياً في التطور التاريخي)، وأن السبب الذي من أجله أصبح تبديل هذا الطابع مسألة ضرورية هي الظروف والمراحل الثورية الجديدة سواء في داخل القطر المصري أو في الوطن العربي كله، كما يفرضه أيضاً ما يحمله هذا الطابع في الحكم من مخاطر محتملة، سواء فيما يتعلق بانهيار الثورة عند غياب هذا الفرد أو تجمدها ووقوفها في منتصف الطريق، باعتبار أن الجماهير الشعبية المنظمة هي أداة حماية للثورة وهي في نفس الوقت أداة تطويرها نحو أهدافها القصوى الكاملة.
إن تبديل طابع الحكم الفردي، لا ينصرف في أذهاننا إلى مجرد إبدال شخص عبد الناصر بقيادة جماعية من «الطقم» الذي حوله. ففي رأينا أن هذا الضرب من التبديل؛ في هذه الارض السبخة التي يقوم عليها هيكل الحكم في غيبة ديموقراطية شعبية، يصبح خطوة إلى وراء، لأن عبد الناصر كشخص يحمل من المزايا الثورية والإمكانيات الإيجابية الخلاقة ما يجعل قيادته الفردية أكثر تقدماً وأعلى، من السُلم الثوري بمسافات من قيادة جماعية لـ «الطقم»(2) الحاكم في القاهرة.. هذا «الطقم»، الذي لا يحمل إيمان عبد الناصر بالعروبة وبالاشتراكية وإنما يُجَر لاهثاً خلف التطور الثوري والعربي الذي يقوده عبد الناصر.
فالتبديل في طابع الحكم الفردي، يجب أن يأتي تتويجاً لديمقراطية شعبية تبدأ من القاعدة الجماهيرية المنظمة، لتتواصل وهي صاعدة إلى الأعلى، إلى شكل ثوري في القيادة الجماعية، تأتي تعبيراً عن انسجام عميق مع هذه الجماهير واحترام راسخ لإرادتها. وإذا كانت هذه الحقيقة هي منطلق الميثاق لفهم المضمون الثوري للقيادة الجماعية، فيمكننا اعتباره قد أمسك فعلاً بجذور المشكلة عندما قال:
«إن جماعية القيادة أمر لا بد من ضمانه في مرحلة الانطلاق الثوري.. إن جماعية القيادة ليست عاصماً من جموح الفرد فحسب، وإنما هي تأكيد للديمقراطية على أعلى المستويات، كما أنها في الوقت ذاته ضمان للاستمرار الدائم المتجدد».
إن الآثار السلبية لطابع الحكم الفردي ليست قاصرة على القطر المصري فحسب بل ألقت ظلالها على النضال العربي بمجموعه (والنضال الوحدوي بخاصة). ولقد كانت كارثة الإنفصال إحدى آثاره السلبية .
لسنا الآن بصدد البحث عن أسباب سقوط الجمهورية العربية المتحدة، وإنما حسبنا أن نشير (ونحن في صدد الحديث عن الحكم الفردي) إلا أن أحد أسباب هذا السقوط كان مرده أساليب الحكم الفردي. إن ما سمي بالتناقضات بين إقليميّ الجمهورية العربية المتحدة هي في الحقيقة تناقضات البيروقراطيتين والبورجوازيتين السورية والمصرية (فليس بين العامل والفلاح في سوريا وبين العامل والفلاح في مصر أي تناقض). ولقد كان التناقض الرئيسي الحاسم هو التناقض بين البيروقراطيتين العسكريتين السورية والمصرية. إن الحكم الفردي، تبعاً لمنطقه في العمل (وهو منطق بيروقراطي بالضرورة) قد أوكل لهاتين البيروقراطيتين حماية الوحدة، وبعثر الجماهير بدلاً من أن ينظمها. هذا جانب من الموضوع، أما الجانب الآخر، فهو أن الحكم الفردي، تبعاً لأساليبه الشخصية الذاتية، وثقته الكاملة الوحيدة بالبيروقراطية العسكرية المصرية؛ هذه الثقة- التي حاول الانفصاليون تفسيرها بالإقليمية والتسلط المصري- ناجمة إلى حد بعيد عن الصلة العميقة الجذور والمستمرة والمباشرة والشخصية بتلك البيروقراطية. وكانت النتيجة العملية لهذه الثقة، التي بُنيت على أساس ذاتي، أن وجدت البيروقراطية العسكرية السورية نفسها في مركز ثانوي وتابع. ومن هذا الشعور بالدونية تجاه البيروقراطية العسكرية المصرية، ومن خلال هذا التناقض تسللت الرجعية (الاقطاعية + البورجوازية) والاستعمار لتصنع الانفصال.
وإذا كان هذا شأن الطابع الفردي للحكم فيما يتعلق بالبيروقراطية العسكرية فإن ثقة الرئيس عبد الناصر بـ«عبد الحميد السراج»، قد لعبت دوراً سلبياً خطيراً في التمهيد لكارثة الانفصال. ان جو الحماس الثوري، الذي رافق قيام الجمهورية العربية المتحدة، قد امتصته وبددته أساليب «السراج»، اللامبدئية واللاثورية. لقد خلق في البلاد جواً مدمراً كريهاً قائماً على «الاستزلام»، وشراء الضمائر (بالوظائف أو بالنفاق أو بالمال)، وكان يُخفي حقداً واضحاً على كل ما هو يساري وثوري. لقد بدأ حياته «زلمة» للشيشكلي، واستمر يتأرجح (منذ سقوط الشيشكلي حتى قيام الوحدة بين مصر وسوريا) بين الكتل والتيارات، حاصراً همومه في مجده الشخصي.. فالعالم ينتهي عند قدميه.. وقد حصل على هذا العالم عندما اختلس ثقة عبد الناصر الشخصية عن طريق مؤامرة سعود.
تلك هي- بإيجاز- بعض آثار الطابع الفردي للحكم التي انعكست على نحوٍ خطر ومُفجع على النضال الوحدوي.
- والنتيجة الثانية لكون الثورة غير شعبية من حيث أداتها هي بقاؤها في منطقة الخطر دوماً. هذه حقيقة ماثلة وأكيدة رغم الشوط العميق الطويل الذي قطعه التطور في القطر المصري. لا يزال الخطر يترصد جميع مكاسب الشعب وانتصاراته، لأنها انتزعت بأسلوب في النضال يمكن تسميته بحق بـ«الغارة الثورية»، لا الزحف المنظم الشعبي المرصوص الذي يغطي ميدان القتال من نقطة الانطلاق إلى أرض المعركة، لذا فإن هذه الغارة الثورية المجيدة التي أصابت الرجعية، على مستوى محلي في مصر وعلى مستوى عربي، بطعنات قاتلة، مهددة دوماً بالخطر والإبادة. إن ظهر الثورة لا يزال مفتوحاً، لا تزال الفجوات الواسعة والعميقة تتخلل الامتداد الثوري، لا تزال جيوب رجعية وانتهازية في مراكز حساسة وهامة وقيادية. وسيبقى هذا الخطر جدياً مادامت الثورة غير مؤمَّنة بالجماهير المنظمة الفاعلة الايجابية. حقاً لقد استطاعت الثورة أن تخلق رأياً عاماً شعبياً يدعمها إلا أنه رأى عام سديمي لم يتحول يوماً إلى قوة مادية منظمة تحمي الثورة وتُطورها وتُقلل احتمالات الخطأ في أعمالها.
ولقد شعرت الثورة بهذه الحقيقة، لذا يؤكد الميثاق الوطني للثورة:
«أن الرجعية مازالت تملك من المؤثرات المادية والفكرية ما قد يُغريها للتصدي للتيار الثوري الجارف خصوصاً في اعتمادها على الفلول الرجعية في العالم العربي المسنودة من جانب قوى الاستعمار..».
إلا أن الثورة التي شعرت بالمخاطر التي تترصدها (والتي أصيبت بجرح بليغ في دمشق) لم تستطع أن تتعمق في البحث عن جذور الخطر، لقد اكتفت بإلقاء تبعة المخاطر على الرجعية، إلا أنها- في الميثاق الوطني الذي يلخص تجارب الثورة- لم تذهب إلى أبعد من ذلك. حقاً إن الرجعية هي المحرك الأساسي، إلا أن بقاء ظهر الثورة مكشوفاً هو الذي يغري الرجعية بالهجوم والتآمر، كما أن أداة الرجعية في التآمر كانت البيروقراطية، التي هي في نفس الوقت أداة الثورة.
إن الثورة في تشخيصها لأسباب الخطر بقيت في إطار العموميات، فلم تَرْقَ من الظاهرة إلى القانون، أمسكت بالمحرض وتركت الأداة. إن بقاء البيروقراطية (والعسكرية بصورة خاصة) في مركز الصدارة هو بقاء الثورة- كلياً ونهائياً- بين أيدي الجماهير المنظمة في منطقة الخطر. ولن تصبح الثورة في منطقة أمان إلا إذا أصبحت الثورة- كلياً ونهائياً- بين أيدي الجماهير المنظمة.
- والنتيجة الثالثة لكون الثورة غير شعبية من حيث أداتها هي اعتمادها الكلي على القمع كوسيلة للنضال ضد الرجعية أو ضد خصوم الثورة الآخرين. ولعل من الطريف أن نذكر في هذه المناسبة أن الثورة قد ألغت البوليس السياسي بعد قيام الثورة بسبعة أيام. ويبدو أن مثل هذا التدبير قد اتخذ بدافع من الحماس الرومانتيكي الثوري وفي فترة ظن خلالها قادة الثورة أن مهمتهم قد انتهت بإسقاط الملك. إلا أن الثورة إذ دخلت في صراع مباشر محموم مع الاستعمار والإقطاع دون أن تكون مستندة على تنظيم شعبي جماهيري، رأت نفسها مُنساقة- راغبة أو كارهة- إلى اعادة تنظيم أجهزة جديدة للقمع، لتكون أداة نضال ضد أعداء الثورة من جهة وأداة حماية للثورة أيضاً.
وفي وحشة الانعزال عن الجماهير، وفي وطيس المعارك ضد الرجعية والاستعمار استشرت أجهزة القمع وتوسعت، وبفعل قانون يكاد يشبه قانون التسارع في الميكانيك، ازدادت هذه الأجهزة تضخماً واتساعاً، وهي إذا كانت في البداية قد نُظمت لتكون أداة بيد الثورة وخدمتها، إلا أنها في غيبة الجماهير وبسبب الفقر الايديولوجي للثورة، انفصلت عن الثورة رويداً رويداً، لتشكل قوة ذاتية خاصة، تكاد تكون فوق قيادة الثورة، وتشدها دوماً في اتجاه غير شعبي وغير ثوري، وهي بسبب طابعها اللاإنساني زادت من عزلة الثورة عن طريق تدابيرها الغبية الهادفة لحماية الثورة، لذا أصبحت- عملياً- في موقف مناقض ومعارض للثورة ذاتها وهكذا تحولت إلى أداة لتخريب الثورة ذاتها، لأن وجودها أصبح رهناً بالإبقاء على الثورة في عزلتها.
إن الارتزاق يقود إلى الكذب والكذب، يوصل إلى النفاق، والنفاق يؤدي إلى الظلم والتسلط… وهكذا دواليك فأصبحت هذه الأجهزة تدور في حلقة جهنمية من الانحلال الأخلاقي الُمنعتق من كل رادع، والقسوة الحيوانية الغارقة في ما يشبه الشذوذ «السادي».
لقد أقامت الثورة هذه الأجهزة لحماية نفسها، إلا أنها أصبحت- بفعل سير تطورها الذاتي الذي يكاد يكون قانوناً- جداراً بين الثورة والجماهير، وأن هذه الأجهزة التي بدأت تعي مصالحها الخاصة رأت في الإبقاء على هذا الجدار سبيلاً لحفظ كيانها واستمرار نفوذها وامتيازاتها، لذا فهي ستبذل جهدها لتعميق جذور هذا الجدار ورفع بنيانه إلى الأعلى.
إن قولنا بأن أجهزة القمع أصبحت تشكل قوة ذاتية خاصة ومستقلة إلى حدٍ ما، ليس مجرد استنتاج تجريدي، بل هو حقيقة مُسْتجرة من الأحداث: قبيل أحداث أيلول/ سبتمبر 1961 في سوريا، ألم تحاول هذه الأجهزة التمرد؟! ألم تحاول فصم عرى الوحدة عندما جرى اقتلاع المباحثي الأول؟! وفي نفس الوقت.. لم ترتفع عقيرة أعداء الوحدة إلا للتنديد بهذه الأجهزة ومع ذلك بقيت هذه الأجهزة بعد ۲۸ أيلول/ سبتمبر 1961 وانسجمت مع طبيعتها عندما أصبحت بخدمة السلطة الانفصالية.
وبما أن لهذه الأجهزة طابعاً محافظاً ومحترفاً، فهي في طبيعتها وصميمها معادية لكل ما هو تقدمي وثوري، ويشدها خيط خفي نحو الرجعية، لذا فإن موقف تلك الأجهزة من الرجعية ومن أعداء الثورة الحقيقيين يتميز بنوع من الاتزان والتعقل الذي يبغي درء الخطر وحصره فحسب. أما موقف تلك الأجهزة من الثوريين والتقدمين فيتميز بشراسة وحماقة لا حد لها، فهي لا تكتفي بإيقاف وحصر معارضتهم للسلطة فحسب، بل أخذَ موقفها شكل اقتحام للضمير الداخلي، شكلَ قمعٍ بأسلوب هجومي فظ. أجهزة القمع هذه تُسكت الرجعي إذا تحدث بما لا يرضيها، أما اليساري الذي لم ير نفسه على وفاق مع السلطة، فيُرغم على إعلان عكس قناعاته، وأن يُفشي مكنونات نفسه. فلا يُطلب منه أن يسكت فحسب، ولا يكتفى بسجنه، بل يُطلب إليه أن يقول- وهو في حالة شنيعة من المهانة- ما ترغبه تلك الأجهزة أيضاً.. عمليات اقتحام وإذلال لا مثيل لها.. عمليات موت معنوي بطيء.. ذلك ما كان يتعرض له اليساري.
إن تلك الأجهزة- لأنها مأجورة ومحترفة- لا ترى الناس إلا أصنافاً ثلاثة: (۱) السوقة أو الدهماء (۲) العملاء والأتباع (۳) الأعداء. وفي حدود هذا التصنيف وعلى هديه عملت هذه الأجهزة… وهكذا انتهت أساليبها إلى امتهان مُتعمد للخُلق الإنساني وعامل تفسيخ لضمير كل مواطن لا يستطيع أن يتماسك أمام ظلام السجن ورطوبته ورهبة السوط ولذعه وإغراء المال والمنصب والجاه. لقد تحولت تلك الأجهزة إلى خطر أخلاقي فعلاً، وخلقت «جواً لا يُطاق، الإنسان لا يستطيع أن ينجو بكرامته حتى الشخصية، الذل يطوق النفس ويجري عليها كعرق الصيف ثخيناً حاراً دبقاً نتناً…».
- والنتيجة الرابعة لكون الثورة غير شعبية من حيث أداتها هي أنها لم تقف من الرجعية موقفاً حاسماً منسجماً مع متطلبات الروح الثورية والمهام الثورية. ولا يعني هذا أن الثورة قد سايرت أو هادنت الرجعية. إن في كلمة «مهادنة» لوصف موقف الثورة من الرجعية بعض الظلم، كما أنها تفتقد الدقة أيضاً. إن الثورة التي أصدرت قوانين الإصلاح الزراعي وقوانين التأميم وعشرات القوانين الهامة التقدمية لا يمكن أن تلّحَق بها هذه التهمة (ومن الطريف أن نذكر أن أكثر الناس إصراراً على هذه التهمة هم الذين يتحاضنون والرجعية العميلة ويشاركونها السلطة بعد الانفصال).
من الطبيعي أن تدابير جذرية، كالإصلاح الزراعي والتأميم، تُفقِد الرجعية قاعدتها المادية وسلاحها الأساسي، إلا أن هذه التدابير لا تنزع جميع أسلحة الرجعية، فلديها نقود عينية وثروات عقارية في المدن، لها نفوذها المعنوي والفكري، لها قراباتها وأبناؤها في أجهزة السلطة، وهناك أخطاء الثورة ونواقص عملها، وأخيراً هناك الرجعية العربية المدعومة من قبل الاستعمار العالمي. هذه الأسلحة تمنح الرجعية نفَساً طويلاً في المقاومة وتمنحها إمكانيات أكيدة لاستجماع قواها وخوض معارك جديدة أو حبك مؤامرات قاصمة وسريعة على الأقل. لذا تتميز المعارك ضد الرجعية باستمرارها وتنوع أساليبها وأشكالها وتعدد ميادينها، إنها معارك على مختلف المستويات تتناول جميع جوانب الحياة ومختلف قطاعات المجتمع، ولا تحتاج إلى شجاعة اقتحامية بقدر احتياجها إلى شجاعة واعية ودؤوبة ويقظة. تروي حكايات الأطفال أن للقط سبع أرواح، كلما قتلّتَ روح تحركت الأخرى للقتال، ويبدو أن للرجعية سبعمائة روح بدلاً عن السبعة.
إن الثورة في نضالها ضد الرجعية لم تفهم طبيعة المعركة، ولم ترَ أبعادها ومستوياتها لذا اكتشفت بعملية الردع والقمع، وفي أحيان أخرى حولت بعض عناصر الرجعية إلى أدوات بيدها. ولقد اعترف عبد الناصر بهذه الحقيقة بقوله:
«أن أول ما واجهناه من مشاكل، أننا كنا- نحن الذين قمنا بالثورة- لا نعرف على وجه التعيين معنى العمل الثوري وطبيعته ومقتضياته، ولقد كنا في حاجة إلى وقت طويل، تجارب وأخطاء، لكي يتبلور في نفوسنا ذلك كله».
المعركة مع الرجعية تقتضي الإبادة الكاملة، الإبادة السياسية والثقافية والاقتصادية، والإبادة المادية إذا اقتضى الأمر ذلك. لقد اكتفت الثورة بقطع أغصان الرجعية وفروعها وجذعها أيضاً، ولكن جذورها بقيت- ولا تزال- ضاربة في باطن الأرض، في حين أن مقتضيات المعركة تستلزم استئصال شأفتها من الجذور وإلى الأبد.
ولو أن الجماهير الشعبية، لو أن العمال والفلاحين، هم الذين قادوا المعركة ضد الرجعية لما اكتفوا بحصر الرجعية وردعها، بل لباشروا عملية إبادة بلا تردد وبلا رحمة أيضاً. فالرجعية لم ترحمهم طوال آلاف السنين. إن جماهير الكادحين لا بد أن تضع المسألة بشكل بسيط وحاسم: «إما أن نعيش نحن وإما أن تعيش الرجعية.. وكل تسوية وكل حل وسط أكذوبة وخدعة لإنقاذ الرجعية».
إلا أن كون الثورة غير شعبية من حيث أداتها ليس السبب الوحيد للموقف الذي اتخذته الثورة من الرجعية. إن السبب الثاني لهذا الموقف هو الخُرافة التي كانت الثورة تؤمن بها، هذه الخرافة هي فكرة السلم الطبقي. كانت الثورة تعيش وهم وجود إمكانية لحل التناقض الطبقي بالتفاهم لا بالنضال، وكان عبد الناصر بكثير من السذاجة أو الديماغوجية- لست أدري- يشبه طبقات المجتمع بالدول في هيئة الأمم المتحدة، وكما أن على تلك الدول أن تتفاهم وتتعايش، كذلك على الطبقات أن تتعايش وتتفاهم وأن تصنع التقدم والرخاء عبر هذا التعايش الطبقي. وهذه الخرافة الفجة ولّدَت طرحاً سياسياً هو الاتحاد القومي.
طبعاً لقد تبددت هذه الخرافة في إحداث الانفصال، إلا أنها تركت آثارها السيئة على سير التطور في القطر المصري في الماضي، كما أنها ستلقي ظلالها- رغم انفضاحها على المستقبل، إذا لم يجرِ ممارسة النضال السياسي عملياً على أساس الصراع الطبقي، وإذا لم تُطبق هذه السياسة بحزم ودأب أيضاً.
إن ارتطام الثورة العنيف بالواقع دفع بها نحو اتجاه أكثر يسارية، وهي تمارس الآن سياسة حازمة طبقية على الصعيد العربي، أما على الصعيد المحلي في مصر، فقد ضربت الرجعية بعنف وبلا رحمة، إلا أن أداتها بقيت كما هي: (المباحث).
- والنتيجة الخامسة لكون الثورة غير شعبية من حيث أداتها هي نمو البيروقراطية- بشقيها العسكري والمدني بشقيها العسكري والمدني- واستفحال خطرها، بحيث تكاد تصبح وريثة الطبقات المستغلة.
طرح الصحفي السوفياتي «فيكتور مايفسكي» على الرئيس عبد الناصر السؤال التالي: لقد دخلت الثورة مرحلتها الثانية.. مرحلة الاشتراكية في التطبيق .. فإلى من تستند الحكومة في بناء هذه الاشتراكية? إلى البورجوازية.. أم إلى الشغيلة?!. فأجاب الرئيس: «ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أن حركة العمال في بلادنا لم تكن قوية في أي وقت من الأوقات.. أما الفلاحون فكانوا في وضع صعب وأكثرهم أميون، أما المثقفون فمرتبطون- إلى حد كبير- بالطبقة التي يخدمونها…».
الذي يهمنا في هذ الجواب أن الرئيس عبد الناصر قد اعترف أن اشتراكية الثورة لا تزال مُفرغة من عنصرها الإنساني.. من العمال والفلاحين، مفرغة من أصحاب القضية الحقيقيين والمباشرين. وفيما يتعلق بضعف حركة العمال وصعوبة وضع الفلاحين، ألا يحق لنا أن تتساءل: ألم يكن ممكناً- خلال عشر سنوات مضت على قيام الثورة- بناء حركة عمالية وفلاحية تتولى عملية البناء الاشتراكي؟! هل أتيحت لهاتين الطبقتين حرية حقيقية- سواء في المجال السياسي أو النقابي- لممارسة نشاطها التقدمي?! تلك هي الاسئلة الحقيقية التي تجنبها الرئيس عبد الناصر. وفي الجواب على سؤال الصحفي السوفياتي «مايفسكي» نقول: «لا الشغيلة هم دعامة الحكم وبناة الاشتراكية في مصر.. ولا البورجوازية أيضاً.. إنها البيروقراطية فهي العمود الفقري للحكم في مصر، فهي التي تبني وهي التي تحمي وهي التي تتمتع.
في غيبة الكادحين عن نضال يرتدي- من حيث الجوهر- الطابع التقدمي (رغم كل المظاهر السلبية التي تلازمه) لا بد أن تلعب البيروقراطية دوراً أساسياً في هذا النضال، تلك هي حقيقة المسألة في مصر.
جذور البيروقراطية في مصر ضاربة في أعماق الأرض وبطون التاريخ لقد بدأت مع مشاكل الري والصرف في الزراعة المصرية، وتلقفها الحكم الإقطاعي والاستعمار فاحتضناها وزادا من امتيازاتها. وتوسعت قاعدتها واستفحل خطرها بسبب التفسخ السياسي الذي كان سائداً قبل الثورة من جهة وبسبب سياسة التعليم المرتجلة التي كدست المثقفين النظريين من جهة أخرى. لقد تضخم الجهاز لكي يمتص هذا العدد الوفير من المثقفين (إذ رسمت سياسة للتوظيف ليس غرضها سد الحاجات الفعلية للدولة، بل هدفها تشغيل العاطلين من حملة الشهادات)، وعندما أخذت الدولة على عاتقها عبء تطوير الاقتصاد ازداد من جديد تضخم الجهاز وتَعَقد وما برح. وهذه الوضعية انعكست من جديد على البيروقراطية نفسها: إن تضخم الجهاز يخلق الفراغ عند الموظف، والفراغ الدائم يخلق الكسل واللامبالاة. وبما أن هذه الأجهزة، هي بالأصل، أجهزة حكم اقطاعي، لذا فقد ورثت عقلية متعالية على الشعب، وخالية من الشعور الجاد بالمسؤولية، كما أنها غير مؤمنة بالاشتراكية.
لقد أدركت الثورة هذه الحقيقة، وحاولت- عبثاً- أن تعملَ شيئاً، فأصدرت قانون تطهير الإدارة الحكومية في ٤ آب/ أغسطس 1952، وحاولت أن تداوي البيروقراطية المدنية بالبيروقراطية العسكرية، ولكن منطلقات الثورة في معالجة المعضلة جعلت كل المحاولات المبذولة عقيمة وفاشلة إلى حدٍ كبير. وهكذا كان الاندفاع التقدمي يتباطأ ويتشرذم ويطيش عندما تتولاه الأجهزة البيروقراطية.
أحد ثوريي الجزائر الكبار(هواري بومدين)، لاحظَ- رغم بُعده عن مصر- هذه الظاهرة السلبية في أجهزة الثورة في مصر. وفي معرض حديث له عن دور الجماهير في المرحلة الثورية الجديدة، مرحلة بناء الجزائر، ذكر ما يلي:
«.. أنظر- مثلاً- نظام عبد الناصر، إنه بالرغم من المدة الطويلة التي مرت عليه لم يستطع- حتى الآن- أن ينطلق انطلاقة سليمة. لماذا؟ لأن العقلية البيروقراطية وروح الوظيفة يحرك المسؤولين.. إنني لا أشك في إخلاص عبد الناصر لقضة الشعب، ولكن الثورة هي مسألة جماهير وتعبئة شعب، والشعب لا يمكن أن يُعبأ عن طريق الأوراق والأوامر الصادرة من المكاتب. إننا لا نريد أناساً يسيّرون الشعب بالتلفون والورقة، نريد مسؤولين متصلين بالجماهير، يعيشون معها ويحركونها.. إن الثورة بحاجة إلى جهار ثوري وجماهيري».
في البلدان الاشتراكية، تم تحطيم وتصفية الأجهزة البيروقراطية المرتبطة بالأنظمة القديمة. وفي معمعان النضال الثوري بُنيت أجهزة جديدة. إلا أن هذه الأجهزة التي انطلقت من بدايات ثورية تحولت- شيئاً فشيئاً- إلى أجهزة بيروقراطية ثقيلة عرقلت تطور النظام الاشتراكي وأضعفت نموه، بسبب ضمور دور الجماهير من جهة وتحويل الديمقراطية الاشتراكية إلى مومياء تخفي طغياناً أوتوقراطياً دامياً.
أما في القطر المصري، فإن البيروقراطية الحالية هي- إلى حدٍ كبير- امتداد للبيروقراطية القديمة، من حيث العقلية ومن حيث النفسية معاً. وزاد الطين بلة إفلاتها من كل نقد جاد أو رقابة شعبية صارمة، فتوطد مركزها واتسع نفوذها، فانفصلت عن المجتمع وأصبحت في موقف التناقض والتعارض معه.
للبيروقراطية في البلدان الاشتراكية مزايا إيجابية إلى جانب الظاهرات السلبية فيها، فهي متخصصة وجادة ودؤوبة ومؤمنة بالاشتراكية، إلا أن السبب الأساسي الذي يضع تصفية مخاطرها، كمهمة مباشرة أمام الشغيلة، هي أنها أصبحت عقبة أمام تطوير الديمقراطية الاشتراكية، هي أنها تشوه التطور الطبيعي للعلاقات الاشتراكية في المجتمع، هي أنها اصبحت تشكل قوة خاصة أخذت مكانها فوق المنتجين المباشرين بشكل خاص وفوق جماهير الشعب بشكل عام. أما البيروقراطية المصرية (فيما عدا قلة متخصصة) فتكاد تفتقد أي سمة إيجابية: الكسل، اللامبالاة، ضيق الأفق، الامتيازات المادية المُسرفة، عدم الإيمان بالاشتراكية، الاسراف والتبذير.. وجاءت اللامبالاة بالسياسة (التي شجعتها الدولة) لتؤكد هذه الجوانب السلبية وتعمق جذورها. أحد الذين عرفوا البيروقراطية المصرية، وصفها بقوله: «يعمل البيروقراطي المصري بأطراف أصابعه وهو في حالة قرف ايضاً». لقد بلغت مسألة البيروقراطية حداً من الخطورة بحيث تكاد توحي للمراقب بأنها ليست ظاهرة مرضية عابرة بل عاهة دائمة في نظام الحكم في مصر.
ولكن.. هل يعني الاعتراف بهذه الحقيقة تبرير استخدام هذه الظاهرة الحتمية والمؤقتة لمهاجمة الاتجاه الاشتراكي نفسه في مصر؟ هل يعني هذا الموافقة على اصطناع الضجيج حول هذه الظاهرة وممارسة انتقاد ديماغوجي لدور الدولة الاشتراكي في مصر؟
إن ممثلي الرجعية- ومن في خنادقها ممن ينسبون أنفسهم لليسار- يسرهم طبعاً مهاجمة التحولات الاشتراكية في القطر المصري تحت ستار مهاجمة البيروقراطية، إلا أننا لن نفعل ذلك، لأننا نميز بين ما هو هامشي وعارض وبين ما هو أساسي ودائم في سير التطور في القطر المصري. لن نغرق في اللحظة الراهنة ولن نضيع في التفاصيل والجزئيات، لأننا لم ننسى الاتجاه العام الأساسي والآفاق الواسعة التي فُتحت في وجه التطور في مصر.
ولكي نوضح مختلف جوانب الموضوع، لا بد من وقفة جديدة:
البيروقراطية هي- قبل كل شيء- مرض فطري لجهاز الدولة الرأسمالي، هي إحدى طحالب السلطة البورجوازية. لقد نمت هذه الفئة وتضخمت مع تطور البنيات الاقتصادية وتعقد الحياة الاجتماعية .. وهي الآن في ذروة قوتها وأوج سلطانها في الدولة الرأسمالية.. حيث جرى نقل السلطة الحقيقية من البرلمان إلى هذه الفئة.
هذه الفئة من البورجوازية (ونعني البيروقراطية)، بحكم ارتباطها بطبقة معينة، ومن حيث الشكل الهرمي التسلسلي لتنظيمها، وبحكم طاعتها المنفعلة وعبادتها للسلطة، وبحكم نشاطها الشكلي الثابت وأفكارها وتقاليدها المكرورة الرتيبة.. هي من حيث الجوهر فئة محافظة في أحسن الأحوال، إن لم تكن رجعية.
ولأن البيروقراطية وليدة النظام الرأسمالي وخدينته في نفس الوقت، لذا فإن تصحيح وتصفية المرض البيروقراطي لن يتم إلا بتصفية النظام الرأسمالي نفسه. النظام الاشتراكي- اذن- هو وحده الذي يُمكِّن من الكفاح ضد البيروقراطية ويفتح الطريق لتصفيتها واقتلاعها من الجذور. وتبعاً لهذا فإن التطور الاشتراكي في مصر سيَطرح على الجماهير الشعبية- بصورة عملية وأكيدة- مهمة تصفية مخاطر هذه الفئة، وإن طبيعة التطور الاشتراكي هي وحدها التي تتيح حلاً جذرياً وتقدمياً لهذه المعضلة، وهذا يعني أن الاتجاه نحو الاشتراكية هو في نفس الوقت خطوة في هذا السبيل. لذا فان هؤلاء الذين يهاجمون التحولات الاشتراكية في مصر، لأن البيروقراطية تلعب الدور الأساسي في مصر، يدافعون من حيث النتيجة عن البيروقراطية التي يزعمون مهاجمتها، لأن كل حديث عن تصفية نفوذها ومخاطرها في ظل النظام الرأسمالي باطل وعابث.
تبين التجارب الاشتراكية (وهي تجارب في البلدان المتخلفة) إنه كلما كانت الظروف الاقتصادية للمجتمع متأخرة وضعيفة، وكلما كان الدور الاجتماعي والتأثير الفعال للطبقة العاملة أقل قوة، تزداد أهمية الدور الذي تلعبه البيروقراطية، وبصورة خاصة في مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية. «وخلال مرحلة الانتقال هذه، حيث لم يشيد بعد أساسه الجديد، وحيث لم يترسخ بعد، وحيث لم تكن الطبقة العاملة قد امتلكت بعد ناصية الإدارة الاقتصادية والاجتماعية… في هذه المرحلة تلعب الدولة دوراً تقدمياً خاصاً في الادارة الاقتصادية والاجتماعية». هذه الظاهرة- إذاً- ليست شراً كلها، فهي حتمية وهي- إلى حد ما- إيجابية خلال مرحلة طويلة من التطور.
وإذا كانت البيروقراطية قد لعبت دوراً أساسياً فى بلدان قد عانت تجارب ثورية مكتملة وناضجة وحيث الظروف الاجتماعية والاقتصادية أكثر تقدماً مصر وحيث الطبقة العاملة فيها أقوى وأنضج ومنظمة في تشكيلٍ سياسي… إذا كان هذا شأن البيروقراطية في مثل تلك البلدان… فكيف يمكن أن تجري الأمور في القطر المصري?
ونحن لا نبغي من وراء حديثنا هذا تبرير وجود واستمرار هذه الظاهرة السلبية، ولكننا أيضاً لن نطالب أحداً باجتراح المعجزات، لأن استئصال البيروقراطية لا يمكن أن يتم بين يومٍ وليلة وبقرارات بيروقراطية معاكسة بل بإيجاد تنظيم شعبي وثوري من جهة وبتطوير الديمقراطية الاشتراكية من جهة أخرى. وبواسطة هذا التنظيم وفي ظل ديمقراطية اشتراكية حقيقية وواسعة وعميقة.. يمكن استئصال شأفتها عن طريق ممارسة نقد جريء موضوعي وبناء من قِبل الطبقة العاملة خصوصاً وجماهير الشعب عموماً. ولا بد من تطور طويل ونضال لا انقطاع فيه ولا هوادة لكي يمكن برء الجسم الاشتراكي من بقايا المجتمع القديم وأولها البيروقراطية.
بقي أن نقول كلمة أخيرة حول هذا الموضوع : إن عبد الناصر لم يحوّل ثورة شعبية إلى الطريق البيروقراطي، ولكنه لم يحوّل ثورة بدأت بأداة غير شعبية (عسكرية) إلى ثورة شعبية… تلك هي حدود المسؤولية التي يتحملها عبد الناصر.
- والنتيجة السادسة لكون الثورة غير شعبية من حيث أداتها هي بطء وتيرة التقدم. ولكن لكي نلتزم الدقة لا بد أن نثبت عوامل أخرى سببت ثقل هذه الوتيرة، منها تجريبية الثورة (سنتحدث عنها بعد قليل) التي لم لها الإمساك بالمنطلق الصحيح للتقدم العاصف (ونعني بهذا المنطلق تجنب الطريق الرأسمالي للتطور). إن تحقيق أهداف ثورية ذات طابع إيجابي يتطلب- كما يقول ميثاق الثورة الجزائرية-:
«استخلاص وتكوين طليعة واعية تشمل العناصر المثقفة من الفلاحين والعمال والمستأجرين بصفة عامة والشبان والمثقفين الثوريين… لأن الثورة ليست مجموعة من الصيغ العملية تطبق بطريقة متناسلة وبيروقراطية…».
إن ثورة ٢٣ تموز/ يوليو إذا افتقدت النسغ الشعبي استبدلت الإنسان الثوري بالإنسان- الاداة. وتتدرج أدوات أجهزة الثورة للتخطيط والتنفيذ- في السُلم الأخلاقي والقومي- من أصحاب النوايا الطيبة إلى الإنسان النظيف إلى إنسان- الراتب إلى المباحثي. إن النموذج الأرفع في أدوات الثورة هم «أصحاب النوايا الطيبة»، هم الذين يعيشون في فرجة مصحوبة بتعاطف «رسمي» مع نضال الجماهير في سبيل قضيتها، ويتميز هؤلاء بالفهم الغامض أو السيء لخصائص الثورة، أو بالإنتهازية المُبطنة الوجلى التي تُفصح عن نفسها في مواقف الإغراء والاصطناع.
هؤلاء هم الكادر القيادي للثورة، وأن مثل هذه النماذج إذ يعوزها الشعور الجاد بالمسؤولية والانفعال الصادق بقضايا الشعب والوعي العميق لروح الثورة والالتصاق بالجماهير، يبقى إيمانها بضرورة التغير الجذري هزيلاً.. هذا «إذا كان الإحساس بالحاجة للتغيير الجذري موجوداً أصلا في نفوسهم».
إن مثل هذه النماذج قد يصلحون كخبراء كأدوات تنفيذ في التفاصيل.. في ميادين كهذه قد يلعبون دوراً إيجابياً.. إلا أنهم بالذات يتحولون إلى أدوات تعرقل وتبطئ التقدم.. يتحولون إلى عصي في عجلة الثورة عندما يتولون مراكز قيادية. وهم بالإضافة إلى كل ذلك يشوهون تنفيذ المهام الثورية التي تلقى على عاتقهم.
هذه حقيقة يجب أن نُعلنها، ولو كانت مُرة: لقد عجزت الثورة عن خلق طليعة واعية.
لكي يتحقق العمل الثوري على نحو سريع وكامل، لا بد من توفر شرطين: الأول تحرّك جماهيري واسع وعميق، والثاني طليعة واعية وثورية لقيادة هذه التحرك. وقد افتقد القطر المصري هذين الشرطين لذا كانت خطى التقدم ثقيلة ومتعرجة.
إن العمل النوري الإيجابي ليس قانوناً يصّدر لينفذ بضربة واحدة ثم ينتهي الأمر، ليس حركة تبدأ من الأعلى فتنعكس الحركات في الأسفل متتابعة آخذة كل واحدة برقاب الأخرى. لا.. إن كل ذلك هو فتح الباب للعمل الثوري الإيجابي والتمهيد له، لأن العمل الثوري الإيجابي هو عمل يومي بسيط ودؤوب فيه صبر وفيه نكران الذات أيضاً، هو عمل بعيد عن الصخب السياسي والثرثرة «الثورية»… وهنا تكمن صعوبته وهنا أهميته وجديته أيضاً.
إن ثورية العمل الإيجابي تستلزم تحريك أوسع الجماهير وإثارة مبادرتها الحارة الدؤوبة التي تستلهمُ مثلاً أعلى يُجدد حماسها واندفاعها وتفانيها في العمل. إلا أن ما يجري في القطر المصري يوحي بأن الأمور لا تجري على هذا النحو. فالجماهير الشعبية تعيش في ركود سياسي حقيقي، والفئات الأكثر وعياً والأكثر تقدماً فيها أدركت تبعيتها للدولة، ولا يحركها سوى حماس سطحي ومؤقت. ويُخيَّل إليّ أن كل منجزات الثورة كانت وليدة ضرب من العلاقات التجارية الصرفة الباردة بين قيادة الثورة والبيروقراطية وجماهير الشغيلة(3).
لقد حيل بين الشعب وبين تحمُل تبعة عملية البناء، وسُلمت المهام الثورية لإطارات غير ثورية وطُلِب إليها- كما يقول عبد الناصر-: «تنفيذ أهداف ثورة لم تنفعل بها».. في حين أن بناء دولة عصرية وتنظيم مجتمع ثوري- بصورة سريعة واقتصادية وجدية- تقضي فتح الطريق لمبادرة الشعب نفسه ولرقابته المباشرة. وخلال النضال اليومي الدؤوب لجماهير الشعب يجري استخلاص طليعة واعية من العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين. وأن طليعة كهذه، هي وحدها، التي تدرك بعمق معنى النضال التاريخي للشعب العربي وتعيش قضيته .. هذه الطليعة، هي وحدها- التي تلتحم- بإصرار ودأب، مع الجماهير الشعبية في شتى مراحل النضال.. تُعلمها وتتعلم منها.
- والنتيجة السابعة لكون الثورة غير شعبية من حيث أداتها هي أن تكتيك الثورة النضالي ضد فرقاء الجبهة الاستعمارية كان مختلفاً إلى حدٍ ما. ففي حين أن تكتيك الثورة النضالي ضد الاستعمارين الإنكليزي والفرنسي يتميز بشدته واستمراره، أما تكتيكها ضد الاستعمار الأمريكي فيتميز بالمناورة.
قبل أن نتحدث عن أسباب هذا التكتيك وجذوره، لا بد أن نتساءل: هل التكتيك الثوري للنضال مجرد هجوم اقتحامي دائم کاندفاعات ثيران المصارعة؟ وفي الجواب على هذا التساؤل نقول: من حيث المبدأ- بالنسبة للثوري- ليس هناك أسلوب مسبق مُحدد ووحيد للنضال. فالثوري، تبعاً لنسَب القوى في المعركة وظروفها، قد يتخذ موقف الاقتحام أو التراجع.. الدفاع أو المناورة أو المهادنة.. وحتى التنازل أحياناً، إلا ان الثوري (خلافاً للانتهازي) لا ينسى لحظةً هدفهُ النهائي الكبير.. هذه حقيقة اثبتها تجارب النضال الثوري في كل أنحاء العالم، كما يمليها الفهم الموضوعي الواعي لمشاكل النضال وأساليبه وظروفه.
ولكن.. قد يتساءل القارئ: ما دامت المناورة جزءاً من التكتيك الثوري… لماذا اعتبرت مناورة الثورة تجاه الاستعمار الأمريكي مظهراً سلبياً في أسلوب نضالها ضده?. قبل أن نجيب على هذا التساؤل لا بد أن نوضح اننا لا نعنى بمناورة الثورة للاستعمار الأمريكي المهادنة أو المسايرة (أو الالتقاء كما يزعم المرتدون المفترون الحاقدون)، بل هي شكل من أشكال النضال الذي تستخدمه الثورة، وهي ثابتة في مواقعها الوطنية، إلا أن هذا النضال يحوي توجساً خفياً من قوة الاستعمار الأمريكي، وتتجلى هذه الخشية غير المنظورة في تذبذب سياسة الثورة تجاه الاستعمار الأمريكي. ولو كان إيمان الثورة بقوى الشعب كاملاً ومُطلقاً لاتخذ أسلوب الثورة النضالي الموقف المناضل بالدرجة الأولى والموقف المناور بالدرجة الثانية، في حين أن الثورة تناور هذا الاستعمار أولاً تم تناضل ضده حيث لا تجدي المناورة فتيلاً، وحيث تصبح المعركة معه ضرورة لا بد منها، وتبقى- غالباً- في موقف الدفاع.
إلا أن ثقة الثورة الضعيفة بقوى الشعب وإمكانياته (التي ولّدَت الخشية من الاستعمار الأمريكي)، لا تفسر بمفردها هذه الظاهرة. ولا بد- لكي يكون تفسيرنا علمياً وكاملاً- أن نضيف عوامل أخرى ساهمت في تحديد تكتيك الثورة. إلا أن هذه العوامل تفسر هذا التكتيك، ولكن لا تبرره.
تُلخص هذه الأسباب بما يلى:
السبب الأول لاختلاف تكتيك الثورة في النضال ضد الاستعمارين هو مكان كل منهما في أرض المعركة المصرية بصورة خاصة والمعركة العربية بصورة عامة. الاستعمار الإنكليزي هو الاستعمار الذي يحتل عملياً وفعلياً المخافر الأمامية في الجهة المعادية لشعبنا، لذا فإن طبيعة النضال ضد النفوذ الاجنبي والسيطرة الاستعمارية حتمت أن تكون المعارك الأولى الفعلية والمادية مع الاستعمار الإنكليزي. يراقب الاستعمار الأمريكي دوماً نتائج المعركة بين الشعوب وبين الاستعمار التقليدي فإذا وجد في جبهة الشعوب قوى مساومة اقتسم الغنيمة مع الاستعمار التقليدي، وإذا تم سحق الاستعمار التقليدي حاول أن يتسلل إلى مواقعه ليرثها، وإذا رأى في انطلاقة الشعب خطراً شاملاً تحالف مع الاستعمار التقليدي ليقف في وجهها، وقد ينسحب إذا رأى خسارة المعركة أكثر من ربحها.. وهكذا فهو- بالنسبة للشعب العربي- يتحول من خطر بالقوة إلى خطر بالفعل كلما تمت تصفية موقع من مواقع الاستعمار التقليدي.
تتميز المعركة مع الاستعمار الإنكليزي- اذن- بأنها معركة اقتلاع بالدرجة الأولى، أما المعركة مع الاستعمار الأمريكي فهي- بشكل أساسي- معركة قطع الطريق أمام تسلله، معركة صد هجومه ودرء خطره الداهم.
أما السبب الثاني فهو أن الثورة وقد أدركت الطبيعة المختلفة لكل من المعركتين أرادت أن تستخدم التناقض الجزئي وغير الأساسي والمؤقت بين أهداف كل من الاستعمارين لمصلحة الشعب. فالاستعمار الإنكليزي بالنسبة لمصر الخطر الواقع والفعلي، بينما الاستعمار الأمريكي هو الخطر الماثل. وكان الهدف المباشر للمعركة هو اقتلاع الخطر الفعلي، ومن الممكن بل من الواجب الاستفادة من تناقضاتها مهما كانت جزئية، لذا يشير أنور السادات إلى: «أن تصرف الثورة حيال أمريكا، من أول يوم للثورة، كان مناقضاً لتصرفها حيال انكلترا» (كتاب الهلال- العدد ٨٨- ص ٧٦)، ولم يكن هذا التصرف وليد جهل بطبيعة الاستعمار الأمريكي، لأن قادة الثورة عندما قاموا بتقدير احتمالات تطور الموقف- عشية إعداد الثورة- أخذوا في الحسبان تدخل أمريكا ضد الثورة باعتبار «أن مركز الثقل في توجيه الحكم- قبيل الثورة- بدأ يتزحزح رويداً رويداً من السفارة البريطانية إلى السفارة الأمريكية..» (نفس المرجع ص: ۱۰٦- ۱۰۷). وتبادلت الثورة الابتسامات مع أمريكا، التي رأت في هذا الموقف مجالاً لإكمال تسللها الذي بدأ قبيل الثورة ولكي ترث النفوذ الإنكليزي في مصر. إلا أن الثورة التي لا ترى في موقفها أكثر من مجرد تكتيك سدت الطريق بحزم أمام المحاولات الامريكية الواحدة تلو الأخرى.
والسبب الثالث لاختلاف تكتيك الثورة حيال الاستعمارين هو حدود وشروط الدعم السوفياتي. فالدعم السوفياتي ليس أمراً أكيداً ومطلقاً في كل الحالات وضمن كل الشروط (وبصورة خاصة عندما تصبح الحرب هي الشكل العملي الوحيد للنضال السياسي). ففي العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وجه «بولغانين» إنذاره إلى فرنسا وإنكلترا ولم تكن أمريكا إلى جانبها. وفي ثورة ١٤ تموز/ يوليو 1958 في العراق- وعندما نزلت الجيوش الأمريكية في لبنان وقف الاتحاد السوفياتي في منتصف الطريق وأعلن أن حدود دعمه لثورة العراق وهي التخلص من المَلكية والخروج من حلف بغداد.. وجاءت أحداث كوبا في تشرين الأول/ أكتوبر 1962 لتؤكد أن سياسة الاتحاد السوفياتي الخارجية هدفها الأساسي التعايش السلمي، وفي حدود هذه السياسة- التي لا تتعداها- ستدعم نضال الشعوب. هذا فيما يتعلق بالدعم السوفياتي العسكري والسياسي. أما فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي والمالي، فإن امكانيات الاتحاد السوفياتي وطاقاته- ومجمل المعسكر الشيوعي- لا تستطيع أن تلبي كامل احتياجات التنمية والتطوير المقررة في برامج السنوات الخمس التي تنفذ في القطر المصري.
تلك هي الأسباب الرئيسية الثلاثة التي ساهمت بتحديد تكتيك الثورة المناور مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإذا أضفنا إليها العامل الأساسي والأهم، وهو افتقاد الثورة الثقة الكاملة المطلقة بقوى الشعب اكتمل لدينا التفسير الموضوعي لجذور هذا التكتيك.
يتجلى تكتيك الثورة المناور مع الولايات المتحدة الأمريكية في مظهرين أساسين(4):
– المظهر الأول هو ذلك الشكل الصاخب المنفعل والمصطنع لموقف الثورة من الحركات الشيوعية المحلية. لقد عرفت الثورة بأي ظفر تَحُك الجلد الأمريكي، لأن السياسة الأمريكية التي يؤرقها هذا الشبح- الشيوعية- رأت في هذا الجانب من سياسة الثورة العامل «المعدل» و«الملطف» لسياسة التعامل والتعاون مع السوفييت ولسياسة الحياد الإيجابي، رأت في هذه السياسة «الشر الأدنى» الذي لا بد من «ازدراده».
– أما المظهر الثاني فهو ذلك التطبيق «القضائي» «الأرثودوكسي» لمبدأ الحياد الإيجابي. إن سياسة الثورة المصرية تضع كلا المُعسكرين في كفة واحدة، مع أن الافق النضالي لبلدان متخلفة في حالة نضال فعلي مع الاستعمار يجعل المنطلقات الأساسية للسياسة التي يمارسها المعسكر الاشتراكي أكثر انسجاماً مع مصالح هذه البلدان وأكثر تعاطفاً مع شعوبها. ولا نعني بهذا أننا نريد فرض قضايا المعسكرين الخاصة ومعاركها المباشرة على السياسة العربية بشكل عام وعلى السياسة المصرية بشكل خاص، ولا نطلب من أحد خوض معارك مراهقة الاستعمار الأمريكي، كما أننا لا نطالب الثورة بالتخلي عن التكتيك المناور في النضال ضد الاستعمار، إلا أن استخدام المناورة بنجاح يقتضي ثقة كاملة ومطلقة بالجماهير الشعبية، هذه الثقة هي وحدها التي تملي سياسة مبدئية وثورية تجاه مختلف المشاكل السياسية العربية والدولية، دون انتظار لالتقاط صدى هذه السياسة في المعسكرات الأخرى.
إن سياسة «عدم الالتزام» بالمعسكرات الدولية قد تكون التعبير الأكثر دقة وملاءمة من كلمة «حياد» لوصف الموقف السياسي الثوري الواجب اتخاذه على صعيد السياسة الخارجية، وأن مثل هذه السياسة الطلقة المرنة المؤمنة بالشعب هي التي تتيح تبني سياسة مناورة وثورية في آن واحد.
وفي توضيح سياسة كهذه يقول «لينين»:
«إن القيام بحرب من أجل القضاء على البورجوازية الدولية، وهي حرب أصعب وأطول وأكثر تعقيداً مئة مرة من أشد الحروب العادية بين الدول، مع التخلي سلفاً عن المناورة وعن استغلال التناقضات في المصالح (حتى ولو كانت تناقضات مؤقتة) التي تقسم أعداءنا، وعن عقد اتفاقات ومصالحات مع حلفاء ممكنين (حتى ولو كانوا حلفاء مؤقتين، وغير مضمونين، ومتقلقلين، ومشروطين) أليس ذلك شيئاً مضحكاً للغاية؟. أليس ذلك شبيهاً بالتخلي سلفاً- عند التسلق الشاق على جبل وعر لم يطرقه أحدٌ من قبل- عن السير أحياناً بصورة متعرجة، والرجوع أحياناً الى الوراء، والعدول عن الاتجاه الذي اختير أولاً لتجربة اتجاهات مختلفة؟».
تلك هي النتائج العملية لافتقاد الثورة أداتها الشعبية.
والسمة السلبية الثانية للثورة هي أنها ثورة تجريبية.
حقاً إن العمل الثوري بحاجة إلى نظرية ثورية. حقاً إن نظرية مجبولة من الواقع القومي الملموس متفاعلة مع الجماهير الشعبية مستنيرة بالتجارب النضالية الأخرى في العالم هي وحدها التي تستشرف آفاق المستقبل وتقلل احتمالات الخطأ وتمنح العمل الثوري الثقة والصلابة والإدراك الواضح العميق للواقع؛ إلا أن فقدان نظرية محددة لا يسلب العمل الثوري أهميته وحقيقته؛ فالثورة تبقى ثورة سواءٌ كانت عفوية تجريبية أو مستندة على نظرية. ثورة بلا نظرية قد تهادن وتساير، قد تتردد وتساوم، وقد تتخبط في أخطاء خطيرة تسلمها للانحراف أو الجمود أو الموت… إلا أنها تبقى ثورة على كل حال.
وثورة ٢٣ تموز/ يوليو في القطر المصري نموذج للثورة التجريبية. يقول عبد الناصر:
«… كنا نشعر بالحاجة إلى ثورة… إلى تغيير جذري، وإنما كنا لا ندرك الطريق إلى هذا التغيير ولا الوسائل لتحقيقه ..».
ويؤكد عبد الناصر في الميثاق الوطني للثورة:
«إن إرادة التغيير الاجتماعي في بداية ممارستها (وبسبب فقدان نظرية كاملة للتغيير الثوري) تجتاز فترة أشبه بالمراهقة الفكرية ..».
ولكن الثورة إذ افتقدت النظرية لم تكن لتفتقد أي دليل للعمل. لقد طرحت- منذ البداية- المبادئ الستة المشهورة: (1) القضاء على الاستعمار.(٢) القضاء على الاقطاع. (۳) القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم. (٤) إقامة عدالة اجتماعية. (٥) إقامة جيش وطني. (٦) إقامة ديمقراطية سليمة.
في هذه الشعارات العامة العريضة تتجاور الأهداف الوطنية مع المطامع الديمقراطية البورجوازية مع الأحلام البورجوازية الصغيرة بالاشتراكية. وفي هذه الشعارات إيمان غامض غير محدد بقضية الشعب وعطف واضح على الجماهير العاملة، فيها معارضة لاستثمار الجماهير واضطهادها.. ولكن على نحو شبه اشتراكي.. أي على نحو ذاتي.
وبمثل هذه الروح وبمثل هذه العقلية خاضت الثورة المعارك. وفي غمار النضال.. وبتجارب الصواب والخطأ تعمق محتوى تلك الشعارات وتوسع مفهومها وجنحت أكثر فأكثر.. ويوماً فآخر نحو اليسار.. وانتقلت الثورة أخيراً إلى مرحلة تجاوزت فيه تلك الشعارات.. ولكن مطامح الثورة بقيت- حتى الآن- في إطار بورجوازي صغير.
يروي لينين عن نابوليون قوله: «نبدأ المعركة.. ثم نرى ..» وهكذا فعل قادة الثورة المصرية.. بدأوا المعركة ليلة ٢٣ تموز/ يوليو عام 1952. وكانت كل معركة تقود إلى أخرى فالنبض الثوري انتقل بعناصر الثورة من معركة إلى معركة ومن مرحلة إلى مرحلة: اسقاط الملكية- تصفية الإقطاع- طرد الإحتلال الأجنبي- إنهاء السيطرة الاقتصادية الاستعمارية- تنمية الإنتاج وفق برنامج خمسي مدروس- نقل المُلكية الخاصة لمعظم وسائل الإنتاج إلى المُلكية العامة… افتقاد النظرية- إذن- لم يوقف سير الثورة، وإن كان قد جعله بطيئاً ومتعرجاً، فيه التواءات وفيه وقفات وفيه مفاجآتٌ أيضاً.
إن الإجراءات التي أنجزتها الثورة والمراحل التي قطعتها- وإن كانت صحيحة من حيث اتجاهها العام- لم تأتِ وفق تسلسل مرحلي أو زمني مخطط يعبر عن سير متدرج يمليه الحل الصحيح والعلمي لمعضلات الواقع المصري الملموس ومقتضياته؛ بل جاءت عبر أسلوب يشبه الومضة الذهنية الذكية.
كيف انعكس الطابع التجريبي للثورة على خطوات الثورة وأعمالها؟
يجدر أن ننوه- منذ البدء- أن جوانب الضعف في الثورة (والتي نجمت عن افتقاد الثورة أداتها الشعبية) هي- إلى حدٍ كبير- وليدة طابعها التجريبي أيضاً. فلو أن الثورة قد انطلقت من المعطيات النظرية المستخلصة من تعميم التجارب الاشتراكية في العالم، لما وقعت في دوامة من التخبط سبق أن عانتها ثورات أخرى في العالم، إلا أن ملامحها النوعية الخاصة لم تُتح لها ذلك.
ولسنا ندعو هنا إلى أولوية النظرية العامة للتجارب الثورية الإنسانية: فالممارسة تملك «فضيلة الحقيقة الواقعة المباشرة»؛ ولكن، كما أكد ميثاق الثورة الجزائرية، }يجب تحاشي التصميمات النظرية المخططة جزافاً بدون أن تُستمد من الواقع الملموس، كذلك يجب تجنب الخطأ الذي يريد منه البعض الاستغناء عن خبرة غيرهم وعن الأخذ بالمكاسب الثورية المختلفة في عصرنا هذا ..».
وعلى عكس هذه الموضوعة كانت الثورة تتقرّى طريقها بوسائلها العفوية الذاتية يوماً فيوماً ومعركة فأخرى. لقد كانت تملك تكتيكاً في العمل ولكنها افتقدت التخطيط الاستراتيجي الطويل المدى.
ولقد كان الطابع التجريبي للثورة من الأسباب التي جعلت المفاهيم البورجوازية الصغيرة إطاراً لاشتراكية الثورة، بالرغم من أن ميثاق الثورة قد أعلن: «أن الاشتراكية العلمية هي الصيغة الملائمة لا يجاد المنهج الصحيح للتقدم، وأن أي منهاج آخر لا يستطيع بالقدر نفسه أن يحقق التقدم المنشود».
إن الشعارات التي أطلقتها الثورة خلال سنيها الأولى: القضاء على الاستعمار والقضاء على الإقطاع وسيطرة رأس المال على الحكم وإقامة عدالة اجتماعية، تتضمن بذور التحول الكبير الذي حدث في تموز/ يوليو 1961. إلا أن تلك الشعارات تعبر بنفس الوقت عن عقلية الثورة ومنطلقاتها الأولى أيضاً. لقد عارضت الثورة الاستثمار، ولكن دون أن تكون هذه المعارضة مبنية على أساس علمي موضوعي وفي إطار تلك الشعارات كانت الثورة تتصور ثم تعلن أنها «تريد التخلص من استغلال الإنسان للإنسان واستغلال المجتمع لبعضه واستغلال الأقلية في المجتمع للأغلبية في المجتمع»؛ ولكن إذ يجري الانتقال من الشعارات العامة المجردة العريضة إلى الشعارات المحددة الملموسة تضيع المشكلة في متاهات البورجوازية الصغيرة وأوهامها… ففي المؤتمر التعاوني المنعقد في ٥/١١/ 1957، بعد أن يتحدث الرئيس عبد الناصر عن محاربة الثورة لاستغلال الإنسان للإنسان والأقلية للأكثرية، يقول:
«.. إننا نعتبر الرأسمالية الوطنية ضرورة لازمة لتقويم اقتصادنا وللتنمية والوصول إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي.. كما أننا نعمل على أن يستخدم رأس المال في خدمة الاقتصاد القومي کاقتصاد للشعب.. وإننا نعتبر أن رأس المال الخاص حر ما دام يعمل لمصلحة الشعب ويعمل للخير العام للشعب؛ وفي نفس الوقت نتدخل، ولا يعني التدخل أننا نريد أن نصفي أو نقضي على الرأسمالية. ولكن نرى من واجبنا أن نراقبها لكي لا تتحكم في الحكم ولا تسيطر على الحكم من أجل استغلال الأغلبية العظمى ..».
وكما ذكرنا في مكان آخر من هذا البحث، أن الثورة في مجابهتها الجدية والمُخلصة لمشكلة التخلف، رأت نفسها مدعوة لقيادة الاقتصاد القومي ومضطرة بالتالي لتجنيد رأس المال الخاص وتعبئته لتنفيذ برامج الإنماء و«توجيهه للخدمة العامة»- كما يقول الرئيس عبد الناصر-؛ إلا أن الرأسمال الخاص الوطني (الذي لا يمكن أن يجند نفسه إلا لربح أكثر والذي يرى وطنه الحقيقي في مكان الربح الحقيقي) أصيب بنفرة من هذه المحاولة، وهذه النفرة كشفت للثورة طبيعة الرأسمال ودوره، وهذا هو أحد الأسباب الهامة للضربة المجيدة في تموز/ يوليو 1961. أما السبب الثاني فهو إدراك الثورة (الذي تأخر بعد تخبط تجريبي دام تسع سنوات) عجز الرأسمال الخاص في البلدان المتخلفة عن تنمية وتطوير الاقتصاد القومي، والسبب الثالث استغلال احتياجات التنمية من قبل الرأسمال الخاص ليحتل لنفسه مواقع الاحتكار التي يحصل منها على كل فوائد هذه التنمية.
تلك هي الأسباب الثلاثة للتحول الكبير في تموز/ يوليو 1961، فإذا أضفنا إليها وجهة نظر الثورة التي تعارض الاستغلال على نحو ذاتي… اكتمل لدينا التفسير الصحيح لاشتراكية الثورة.
.. إذن فاشتراكية الثورة جاءت حلاً لمشكلة التخلف بالدرجة الأولى في حين أن الاشتراكية وليدة لتطور المجتمع من جهة ولطموح الجماهير الكادحة لإلغاء الاستثمار من جهة أخرى. إن ذلك الفهم المشوه والجانبي للاشتراكية.. هذه النظرة الحِرَفية للاشتراكية هي التي جعلت اشتراكية الثورة ضرباً من اشتراكية البورجوازية الصغيرة، التي تجعل من تضييق نطاق الاستثمار هدفها البعيد (لا المرحلي) لأنها لم تُعلن بوضوح وحسم هدفها بإلغائه من الجذور وإلى الأبد. ولذا يعلن الميثاق:
«إن سيطرة الشعب على كل أدوات الانتاج لا تستلزم تأميم كل وسائل الانتاج ولا تُلغي الملكية الخاصة ولا تمس حق الإرث الشرعي المترتب عليها، وإنما يمكن الوصول إليها بطريقين: أولهما خلق قطاع عام وقادر يقود التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسؤولية الرئيسية في خطة التنمية، ثانيها وجود قطاع خاص يشارك في التنمية في إطار الخطة الشاملة لها من غير استغلال على أن تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعين مسيطرة عليهما معاً ..».
تلك هي اشتراكية الـ« فوق» التي لم تأتِ عبر نضال عمالي ضد الاستغلال الرأسمالي، حيث تبقى غائمة آفاق تطور المجتمع إلى مجتمع اشتراكي كامل في ظروفه وخصائصه.
وفي حل المشكلة الزراعية بدأت الثورة من منطلقات مماثلة.. منطلقات بورجوازية صغيرة أيضاً، لقد انساقت الثورة مع الحنين العميق للتملك لدى الفلاح وأرست هذا الحنين أيضاً وبررته باسم الفهم الصحيح للواقع، ورأت في القضاء على الإقطاع حلا للمشكلة. ورد في الميثاق:
«ان التطبيق العربي للاشتراكية في مجال الزراعة يمكن تأمينه بالمُلكية الفردية للأرض في حدود لا تسمح بالإقطاع ..».
عندما تكون البورجوازية هي التي تُمسك بالمعول لتهدم صرح الإقطاع.. فإنها تكتفي بالقضاء على الملاكين العقاريين الكبار، وأن إجراءً كهذا هو الذي يتلاءم بالفعل مع أهداف البورجوازية السياسية والاقتصادية. أما المجابهة الاشتراكية لمشكلة الأرض فلا بد أن تأخذ منحى آخر؛ فالمسألة الزراعية بالنسبة للتخطيط الاشتراكي أبعد وأعمق من مجرد القضاء على الإقطاع.
إن الغاء الاقطاع يضيّق نطاق الاستثمار ولكنه لا يلغيه، لذا فإن شعار «الأرض لمن يحرثها» هو وحده الشعار المنسجم مع الاشتراكية، كما أن المجابهة الاشتراكية لمشكلة الأرض تتجنب الإصرار على التملك الفردي الذي يؤدي إلى تفتيت الأرض وتعتبر أن المهم هو تحديد حجم الوحدات الزراعية القابلة فنياً للاستثمار وتكوين شبكة من هذه الوحدات طبقاً لتخطيط اقتصادي مدروس، فإذا أضفنا إلى ذلك مسألة أسلوب الاستثمار ووجوب جعله جماعياً وتنظيم شكل جماعي للمرافق التابعة للزراعة يكون الإطار العام للحل الاشتراكي لمشكلة الزراعة قد اكتمل، وبالتالي يكون الطريق قد سُد نهائياً أمام أي تطور قد يؤدي إلى بعث علاقات الإنتاج الرأسمالية في الريف(5).
إن حلًا كهذا هو الذي اختارته الثورة الجزائرية. لقد أعلن أحمد بن بلة:
«هدفنا ثورة زراعية لا إصلاح زراعي ..».
وإذا كانت هذه هي نتائج العقل التجريبي للثورة فيما يتعلق بالبنيات التحتية للمجتمع، فإن آثار هذا العقل قد انعكست بشكل خطير ومفجع على الجوانب الأخرى للنضال الاشتراكي ويتجلى أثر فقدان التجانس في خطوات الثورة بمسألة النضال الثوري ضد البنيات الفوقية للمجتمع القديم. فلكي يكون النضال ذا طابع اشتراكي متجانس ومتكامل فعلاً لا بد أن يتناول مختلف مستويات البناء الاجتماعي ومختلف قطاعات المجتمع. فالاشتراكية ليست مجرد إلغاء للاستغلال، بل هي- بالأساس- محاولة لإنقاذ إنسانية الكائن البشري التي سحقها الاستغلال، وتحريره من كل ظروف الضياع التي أفقدته جوهره الإنساني. فالاشتراكية حل كلي وجذري لمشكلة الإنسان.. ولكن اشتراكية الثورة (الحِرَفية والتجريبية لم تدمر سوى البنيان التحتية للمجتمع القديم، في حين أن البناءات الفوقية بقيت بعيدة عن الريح الثوري، مقطوعة عن التطور الذي أصاب البنيات التحتية. فالقطاع الثقافي لا يزال في قبضة الرجعية والبورجوازية، والتعليم- وإن كان قد أخذ منحىً عملياً تطبيقياً- إلا أنه بعيد عن خلق أجيال تؤمن بالعلم باعتباره الحقيقة الوحيدة في الحياة، كما أن الأطر التقليدية الإقطاعية البورجوازية لاتزال تهيض انطلاقاً كاملاً حقيقياً للمجتمع.
حقاً إن النضال لتصفية البنى الفوقية المتخلفة لا يمكن أن يتم بسرعة (كما هو الأمر فيما يتعلق بالبنى التحتية)، إلا أن الثورة لم تلتفت حتى الآن إلى هذه المشكلة. وهذا في رأينا من أكثر الجوانب السلبية خطورة في تجربة ثورة ٢٣ تموز/ يوليو.. وأدعاها إلى القلق حول مستقبل هذه التجربة.
*** *** ***
هوامش:
(1) الكتاب رقم (1) من سلسلة ( في الفكر السياسي » – «حول تجربة حزب البعث» – ص: ۲۰۱
(2) ان حكمنا على هذا «الطقم » ليس شاملاً لمجموعه. فهو يحوي عناصر ثورية فعلاً ومؤمنة بالعروبة وبالاشتراكية، ونخص بالذكر: «كمال رفعت»
(3) إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الناصر القاضية بمنح نسب من الأرباح للعمال قد ساهمت- بلا ريب- بإحداث موجة التفاف عمالية حول الثورة الاشتراكية، إلا أنها في رأينا ليست وسيلة لتربية الطبقة العاملة تربية اشتراكية حقة، كما أن لها جانبها السلبي، إذا لم توصل بوعي اشتراكي كامل، وقد تنزلق بالعمال إلى نزعة عمالية مهنية ضيقة تسمى في الأوساط الاشتراكية الغربية بـ«التريدينيونية». إن النضال السياسي الذي يربط القضية العمالية ربطاً ثورياً بالمشكلة العامة الأساسية لتطوير المجتمع هو السبيل الوحيد لتعبئة الطبقة العاملة في سبيل التحويل الاشتراكي للمجتمع .
(4) بحثنا هذا الموضوع بإسهاب في دراستنا: «النضال العربي والسياستين الأمريكية والإنكليزية». وسننشرها في كتاب قادم.
(5) راجع ميثاق الثورة الجزائرية والتقرير المذهبي للاتحاد الوطني للقوى الشعبية في المغرب (مراكش).
……………………………..
يتبع.. الحلقة السابعة بعنوان: (إيديولوجية الثورة).. بقلم الأستاذ “ياسين الحافظ”
