
معقل زهور عدي
منذ أن كتب رفاعة الطهطاوي كتابه “تخليص الإبريز في تلخيص باريز” في منتصف القرن التاسع عشر مفتتحاً عصر ما سمي بالتنوير في الفكر الإسلامي- العربي, مر التنوير بالعديد من المراحل صعوداً وهبوطاً, ففي المرحلة التالية لرفاعة الطهطاوي كان لدينا جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده ثم تلامذة محمد عبده ومنهم علي عبد الرازق ورشيد رضا في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وحتى ذلك الوقت كان التنويريون في الفكر الإسلامي على اطلاع واسع بالإسلام والتاريخ الإسلامي, كما كانوا حريصين على نقد الجوانب الفكرية والممارسات التي لحقت بالإسلام وشوهت صورته خلال مئات السنين .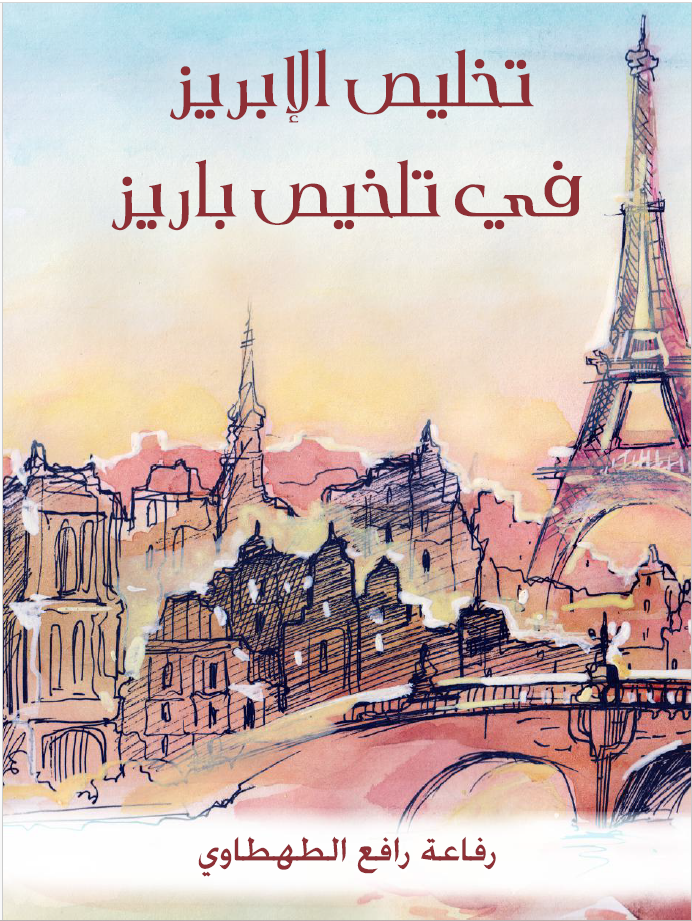
صحيح أنهم تميزوا جميعاً بشيء من الاطلاع على الثقافة الغربية والتأثر بها إلى هذا الحد أو ذاك لكنهم لم يخرجوا عن ثوابت الإسلام في أي وقت خاصة فيما يتعلق بالعقيدة .
في مرحلة لاحقة ومع ازدياد الاصطدام مع الغرب عبر الاحتلالات العسكرية للمشرق والشمال الأفريقي العربي تراجعت حركة التنوير, وعوضاً عنها رأينا تنويراً آخر من خارج الفكر الإسلامي أعمق تأثراً بالثقافة الغربية ينشأ في رعاية الدوائر الغربية الكولونيالية مع اكتشاف الحملات الاستعمارية أن الإسلام عقبة كأداء أمام الهيمنة الغربية على المنطقة وأن من الضرورة بمكان اختراق الفكر الإسلامي وهكذا شهدنا اهتماماً مكثفاً برعاية مراكز بحثية, ومفكرين وباحثين رفعوا راية التنوير من خارج الفكر الإسلامي إلى الحد الذي دعا فيه البعض للقطع بصورة تامة ونهائية مع كل ماله علاقة بالإسلام والتاريخ الإسلامي والنظر إليه جملةً بوصفه عقبة أمام الحداثة كما ذهب إليه أدونيس .
يمكن النظر إلى التحولات الفكرية التي مربها الشيخ رشيد رضا كنموذج للتحول الذي لحق بحركة التنوير الأصلية التي بدأتها مدرسة الأفغاني ومحمد عبده, فرشيد رضا الشيخ العالم بالدين والذي أعجب بالفكر الاصلاحي للشيخ محمد عبده وحرص أن يكون خليفته في الاصلاح والتنوير وأنشأ من أجل ذلك مجلة المنار عام 1898 بعد أن انتقل من طرابلس إلى مصر, أظهر في تحوله للنشاط السياسي تفهما للأفكار والقيم المستمدة من الثقافة الغربية فانخرط مع ميشيل لطف الله وعبد الرحمن الشهبندر ورفيق العظم وحافظ السعيد وعلي النشاشيبي عام 1909 في إنشاء جمعية اللامركزية التي كانت تهدف للحصول على حقوق العرب في الحكم الذاتي وممارسة لغتهم القومية في المناطق العربية والمشاركة في السلطة السياسية , ثم تحولت تلك الجمعية إلى حزب الاتحاد السوري الذي كان أكثر وضوحاً في تبني الديمقراطية الحداثية والكيانية السورية ذات الانتماء العربي .
لم تجد جمعية اللامركزية أي حرج في الاتصال بالدول الغربية من مقرها في مصر, وهناك مؤشرات لنظر الشيخ رشيد رضا للطريقة التي كانت تحكم بها بريطانيا مصر بطريقة ايجابية من حيث السماح بالحريات والأحزاب والصحافة وانخراطه في التواصل مع البريطانيين في مصر من أجل الحصول على تعهد باحترام حقوق العرب في الاستقلال مقابل تحالف العرب مع الحلفاء في الحرب العالمية الأولى .
هذا التحول الفكري السياسي من شيخ إسلامي يؤمن بالإصلاح الديني من خلال التربية والتعليم إلى العمل السياسي ضمن أطر تنظيمية ليبرالية- قومية تضم المسلم والمسيحي وتتبنى النموذج الديمقراطي ثم إلى حزب سياسي لم يكن هدفه الخلافة ولا فرض دولة دينية بل دولة مواطنة ديمقراطية, أقول هذا التحول الملفت تكرس نهائيا مع انتقال رشيد رضا إلى دمشق في العهد الفيصلي ومشاركته بأعمال المؤتمر السوري العام مندوباً عن طرابلس ثم رئاسته للمؤتمر ومشاركته الفعالة في وضع الدستور الذي أراد التأسيس لدولة سورية حديثة دستورية ديمقراطية بما في ذلك النقاشات حول ما أراده التيار الإسلامي المحافظ في المؤتمر من وضع بند ينص على أن دين الدولة الإسلام والاعتراضات التي نشأت داخل المؤتمر على ذلك ثم الحل التوفيقي بالاكتفاء بفقرة تنص على أن دين الملك هو الإسلام في حين أن صلاحيات الملك كانت مقيدة إلى حد كبير وفق الدستور .
يمكن النظر لهذا التحول الفكري الهام والجوهري في حياة الشيخ رشيد رضا باعتباره مؤشراً لتيار إسلامي ليبرالي يتجاوز في الحقل السياسي كل ما سبق من انجاز للمدرسة الإصلاحية لجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وتلاميذهم .
لكن ماذا حدث بعد ذلك ؟
بعد دخول الفرنسيين دمشق دخول الغازي المحتل واتضاح تواطئ السياسة البريطانية على تسليم سورية للاحتلال الفرنسي واحتلال فلسطين وفصلها عن سورية ثم فتح الباب أمام الاستيطان الصهيوني تنفيذا لوعد بلفور وتقسيم سورية , تراجع الفكر السياسي لرشيد رضا, وفي لجوئه إلى مصر ثانية بعد الاحتلال الفرنسي لسورية لم يعد رشيد رضا ذلك المفكر التنويري السابق فأعاد إصدار مجلة المنار بعد أن تصالح مع الفكر الإسلامي التقليدي ومع نزعته الاصلاحية التربوية القديمة إضافة للتخلي عن الحداثة الغربية بما تحمله من أفكار ديمقراطية , كما شهدنا إعادة اهتمام الشيخ رضا بنظرية الخلافة في الاسلام مما يشكل تراجعا واضحا عن فكره السياسي الذي كان دليل ممارسته السياسية في العهد الفيصلي .
مثل تراجع رشيد رضا الفكري بداية تراجع الخط الاصلاحي التنويري الإسلامي, واعتباراً من الثمانينات من القرن السابق تغلبت على الفكر الإسلامي موجة من التشدد جاءت كرد فعل على هزيمة حزيران 1967 وعلى فشل الأنظمة الحاكمة وما رافقها من أفكار قومية واشتراكية, وبفعل ازدياد نفوذ التيارات السلفية القادمة من دول الخليج .
والمفارقة التي نشهدها والتي تشكل جوهر أزمة الفكر الإسلامي أنه في الوقت الذي أصبح فيه ملحاً أكثر من أي وقت مضى تجديد ذلك الفكر في ضوء ما أحدثته ثورة الاتصالات من إمكانات لعرض مختلف الآراء, وضرورة مراجعة كل ما لحق بالإسلام من إضافات أصبحت مع الزمن وكأنها من صلب الدين .
أما في حقل السياسة فالمفارقة تصبح أكبر وأوضح أثراً, بعد تجربة تطبيق المفاهيم الاسلامية المتشددة في الحكم في الدول وأشباه الدول هنا وهناك وما خلفته من ردات فعل لدى الجمهور .
واليوم ونحن نشهد ذلك التداخل والاختلاط بين ضرورة تنوير يعيد الاضاءة على جوهر الاسلام وقيمه العليا ويتصالح مع العصر والعلم والثقافة وخصوصا مع الديمقراطية ومفهوم المواطنة وبين ذلك الهجوم الذي يكاد أن يكون أعمى على كل ما يتصل بالإسلام والتاريخ العربي الاسلامي تحت راية “التنوير .”
فإن المسؤولية إنما تقع على الفكر الإسلامي الذي لم يمتلك شجاعة المراجعة والنقد وإعادة الاعتبار للعقلانية في الفكر العربي الإسلامي, وبدلاً عن ذلك لزم أقصى درجات الجمود والمحافظة ناسيا أنه بموقفه ذلك إنما يفسح الطريق أمام من يتسلق على سلم “التنوير” حاملاً معول الهدم برعاية وتمويل جهات مشبوهة, ولن تنفع أمام تقدمه محاربة الفكر بالعنف , ولا بفكر جامد متخشب يقف في المكان الذي وقف عنده الفكر الإسلامي منذ أواسط العصر العباسي دون أن يتجرأ على التقدم خطوة وأحدة نحو الأمام .

المصدر: صفحة الكاتب على وسائل التواصل
