
(الحرية أولاً) ينشر حصرياً الكتاب المفقود «في الفكر السياسي» بجزئيه، للمفكرين “الأربعة الكبار”، وهذه الحلقة الثالثة من الجزء الثاني– بعنوان: (القطر المصري قبل الثورة).. بقلم الأستاذ “ياسين الحافظ”
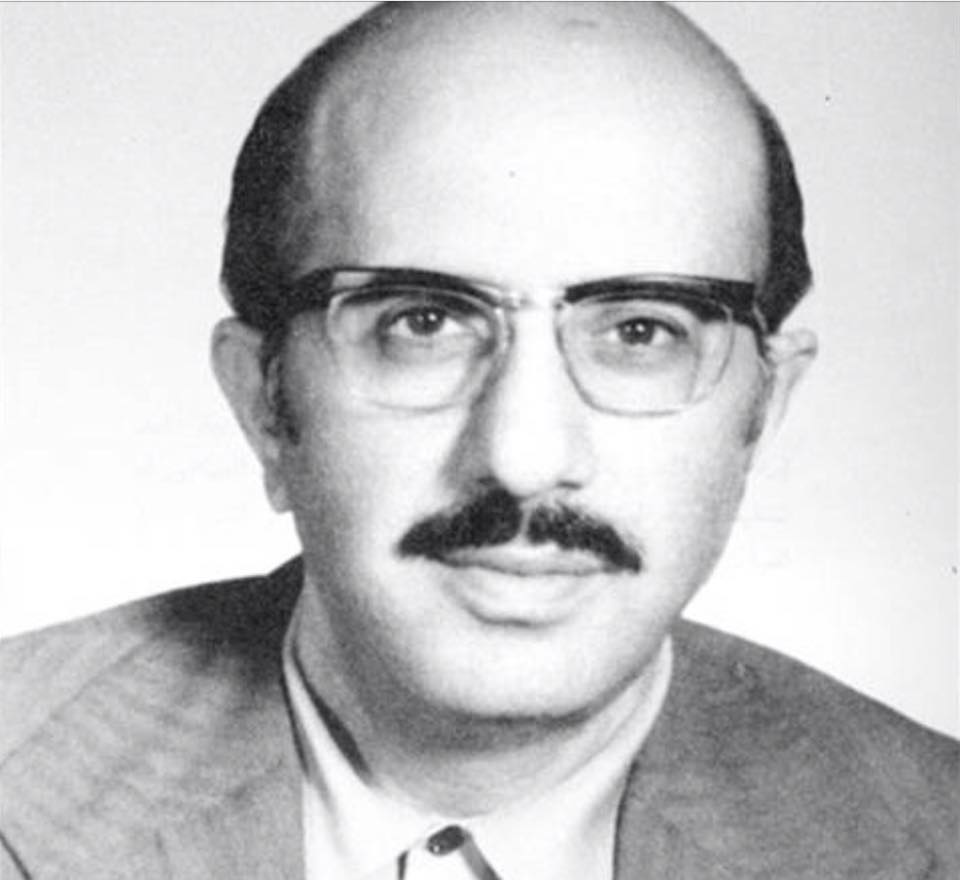
(2)
القطر المصري قبل الثورة
لكي نتمكن من إعطاء حكم موضوعي على ثورة ٢٣ تموز/ يوليو ١٩٥٢ وأثرها على القطر المصري، لا بد من وقفة قصيرة حول الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت قائمة في مصر قبل الثورة.
كان المجتمع المصري قبل الثورة شبه مستعمَر وشبه إقطاعي. فهو يعاني احتلالاً عسكرياً مباشراً وسيطرة اقتصادية أجنبية مع واجهة مزيفة لحكم وطني عميل، ولهذا فهو شبه مستعمَر. وهو مجتمع إقطاعي بدأ فيه عصر الرأسمالية، ولهذا فهو شبه إقطاعي.
ونفذت السيطرة الاستعمارية إلى جميع نواحي الحياة المصرية، وتحول الانتاج الزراعي المصري إلى طور الاقتصاد التجاري، وجرى الاعتماد الكلي على الزراعة، وأصبح القطن المحصول الرئيسي والأساسي، وأصبحت- بالتالي- تجارة مصر الخارجية وسياستها النقدية تحت رحمة النفوذ البريطاني. وبما ان بريطانيا ومستعمراتها كانت العميل الأول للصادرات المصرية (وهي القطن بصورة أساسية)، لذا جرى الاعتماد بصورة كلية أو شبه كلية على بريطانيا لاستيراد حاجات مصر من الواردات. وهكذا جرى استثمار مصر كمستوردة وكمصدرة، فبقي الميزان التجاري مختلاً، إذ امتص الاستعمار- بهذه الطريقة- كل إنتاج الشعب، ولم يبقي أي فائض لتمويل المشروعات الصناعية المحلية. وبالإضافة إلى كل هذا فإن بريطانيا، لكي تمنع تصنيع مصر، كانت تتحكم في نوع السلع التي تستوردها مصر، فأحبطت مساعي مصر لاستيراد ما يلزمها من الآلات والمعدات اللازمة لتشجيع بعض الصناعات الناشئة وبخاصة صناعة الغزل والنسيج في فترة ما بين الحربين. أما سياسة مصر النقدية- التي كانت موكولة للبنك الأهلي المصري (الذي لم يكن مصرياً ولا أهلياً) باعتباره مصرف إصدار ومصرف حكومة- فقد رسمت وفقاً لمصالح وإرشادات لندن. وكان المصرف المذكور يعتمد في غطائه النقدي على سندات الحكومة البريطانية بنسبة كبيرة، ان لم تكن قد بلغت حد الخطورة، فإنها على الأقل فرضت على النقد المصري الأسر في حلقة الاسترليني، وبالإضافة إلى ذلك فإن سياسة المساهمين في البنك المذكور لم تتجه إلى العناية بالنشاط الصناعي والتجاري في مصر، ولم تكن لديهم الرغبة في استخدام رأس مال البنك وودائعه في المعاملات التجارية بل كانوا يفضلون استخدامها في اقتناء الاوراق المالية وبخاصة سندات الحكومة البريطانية(1). فإذا أضفنا إلى كل ذلك أن ما ينوف على ثلث رؤوس الأموال المستثمرة بالتجارة والصناعة هي رؤوس أموال أجنبية، اكتملت لدينا الصورة العامة للسيطرة الاستعمارية الاقتصادية على مصر.
لقد تجلى التوزيع السيء للملكية في مصر على أجلى صوره وأكثرها ظلماً وقسوة. فقد كان ٦٪ من الملاك (مجموع: الملاكين ٢,٧٦٠,٧٧١) يحتكرون ٦٥٪ من الأراضي الزراعية، وكانت النتيجة العملية لتركيز الملكية الزراعية المضطرد في أيدٍ قليلة، هي حرمان ملايين الفلاحين وإفقارهم إلى حد ادنى من مستوى أبسط ضرورات الحياة، وازداد عدد البروليتاريا الريفية يوماً فآخر، الذين كانوا يعانون بالدرجة الأولى، مساوئ هذا التوزيع، وقاسوا عذابات استغلال الأرض الزراعية، وعاشوا في مستوى معيشي بالغ الإدقاع والانخفاض، بدخل بلغ متوسطه أربع جنيهات في السنة(2). ونتيجة ذلك كله نقص متوسط القيمة الغذائية لغذاء المصريين إلى ما دون الحد الأدنى الضروري للإنسان، من ٢٩٥٣ حُريرة إلى ٢٣٣٧ حُريرة(3) (قدر خبراء التغذية الحد الأدنى للراتب الحراري الضروري للإنسان بـ ٢٥٠٠ حريرة).
وبالإضافة إلى اتساع الملكيات الزراعية، فإن هناك عاملاً آخر يتساوى في الأهمية مع العامل الأول، وهو شكل استغلال الملاكين لأراضيهم. إذ يعيش هؤلاء في المدن الكبرى ولا يباشرون استثمار الأرض بأنفسهم، وإنما يقومون بتأجيرها، ويقومون كذلك بالمتاجرة ببيع وشراء الأراضي ويستثمرون المستأجرين الصغار والمزارعين الصغار عن طريق إغراقهم بالديون والسِلف والإيجارات المتأخرة والاحتفاظ بهم في درجة من التبعية الاقتصادية لا يستطيعون معها فكاكاً من الأرض، بينما لا تقوم أية علاقة بينهم وبين العمال الزراعيين الذين يعملون أساساً لحساب المستأجرين أو لحساب المزارعين المتوسطين.
وقام تحالف عضوي بين الاستعمار وملاك الأراضي، (لأن نوعية الإنتاج الزراعي فرضت الاعتماد على السوق الاستعمارية لتصريف المحصول الرئيسي لأراضيهم لأن القطن لا يمكن أن يصبح محصولاً للاستهلاك في السوق المحلية إلا إذا استوعبت صناعة الغزل والنسيج كل الكمية المنتجة من القطن)، ومن ناحية أخرى اعتمد كبار الملاك على الأموال المصرفية الأجنبية للحصول على السلف وقروض المساعدة لتسويق القطن. كما أن البعض من كبار الملاك كانوا يقومون بإيداع فائض أموالهم في المصارف مقابل فوائد محددة، فيؤدون بذلك دوراً رأسمالياً مالياً وثيق الصلة بالرأسمالية الاستعمارية. وعلى أساس هذه المصالح المتبادلة زاد الاستعمار من نفوذ كبار الملاك بينما قام كبار الملاك بحماية نفوذ الاستعمار.
وإلى جانب كبار الملاكين العقاريين تقوم الرأسمالية المالية المصرية المرتبطة مباشرة مع الاستعمار. أما الرأسمالية المصرية غير الاحتكارية، فهي في أغلبها تجارية، أما الرأسمالية المرتبطة بالصناعة فقد كانت ضعيفة وغير مستقلة استقلالاً كاملاً ، نظراً لعدم وجود حدود واضحة بينها وبين البرجوازية التجارية ولاعتمادها على المصارف الأجنبية وعلى الأسواق الخارجية لاستيراد الأدوات والآلات والوقود .
إن مراجعة تاريخ مصر الاقتصادي، تدل دلالة قاطعة على أن مستوى المعيشة كان يسير في هبوط تدريجي مستمر منذ مطلع القرن العشرين، لأن الزيادة الطفيفة التي تصيب الدخل القومي لا تكفي ولا توازي الزيادة في عدد السكان، لأن هذه الزيادة كانت تلاحق النمو في الإنتاج القومي وتمتصه وتتجاوزه مؤدية إلى هبوط مستوى المعيشة.
ولكي نعطي صورة ملموسة للوضع الاجتماعي في مصر، لا بد أن ننوه- مثلاً- بنشوء فئات اجتماعية يمكن تسميتها بـ «البروليتاريا الرثة» من أصحاب الحرف المُفلسين والعاطلين عن العمل لمدة طويلة وماسحي الأحذية وجامعي أعقاب السجائر والمتسولين والنشالين وخدم البيوت. ويكفي لتصوير مدى اتساع هذه الطبقة أن نذكر أن عدد خدم البيوت وحدهم قد بلغ في عام 1947 نحو (٢,٧١٦,٩١٧) خادماً(4) أي ما يوازي ضعف عدد الطبقة العاملة في المدن.
تلك هي الصورة العامة للوضع الاجتماعي والاقتصادي في مصر قبل الثورة. ولكي تكتمل الصورة لا بد أن نلخص الخطوط العامة للوضع السياسي قبيل الثورة:
بانتهاء الحرب العالمية الثانية استؤنف النضال السياسي ضد الاستعمار. وتحت ضغط الجماهير، بدأت الأجهزة السياسية الرجعية تطالب بالمفاوضة مع «الحليفة» بريطانيا «لتحقيق الجلاء والعمل على زيادة ما بين مصر وبريطانيا من علاقات الصداقة والتحالف».
كان في القطر المصري رأي عام جماهيري معادٍ للاستعمار والرجعية، إلا أنه لم يكن مُنظماً على نحو يكفل معركة جادة واعية ضد الاستعمار والرجعية.
إن الرجعية بسبب إدراكها المباشر للوضع الطبقي المتفجر، ونظراً لطابعها المتخلف البالغ التعفن والبالغ الجمود، وبسبب عمق النفوذ الاستعماري، قد سَحقت بلا رحمة وبلا كلل وفي مختلف العهود الحركات الشعبية المنظمة، سواء على الصعيد العمالي أو على صعيد التنظيم السياسي، لقد افتقدت مصر الحركات العمالية المنظمة والحركات السياسية الثورية والشعبية القوية. وهكذا وجدت الجماهير نفسها في وضع ثوري بلا تنظيم ثوري، بل مجرد رأي عام متحمس ومتحفز.
ومن بين الأجهزة السياسية التقليدية كان “الوفد” هو التشكيل السياسي الوحيد الذي احتفظ بجذوره الشعبية وبعناصر نشيطة من البورجوازية الصغيرة. إلا أن انتقال قيادة الوفد إلى أيدي كبار الملاكين العقاريين ألقى به في وضع متردد ومتناقض، كانت القيادة الوفدية- عندما حكمت عام 1950- (تفاوض الانجليز وتخاف تحرك الجماهير وتفاوض أمريكا وهي تعتذر لإنجلترا وترفض الدفاع المشترك مع الاستعمار وهي تلعن الاتحاد السوفياتي)، ولهذا السبب عجز الوفد عن قيادة النضال الجماهيري قيادة فعلية وثورية.
وبحريق القاهرة وبإقالة الحكومة الوفدية في ٢٦ كانون الثاني/ يناير 1952 بلغ الوضع الثوري مداه ونضج للانفجار في كل لحظة. وبلغت الأجهزة السياسية التقليدية درجات الخيانة وأقصى درجات الشراسة معاً، واضطرت الرجعية أن تحكم بصورة مباشرة، فأطاحت بلعبتها التضليلية (لعبة الديمقراطية البرلمانية الخاصة بالباشوات والمحتكرين وعملاء الاستعمار المباشرين) قبل الثورة بستة أشهر، وأعلنت الأحكام العرفية، وملأت السجون بالمناضلين وأوقفت حركة الكفاح المسلح ضد الاستعمار الإنكليزي في القنال.
وفي الأشهر الستة التي سبقت الثورة (من ٢٦ كانون الثاني/ يناير إلى ٢٢ تموز/ يوليو) بلغ الارتباك أشده وأقصاه في صفوف الرجعية، وتهيأ الملك للفرار، وتولت الحكم خمس وزارات بأمر من السراي والاستعمارين الانكليزي والامريكي، وعبثاً حاولت الرجعية مواجهة الأزمة الوطنية العميقة والواسعة معاً. لقد غرقت الرجعية حتى هامتها في الصعوبات، وبلغت الأزمة ذروتها، لقد تفسخت الرجعية وضعفت وأنهكت وتلطخت بالخزي والعار. وفي هذه الفترة المناسبة وفي اللحظة المناسبة أيضاً انفجرت أحداث ٢٣ تموز/ يوليو ١٩٥٢.
وكان وراء هذه الأحداث تشكيل من الضباط الصغار، خاضوا معركة فلسطين، وساهموا بصورة جدية بمعارك الكفاح المسلح في القنال، وهم لهذا قد أمسكوا بمخازي الرجعية مجسدة. لقد عاشوا المأساة وعانوا التجربة المُرة، واكتشفوا- بصورة ملموسة ومباشرة- الزيف والتخلف والخيانة، لذا كانت الضربة الحاسمة ضربتهم.
*** *** ***
هوامش:
(1) سلسلة اخترنا لك- العدد ۲٦- كفاح الشعب والجلاء – ص: ۱۷۲.
(2) ثورة مصر القومية- إبراهيم عامر- إصدار دار النديم بالقاهرة ١٩٥٧.
(3) من الجدير أن نشير إلى أن هذا الرقم الإحصائي نظري محض، نظراً للتفاوت الواسع بين طبقات الشعب في مصر، ويمكننا الجزم بأن جماهير الفلاحين بخاصة كانت تعاني مجاعة خفية دائمة.
(4) الإحصاء السنوي للجيب ١٩٥٠ – القاهرة .
……………………………..
يتبع.. الحلقة الرابعة بعنوان: (انقلاب أم ثورة).. بقلم الأستاذ “ياسين الحافظ”
