
محمد تركي الربيعو *
في عام 1997، أصدر المؤرخ المصري خالد فهمي كتابه الشهير «كل رجال الباشا» الذي سيترجم في عام 2001 للعربية. وعلى الرغم من أهمية ما قدمه فهمي في هذا المؤلف، إلا أنه سينتظر عقدا كاملا ليعاد التركيز عليه، ولاسيما بعد الثورة في مصر وتولي الجيش السلطة لاحقاً.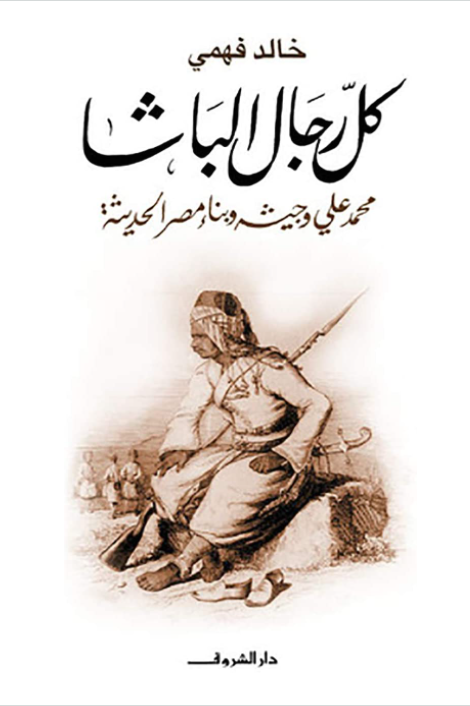
مع الباشا وجنوده، أتى فهمي بعدة بحثية وشعائرية/ كتابية جديدة. فمنذ الصفحات الأولى، بدا حاملاً على عاتقه مهمتين، الأولى إعادة قراءة شخصية محمد علي والبحث في دوافع الرجل ورؤيته، والثانية تجديد الكتابة التاريخية حول مصر القرن التاسع عشر، من خلال منهج بدا في البداية وكأنه قريب من مدرسة كاملة كانت قد أسهمت بكتابات غزيزه ومهمة عن مصر، وبالأخص كتابات تيموثي ميتشل. مع ذلك، حمل فهمي أيضا رؤية نقدية لهذه المدرسة المهمومة بفكرة الكولونيالية والكولونيالي المحلي، من خلال البحث في حيوات الناس العاديين (الفلاحين) ومقاومتهم سلطة محمد علي ورفضهم الانضمام لجيشه، وتشويه أجسادهم أحيانا كبديل عن الرفض العلني. ولعل هذا الهم (أساس نظري ومتابعة لعالم الأفكار، والآخر محاولة كتابة تاريخ جديد) سيبقى يميز كتابات فهمي اللاحقة، وبالأخص مع صدور كتابه الأخير «السعي للعدالة: الطب والفقه والسياسة في مصر الحديثة» ترجمة حسام فخر، إذ يشعر القارئ لهذا العمل أنّ ما قام به فهمي في كتابه السابق، لم يكن سوى البداية لمشروع أعمق. ففي هذا المشروع، سيقرّر فهمي من جديد خوض سجال معرفي واسع، لكن ليس مع أستاذه ميتشل ومدرسة التابع حسب، بل أيضا مع كتابات أخرى حظيت باهتمام واسع في السنوات الأخيرة في العالم العربي. وأشير بالأخص هنا إلى رؤى طلال الأسد ووائل حلاق حول الحداثة والشريعة. والممتع في مشروعه الجديد منهجُ الكتابة نفسه، الذي يعتمد على مجموعة عناصر (مواد وأرشيف محلي، ومقاربات أنثروبولوجية ومحاولة توظيفها لفهم اليومي في الماضي، وأسلوب الكتابة غير التقليدي). فغالباً ما يبدأ كل فصل بقصة تكون بمثابة فاتحة للدخول إلى مسرح الحدث التاريخي. ولعل هذا المنهج هو سبب وصفنا هذا التاريخ بالجميل، وليس ذلك تغنّياً بالماضي، بل يكمن مصدر الجمالية في أسلوب ومنهج الكتابة التاريخية. إذ لن نعثر في صفحات الكتاب على مؤرخ يحاول تدوين تفاصيل عن الماضي حسب، بل هو قبل كل شيء منخرط في اليومي وأسئلته، وعبره ينطلق للغوص في قلب المدينة التاريخية ودهاليزها، تارة بأدوات مؤرخ وأخرى بحس رحالة أو أنثروبولوجي يسير وراء القصص والفضاءات العامة عله يعثر على معان أخرى.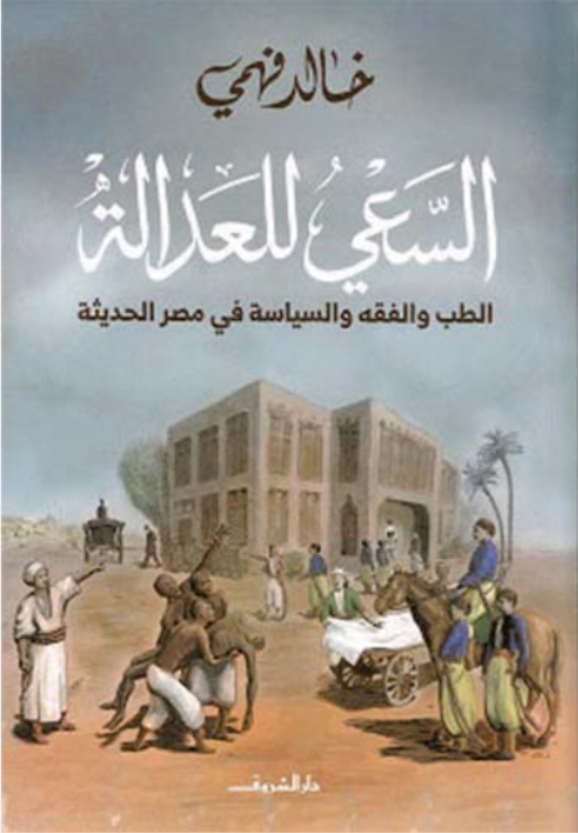
مصر ليست الهند:
وعادة فهمي في مقدمات كتبه إبداء رؤية نظرية وتاريخية غنية عن موضوعه وخطة بحثه. فالطب الجنائي (موضوع الكتاب) الذي عادة ما ربطته مدرسة التابع بقدوم الكولونيالية، ليس كذلك في رؤية فهمي، بل هو ناجم عن جهود محلية. إذ يعتقد فهمي أنّ هناك أسبابا محلية دفعت الباشا (محمد علي) إلى تأسيس مدرسة الطب في قصر العيني، وبالتالي ينبغي النظر إلى هذا القصر ودراسته في سياق عثماني، لا في سياق أوروبي، ولذلك يرى فهمي أنّ أفكار بارثا تشاترجي والمدرسة الهندية لا تنطبق على الحالة المصرية، إذ لا يمكن وصف المجتمع المصري قبل 1882 بأنّه مجتمع كولونيالي، كما ذهب لذلك ميتشل. في المقدمة أيضا، سيبدي فهمي رغبة بفتح نقاش حول أفكار طلال أسد وحلاق، إذ يدفع أسد بأنّه ينبغي النظر إلى العلمانية على أنها قد استحدثت فصلا عميقا وجوهريا بين الأخلاق والقانون. بمعنى أنّ ما يميز العلمانية استحداثها نظاما قضائيا لا ينبع من المثل والقيم الأخلاقية التي تحكم علاقات الناس ببعضها. في حين يرى فهمي أنّ إشكالية أسد تتمثّل في أنه لا يولي اهتماما لدراسة المؤسسات التي ساهمت في هذه التحولات، وهذا ناجم عن فقر في المادة التاريخية، كونه بقي يركز على خطابات الإصلاحيين وكتاباتهم، ولذلك سيذهب بنا فهمي إلى الأرشيف للبحث أكثر في هذه الجوانب وطريقة تعامل الناس في الماضي مع التغيرات القانونية في حياتهم، ليصل إلى فكرة جريئة تقول إنّ القانون لم يمثل قطيعة مع الشريعة (حلاق) بل هو امتداد ومرحلة من مراحل التطور التاريخي للشريعة، بدلا من وصمه بأنه نموذج من نماذج الهجمة الغربية.
الشمّ والمدينة: تاريخ آخر لمصر
تحتاج الأفكار في الكتاب إلى الكثير من المقالات لنوفيها حقها، ولذلك نتوقف على أسلوب فهمي في كتابة الفصل الثالث وعنوانه «الأنف تروي قصة مدينة» الذي برأينا يفتح الأبواب أمام كتابة تاريخ آخر لمصر في القرنين الأخيرين. يرى فهمي أنّ مؤرِّخي القاهرة الحديثة، اعتادوا التركيز على حاسة البصر على حساب شمّ الروائح. ولذلك نراهم يفضّلون التأمّل في المناظر البديعة من شرفات المباني وصور المدينة ورسم خرائطها، بدلا من الحديث عن روائح المدينة وروحها. وهنا يقترح قلب المعادلة أو زاوية النظر من خلال الاعتماد على الأنف كدليل للكتابة عن قصة قاهرة القرن التاسع عشر. فيدعونا للتأمّل في رائحة الزنخة الكامنة تحت التاريخ الرسمي، وإلى التأمل في روائح يوميات الناس العادية المليئة كالمعتاد بالأكل والتغوط والتبول والتحلل والنكاح.
لكن من أين نبدأ؟ هنا سنعيش مع فهمي مغامرة أو لعبة كتابية ممتعة، من خلال البدء بمقدمة وأسلوب شبيهين بإحدى مقدمات تيموثي ميتشل (هل الناموسة تتكلم؟). ففي صباح يوم ربيعي في 1878 كان طفل يلعب مع أقرانه قرب ثكنات قصر النيل عندما لاحظ كلبا يشمشم خرقة قديمة مدفونة في الأرض. وعندها ركضوا يعلمون شيخ الحارة بأنهم عثروا على شيء ما، ليكتشفوا مع رجال الشرطة آنذاك أنّ الخرقة تعود لطفلة صغيرة ولدت وتوفيت. وبعد تحريات سريعة تبين أنّ الطفلة ولدت لأم صغيرة من الصعيد كانت قد تعرفت على جندي وحملت منه. وهنا قد يتوقع القارئ أنّ فهمي قد يذهب للبحث عن هذا الجندي، الذي شغل باله في كتابه الأول. إلا أنه سيتوقف عند هذه الحكاية، فهو دائما ما يبدأ فصوله بصورة أو حكاية ما ليسير خلفها متتبعا خيوط القصة وبدايتها، ومن ثم يقوم بربطها بالتاريخ العام للمدينة. وفي حدثنا سترتبط قصة شمّ الكلب برحلة إسماعيل باشا وعلي مبارك إلى باريس سنة 1867، التي اعتبرت بمثابة خطوة حاسمة في دفع الخديوي لإعادة تشكيل القاهرة، على غرار باريس. يومها لم يبد مبارك وهو يسجل تفاصيل الرحلة أي اهتمام بوصف شوارع المدينة ومطاعمها ومقاهيها، بل كل ما أثار اهتمامه هو مجاري باريس، فوصفها بقوله «عبارة عن مبان عظيمة الارتفاع تحت شوارع المدينة معقودة من أعلاها، يتوصل إليها بسلالم في فتحات مخصوصة في الشوارع يدخل منها النور والهواء».
وعند عودته من باريس قدّم علي مبارك خطة للخديوي إسماعيل لإعادة تنظيم شوارع القاهرة، تبدأ من قلب المدينة القديمة. وبعد عقود سيأتي باحثون ليقرأوا زيارة مبارك لباريس بوصفها بداية ونقطة بناء مشروع القاهرة الحداثي، من خلال اقتراح بناء تنظيم شبيه بباريس ومجاريها وشوارعها. وبالتالي غدا المشروع الحديث للقاهرة مرتبطا وفق السردية السائدة بالتأثر بالغرب وأفكاره، ما يعني أنّ رائحة القاهرة قد تغيرت بعد زيارة مبارك للغرب الحديث. هنا سيكون لفهمي رأي آخر، فهو يرى أنّ رائحة المدينة كانت قد شهدت تغيرات عديدة هذه الفترة، ما يوحي بأنّ حداثة القاهرة قد انطلقت قبل ذلك بكثير. وبالتالي تغدو الرائحة وتتبّع آثارها في كتاب فهمي مسرحا جديدا للاطلاع على قصة أخرى للحداثة في المدينة، أو على الحداثة المحلية المصرية. يتتبّع فهمي الإجراءات التي قامت بها مؤسسات إدارية أو أجهزة إدارية لتحسين مجال النظافة في المدينة من خلال استئصال مصادر العفونة مثل، المجارير والبرك الراكدة والمدابغ والسلخانات وأسواق الأسماك ومقالب القمامة. وفي الغالب كانت هذه الإجراءات تنطلق من فكرة نظرية الأوخام كسبب للمرض. لم يتم تجاهل النظافة بشكل كامل في العصر العثماني، لكن التشديد الكبير على أهميتها وقع في القرن التاسع عشر. فعلى سبيل المثال تم إنشاء وحدة شرطة خاصة وتتكون من حراس يقومون بجولات تفتيشية لمنع الأهالي من إلقاء القمامة في الشوارع. أما باعة الأطعمة التي تنبعث منها روائح نفاذة، خاصة الجزارين وباعة السمك، كان واجبا عليهم الحصول على تصريح خاص قبل افتتاحهم ـ كما طلب من باعة الفسيخ الابتعاد عن المحلات التي بها ممر العالم الأكبر والشوارع المطروقة. وبالتالي يلاحظ أنّ إجراءات تحسين واقع ورائحة المدينة لم تأت جراء التأثر بالغرب (رحلة علي مبارك) بل هو مشروع أقدم من ذلك، ونجم عن وعي محلي مصري بضرورة الاهتمام بالمدينة من أجل الصحة العامة.
تبدو حجة فهمي في هذا الفصل (وباقي الفصول) حول الحداثة المحلية، لا الكولونيالية، قوية وغنية، لكن ما يسجّل على مقاربته أنّ تركيزه على رصد المحلي، ظهر وكأنه يسبّب عن غير قصد حالة من الفصل بين المصري (المحلي) والأوروبي. ولعل مردّ ذلك، تركيزه في كتابه على إظهار الجانب المحلي في مصر وتطوره (في القرن التاسع عشر) بدلا من التركيز على التأثيرات الغربية، التي انشغلت بها مدارس عديدة. وهذا أظهر القاهرة أحيانا في الكتاب وكأنها تعيش بمعزل عن العالم. في حين نعتقد، ولا شك أنّ فهمي يشاطرنا ذلك، أنّ هذا التطور المحلي كان أيضاً يتأثر ويؤثر في التغيرات العالمية من حوله. وهذا ما سماه الباحث الألماني استفان ويبر «الحداثة المتشابكة» التي يقصد بها أنّ التغيرات التي نقلت المجتمع والمدينة من الوضع القديم إلى الوضع الحديث، جرت ضمن سياقات تاريخية وثقافية متشابكة ومتداخلة على الصعيدين المحلي والعالمي. وفي جميع الأحوال، كتاب فهمي الأخير بمثابة عالم غني ومغامرة كبيرة وممتعة للتعرّف على الحياة اليومية وكيفية قراءتها والكتابة عنها في مصر الحديثة، والعالم العربي عموماً.
* كاتب سوري
المصدر: القدس العربي
