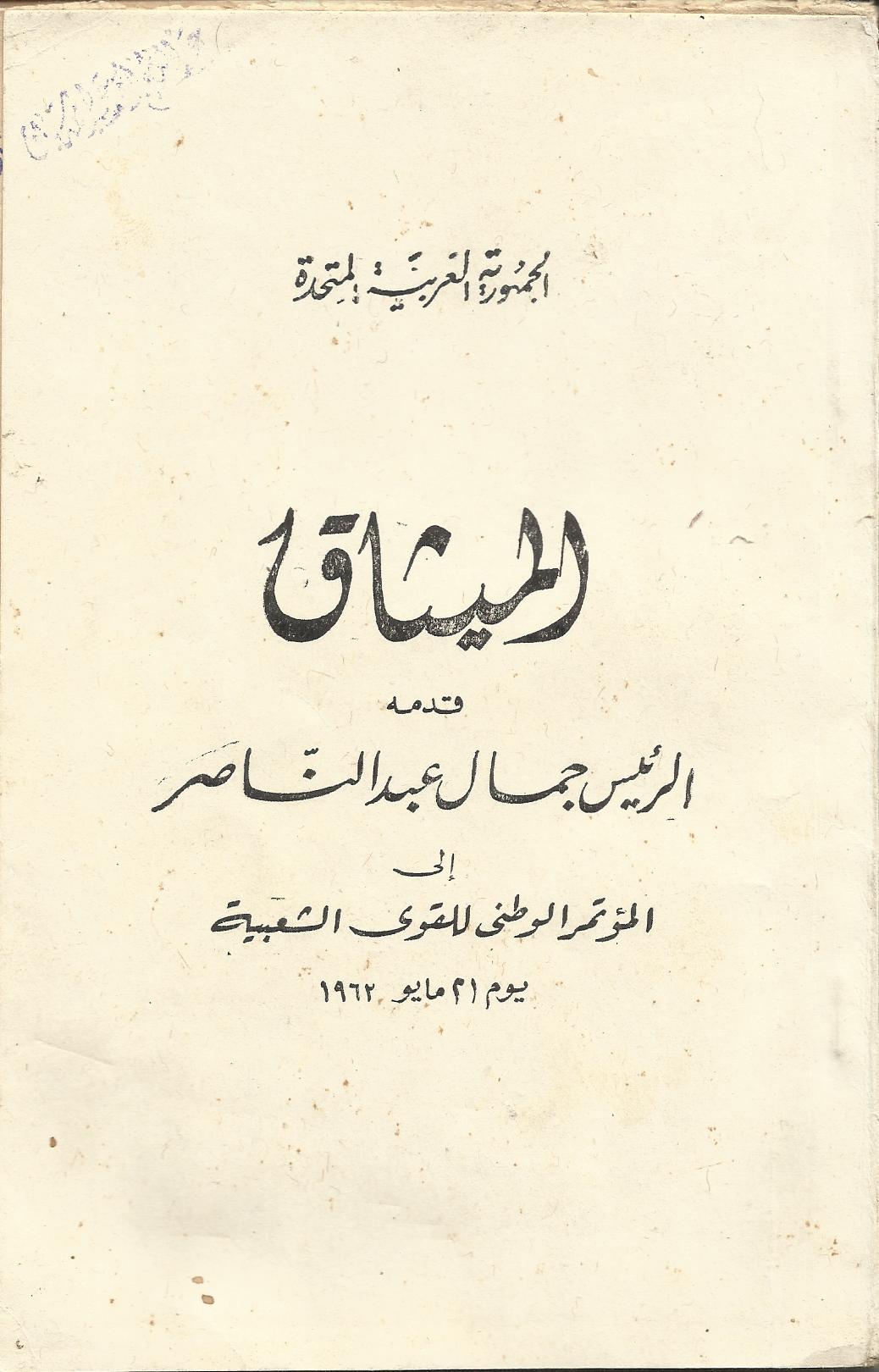
البــاب الثـالـث
جذور النضال المصري:
منذ زمان بعيد في الماضي لم تكن هناك سدود بين بلاد المنطقة التي تعيش فيها الأمة العربية الآن، وكانت تيارات التاريخ التي تهب عليها واحدة؛ كما كانت مساهمتها الإيجابية في التأثير على هذا التاريخ مشتركة، ومصر بالذات لم تعش حياتها في عزلة عن المنطقة المحيطة بها، بل كانت دائماً بالوعى – وباللاوعي في بعض الأحيان – تؤثر فيما حولها، وتتأثر به كما يتفاعل الجزء مع الكل، وتلك حقيقة ثابتة تظهرها دراسة التاريخ الفرعوني صانع الحضارة المصرية والإنسانية الأولى، كما تؤكدها بعد ذلك وقائع عصور السيطرة الرومانية والإغريقية.
وكان الفتح الإسلامي ضوءاً أبرز هذه الحقيقة، وأنار معالمها، وصنع لها ثوباً جديداً من الفكر والوجدان الروحي، وفى إطار التاريخ الإسلامي، وعلى هدى من رسالة محمد – صلى الله عليه وسلم – قام الشعب المصري بأعظم الأدوار دفاعاً عن الحضارة والإنسانية، وقبل أن ينزل ظلام الغزو العثماني على المنطقة بأسرها كان شعب مصر قد تحمل ببسالة منقطعة النظير مسئوليات حاسمة لصالح المنطقة كلها؛ كان قد تحمل المسئولية المادية والعسكرية في صد أول موجات الاستعمار الأوروبي التي جاءت متسترة وراء صليب المسيح؛ وهى أبعد ما تكون عن دعوة هذا المعلم العظيم، وكان قد تحمل المسئولية المادية والعسكرية في رد غزوات التتار، الذين اجتاحوا سهول الشرق واجتازوا جباله؛ حاملين الخراب معهم والدمار، ثم كان قد تحمل المسئولية الأدبية في حفظ التراث الحضاري العربي وذخائره الحافلة، وجعل من أزهره الشريف حصّناً للمقاومة ضد عوامل الضعف والتفتت؛ التي فرضتها الخلافة العثمانية استعماراً ورجعية باسم الدين، والدين منها براء.
ولم تكن الحملة الفرنسية على مصر – مع مطلع القرن التاسع عشر – هي التي صنعت اليقظة المصرية في ذلك الوقت، كما يقول بعض المؤرخين؛ فإن الحملة الفرنسية حينما جاءت إلى مصر وجدت الأزهر يموج بتيارات جديدة تتعدى جدرانه إلى الحياة في مصر كلها؛ كما وجدت أن الشعب المصري يرفض الاستعمار العثماني المقنع باسم الخلافة، والذى كان يفرض عليه – دونما مبرر حقيقي – تصادماً بين الإيمان الديني الأصيل في هذا الشعب، وبين إرادة الحياة التي ترفض الاستبداد.. ولقد وجدت هذه الحملة مقاومة عنيفة لسيطرة المماليك، وتمرداً مستمراً على محاولاتهم لفرض الظلم على الشعب المصري، وبرغم أن هذه المقاومة العنيفة والتمرد المستمر قد كلفا شعب مصر غالياً في ثروته الوطنية وفى حيويته؛ فإن الشعب المصري كان صامداً ثابت الإيمان. على أن الحملة الفرنسية جاءت معها بزاد جديد لطاقة الشعب الثورية في مصر ذلك الوقت؛ جاءت ومعها لمحات من العلوم الحديثة التي طورتها الحضارة الأوروبية، بعد أن أخذتها من غيرها من الحضارات؛ والحضارة الفرعونية والعربية في مقدمتها؛ كذلك جاءت معها بالأساتذة الكبار الذين قاموا بدراسة أحوال مصر والكشف عن أسرار تاريخها! القديم، وكان هذا الزاد يحمل في طياته ثقة بالنفس، كما كان يحمل آفاقاً جديدة تشد خيال الحركة المتحفزة للشعب المصري . ولقد كانت هذه اليقظة الشعبية هي القوة الدافعة وراء عهد محمد علي، وإذا كان هناك شبه إجماع على أن محمد علي هو مؤسس الدولة الحديثة في مصر؛ فإن المأساة في هذا العهد هي أن محمد علي لم يؤمن بالحركة الشعبية التي مهدت له حكم مصر، إلا بوصفها نقطة وثوب إلى مطامعه، ولقد ساق مصر وراءه إلى مغامرات عقيمة استهدفت مصالح الفرد؛ متجاهلة مصالح الشعب.
إن اليابان الحديثة بدأت تقدمها في نفس هذا الوقت الذى بدأت فيه حركة اليقظة المصرية، وبينما استطاع التقدم الياباني أن يمضى ثابت الخطى؛ فإن المغامرات الفردية عرقلت حركة اليقظة المصرية، وأصابتها بنكسة ألحقت بها أفدح الأضرار . إن هذه النكسة فتحت الباب للتدخل الأجنبي في مصر على مصراعيه، بينما كان الشعب قبلها قد رد – بتصميم ونجاح – محاولات غزو متوالية، كانت أقربها في ذلك الوقت حملة “فريزر” ضد رشيد.
ومن سوء الحظ أن النكسة وقعت في مرحلة هامة من مراحل تطور الاستعمار؛ فإن الاستعمار كان قد تطور في ذلك الوقت من مجرد احتلال المستعمرات واستنزاف مواردها إلى مرحلة الاحتكارات المالية لاستثمار رءوس الأموال المنهوبة من المستعمرات، وكانت النكسة في مصر باباً مفتوحاً لقوى السيطرة العالمية. وبدأت الاحتكارات المالية الدولية دورها الخطير في مصر، وركزت نشاطها في اتجاهين واضحين، هما: حفر قناة السويس، وتحويل أرض مصر إلى حقل كبير لزراعة القطن؛ لتعويض الصناعة البريطانية عن أقطان أمريكا التي قل ورودها إلى بريطانيا بسبب انتهاء سيطرتها على أمريكا، ثم انقطع وصولها تماماً بسبب ظروف الحرب الأهلية الأمريكية، ولقد عاشت مصر في هذه الفترة تجربة مروعة؛ استنزفت فيها كل إمكانيات الثروة الوطنية لصالح القوى الأجنبية، ولمصلحة عدد من المغامرين الأجانب؛ الذين تمكنوا من السيطرة على أمراء أسرة محمد علي، وساعدهم على ذلك فداحة النكسة التي أصيبت بها حركة اليقظة المصرية.
على أن روح هذا الشعب لم تستسلم، وإنما استطاعت تحت المحن العصيبة في هذه الفترة أن تختزن طاقات تحفزت لإطلاقها في اللحظة المناسبة، وكانت هذه الطاقة هي العلم الذى حصل عليه آلاف من شباب مصر الرواد ممن أرسلوا – أيام الصحوة التي سبقت النكسة من حكم محمد علي – إلى أوروبا ليتمكنوا من العلم الحديث؛ فإن هؤلاء استطاعوا بعد عودتهم إلى الوطن أن يجلبوا معهم بذوراً صالحة، ما لبثت التربة الثورية الخصبة لمصر أن احتضنتها؛ لتخرج منها بشائر نبت ثقافي جديد راح ينشر ألواناً رائعة من الأزهار على ضفاف النيل الخالد، وليس صدفة أن هذه الزهور المتفتحة على ضفاف وادي النيل كانت بمثابة الومضات اللامعة التي لفتت أنظار العناصر المتطلعة إلى التقدم في المنطقة كلها نحو مصر، وجعلت منها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر منبراً للفكر العربي كله، ومسرحاً لفنونه، وملتقى لكل الثوار العرب من وراء الحدود المصطنعة والموهومة، ولقد أحست الاحتكارات الاستعمارية الطامعة في المنطقة بالأمل الجديد يستجمع قواه ويتحفز، وكانت بريطانيا بالذات لا تحول أنظارها عن مصر؛ بحكم اهتمامها بالطريق إلى الهند، ومن ثم ألقت بثقلها كله في المعرك! ة الثورية التي لاحت مقدماتها بين القوى الشعبية وبين أسرة محمد علي الدخيلة المغامرة، وكانت ثورة عرابي هي قمة رد الفعل الثوري ضد النكسة، وكان الاحتلال البريطاني العسكري لمصر سنة 1882؛ ضماناً لمصالح الاحتكارات المالية الأجنبية وتأييداً لسلطة الخديوي ضد الشعب، هو التعبير عن إرادة الاستعمار في استمرار بقاء النكسة، ومواصلة القهر والاستغلال ضد شعب مصر.
إن قوة الاحتلال البريطاني العسكرية، ومؤامرات المصالح الاحتكارية الاستعمارية، والإقطاع الذى أقامته أسرة محمد علي باحتكارها للأرض أو اقتسام جزء منها بين أصدقائها أو أصدقاء المستغلين الأجانب.. ذلك كله لم يستطع أن يطفئ شعلة الثورة على الأرض المصرية.
إن وادى النيل لم تنقطع فيه أصوات النداءات الثورية.. في مواجهة هذا الإرهاب المتحكم؛ الذى تسنده قوى الاحتلال الأجنبي، والمصالح الدولية الاستعمارية.
إن أصداء المدافع التي ضربت الإسكندرية، وأصداء القتال الباسل الذى طعن من الخلف في التل الكبير؛ لم تكد تخفت حتى انطلقت أصوات جديدة تعبر عن إرادة الحياة التي لا تموت لهذا الشعب الباسل، وعن حركة اليقظة التي لم تقهرها المصائب والمصاعب.
لقد سكت أحمد عرابي لكن صوت مصطفى كامل بدأ يجلجل في آفاق مصر. ومن عجب أن هذه الفترة التي ظن فيها الاستعمار والمتعاونون معه أنها فترة الخمود كانت من أخصب الفترات في تاريخ مصر؛ بحثاً في أعماق النفس، وتجميعاً لطاقات الانطلاق من جديد.
لقد ارتفع صوت محمد عبده في هذه الفترة ينادى بالإصلاح الديني.
وارتفع صوت لطفى السيد ينادي بأن تكون مصر للمصريين.
وارتفع صوت قاسم أمين ينادي بتحرير المرأة.
وكانت تلك كلها مقدمة موجة ثورية جديدة؛ ما لبثت أن تفجرت سنة 1919 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وبعد خيبة الأمل في الوعود البراقة التي قطعها الحلفاء على أنفسهم خلال الحرب، وفى مقدمتها وعود “ويلسون” الذى ما لبث هو نفسه أن تنكر لها واعترف بالحماية البريطانية على مصر . وركب سعد زغلول قمة الموجة الثورية الجديدة؛ يقود النضال الشعبي العنيد الذى وجهت إليه الضربات المتلاحقة أكثر من مائة عام متواصلة، دون أن يستسلم أو ينهزم.
إن ثورة الشعب المصري سنة 1919 تستحق الدراسة الطويلة؛ فإن الأسباب التي أدت إلى فشلها هي نفس الأسباب التي حركت حوافز الثورة في سنة 1952.
إن هناك ثلاثة أسباب واضحة أدت إلى فشل هذه الثورة، ولابد من تقييمها في هذه المرحلة تقييماً أميناً ومنصفاً.
أولاً: إن القيادات الثورية أغفلت إغفالاً يكاد أن يكون تاماً مطالب التغيير الاجتماعي؛ على أن تبرير ذلك واضح في طبيعة المرحلة التاريخية التي جعلت من طبقة ملاك الأراضي أساساً للأحزاب السياسية التي تصدت لقيادة الثورة، ومع أن اندفاع الشعب إلى الثورة كان واضحاً في مفهومه الاجتماعي إلا أن قيادات الثورة لم تتنبه لذلك بوعى؛ حتى لقد ساد تحليل خاطئ في هذه الظروف ردده بعض المؤرخين؛ مؤداه أن الشعب المصري ينفرد عن بقية شعوب العالم بأنه لا يثور إلا في حالة الرخاء. ولقد استدلوا على ذلك بأن الثورة وقعت في ظروف الرخاء الذى صاحب ارتفاع أسعار القطن في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الأولى، وذلك استدلال سطحي؛ فإن هذا الرخاء كان محصوراً في طبقة ملاك الأراضي، وطبقة التجار والمصدرين الأجانب، الذين استفادوا من ارتفاع الأسعار؛ وبذلك زاد التناقض بينهم وبين الكادحين من الفلاحين، الذين كانوا يروون حقول القطن بعرقهم ودمائهم؛ دون أن تتغير أحوالهم بارتفاع أسعاره، وكان هذا الحرمان في القاعدة بتناقضه مع الرخاء في القمة من أسباب الاحتكاك الذى أشعل شرارة الثورة.
إن المحرومين كانوا هم وقود الثورة وضحاياها، لكن القيادات التي تصدت في مقدمة الموجه الثورية سنة 1919، بإغفالها للجوانب الاجتماعية من محركات الانفجار الثوري لم تستطع أن تتبين بوضوح أن الثورة لا تحقق غاياتها بالنسبة للشعب إلا إذا مدت اندفاعها إلى ما بعد المواجهة السياسية الظاهرة من طلب الاستقلال؛ ووصلت إلى أعماق المشكلة الاقتصادية والاجتماعية. ولقد كانت الدعوة إلى تمصير بعض أوجه النشاط المالي هي قصارى الجهد في ذلك الوقت، في حين أن الدعوة إلى إعادة توزيع الثروة الوطنية أصلاً وأساساً كانت هي المطلب الحيوي الذى يتحتم البدء فيه من غير تأخير أو إبطاء.
ثانياً: إن القيادات الثورية في ذلك الوقت لم تستطع أن تمد بصرها عبر سيناء، وعجزت عن تحديد الشخصية المصرية، ولم تستطع أن تستشف – من خلال التاريخ – أنه ليس هناك صدام على الإطلاق بين الوطنية المصرية وبين القومية العربية.
لقد فشلت هذه القيادات في أن تتعلم من التاريخ، وفشلت أيضاً في أن تتعلم من عدوها الذى تحاربه، والذى كان يعامل الأمة العربية كلها على اختلاف شعوبها طبقاً لمخطط واحد.
ومن هنا فإن قيادات الثورة لم تنتبه إلى خطورة وعد “بلفور” الذى أنشأ إسرائيل لتكون فاصلاً يمزق امتداد الأرض العربية، وقاعدة لتهديدها؛ وبهذا الفشل فإن النضال العربي في ساعة من أخطر ساعات الأزمة حرم من الطاقة الثورية المصرية، وتمكنت القوى الاستعمارية من أن تتعامل مع أمة عربية ممزقة الأوصال مفتتة الجهد.
واختصت إدارة الهند البريطانية بالتعامل مع شبه الجزيرة العربية ومع العراق، وانفردت فرنسا بسوريا ولبنان، بل وصل الهوان بالأمة العربية في ذلك الوقت إلى حد أن جواسيس الاستعمار تصدروا قيادة حركات ثورية عربية، وكانت بأمرهم وبمشورتهم تقام العروش للذين خانوا النضال العربي، وانحرفوا عن أهدافه.
كل هذا والحركة الثورية الوطنية في مصر تتصور أن هذه الأحداث لا تعنيها، وأنها لا ترتبط مصيرياً بكل هذه التطورات الخطيرة.
ثالثاً: إن القيادات الثورية لم تستطع أن تلائم بين أساليب نضالها وبين الأساليب التي واجه الاستعمار بها ثورات الشعوب في ذلك الوقت.
إن الاستعمار اكتشف أن القوة العسكرية تزيد ثورات الشعوب اشتعالاً؛ ومن ثم انتقل من السيف إلى الخديعة، وقدم تنازلات شكلية لم تلبث القيادات الثورية أن خلطت بينها وبين الجوهر الحقيقي، وكان منطق الأوضاع الطبقية يزين لها هذا الخلط.
إن الاستعمار في هذه الفترة أعطى من الاستقلال اسمه وسلب مضمونه، ومنح من الحرية شعارها واغتصب حقيقتها.
وهكذا انتهت الثورة بإعلان استقلال لا مضمون له، وبحريه جريحة تحت حراب الاحتلال، وزادت المضاعفات خطورة بسبب الحكم الذاتي الذى منحه الاستعمار، والذى أوقع الوطن باسم الدستور في محنة الخلاف على الغنائم دون نصر.
وكانت النتيجة أن أصبح الصراع الحزبي في مصر ملهاة تشغل الناس، وتحرق الطاقة الثورية في هباء لا نتيجة له. وكانت معاهدة سنة 1936 التي عقدت بين مصر وبريطانيا، والتي اشتركت في توقيعها جبهة وطنية تضم كل الأحزاب السياسية العاملة في ذلك الوقت؛ بمثابة صك الاستسلام للخديعة الكبرى الذى وقعت فيها ثورة سنة 1919، فقد كانت مقدمتها تنص على استقلال مصر؛ بينما صلبها في كل عبارة من عباراته يسلب هذا الاستقلال كل قيمة له وكل معنى.
يتبع؛ الباب الرابع (درس النكسة)…

التعليقات مغلقة.