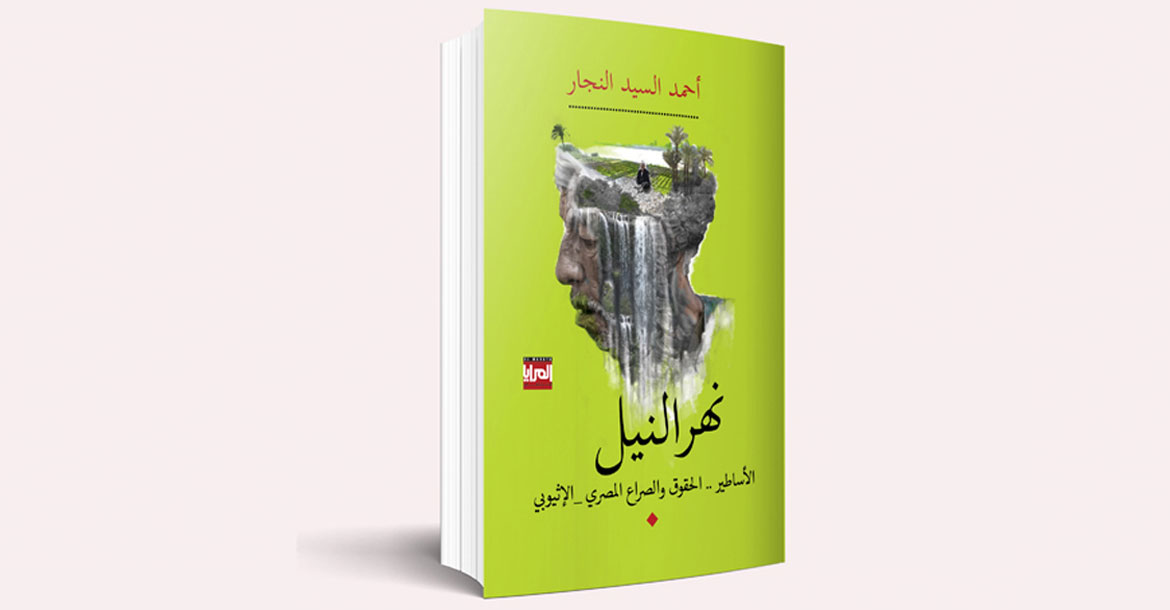
ماهر الشيال *
في الرابع والعشرين من أبريل الماضي صدر كتاب «نهر النيل.. الأساطير.. الحقوق والصراع المصري- الإثيوبي» للخبير الاقتصادي «أحمد السيد النجار» عن دار المرايا للإنتاج الثقافي.. ويقع الكتاب في 309 صفحة من القطع الكبير، ويضم مقدمة وخمسة فصول ثم خاتمة.
يتناول الكتاب في الفصل الأول ما أطلق عليه الكاتب، فقه انتساب المياه.. القانون الدولي واتفاقيات مصر ودول حوض النيل والأوضاع المائية الراهنة.. ويختص الفصل الثاني بالحديث عن النيل من حيث النشأة والأساطير وطبوغرافية النهر وسماته.. وفي الفصل الثالث يتناول ’أحمد النجار‘، السد الإثيوبي وأوهام إمكانية حصول مصر على جزء من مياه نهر “الكونغو”، كما يتضمن الفصل الحديث عن صراع الإرادات بين مصر وإثيوبيا والمسارات الممكنة لحل الازمة.. في الفصل الرابع يتناول الكاتب أهم المشروعات التي تم إنجازها لضبط النيل، وعلى رأسها السد العالي.. ثم يختم فصول الكتاب الخمسة بـ فصل عن الاستراتيجية المائية المصرية ومدى ملاءمتها وكفاءة تطبيقها ثم خاتمة سريعة للكتاب يوجز فيها أهم ما يقترحه بخصوص الاستراتيجية المصرية في الحفاظ على الحق في مياه النيل، وجدوى طرق تقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك، كما يُلمّح الكاتب إلى أهمية جنوب السودان وأوغندا كأفضل مسرح لإقامة مشروعات تنمية إيرادات روافد النيل.
تلازم وجودي:
يتناول ’النجار‘ في مقدمة الكتاب ارتباط مصر بالنيل ارتباطاً يتجاوز الجانب المادي في توفير الاحتياجات المائية للبلاد إلى حالة من التلازم الوجودي “…بين نهرٍ معطاء للمياه، إكسير الحياة، وشعبٌ قادر على صنع الأعاجيب بالمياه بما منح النهر ألقاً وزهواً بالحضارة التي ازدهرت على ضفتي واديه الخصيب ودلتاه العظيمة وشكلت فجر ضمير الإنسانية”. ما جعل من الحديث عن المساس بحقوق مصر التاريخية في النهر العظيم؛ تهديداً مباشراً لوجود مصر ونذيراً بالدمار الشامل لكل أوجه الحياة على أرضها.
ولا شك أن تلك العلاقة القوية بالنهر جعلته ذا مكانة قدسية استثنائية ومحوراً للعديد من الأساطير مثل نسبته إلى الإله “نون” وربط فيضانه بدموع “إيزيس” وباللقاء الحميم بين “حاتحور” و”حورس” وفق المعتقدات المصرية القديمة.
وعن الموقف الإثيوبي المتعنت يؤكد الكاتب أن الدوافع الإثيوبية ليست مبرَّأة عن الكيد والعداوة ومنطق الاستحواذ والهيمنة.. مضيفاً أن على مصر أن تضع أمامها كل الخيارات مفتوحة دون استبعاد لاستخدام القوة حماية لحياة مصر وشعبها وحقوقها المائية.. طالما أصرت إثيوبيا على السير في اتجاه تأجيج الأزمة وممارسة “البلطجة” والضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.. مشدداً على عدم غض الطرف عن نقاط الضعف الاستراتيجية لإثيوبيا كونها دولة حبيسة لا منافد بحرية لها وكونها تنخرط طوال الوقت في صراعات إقليمية، بالإضافة إلى طبيعتها السكانية متعددة الأعراق ما يثير النزاعات الداخلية فيها بين الحين والآخر.
يتطرق الكاتب بعد ذلك في مقدمته إلى وضع نهر النيل حالياً كونه أطول أنهار العالم (6820) كم يقطع خلالها مناطق مناخية مختلفة، من المناخ الاستوائي إلى المناخ الموسمي المداري وصولاً إلى المنطقة المدارية ليقطع بعد ذلك مسافة تقدر بنحو (2521) كم من مصب نهر عطبرة حتى قناطر الدلتا شمال القاهرة إلى حيث مصبه عند البحر المتوسط في دمياط ورشيد.. ورغم ذلك فإن الإيراد المائي للنيل يعتبر قِزماً إذا ما قورن بإيراد نهر “الأمازون” الذي يفوقه بـ 60 مِثلاً، ونهر “الكونغو” الذي يفوق إيراده السنوي إيراد النيل بـ 14 مِثلاً، وكذلك أنهار “اليانغتسي (تشانغ جيانغ)” و”الغانج” و”الميسيسبي” و”الفولجا” و”الدانوب” التي يبلغ إيراد كل منها عدة أضعاف إيراد نهر النيل.. ورغم ذلك فإن شعوب تلك الأنهار لم تستطع الإمساك بزمام ريادة الحضارة الإنسانية وصياغة أسسها في شتى المجالات مثلما فعل الشعب المصري في وادي النيل ودلتـاه.. .
ومن المعروف أن النيل بقي متاحاً للاستخدام بلا قواعد أو حدود حتى القرن العشرين.. ليشهد بعد ذلك توقيع عدد من الاتفاقات فرضها تشكل الدول في المناطق المختلفة وزيادة السكان المطردة.. لكن ذلك لم يَحُّل دون التنازع الذي غذّته قوى خارجية اعتماداً على طبيعة الحكم الإثيوبي الحالي وما تتسم به من تطرف واتجاه واضح نحو حل أزمات الداخل باصطناع أزمات خارجية وصراعات إقليمية دون حاجة ملحة لذلك إذ تصل كمية الأمطار الساقطة على الهضبة الإثيوبية إلى حوالي 900 مليار متر مكعب يتبدد معظمها بفعل البخر والتشرب والتسرب، في حين تبلغ حصة مصر من المياه أقل من 60 مليار متر مكعب سنويا.. وهو ما يجعل مصر متمسكة بمبدأ عدم المساس بتلك الحصة المحدودة التي أصبحت لا تفي بحاجتها بعد الزيادة السكانية الكبيرة في السنوات الأخيرة.. ما يدعم موقف مصر أنها لم تدخر وسعاً في سبيل تطوير المشروعات التنموية في دول حوض النيل مثل سد أوين لتوليد الكهرباء في أوغندا والذي مولته مصر بالكامل من أجل تخزين المياه لحسابها في بحيرة فيكتوريا؛ لكن اعتراض الدول المُشاطئة للبحيرة على التخزين الذي سيتسبب في إغراق بعض الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب المياه في البحيرة متراً واحداً حال دون استفادة مصر منه بعد تمويلها لإنشاء السد بالكامل بالإضافة لدفعها تعويضات لأوغندا عن بعض الأضرار التي نجمت عن المشروع وكان ذلك عام 1949، هذا بالإضافة إلى أغلبية السدود والمرافق المائية التي تم إنشاؤها في السودان في فترة وجوده مع مصر في دولة واحـدة.
نوايا أثيوبيا السيئة:
ويعود الكاتب للتأكيد على نوايا السوء التي تُغلف موقف الجانب الإثيوبي الذي أعلن عن النية في استخدام مياه النيل في التنمية رغم أن كل الاتفاقيات القديمة تمنعهم من ذلك بسبب التُخمة المائية التي تتمتع بها إثيوبيا التي تضم نحو 30 نهراً آخر بالإضافة إلى كميات الأمطار الهائلة والمياه الجوفية.. ما يستلزم اتخاذ موقف حازم تجاه تلك التحركات التي تعتمد على منطق الاستحواذ على المياه التي تنبع من الأراضي الإثيوبية وفرض الأمر الواقع بصورة أقرب إلى “البلطجة” وتدفع بالأمور إلى التصعيد غير الودي.. ما يُحتم العمل على نقاط الضعف الاستراتيجية للدولة الإثيوبية لمجابهة تلك الاخطار الوجودية المحدقة بمصر أرضاً وشعباً.
الفصل الأول: فقه انتساب المياه.. القانون الدولي واتفاقيات مصر ودول حوض النيل والاوضاع المائية الراهنة
إلى من تنتسب المياه؟ يجيب الكاتب في هذا الفصل على العديد من التساؤلات المتعلقة بالأفكار المعتمدة في تحديد انتساب المياه، ويخلص إلى فكرتين رئيستين، الفكرة الأولى: تؤكد على أن المياه تنتسب إلى مصدرها، أما الفكرة الثانية: فتعتمد مبدأ أن المياه تنتسب لمن استخدمها واعتمدت حياتها عليها تاريخياً وبصورة سابقة على حاجة الآخرين إليها، أي انتساب المياه إلى الحياة التي خلقتها والتي يمكن أن تنهار إذا غابت تلك المياه أو تم احتجازها من دولة المنبع أو المجرى الأوسط.. ولم تكن الصراعات لتنشأ على التحكم في مياه الانهار الكبيرة إذ كانت عصية على ذلك، بل كانت تدور حول السيطرة على المناطق الخصيبة وتلك المزدهرة بالصيد في أحواض تلك الأنهار.. لكن التطورات التقنية الهامة التي واكبت بداية القرن العشرين مكنت الإنسان من امتلاك القدرة على بناء السدود لتغيير مسار الأنهار الكبيرة وتقييدها كليا؛ فانفتحت بذلك بوابات الصراع على الحق في استخدام المياه.
لم تلتفت مصر إلى خطورة وجود قلبها المائي خارجها بحكم محدودية عدد السكان ووفرة المياه.. إلا أنه مع تأسيس الدولة الحديثة في مطلع القرن التاسع عشر بدأ عدد السكان في التزايد بوتيرة متسارعة ما زاد من احتياجات مصر المائية؛ فبدأت الدولة المصرية في عهد محمد علي بتنفيذ عدد من المشروعات التي استهدفت ضبط النيل، واستمرت تلك المشروعات حتى عهد الخديوي إسماعيل وتنوعت بين القناطر والأهّوِسة والترع والمصارف، كاستثمار عادل لإيراداتها المائية كدولة مصب.
ويشير الكاتب إلى أن الدول “الاستدمارية”- بالدال بدلاً من العين- كما يحلو للمؤلف تسميتها هي التي بدأت في بناء الترتيبات والتعهدات المائية المرتبطة بالتدفق والاقتسام التاريخي للمياه نيابة عن الدول التي تحتلها.. ورغم أن هذه التعهدات قد وُضعت وفق مصالح المحتل وحفظ التوازنات الإقليمية إلا أنها “تظل تشكل أحد الأسس الهامة التي تحكم العلاقات بين دول حوض النيل بشأن تقسيم مياهه وفقاً لقاعدة الاستخلاف في القانون الدولي”.
وعن تطور الإطار القانوني الدولي في معالجة قضية اقتسام المياه في الأنهار الدولية والمنهج المصري في النظر إلى قضية المياه المشتركة في نهر دولي مثل نهر النيل يشير ’النجار‘ إلى أن الأسس النظرية والقانونية المتعلقة بهذا الإطار قد مرت بمراحل طويلة وتغيرات عاصفة بسبب العديد من النزاعات التي تنامت بتعاظم القدرة البشرية على إقامة الخزانات والسدود والقدرة على نقل المياه لزراعة المناطق الفقيرة مائيـاً.
ويلخص الكاتب تلك الأسس فيما يلــي:
1- نظرية السيادة المطلقة وتطبيقاتها في الواقع “فقه هارمون” وهي تعتمد مبدأ السيادة المطلقة لكل دولة على أراضيها وبالتالي فإن دولة المنبع تسيطر بشكل كامل على المياه دون القبول بأي حقوق لدول المجرى والمصب.
2- نظرية الحقوق النهرية أو التكامل الإقليمي المطلق وهي عكس النظرية السابقة تماماً، وتقضي بأن كل دولة من دول الحوض من حقها أن تستقبل نفس كمية المياه التي تتدفق من المنابع دون المساس بهذه المياه أو تلويثهـا.
3- نظرية التقسيم العادل لمياه النهر وتسمى أيضا بنظرية السيادة الإقليمية المقيدة وتعتمد مبدأ التوزيع العادل للمياه وفق الاحتياجات مع مراعاة الحصة التاريخيـة.
في هذا الجزء يتناول الكاتب الاتفاقية الإطارية للاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية بشيء من النقد والتحليل وهي الاتفاقية التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1997، ولم تدخل حيز التنفيذ سوى عام 2014، بعد اكتمال تصديق 35 دولة عليها.. ويحدد ’النجار‘ نقاط نقده لهذه الاتفاقية في ما يتعلق بنص الاتفاقية الذي اعتبره “مطاط وحمّال أوجه” مع وجود تعارض واضح بين بعض المواد الواردة بنص الاتفاقية.. وأخطر ما ورد في الاتفاقية تلك المادة المتعلقة بإمكانية إلغاء الاتفاقات القائمة وإقرار معاهدات جديدة وهو ما أعلنت مصر رفضه.. إذ يتعارض مع منهجها المعتمد في تقسيم المياه وهو الأقرب إلى نظرية التكامل الإقليمي المطلق، مع استعداد مصر الدائم للإسهام في المشروعات التي تهدف إلى تعظيم إيرادات دول الحوض من مياه النيل.
يستعرض الكاتب في هذا الجزء الاتفاقيات حول مياه النيل بين مصر ودول الحوض بداية من البروتوكول الذي وقعته عنها بريطانيا مع إيطاليا في 15 نيسان/ أبريل 1891، والذي يقضي بتعهد إيطاليا بعدم إقامة أية منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة، مروراً بالاتفاقية الموقعة في 15 أيار/ مايو 1902 بين بريطانيا وملك إثيوبيا “منليك الثاني” والتي تتضمن تعهد إثيوبيا بعدم القيام بأي أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط يكون من شأنها الحد من تدفق مياه النيل إلى مصر إلا بعد الرجوع والاتفاق مع حكومتي بريطانيا والسودان.. ثم اتفاقية 1906 بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا في لندن بشأن الهضبة الإثيوبية وحفظ حقوق مصر في مياه النيل الازرق وروافده.. وصولاً إلى اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل بين مصر والسودان الموقعة في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1959 التي تضمنت الموافقة على إنشاء السد العالي.
اتفاقية عنتيبي:
في هذه الاتفاقية حاولت إثيوبيا وضع القواعد التي تضمن لها اقتطاع جزء من حصتي مصر والسودان وتم توقيع الاتفاق في 14 أيار/ مايو 2010 بين إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وراوندا والتحقت كينيا بعد ذلك بركب الموقعين بينما رفضت مصر توقيع الاتفاق الذي كان كاشفاً عن النوايا الخبيثة لإثيوبيا التي استغلت تراجع الدور المصري في إفريقيا منذ عهد السادات، في توحيد كلمة دول حوض النيل ضد المصالح المصرية.
الفصل الثاني: النيل… النشأة والأساطير وطبوغرافية النهر وسماته
كيف نشأ النيل؟
يستعرض الكاتب في بداية هذا الفصل نظريات نشأة النيل المختلفة مروراً بالتطورات التي لحقت بمجراه ومنابعه وروافده وصولاً إلى صورته الراهنة.. وتبدأ هذه النظريات بنظرية نيل الصحراء الغربية كأصل سابق للنيل وهي النظرية التي ذهب إليها عدد من علماء الجيولوجيا على رأسهم ”ماكس بلانكنهورن” الذي افترض وجود نهر ضخم أسماه النهر الليبي يجري داخل مصر وحدها من الجنوب إلى الشمال على بعد 100 كم غرب موقع النهر الحالي، كما افترض أن هذا النهر بدأ في عصر الأيوسين وانقرض في البليوسين.. وقد قبل العالِم “تيودور أرلت” هذه الفرضية مع تطوير طفيف يجعل بداية النهر جنوباً من المنطقة التي تضم العاصمة السودانية الخرطوم حالياً ليشمل كل الروافد النوبية دون الاتصال بالروافد الحبشية.
ثم يعرض الكاتب بالتفصيل لنظرية النيل الحديث التكوين التي ذهب إليها العلماء “بروكس” و”هيوم” و”كريج” بعد الاستدلال بسُمّك طبقات الغرين الحبشي الموجودة في مصر (حوالي 10 أمتار) ما يؤكد أن عمر النظام النهري الحديث للنيل الراهن لا يتجاوز 12 ألف عام قبل الميلاد بحساب معدل الترسيب السنوي البالـغ 1مم.
ويرفض الكاتب ما ذهب إليه البعض من أن المجرى قد شُق بواسطة أنهار الصحراء الشرقية في العصر المطير نظراً لتركز الأرض السوداء غرب النهر إضافة إلى ضخامة المجرى وارتفاع ضفافـه.
وهناك نظرية الأصل الالتوائي التي نادى بها “بيدنل” و”هيوم” و”ساندفورد” استناداً إلى فرضية اندفاع حافة الأخدود الإفريقي العظيم الناتج عن الانكسار الهائل في قارة “جندوانا لاند” في عصر الأوليجوسين ما تسبب في حدوث التواء مقعر على محور طولي من الشمال إلى الجنوب هو المجرى الحالي، وهو ما يعني “أن وادي النيل المصري هو ظاهرة تعرية نهرية على امتداد وادٍ التوائي متقعر”.
وتذهب نظرية الأصل الانكساري للنيل إلى أن سلسلة من الحركات الأرضية أدت إلى مجموعة من الانكسارات والفوالق التي مهدت وادي النيل وشكلته ودلتاه وهو ما يذهب إليه كثيرون منهم د. رشدي سعيد.
ويختتم ’النجار‘ نظريات نشأة النيل بعرض مجمل لنظريات ارتباط النيل بمنابعه الاستوائية والحبشية مثل ما ذهب إليه “أرلت” من أن النيل الأزرق ونهر عطبرة كانا مجموعة نهرية مستقلة ويصبان في البحر المتوسط قرب شبه جزيرة سيناء قبل تكوّن البحر الأحمر وهي نظرية أثبتت الدراسات الجيولوجية استحالتها لأسباب عديدة.. بينما افترض آخرون أن نهراً هائلاً كان ينبع من فلسطين ويحتل منخفض البحر الأحمر ويصب في المحيط الهندي قرب عدن وكان يرفده من الغرب رافد كبير يجمع مياه الهضبتين الاستوائية والحبشية قبل أن تتسبب الحركات الأرضية في قلب انحدارات الأرض ما أدى إلى انفصال الرافد الغربي الذي كان يجمع مياه الهضبتين الاستوائية والحبشية واتصاله بحوض النيل.
ويذكر الكاتب ما أورده د. جمال حمدان في “شخصية مصر” من أن النيل بدأ مصرياً بحتاً أو مصرياً نوبياً على أقصى تقدير في عصر الأيوسين وأن أقصى منابعه الجنوبية كانت تقع في بحيرة أو عروض حافة سبلوقة العرضية المرفوعة التي كانت تشكل خط تقسيم المياه في تلك المنطقة وكانت العطبرة هي الرافد الوحيد غير المصري في ذلك الحين.
طبوغرافية النيل من المنابع الاستوائية والحبشية إلى المصب:
جنوب خط الاستواء بدرجتين عند جبال “موفمبيرو” التي تفصل بين منابع النيل ونهر الكونغو- تنحدر ثلاثة روافد لتكوّن نهر “كاجيرا” الذي يصب في بحيرة “فيكتوريا” فيما يمكن اعتباره المنبع الأول للنيل- تحديداً أحد الروافد الثلاثة المسمى “روفوفو” حسب ما أورده “إميل لودفيغ” في سِفْره العظيم ”النيل حياة نهر”.
وتعتبر بحيرة “فيكتوريا” كبرى البحيرات العذبة في العالم من حيث المساحة (67 ألف كم2) إلا أنها ضحلة نسبيا- يبلغ عمقها نحو 40متراً فقط- ورغم أنها تستقبل سنوياً من 100 لـ 113 مليار م3 من مياه الأمطار إلا أنها تفقد نحو (94.5مليار م3) سنويا بفعل البخر ما يجعلها تشكل نظاماً نهرياً مستقلاً في سلسلة النظم النهرية والبحيرية التي يضمها نهر النيل.
ويأخذنا الكاتب في رحلة مع النهر الذي يخرج من “فيكتوريا” بإيراد مائي يبلغ (23.5مليارم3) ليصب شمالاً في بحيرة “كيوجا” الضحلة بعمق 6 أمتار، ثم إلى بحيرة “سالسبوري” ويبدو اندفاع النهر بطيئاً بفعل الانخفاض الشديد في مُعامل الانحدار، ولكن النهر العجيب يضيق مجراه من 300م إلى نحو 6 أمتار فقط ليندفع جباراً وسط كتل صخرية تؤكد الأصل الانكساري للنيل؛ ليلقي بنفسه من ارتفاع 40 متراً عند شلالات “الميرشيزون” ليصب في بحيرة “ألبرت” التي تعتبر المركز الأكبر لتجميع مياه المنابع الاستوائية للنيل.
يُكمل النيل مسيره بعد ذلك لنحو 200 كيلو متراً في هدوء صالحاً للملاحة حتى بلدة نيمولي على الحدود الأوغندية السودانية ليبلغ إيراده عند هذه النقطة نحو (25.2مليار م3) ليمضي مجراه مجدداً ويندفع كالسيل في منطقة الشلالات قبل أن يصل إلى بحر الجبل.. وهنا يتبدد النيل مع انخفاض معدل الانحدار في مستنقع هائل المساحة (نحو 60 ألف كم2) فاقداً بفعل عوامل عدة نحو (15مليارم3) من إيراده.. ليُكمل المسير بإيراد قدره نحو(9.1مليارم3) من أصل (169.6مليارم3) هي حجم الأمطار التي سقطت على هضبة البحيرات الاستوائية.
ثم ينتقل بنا الكاتب عبر رحلة النهر العظيم إلى هضبة الحبشة القلب الحقيقي الذي يضخ المياه إلى المجرى الأوسط والأدنى للنهر عبر روافد “البارو” الذي يمنح “السوباط” نحو (9.4مليارم3) سنويا ليرتفع بإيراده إلى (13.5مليارم3) يصبها في النيل الأبيض الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام ويبدو كبحيرة هائلة بسبب اتساعه وبطء جريانه.. وإلى شمال الهضبة حيث يتداخل نحو ثلاثين نهيراً وجدولاً أهمها الأباي الأصغر تصب المياه في بحيرة تانا التي ينطلق منها النيل الأزرق الذي يندفع بقوة لنحو من 80 كم منحدرا لحوالي 1300 متراً ليقطع مسافة 940 كم حتى يصل “الروصيرص” ليبلغ إيراده السنوي عند الخرطوم حوالي (54 مليارم3) يصل منها إلى أسوان نحو (48 مليار م3) سنوياً.
مصب النيل في مصر: سر الحياة وأداة الحضارة ومبعث الأساطير
يشير ’النجار‘ إلى أن النيل لا يحصل على أي مصادر جديدة لتغذيته بالمياه بعد مصب نهر عطبرة فيه حيث ينطلق في اتجاه الشمال مع ميل خفيف نحو الغرب قبل أن ينعطف بشكل حاد ليصبح اتجاهه جنوب غربي قبل أن يعاود الانطلاق مرة أخرى نحو الشمال ليصل إلى مدينة دنقلة التي تبعد عن مدينة عطبرة بنحو760 كم عبر مجرى النهر ويبلغ عرض المجرى في هذه المسافة نحو 400 متر ويبلغ معدل البخر حداً مرتفعاً يصل إلى 8 مم يومياً ويصل التصريف السنوي للنيل عند دنقلة (85.6مليار م3) ومن دنقلة إلى وادي حلفا يقطع النيل 450 كم قبل أن يودع الأراضي السودانية قبل دخوله إلى مصر.
وكتعبير عن قدرة ودأب الشخصية المصرية ينتصب معبدا رمسيس عند أبي سمبل وقد نُحتا في الصخر تخليداً لذكرى الملك العظيم بإبداع شعب قادر على صنع المعجزات متى توفرت له القيادة الوطنية المخلصة كما حدث بعد ذلك عند بناء السد العالي ”أعظم مشروع بنية أساسية في العالم على مدار التاريخ”.
وترتبط كثير من الأساطير المصرية بنهر النيل مثل أسطورة الإله “خنوم” الذي اعتبروه سيد المياه ورمزوا له بتمثال على هيئة كبش عظيم وبنوا معبده في منطقة الشلالات التي اعتقدوا أن النيل يخرج عندها من باطن الأرض.
“أما نظرية الأشمونين أو هرموبوليس- ومن عندنا نقول إن هناك قرية مصرية تمتلئ بالمعابد والآثار المصرية القديمة تسمى الأشمونين تتبع محافظة المنيا- هذه النظرية تذهب إلى أن الإله “نون” رب المياه الأزلية كان هو كل شيء وكان يحتوي على جميع عناصر الخليقة وعندما بلغت المياه الغامرة لكل شيء في الانحسار ظهر تل الابدية وظهرت عليه كائنات إلهية وكان عددها ثمانية التي تعني “شمون” باللغة الهيروغليفية وعلى أي الأحوال فإن “نون” إله المياه الازلية عند قدماء المصريين هو الأصل في النظريتين لكل الآلهة ولو تأملنا الكلمة ونون فإن تحويرها إلى نيل هو أمر مرجح تماما خاصة وأن منبع مياه النيل وفقا للمصريين القدماء هو هذه المياه الازلية”.
وإلى جانب نون وخنوم اعتبر المصريون القدماء “أوزير” إله عالم الموتى وخصوبة الأرض والنماء والزرع هو والنيل شيئاً واحداً أما “هابي” فهو روح النيل وجوهره الحراكي الذي تتحدث عنه الأساطير باعتبار كهفه موجوداً في مضيق قرب أسوان حيث يطلِق ذلك الإله الغامض المياه التي تغمر حقول مصر العليا.. “وعلى مقربة من القاهرة كان هناك مجرى يعرف باسم بيت هابي وهو مجرى آخر ينظم الفيضان لصالح مصر السفلى، وكانت الطقوس الدينية تقام كل عام عند هذين الموضعين وقرب مقاييس النيل الأخرى عند وفاء النيل فيقذفون في النيل بالكعك وحيوانات الضحية والفاكهة والتمائم لتثير قوة الفيضان وتحافظ عليها وكذلك تماثيل الإناث لتثير إخصاب النيل العظيم فيفيض في أمواج عاتية وينثر نفسه خلال المملكة معطياً الحياة للأرض”.
إلى غير ذلك مما يجل عن الحصر من الأساطير التي تؤكد ارتباط المصري القديم بالنيل كما لم يرتبط إنسان آخر.. ما يجعل الصراع الحالي حول حقوق مصر التاريخية في مياه النهر العظيم أمراً لا يهدد الحياة في مصر فحسب بل يصل إلى درجة محاولة هدم أحد أهم مقومات الشخصية المصرية والعبث بوجودها الذي ارتبط بالنيل منذ الأزل.
الصراع المصري الإثيوبي.. وسبل مواجهة الفقر المائي الذي دخلته مصر:
وفي الفصول الثلاثة الأخيرة من الكتاب، التي تتناول الصراع المصري الإثيوبي وسبل مواجهة الفقر المائي الذي دخلت مصر أكثر مراحله خطورة، وأهم المشروعات التي تم إنجازها للحفاظ على مياه النيل وأهمها السد العالي.. أكبر مشروع للتنمية الشاملة في العالم خلال القرن العشرين.. ثم استراتيجية مصر المائية ومدى ملاءمتها وكفاءة تطبيقها.. قبل أن يختم الكاتب «أحمد السيد النجار» كتابه مجّملاً أهم ما ورد فيه من رؤى ومقترحات لمواجهة الأزمة.
تدويل القضية.. كان الخيار الأصوب:
في الفصل الثالث من الكتاب يتناول الكاتب الصراع المصري الإثيوبي بالتحليل مع عرض لعدد من المسارات المقترحة لحلحلة الأزمة الراهنة؛ مستبعداً الحلول غير الواقعية التي تكتنفها الأوهام مثل اقتراح نقل مياه نهر الكونغو إلى مصر لتعويض النقص الذي سيطرأ على حصة مصر بعد بدء ملء خزان سد النهضة.
يتناول ’النجار‘ في بداية الفصل مطالب القاهرة العادلة في ضرورة احترام إثيوبيا لحقوق مصر التاريخية في مياه النيل ما يستلزم عدم المساس بحصتها السنوية من المياه، والالتزام التام بكل الاتفاقيات التي وقعت عليها إثيوبيا في العهود السابقة والخاصة بمياه النيل وإقامة السدود وعدم اتخاذ القرارات بشكل فردي فيما يتعلق بالأمن المائي لمصر والسودان دولتي المجرى الأوسط والمصب.
ولا يُخفي الكاتب وجهة نظره فيما يتعلق بتقصير السلطات المصرية في إعطاء القضية ما تستحقه من الاهتمام وعدم طرح كل الخيارات إزاء التعنتْ الإثيوبي والتمسك بشكل مطلق بالتفاوض الودي الذي زاد من أطماع الجانب الإثيوبي.
ويرى ’النجار‘ أن تدويل القضية بعرضها على المنظمات الدولية المعنية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.. كان الخيار الأصوب منذ البداية.. كما أن الصمت المصري خلال عقد كامل (2021:2011) بدا غير منطقي وغير مفهوم باستثناء ما جاء في الخطاب الرئاسي المصري في آذار/ مارس الماضي الذي أعلن فيه لأول مرة أن كل الخيارات مفتوحة لحماية الحقوق المصرية في مياه النهر العظيم.
بالنسبة لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقعت عليه مصر في آذار/ مارس 2015، يرى ’النجار‘ أن هذا الاتفاق لا يحمي حقوق مصر إذ جاء على أرضية الموقف الإثيوبي كلياً فلم يحقق أي مطلب رئيسي من مطالب مصر.. وهو ما يمكن “اعتباره هزيمة دبلوماسية للمفاوض الرسمي المصري في قضية سد النهضة”.
وقد أرفق الكاتب نص الاتفاقية في نهاية الفصل مشدداً على أنها خَلت من أي نص يشير من قريب أو بعيد إلى احترام حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، والأخطر من ذلك أن ديباجة الاتفاق تتحدث عن الموارد المائية العابرة للحدود ولا تصف النيل الأزرق بالنهر الدولي وهو ما يُعد انتصاراً واضحاً للرؤية الإثيوبية!.
كما تضمن الاتفاق في مادته الأولى التشديد على ضرورة التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف نواحيها، وهو ما يُعد تأسيساً لحقوق إثيوبية المزعومة في مياه النيل الأزرق بالمخالفة الصريحة للاتفاقية البريطانية الإثيوبية الموقعة في 15 أيار/ مايو 1902.
ورغم أن هذا الاتفاق قد تضمن العديد من المواد التي تدعم وجهة النظر الإثيوبية على حساب الحق المصري إلا أن إثيوبيا لم تلتزم بما ورد في مادته الخامسة التي حددت فترة 15 شهراً للاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لبحيرة السد.. ولم تسفر المفاوضات عن شيء بهذا الخصوص بعد مرور أكثر من 70 شهراً على توقيع هذا الاتفاق الذي أشار في مادته التاسعة إلى مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة وهو ما يعد إقحاماً غير بريء لأمر لا علاقة له بموضوع الاتفاق الذي ينظم التعاون بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بشأن النهر الدولي.
نهج أثيوبيا العدواني:
في الجزء الثاني من الفصل يتناول الكاتب عدداً من الحقائق فيما يتعلق بالجانب الإثيوبي ومنهجه الواضح في التعامل مع الأنهار الدولية.. ويعتمد هذا النهج على منطق الاستحواذ والاعتداء على حقوق الآخرين استناداً إلى نظرية السيادة المطلقة الفاسدة كلياً أو ما يعرف بفقه “جدسون هارمون”.. هذا النهج العدواني هو ما اعتمدته إثيوبيا في قضية نهر “أومو” الذي تتشارك فيه مع كينيا، حيث قامت ببناء ثلاثة سدود على النهر ما أضر أبلغ الضرر ببحيرة “توركانا” الكينية، ولم تكتف إثيوبيا بذلك بل استهدفت مجموعات السكان المتضررين بانتهاكات وأعمال عنف على نطاقٍ واسع.
ومن المعروف أن الجانب الإثيوبي قد استهدف النيل الأزرق- قلب مصر المائي- بإقامة عدد من السدود عام 1996، بعد تردي العلاقات مع مصر عقب المحاولة الفاشلة التي استهدفت اغتيال مبارك في أديس أبابا.
ويلمح الكاتب إلى أن هذه الممارسات التي تنتهك كافة المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية تُعّتبر إحدى تجليات الأزمة المستحكمة التي تعيشها إثيوبيا منذ زمن بفعل نقاط الضعف التي تعاني منها الدولة الحبيسة ذات الإرث العدائي مع كل جيرانها بالإضافة إلى الصراعات الداخلية التي لا تهدأ بين العرقيات المتناحرة على النفوذ والسلطة.. ورغم القفزة الهائلة التي حققها الاقتصاد الإثيوبي والتي نقلت البلاد من ثاني أفقر دول العالم في1999، إلى تحقيق أعلى معدلات النمو 9.1% في 2019، بمساندة كبيرة من الصين؛ إلا أن نحو 71% من الإثيوبيين مازالوا يعيشون تحت خط الفقر، ما يعني حاجة البلاد الماسة لتهدئة النزاعات الداخلية والإقليمية خلال العقدين القادمين على أقل تقدير حتى يتحول هذا النمو المتسارع إلى واقع ملموس على الأرض.
إجراءات مقتَرَحة:
ويقترح ’النجار‘ بعض الإجراءات الداخلية لمواجهة أزمة المياه في مصر؛ كتغيير أنماط الري، وتقليل الفواقد الضخمة في النقل والتسرب والبخر وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على نوعية المياه ومطابقتها للمعايير الدولة حفاظاً على صحة الإنسان وسلامة التربة والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية التي يقترح الكاتب تغيير بعض أنواعها وإحلال أخرى أقل استهلاكاً للمياه.
وبالنسبة للمشروعات التي تستطيع مصر من خلالها زيادة مخصصاتها المائية يقترح النجار تطوير المدخرات الرئيسية الجامعة للسيول للحفاظ على 92% من مياه الأمطار التي تسقط على حوض نهر كاجيرا؛ وتتبدد دون الاستفادة منها بينما لا يصل إلى مجرى النهر سوى 8% من هذه الإيرادات الهائلة.. كما يقترح ردم مستنقعات بحيرة كيوجا وتحويلها إلى أراض زراعية خصبة لصالح أوغندا مع نقل المياه عبر قنوات مبطنة إلى نيل فيكتوريا، وكذلك تطوير قناة كازنكا التي تربط بين بحيرتي إدوارد وجورج المغذيتين لنهر سمليكي؛ وأخيراً إعادة العمل بمشروع قناة جونجلي المتوقف منذ سنوات والذي كان يهدف لإنقاذ نحو 17 مليار م3 من مياه بحر الجبل وبحر النعام قبل تبددها في مستنقعات جنوب السودان.. أما فيما يتعلق بفكرة نقل مياه نهر الكونغو إلى نهر النيل والتي تقدر بنحو 112مليار م3 فيرى الكاتب أنها فكرة غير علمية وهي بمثابة أسطورة خادعة وهروب من بؤس الواقع إلى آفاق الخيال، كما اعتبر الترويج لهذه الفكرة إلهاء لمصر عن المطالبة بحقوقها المائية التي يتم سلبها بواسطة سد الخراب الإثيوبي.
ويستعرض ’النجار‘ في الفصل الرابع من الكتاب أهم المشروعات المصرية لضبط النيل وذروتها السد العالي وهو المشروع الأكبر والأهم في مجال التنمية الشاملة في العالم خلال القرن العشرين.. أما الفصل الأخير فقد تناول فيه الكاتب الاستراتيجية المائية المصرية ومدى ملاءمتها وكفاءة تطبيقها مستعرضاً أهم ملامح هذه الاستراتيجية وأهم الدراسات العلمية التي استندت إليها وأهم البدائل الآمنة التي يمكن الاستعانة بها وعلى رأسها المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف ومشروعات تحلية مياه البحر.
ويختتم ’النجار‘ كتابه بالتأكيد على أن الأزمة تتطلب طرح أهداف ومشروعات محددة لتحقيق زيادات ملموسة كمياً في الإيرادات المائية مع تقليل الفواقد وترشيد الاستهلاك مع موقف أكثر وضوحاً وصلابة في مواجهة الصلف الإثيوبي حفاظاً على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل الذي هو باعث حضارتها وسر عظمتهـا.
* كاتب مصري
المصدر: أصوات أونلاين

التعليقات مغلقة.