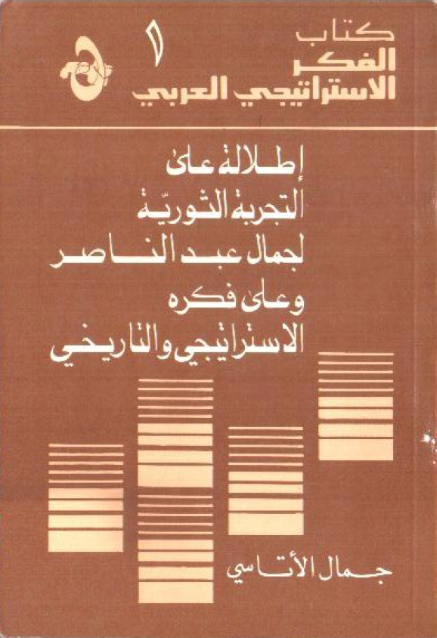
الدكتور جمال الأتاسي
دمشق – 1981
أولاً – مع الثورة في مسارها التاريخي العام: الثورة المستمرة وحضور عبد الناصر (4/4)
أولاً – مع الثورة في مسارها التاريخي العام
الثورة المستمرة وحضور عبد الناصر
(4/4)
هذا تاريخ أمتنا وقيادة عبدالناصر كانت قمة فيه، ومن بعدها كان الانحدار الذي لم يتوقف. ومن قبل عبدالناصر كانت هناك مقدمات وانجازات على طريق النضال القومي، وأمسك عبدالناصر بتلك المقدمات والإنجازات كلها، وصاغها فكراً وممارسةً وعملاً، صياغة نهضت بالأمة وتقدمت بثورتها مراحل وخطوات. وكانت هزيمة حزيران (يونيه) الامتحان الرهيب الذي كاد يُسقط تلك القيادة ويُسقط تجربتها الثورية. شيء واحد بقي وقتها في الساحة هو القوة العفوية لحركة الجماهير، تلك القوة الثورية التي وقفت في وجه السقوط ووجه الهزيمة وأعادت عبدالناصر ليتابع مهمته التاريخية، وقد حدد مهمته المرحلية بعدها بإزالة آثار العدوان، وقضى قبل إنجاز هذه المهمة. والجماهير الهائلة التي رفعته من السقوط هي نفسها التي مشت تُشيع جثمانه منادية بتصميم واحد ” حنكمل المشوار “… ولكن المشوار انقطع فالجماهير تفرقت ولم تجد أمامها من يحشدها من جديد على طريق أهدافها، ولم تجد من يواصل بها المسار. ذلك أن طريق عبدالناصر كان قد انقطع أيضاً بغيابه، لأن حضوره كان مقوماً أساسياً من مقومات ذلك الطريق، ووجوده كان يشد ثورية الجماهير إلى الأمام. وذلك أن عبد الناصر هو الذي صاغ تلك العلاقة الحية بينه وبين جماهير الشعب، وكان يندمج بأحاسيسها ومطالبها بحيث يكاد يتوحد معها، وبهذا التعامل معها كان يحس نبض حياة الأمة وتاريخها، ويتعامل مع حركة التاريخ. وفي وجه من ينادون المعلم والقائد كان يقول دائماً: الشعب هو المعلم والشعب هو القائد، ما كان يقول لقد فعلت وأنا حققت، بل كان يقول إرادة الشعب حققت والشعب هو الذي طور المبادئ و” لقن طلائعه أسرار آماله الكبرى… وأقام من وعيه حافظاً لها… “.
ما أراد عبدالناصر أن يمارس ذلك الدور الأبوي الذي تتسم به وتفرضه على جماهير شعبها الدكتاتوريات الشرقية السائدة في الأقطار المتخلفة، بل كان ينادي ” إرفع رأسك يا أخي… ” وما كان يخاطب جماهير الشعب بـ يا أبنائي … بل كان خطابه دائماً أيها الأخوة المواطنون … “. وفي وقفته الأخيرة مع الشعب، وفي آخر كلمة خاطب بها جماهير الأمة، عبر منصة المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي في 26 تموز (يوليو) عام 1970، تلك الكلمة التي وصفت بأنها كانت ما يشبه ” الوصية ” أعطى شهادة للتاريخ عن محصلة النضال الثوري لشعبه، بل عن محصلة نضاله هو بالشعب ومع الشعب ومن أجل قضية الأمة، وعن محصلة تجربته الثورية حيث قال:
“… ويضاعف من قيمة المكتسبات الهائلة في ضمير الشعب المصري، أن تجربته التاريخية كانت على مر العصور أوسع من مصلحته الذاتية، وأكبر من حدوده السياسية وذلك بحكم انتمائه العضوي إلى أمة عربية تعيش في قلب العالم جغرافياً وحضارياً. ولست أريد ان أعود إلى الماضي وصفحاته المشرقة، وإنما يكفينا استعراض ما لا يزال حياً في أذهاننا منذ اليوم الذي ارتفعت فيه أعلام ثورة 23 يوليو… إن الشعب المصري تحت أعلام هذه الثورة رفض السلامة عن طريق الانعزال، ورفض الأنانية برفض كل مغرياتها الوقتية، لقد جعل قضية أمته قضيته، وعاش النضال من أجلها بحياته، وكان في ذلك يصدر عن وعي بمسار التاريخ لم يساوره فيه شك أو تردد، أثبت أبناء هذا الشعب دائماً أنهم الأمناء… الأمناء بالكلمة… والأمناء بالفعل… لم تكن الحرية والاشتراكية والوحدة بالنسبة له كلمات وإنما كانت الحرية والاشتراكية والوحدة بالنسبة له أعمالاً ، بل كانت كلها بالنسبة له قتالاً. وليس هناك عَلَم شريف يرفرف على الأرض العربية إلا وكانت يد الشعب المصري أول الأيدي التي امتدت لتساعد على اقامته. وليست تعنينا في ذلك شهادة أي فرد وإنما تعنينا في ذلك شهادة التاريخ مبرأة من العقد ومن الأهواء ومن التحزب ومن النسيان “…
تلك كانت محصلة مرحلة عبدالناصر، وكان شعب مصر بعبدالناصر، وكان عبدالناصر بشعب مصر بل بشعوب الأمة العربية المتطلعة الى وحدتها كلها. ولكن عبدالناصر، وكما قال أحد الكتاب اليساريين العرب ” وصل بجماهير مصر وجماهير الأمة العربية الى منتصف الطريق ثم قطعها… وصل بها إلى مستوى جديد من الوعي السياسي الوطني والقومي بل والتقدمي الاشتراكي، ولكنه لم يصل بها إلى انضاج تجربتها الديمقراطية في بناء تنظيمها وعلاقاتها ولم يصل إلى إكمال الأيديولوجية التي تطابق واقعها وثورتها، وترسم بوضوح مسيرتها إلى أهدافها. والقطيعة أو الانقطاع جاءا من حيث أنه لم يبّن الضمانة ولم يبّن البديل الذي يواصل المسار بوجوده ومن بعده. لم تكن تلك إرادته، أي أن يكون في موقع البديل دائماً، وفي موقع الأبوية والاتكال عليه ولكن هكذا جرت الأمور، ولمجريات الأمور أسبابها وقوانينها، ولكن الوقائع استقرت على أن تظل إيجابيات عبدالناصر في مسار تجربته هي إيجابيات تقدم الأمة، وعلى أن تكون الثغرات التي خلفها من حوله ومن بعده، هي الثغرات التي نفذت منها قوى الثورة المضادة، ومنها دخل الإرتداد والتحول عن طريق عبد الناصر وطريق ثورة الأمة الواحدة .
لقد أشار عبدالناصر أكثر من مرة إلى واحدة من تلك الثغرات في تجربته ونص على ذلك في الميثاق بقوله “… إن هذا الشعب البطل بدأ زحفه الثوري من غير تنظيم سياسي يواجه مشاكل المعركة، كذلك فإن هذا الزحف الثوري بدأ من غير نظرية كاملة للتغيير الثوري ” … ولكن ما لم يقله عبدالناصر هو أنه بحضوره، وبحركة فعله وحركة فكره، كان يسد حيزاً من هذا الفراغ في حياة الجماهير وفي تقدم حركة الثورة. وإذا ما كان لهذا الدور إيجابياته فلقد كانت له سلبياته أيضاً، فمثل ذلك الاكتفاء بقيادة عبدالناصر وتركه الأمور لمبادراتها، كان حائلاً دون الدفع على طريق سد تلك الثغرة، وبذلك أضعف جانباً من جوانب بناء أداة الثورة وتنظيمها، ليُفقدها بالتالي ضمانة استمراريتها من بعده .
ولكن هل كانت تلك مسؤولية عبدالناصر وحده؟ أم أن مثل تلك القصورات والثغرات مرتبطة بالظروف السياسية والاجتماعية والثقافية العامة لأمتنا التي تحرَّك من خلالها نضالنا الوطني والقومي وتحرَّك من خلالها عبدالناصر، مرتبطة بمستوى تطور الوعي السياسي والأيديولوجي للطلائع المثقفة من أمتنا وللقيادات التي تقدمت على رأس حركات النضال العربي بمختلف فصائلها وأحزابها وتنظيماتها، وإلا فلماذا لم يأت من يسد ذلك الفراغ من بعده، أو لماذا لم يقم البديل بوجوده؟ ذلك أن هذه القصورات كانت مرتبطة بقصورات الجانب الديمقراطي في التجربة .
وهذه مسألة أساسية تستحق أن نقف عندها، لأن الإجابة عليها هي التي تضعنا على طريق تكملة ذلك ” المشوار ” الذي انقطع، ” مشوار” الثورة العربية الذي مضت فيه قيادة عبدالناصر بنهج معين، عبر مراحل وأطوار متعددة، وكانت له مقدماته ثم كانت له إنجازاته وانتصاراته كما كانت له قصوراته وانكساراته. أي هي التي تضعنا في النهاية أمام ما تتطلبه المرحلة الراهنة- مع هذا التمزق والانتكاس الذي تمر به أمتنا- من صياغة جديدة لحركة الثورة ولمنظورها وبرنامجها وقواها. ثم إن وقوفنا على تجربة عبدالناصر بكل معطيـاتها، لا يردُنا إلى مرحلة مضت وفات زمانها، بل هو يضعنا في صميم المسائل التي نواجهها اليوم في حاضرنا وفي تطلعنا للمستقبل. والواقع أيضاً أن العديدين منّا، في أيام عبدالناصر وبخاصة في السنوات الثلاث الأخيرة من حياته، كانوا يتساءلون ويسألون أنفسهم، ماذا سيحل بقضية أمتنا ووقفتنا النضالية إذا انتهى أو غاب عبد الناصر. أي أننا كنا ندرك، لا ما يجسده حضور عبدالناصر وقيادته للأمة من إيجابيات فحسب، بل ولما يغطي عليه هذا الحضور، بل ويموهه أحياناً من ثغرات ومن سلبيات، وما تؤدي إليه هذه التغطية في النهاية من قصورات في إنضاج الوعي الثوري والتجربة الثورية لحركة الجماهير وتنظيمها. ولكن وعي القصور لا يعني بالضرورة تداركه، لأن القصور لا يبقى محصوراً في إطار تجربة عبد الناصر وما قوي عليه، بل هو قصور في حركة نهوض الأمة وفي تطور الوعي التقدمي لطلائعها الثقافية والسياسية: وإلا فلماذا بقينا قاصرين عن ملء ذلك الفراغ وتدارك ذلك التقصير بحضور عبدالناصر وبخاصة بعد غيابه؟
فعبدالناصر لم يكن نسيج ذاته أو قائماً بذاته، بل هو نسيج مرحلة في تاريخ أمتنا، وأياً ما كانت ثغراتها فلقد كانت مرحلة نهوض وتقدم. وعبدالناصر إذا ما جسد صورة نموذجية للرجل التاريخي، كما هو الأمر بالنسبة للرجال التاريخيين العظام الذين برزوا في حياة الأمم وكان لهم دورهم التاريخي، فانه لم يأت استثناءً بل تجاوباً مع ظروف أمة وتلبية لحاجتها وتعبيراً عنها، وكما قال عبدالناصر ذاته ” ما أنا إلا تعبير عن القومية العربية في مرحلة من حياة الأمة… ” .
إن المسائل الديمقراطية كانت مطروحة في وجه النظام الذي كان يرأسه عبدالناصر في مختلف مراحل تطوره وانتقالاته الوطنية والقومية والتقدمية والاشتراكية. كانت مطروحة من اليسار ومن اليمين أيضاً بصيغ مختلفة. وإذا ما غطت الشخصية التاريخية لعبدالناصر وجماهيريته وإنجازاته وخطواته المتقدمة على من سواه، وإذا ما غطت في قليل أو في كثير، على القصورات الديمقراطية في نظامه وممارسات ذلك النظام، فإنها اليوم وبعد ذلك الارتداد الكبير من بعده وهذا الانكسار المتواصل لحركة الجماهير وللعمل الثوري، تعود لتحتل مكان الصدارة كمسألة مركزية في النضال الوطني والقومي. لقد جاء عبدالناصر إلى الحكم في مصر وراء ” ست رايات أو مبادئ “، كان من بينها ” إقامة ديمقراطية سليمة… ” ولقد حاول عبدالناصر في مختلف مراحل تجربته أن يجد صياغة في ” الدساتير المؤقتة ” وفي الميثاق وفي التنظيمات الشعبية والرسمية، لذلك المبدأ الهدف، ولكنها كلها لم تستطع في النهاية أن تلبي الوعد الديمقراطي في تحقيق المواطنية الديمقراطية الكاملة وحرية المواطن والمساواة الفعلية بين المواطنين بعد أن أنجزت الكثير من تحقيق حرية الوطن، هذا التحقيق الذي عادت وارتدت عليه هزيمة حزيران (يونيه) .
ولكن هل كانت مثل هذه التوجهات الديمقراطية التي نتوجه بها اليوم، وبعد معاناة الهزيمة، ومعاناة حركة الردة من بعد عبدالناصر وصعود قوى الثورة المضادة ونظم الاستبداد المشرقي، هل كانت توجهات أساسية وقفت عندها قوى التقدم واليسار العربي قبل مرحلة الانكسار هذه وما كشفت عنه من ضعف البنيان العربي في لحمة الوطنية الديمقراطية الأساسية؟
واقع الأمر أن هذا التأكيد على الديمقراطية السياسية، كموقف أساسي ومبدئي، هو موقف جديد، ومن خلال استيعاب موضوعي لحركة تطورنا ومن خلال وعي ثوري جديد، بحيث أصبحنا نتلمس تلك الثغرات التي خلفتها وراءها حركة تقدمنا، وكانت تعبيراً عن تأخر وعينا الثوري من حيث استيعابه للمسار التاريخي لتشكل الدول القومية الحديثة، ومن حيث مطابقته مع واقعنا وحاجات نهوضنا الأساسية، وما تتطلبه من تركيز ديمقراطي لبنياننا السياسي والاجتماعي قبل أي شيء آخر .
إن الكثير من الثورويين كانوا يحسبون أن تلك ” الليبرالية السياسية والثقافية ” ترتبط بمرحلة تاريخية لنظم اجتماعية أخرى، تخطاها نضالهم الثوري إلى مرحلة تاريخية متقدمة عليها. ولكن الفكر التاريخي، أو بالأحرى المفهوم الجدلي للتاريخ وفقاً للاشتراكية العلمية، يضعنا أمام حقيقة، وهي أنه ليس بمقدور مجتمع من المجتمعات أو شعب من الشعوب أن يتخطى مرحلة من مراحل تطور المجتمعات الإنسانية، ما لم يتمثل قيمها وإنجازاتها وبذلك يقوى على تجاوزها والتقدم عليها، أي بعد توظيفها في بناء حركة تقدمه.
ان هذه المسألة، وعلى المستوى الثقافي بخاصة، كانت من المسائل التي شغلت المفكر العربي المغربي عبدالله العروي في مؤلفاته وبخاصة في كتابه ” الأيديولوجية العربية المعاصرة ” و” العرب والفكر التاريخي ” التي لخصها في مقدمة كتابه الثاني بقوله: ” بدأت أحس أن المشكل الأساسي الذي أحوم حوله منذ سنين هو الآتي: كيف يمكن للفكر العربي أن يستوعب مكتسبات الليبرالية قبل (أو بدون) أن يعيش مرحلة ليبرالية؟. وهذه المسألة التي يطرحها العروي في بُعدها الثقافي والتاريخي والحضاري ننقلها إلى مستواها السياسي والاجتماعي فنقول اليوم: ما هو السبيل لأن تتقدم ثورتنا العربية كثورة ” وطنية ديمقراطية “، وأن تبني اندماجها الوطني ووحدتها القومية ودولتها العصرية وتمضي في هذا الإطار لتأخذ بعدها الاجتماعي الجذري كثورة اشتراكية، أي كيف لها أن تأخذ أولاً بمنجزات الثورة البورجوازية، في ليبراليتها السياسية والثقافية، من غير أن تعيش مرحلة التطور البورجوازية وحكم الطبقة البورجوازية، ثم من غير أن تأخذ بالمنهج الرأسمالي في بناء قاعدتها في الإنتاج والتنمية؟
ولقد قدمت التجربة الناصرية في مسارها جواباً على هذه المسألة، بل لقد أعطت التجربة الثورية العربية في تلك المرحلة جوابها من خلال ممارسة عبدالناصر. وكان الجواب، وكما كشفت حركة الردة، مقصراً عن الوفاء بالحاجة، ليعود اليوم ويطرح نفسه من خلال التقصير، لا في الدور التاريخي الذي أداه عبدالناصر، بل في بناء حركة الثورة العربية ككل .
وإذا وقفنا هنا عند جانب من جوانب القصور الديمقراطي في تلك المرحلة، كما ألمحنا قبل ذلك إلى مسألة الأيديولوجية ونظرية العمل السياسي والثوري والوقوف دون صياغتها صياغة ملائمة، وإلى مسألة الحزب الثوري أي التنظيم السياسي الملتزم بالأيديولوجية الثورية والذي ” يواجه مشاكل المعركة ” ويدفع بحركة التغيير ويحمي من الانتكاسة والردة… فإنها كانت قصورات وثغرات موضوعية في مسار التجربة، بل في مسار المرحلة إذ لم تقم أمامها تجربة بديلة. ولقد كانت لعبدالناصر محاولاته وأساليب قيادته في معالجة هذه المسائل، أو في سد هذه الثغرات بحضوره في قمة السلطة، وبشعبيته التي كان يشد بها الجماهير. وبقناعتنا أن مراجعة تجربة عبدالناصر في إطارها التاريخي، ومتابعة حركة تطوره الفكري والاستراتيجي، يقدمان لنا معطيات هامة للاستدلال بها في مواجهة هذه المسائل اليوم، وعلى ضوء ما تغير في الساحة بعد ذهاب عبدالناصر .
وما تغير شيءٌ كثير، وإذا كانت سلبيات قوى الثورة المضادة المتحركة بحرية في الساحة هي البادية على السطح، فثمة إيجابيات أمامها تعطي المؤشر للمستقبل، منها هذا التوجه الديمقراطي الأساسي الذي تتوجه به القوى التقدمية العربية في حركة نضالها وفي فكرها وإرادة التغيير وإرادة تجديد نهوضها الثوري. ولكن منها أيضاً، التقاء اليسار العربي بما يشبه الاجماع، على الأهداف الاستراتيجية الكبرى لحركة الثورة العربية والتي تجد رموزها في كلمات ” الحرية والاشتراكية والوحدة “، وهي بذاتها الأهداف التي وضعتنا على طريقها بالممارسة تجربة عبدالناصر، أيا ما كانت ثغراتها، وأياً ما كانت التشويهات التي نالت منها والانحرافات والردات التي جاءت بعدها .
ولكن تجربة عبدالناصر ومرحلته، أياً كانت حركة المراجعة وأياً كانت الانتقادات التي توجه إليها، تبقى تجربة غنية جداً ومرحلة نهوض. وإذا كانت ثورتنا العربية تمضي مراحل وأطواراً، فيها النهوض وفيها الانتكاس، فإننا حين نأخذ بفكرة استمرارية الثورة وضرورتها، لا بد أن نأخذ أيضاً من تلك التجربة انجازاتها كمكتسبات لنا ونقاط استناد. فالبناء الثوري يأتي في سياقه التاريخي، ولا يعود لنقطة البداية أو يبدأ من الفراغ. ثم إن تجربة عبدالناصر هي التي أبرزت أكثر من غيرها ما هناك من خصوصية في حركة الثورة العربية، وشدّت الآخرين للتطابق معها .
وإذا ما بلور عبدالناصر مهمات الثورة العربية وأهدافها في صياغة استراتيجية مرحلية معينة قوامها بدايةً ” الوطنية ” فلقد طالب أن تكون نظريتها في النهاية إبداعاً لا اتباعاً، وطالب بثورة ثقافية لتكمل الثورة السياسية والاجتماعية ولتخلق المناخ المواتي للإبداع الفلسفي والنظري، ولتضع الثورة في سياق فكرها التاريخي ونهوضها الحضاري .
والمطالبة إذا لم تكن إنجازاً فإنها تبقى تعبيراً عن وعي وحاجة… وإذا كان الجو السائد اليوم في حياتنا ومن حولنا هو التشتت والضياع لا جو التوحد والإبداع، فلا أقل من أن نعود لتثبيت المرتكزات التي تجمع من حولها شتاتنا وهي مرتكزات تظل تُقدمُها لنا تجربة عبدالناصر أكثر من سواها .
______________
يتبع..
ثانياً- فكر عبد الناصر في جدلية تقدمه ونضجه: من الثورة الوطنية الى الثورة الكاملة والاشتراكية العلمية (1/4)

التعليقات مغلقة.