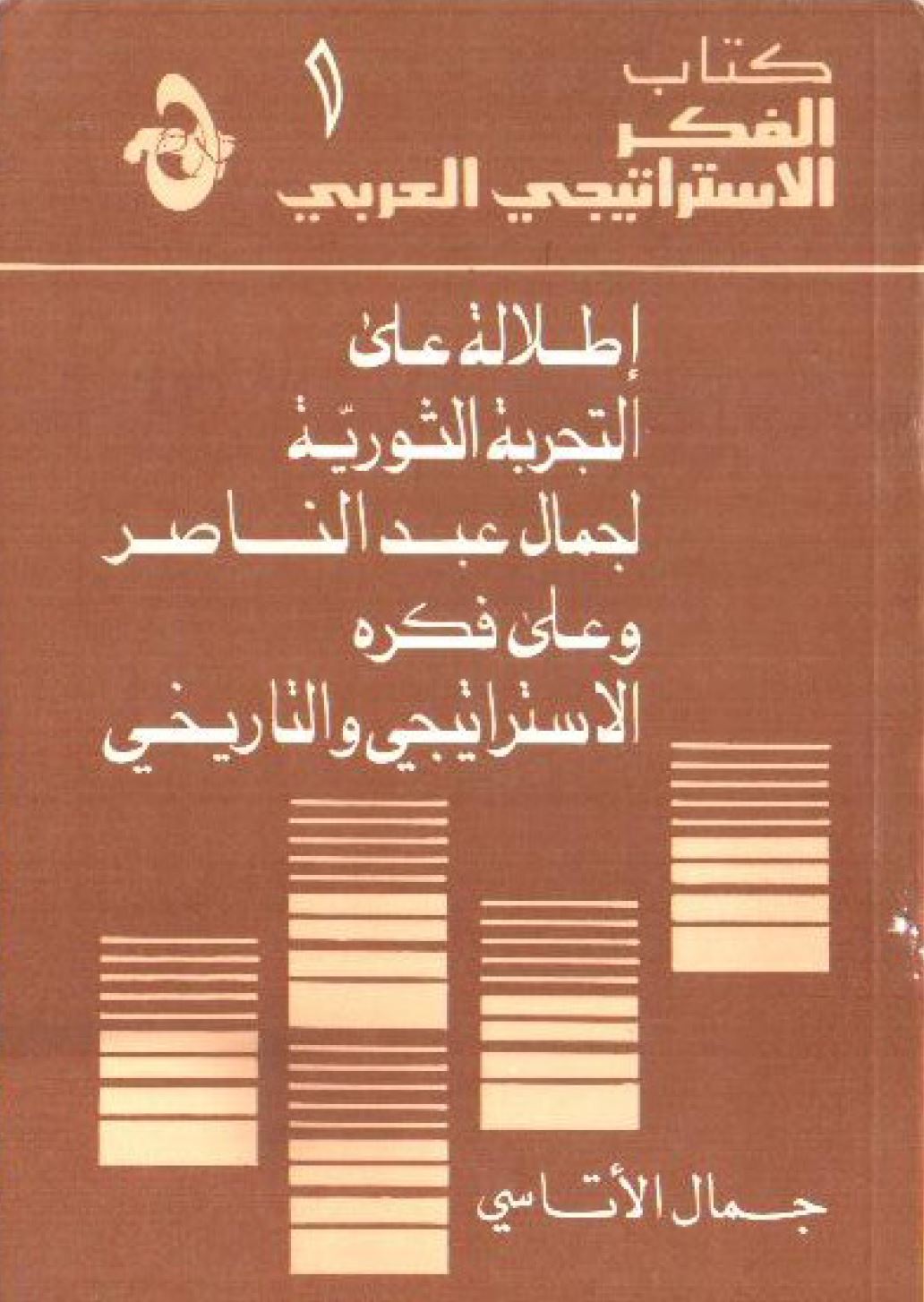
الدكتور جمال الأتاسي
دمشق – 1981
أولاً – مع الثورة في مسارها التاريخي العام: الثورة المستمرة وحضور عبد الناصر (2/4)
أولاً – مع الثورة في مسارها التاريخي العام
الثورة المستمرة وحضور عبد الناصر
(2/4)
نستطيع أن نحدد بالتأكيد أين ومن أين بدأت: إنها بدأت ثورة وطنية مصرية تخلع الملك وتسقط النظام الملكي ومعه حلفه الطبقي، أي تسّقطه كنظام اجتماعي وسياسي، وتطرد الاستعمار وأعوانه. ولقد حققت ثورة عبدالناصر، أول ما حققت، ذلك الاستقلال الوطني الكامل للقطر المصري وحكم أبناء شعبه كما لم يتحقق منذ عشرات القرون .
إنها ثورة التحرر الوطني وهي تواصل مسارها، ولكنها، ولوجود عبدالناصر على رأسها وما جسده هذا الوجود لعبدالناصر، رجل التاريخ والمتعامل مع حركة التاريخ، عبدالناصر المنفتح بكليته على الشعب وأحاسيسه وتطلعاته، والفاعل في حركة الجماهير والمتفاعل معها، يصنع معها وبنضالها وبتقدم وعيها، حركة التاريخ، فإن هذه الثورة أخذت صيغة الثورة المستمرة، محددة أبعادها الأولى في أنها ثورة سياسية واجتماعية معاً، صاعدة بهذه الثورة مراحل وأطواراً، آخذة شيئاً فشيئاً بعدها القومي العربي دفعاً على طريق وحدة نضال الأمة ووحدة أهدافها، وعلى طريق اندماجها ووحدتها، متطلعة إلى أن تكون ثورة شمولية تقدم تجربتها الإنسانية ومعانيها الحضارية .
تلك بداية وذلك مسار، أما أين انتهت وأين يمكن أن تنتهي مثل هذه الثورة، فقد قال عبدالناصر بعد عشر سنوات من البداية: يسألون أين نقف بثورتنا ” لا أعرف أين نقف، إننا لن نقف إلا عندما ينتهي استغلال الإنسان للإنسان… “. وهذه النهاية جدلية مثل جدلية الصراعات الاجتماعية والاقتصادية وجدلية التاريخ الإنساني، وتظل مفتوحة على المستقبل.
إنها ثورة بدأت من استيعاب تاريخ النضال الوطني التحرري لمصر، ومن استيعاب مراحله السابقة وانتفاضاته الثورية، واستيعاب قصورات ذلك النضال وعثراته، لتنتقل إلى استيعاب معطيات الحاضر. وهي إذا ما أعطت المقدمات الأولية لهذا الاستيعاب في كتاب ” فلسفة الثورة “، مؤكدة على الأبعاد الزمنية والأطر ” المكانية ” التي تتحرك فيها هذه الثورة فلقد جاء عبد الناصر ليوضح بعد ذلك هذا الاستيعاب، في مقدمة ” الميثاق الوطني “، من خلال استعراض قصورات الثورة الوطنية المصرية لعام 1919 وعوامل انتكاسها وفشلها، وقد حدد ثلاثة جوانب من تلك القصورات:
أولاً – إن القيادات الثورية ( في تلك المرحلة) أغفلت إغفالاً يكاد أن يكون تاماً مطالب التغيير الاجتماعي، على أن تبرير ذلك واضح في طبيعة المرحلة التاريخية التي جعلت من طبقة ملاك الأراضي أساساً للأحزاب السياسية التي تصدت لقيادة الثورة…
ثانياً – إن القيادات الثورية في ذلك الوقت لم تستطع أن تمد بصرها عبر سيناء وعجزت عن تحديد الشخصية المصرية، ولم تستطع أن تستشف من خلال التاريخ أنه ليس هناك من صدام على الإطلاق بين الوطنية المصرية وبين القومية العربية. لقد فشلت هذه القيادات في أن تتعلم من التاريخ، وفشلت أيضاً في أن تتعلم من عدوها الذي تحاربه، والذي كان يُعامل الأمة العربية كلها على اختلاف شعوبها طبقاً لمخطط واحد…
ثالثاً- إن القيادات الثورية ( تلك) لم تستطع أن تلائم بين أساليب نضالها وبين الأساليب التي واجه الاستعمار بها ثورات الشعوب في ذلك الوقت…” .
وهكذا فعلى محور الصراع الاجتماعي والطبقي، وعلى محور النضال الوطني والقومي العربي وعلى محور النضال ضد الاستعمار بأشكاله التقليدية والامبريالية الجديدة، على هذه المحاور الثلاثة صاغت الثورة الناصرية حركتها التاريخية. ولكن عبدالناصر، وفي إطار الواقع التاريخي والجغرافي والسكاني لمصر، وفي إطار معطيات الواقع العربي وفواصل التجزئة القائمة بين أقطاره واختلاف أطوارها في التقدم والتحرر واختلاف نظمها، ثم وفي مواجهة ذلك الواقع المتجسد بقيام الكيان الإسرائيلي الاستعماري الاستيطاني التوسعي المدعم بالحلف الإمبريالي- الصهيوني العالمي، أراد أن يجعل من مصر، القطر العربي الأكبر والأكثر تقدماً في اندماجه الوطني وتطوره الاجتماعي والثقافي وكذلك في موقعه الاستراتيجي الدولي، ذلك المرتكز الذي لا بد منه لبناء تلك الثورة بكل أبعادها الاستراتيجية والاجتماعية والوطنية والقومية والدولية، وأن يجعل من تجربته في مصر النموذج والقدوة، وأن يُحمّل مصر العبء الأكبر، وأن يجعل منها المرتكز الاستراتيجي لثورة الأمة، تمشي في مقدمتها، وتدفع بحركتها وتقود تلك الحركة.
لقد قامت ثورات وحركات متعددة في أرجاء مختلفة من الوطن العربي، بعضها جاء من قبل عبدالناصر، وبعضها في حضوره وبمساندته، وبعضها قام في منافسة ومن خلال ادعاء التقدم عليه… بعضها كان شامخاً شموخاً كبيراً وله رصيده العربي والدولي الكبير كثورة الجزائر حين مشت بنضالها الرائع إلى النصر، ولكن أياً منها لم تأخذ بعدها القومي وبعدها الشمولي مثل ثورة عبد الناصر، لعاملين اثنين هما: دور مصر وشعب مصر ومكانة مصر في الوطن العربي، والدور التاريخي لشخصية عبدالناصر، ثم هناك علاقة قيادة عبدالناصر بجماهير الأمة ، تلك العلاقة التي لم تقم لقيادة غيرها .
وأذكر بهذا الصدد كلمة للرجل الذي كان رمزاً كبيراً من رموز الثورة الجزائرية والرئيس الأول لدولتها الوطنية المستقلة أحمد بن بلا. كان ذلك في شهر أيار (مايو) عام 1963 عند زيارة وفد رسمي وشعبي من ” حركة 8 آذار (مارس) في سورية ” للجزائر، وانفردتُ للحظة في إحدى مناسبات تلك الزيارة بالرئيس بن بلا ومعنا رجل ثالث، وكان الحديث عن الوحدة الثنائية (مصر وسورية) أو الثلاثية (مصر- سورية- العراق) وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه قيادة ثورة الجزائر في التأثير على الجانبين الصديقين لها، دفعاً بمسيرة الوحدة إلى الأمام . وشاء الرجل أن يتحدث عن النقلة النوعية التي يمكن أن تحّدثها الجزائر إذا ما دخلت في المسيرة الوحدوية، وعن إمكانية أن تحل الإشكالات بأن تأخذ القيادة الثورية الجزائرية دورها القيادي في تلك الوحدة. وجاء جواب أحمد بن بلا بما يعني على وجه التحديد: ” قضيتكم اليوم أن تقوم وحدة ثلاثية بين مصر وسورية والعراق ولا بد من التركيز على إنجازها، وهناك وجهة نظر هي أن تكون البداية بإعادة الوحدة بين مصر وسورية أولاً، وهي وجهة نظر محقة لما تعنيه من إسقاط فعلي للانفصال وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي. أما موضوع الجزائر فإنني مؤمن بالوحدة وضرورتها ولكننا ما زلنا في بداية استقلالنا الوطني ولدينا مهمات كثيرة وعويصة لا بد من إنجازها لنضع أنفسنا على هذا الطريق. ولكن لتكن الأمور واضحة أمامكم، لا وحدة إلا بمصر أولاً ولا وحدة إلا بعبد الناصر رئيساً لدولتها. فهناك مصر وحجم مصر أو دورها، وهناك أيضاً دور عبد الناصر كرئيس لمصر وشعبيته العربية. فلو افترضنا أننا انضممنا بالجزائر لوحدة من هذا القبيل، فإنه سيكون من السهل علينا في مثل هذه الحال إقناع شعب الجزائر بالتصويت للرئيس عبدالناصر رئيساً له ولدولة الوحدة. ولكنني لا أتصور مطلقاً أن بالإمكان إقناع شعب مصر، بل ولا شعب سورية ولا أي شعب عربي آخر يدخل الوحدة ودولة الوحدة، أن يكون رئيساً له غير رئيس مصر وغير الرئيس جمال عبدالناصر ” .
فمصر والدور القومي الكبير لمصر، ومصر بعبدالناصر والحيز الذي شغلته قيادة عبدالناصر، عاملان استراتيجيان كبيران في إرساء معالم ثورة الأمة تلك، وعبدالناصر، ومنذ حرب السويس عام 1956، جاء يحتضن قضية الأمة العربية كلها، ونضال الأمة على جميع ساحاتها، وعاش لهذه القضية ولذلك النضال بكليته وقضى على طريقهما وفي سبيلهما.
ولكن ثورة عبد الناصر التي كانت الثورة المستمرة والمتعددة المراحل والمتجددة صعوداً إلى الأمام، هذه الثورة أين كان توقفها، وما هو سر توقفها عند غيابه. ولماذا جاء هذا الانتكاس وصعود قوى الثورة المضادة من بعده، وصعودها في مصر أولاً لترتد بها عن طريق الثورة، ولتخرج بها عن طريقها الوطني والقومي الثوري، وليسّهل على قوى الثورة المضادة أن تمتد بعد ذلك إلى العديد من الساحات العربية. ذلك أن تلك الثورة، ولو أنها احتضنت قضية الأمة العربية كلها، وكانت التعبير عنها في مرحلة أساسية من مراحل التحرر العربي والنهوض، ومن مراحل تاريخها، فإنها كانت ثورة بمصر وبعبدالناصر، كحلقتين قويتين من حلقات تركيبها وتكوينها. وبعد أن ذهبت قيادة عبد الناصر دون أن تخلف بديلاً لها وفي مستوى دورها وفعلها، تحركت الثورة المضادة من داخل مصر وخارجها، بل ومن داخل النظام الناصري نفسه، لتضرب الحلقة الثانية، ولتجهض مشروع عبدالناصر في الثورة العربية الشاملة .
إنها قوى الثورة المضادة من أعداء التقدم وأعداء تحرر الأمة ووحدتها، كانت دائماً موجودة وأمام كل عثرة من عثرات الثورة وأمام كل مأزق من المآزق التي مرت بها. كانت تتهيأ للانقضاض، ولكن وجود عبد الناصر والتحام حركة الجماهير به كانت تقف سداً في وجهها. لقد تهيأت للانقضاض عند حرب السويس، وكذلك عند انفصال وحدة مصر وسورية. ولكن ذلك ما كان ليعطي إلا دفعاً جديداً للثورة، ونقلة نوعية جديدة، إلا أن قوى الثورة المضادة استطاعت أن تجد رصيداً لها داخل نظام حكمه أيضاً، ومن خلال ثغرات في تكوينه وفي تركيبه الاجتماعي ومن قصورات ديمقراطية فيه. ومحاولة الانقضاض من داخل النظام لم تأت بعد غياب عبد الناصر فقط، بل وجاءت عندما اهتز النظام واهتزت ثورة عبد الناصر، بل وثورة الأمة العربية كلها وما بيتت عند هـزيمة حزيران (يونيه)، وعبّرت عن نفسها في تلك المؤامرة العسكرية التي استُجر إليها المشير عبد الحكيم عامر على رأس زمرة من قيادات الجيش المهزوم والأجهزة المتواطئة، والتي تحركت في 11 حزيران (يونيه) للاستيلاء على الحكم ووقف في وجهها عبد الناصر بلا جيش، وإنما بحضوره وبحركة الجماهير العظيمة التي رفعته من جديد في 9 و 10 حزيران (يونيه) .
إن الكثيرين ممن كتبوا وبحثوا وأعطوا تقييمات لمرحلة عبد الناصر ولتجربته الثورية وقفوا عند الهزيمة، هزيمة حزيران (يونيه)، وأوقفوا ثورة عبد الناصر عندها، واعتبروها هزيمة لها، وإن اختيار الحرب لم يكن كاشفاً لثغرات فيها وثغرات نظامها فحسب، بل وهزيمة لبرنامجها ونهاية وقفت عندها تلك الثورة !.
والواقع أن تلك الهزيمة واختيار الحرب، بالشكل الذي جاءا عليه، كانا اختباراً قاسياً وخطيراً لعبد الناصر وثورته، كاد يسقطه ويسقط نظامه، ولكن الجماهير التي تحركت في 9 حزيران، في مصر أولاً ثم في أرجاء الوطن العربي الكبير، وقفت حائلاً دون هزيمة عبد الناصر وهزيمة ثورته، وأحبطت حركة الثورة المضادة، وأعادت عبدالناصر إلى موقع القيادة. لقد ذهِلَ الكثيرون، ولكن من غير العرب، في أن يروا جماهير أمة بأكملها تقف مثل هذه الوقفة وتسير وراء قائد خسر الحرب، ذلك أنهم لم يدركوا طبيعة الرابطة والعلاقة الثورية التي قامت وتوطدت بين جماهير الأمة وعبدالناصر، وأن حضوره في تلك المرحلة أصبح وكأنه من مستلزمات استمرار ثورتها بل ومن مستلزمات تاريخها.
إنها واحدة من المواقف القليلة التي وجد فيها عبد الناصر الجماهير أمامه لا وراءه ، بل وعندما كانت الجماهير تطالبه بالعودة لقيادة ثورتها، كانت أمامه. وهذا ما استوعبه عبد الناصر كلية، واستجابته لإرادة الجماهير في العدول عن استقالته، أخذ بها كإرادة للجماهير في التغيير، وفي تجديد حيوية الثورة وتصحيح مسارها .
إننا نعيش اليوم، وبعد أربعة عشر عاماً من ” حرب الأيام الستة ” مرارة الهزيمة بكل أبعادها ليسود هذا الجو من التمزق الرهيب الذي تعيشه أمتنا ضياعاً عن أهدافها، وعجزاً عن التصدي لآثار تلك الهزيمة ذاتها. فتلك الهزيمة كشفت، حتى العظم، عن ضعف ما بناه التقدم العربي، بل عن ضعف بنيان نظام عبد الناصر الذي كان متقدماً على كل ما عداه من النظم العربية. ولكننا نظلم ثورة عبد الناصر ونظلم تاريخ أمتنا إذا ما وقفنا بتلك الثورة عند تلك الهزيمة أو عند هذا التردي الذي آلت إليه أوضاعنا العربية اليوم وأغفلنا تلك المرحلة التي جاءت في أعقاب الهزيمة مباشرة، ورداً عليها، وإذا أغفلنا النهج الذي سار فيه عبدالناصر تصدياً للهزيمة ونتائجها، وحفاظاً على مكتسبات الثورة وأهدافها. وحري بنا أن نقول عن عبد الناصر بهذا الصدد ما قاله في كلمته التي ألقاها بمناسبة ذكرى الثورة في 23 تموز في أعقاب الهزيمة مباشرة: ” إنني أثق أن أجيالاً قادمة سوف تلتفت إلى هذه الفترة وتقول: كانت تلك من أقسى فترات نضالهم، لكنهم كانوا على مستوى المسؤولية وكانوا الأوفياء بأمانتها… ” .
ولكن الهزيمة، ثم عودة عبدالناصر إلى قيادة الأمة من جديد تحت شعار ” إزالة آثار العدوان ” الذي رفعه عبد الناصر شعاراً مرحلياً لمعركة ” لا بديل عن النصر فيها ” أدخل الثورة الناصرية في طور جديد، ووضعها أمام تلك المهمة المرحلية التي أصبحت متقدمة على كل ما عداها من المهمات، وكأنها رهنت تلك الثورة لها، وأوقفتها عند إنجازها، لتقوى على تثبيت استمراريتها من بعدها. ولكنها أيضاً، ومن خلال ذلك الهدف المحدد الذي حصر عبدالناصر مهمته التاريخية في تلك المرحلة بإنجازه، فقد كان مطالباً بمراجعة مساره الاستراتيجي كله .
إن الجيوش قد هزمت في الحرب، ولكن إرادة الأمة لم تهزم… هذا هو المؤشر الذي استمده عبد الناصر من حركة الجماهير عندما عاد إلى موقع القيادة، وراح يجدد المسار واعتبر أن تلك الهزيمة مسؤوليته من خلال موقعه القيادي الذي كان يحتله في نضال الأمة، وأن إزالة آثار تلك الهزيمة أصبحت مهمته الأولى التي لا بد له أن يحمل أعباءها كلها، ثم يكون بعد ذلك، حكم الأمة عليه وعلى ثورته، وحكم التاريخ .
وموقفه منذ العاشر من حزيران (يونيه) لعام 1967 يمكن أن يتلخص بكلمات: لقد قاد الأمة وهزمت في معركة حربية، وأعادته الأمة إلى قيادتها فلا بد أن ينتصر. وصب كل جهده وبكل ما يطيق انسان وبكل ما يفكر ويعمل ويقوى، على أن يجعل الهزيمة معركة في حرب لم تتوقف ولم تنته، والانتصار في تلك الحرب أصبح الضرورة التاريخية التي لا بديل عنها، وليس لاسترجاع الارض المحتلة وإجلاء العدو عنها فحسب، بل تأكيداً لقضية ثورة الأمة ولاستمراريتها وقدرتها على إنجاز مهماتها وتحقيق أهدافها .
لقد ظل عبدالناصر هو نفسه من حيث توجهه العام الفكري والسياسي، الوطني والقومي والاشتراكي، ومن حيث مبادئه ومنطلقاته، ولكنه انتقل نقلة نوعية إلى طور جديد، وأضاف وأصبح شيئاً جديداً وتسلح بخبرات جديدة. لقد ظل الثورة، ولكنه أصبح عقلية الثورة وعقلانيتها التي تضع كل شيء على محك الواقع الملموس وعلى محك الجدوى .
كان مسار عبدالناصر، كما قال في كثير وكثير من المرات، التعلم من التجربة والخطأ. ولكن بعد الهزيمة لم يعد هناك أمامه من هامش كبير للخطأ ولا من مجال للتجربة، فالممارسة لا بد أن تخضع لمنهجية واضحة كل الوضوح وأن تكون حساباتها دقيقة سواء في التخطيط أو في التطبيق والعمل .
وتقدم عبدالناصر بعد الهزيمة، وبجهدٍ خارق لا يقبل التردد والكلل، تقدم على طريق بناء قوة مصر وصمودها، جدد بناء جيشها وتسليحه وتدريبه وترسيخ قوته، وزج في صفوفه بكل خريجي الجامعات وكل الكفاءات المتاحة، ونقله أيضاً نقلة نوعية. وجدد بناء الدولة والنظام وأسقط ما قوي على اسقاطه من داخله، من ترهل ومواقع قوى وأجهزة مخابراتية ومعوقات. وصمد بالاقتصاد رغم الخسائر الكبرى، وعزز حركة الإنتاج وأعطى لحركة الجماهير حيزاً أوسع من الرقابة على الدولة ومن الدفع بها. ولو أن وعد ” الديمقراطية السليمة ” ظل وعداً مؤجلاً في جوانب عديدة منه، والى أن ينكسر العدوان. لقد أحدث تغييرات في إطار التنظيم السياسي والتنظيمات الشعبية والحكومية والمجالس وأبقى المجالس واللجان بحالة انعقاد الى أن تنتهي المعركة ثم يأتي التقييم والحساب والتغيير الثوري .
بل وعندما تحركت مظاهرات العمال والطلاب في وجه النظام في أواخر شباط ( فبراير) لعام 68، احتجاجاً على ضعف الأحكام التي صدرت بحق العسكريين الذين تسببوا بهزيمة حزيران (يونيه)، واصطدمت مع قوات الأمن، لم يقف ليندد بتلك التحركات الشعبية، بل اعتبرها دليل صحة وعافية ولو أنه كشف عن طبيعة بعض القوى المضادة للثورة التي تحاول أن تستغل هذه الأجواء في ظروف الحرب ونادى ” لا يجوز أن تقع الثورة في تناقض مع الجماهير صاحبة الحق في الثورة وصاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة أو أن تقع في تناقض مع العمال أو الطلبة أو مع جماهير الشعب العامل… ” بل وجد في ذلك التحرك الشعبي دليلاً على أن جماهير 9 و 10 حزيران ( يونيه) ما زالت يقظة وتطالب بالتغيير وتطالب بالحساب ومضى على طريق التغيير وعلى طريق المعركة، وقدم ترجمة عملية لذلك في بيان 30 آذار (مارس)، الذي جاء برنامجاً مرحلياً لإنجاز المهمات الضرورية واللازمة لتحقيق الهدف المرحلي، هدف إزالة آثار العدوان .
ولكن بيان 30 مارس كما جاء محدداً بذلك الهدف المرحلي الذي وضعته الهزيمة على طريق الثورة، ظل منهاجاً مرتبطاً كل الارتباط بالبرنامج الاستراتيجي الأساسي للثورة، وهو البرنامج الذي نص على منطلقاته ومقوماته وأهدافه ” ميثاق العمل الوطني ” .
________________
يتبع..
أولاً – مع الثورة في مسارها التاريخي العام: الثورة المستمرة وحضور عبد الناصر (3/4)

التعليقات مغلقة.