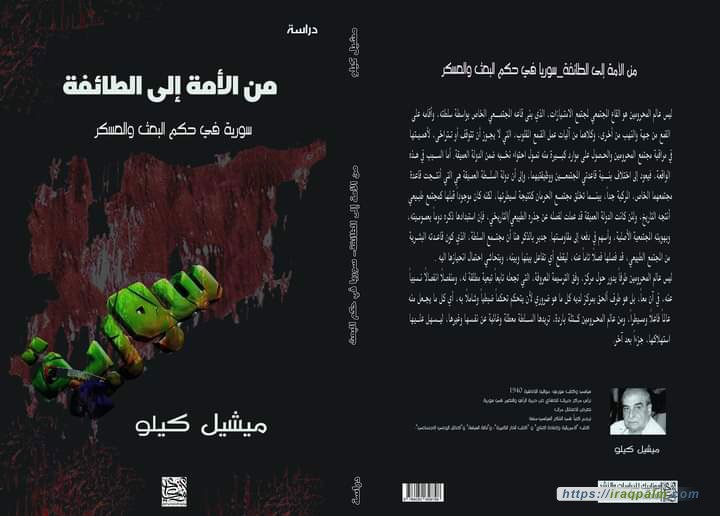
( الحرية أولاً ) ينشر حصرياً كتاب «من الأمة إلى الطائفة، سورية في حكم البعث والعسكر» بأجزائه الثلاثة كاملاً للكاتب الأستاذ: ’’ميشيل كيلو‘‘.. الحلقة التاسعة عشر: الأسدية في السلطة (الفصل الثاني – هوية “الثورة”)
من الأمة إلى الطائفة
سورية في حكم البعث
قراءة نقدية
ميشيل كيلو
باريس ٢٠١٧/٢٠١٩
الفصل الثاني
هوية “الثورة”
من أوهام الاشتراكية…
لم ينفِ عسكر انقلاب عام ١٩٦٣ ما اعتقده قطاع من اليسار السوري، السوفياتي الولاء والهوى، حول هوية خيارهم السياسي الاشتراكي، بعد فشل الوحدة كمشروع قومي، وتخليهم عن أولويتها، واستبدالها بمشروع اجتماعي، ما أن قرروا الأخذ به حتى أصدروا سلسلة قرارات ومراسيم تأميمية بدت أكثر اشتراكية من تلك اتخذها جمال عبد الناصر في مصر، وقيل في حينه إنها تؤذن بقدوم عصر اشتراكي عربي، كان اليسار الشيوعي وبعض القومي قد أعلن نضج شروطه الدولية، لأسباب منها خضوع العرب بدورهم لما سمي في حينه “سمة العصر”: وهي فرضية بدت مسَلمة في نظر أتباع النهج السوفياتي، قالت إن التطور التاريخي غدا بعد ثورة أكتوبر الاشتراكية وقيام الاتحاد السوفياتي خطياً وواحدي الاتجاه، وهو ذاهب حتماً ذهاباً لا راد له، وغير قابل للتغيير، من الرأسمالية إلى الاشتراكية، ويتيح للبلدان التابعة والمتخلفة الانتقال إلى النظام الاشتراكي دون المرور بالرأسمالية، بما يتيحه لها التحالف مع السوفيات ومعسكرهم لها من دعم وخبرات ثورية. هذا الانتقال يمتلك أيضاً شروطاً محلية ملائمة، كانتماء ضباط “اللجنة العسكرية” إلى طبقة الفلاحين الفقراء والمتوسطين، واعتمادهم خطاً سياسياً مغايراً لخط ميشيل عفلق، مؤسس البعث الأول.
هذه الرؤية السياسية اكتسحت الساحة، رغم أنه شابتها جوانب افتراضية، وأن خلافاً نشب حولها بين مختلف التيارات الماركسية والقومية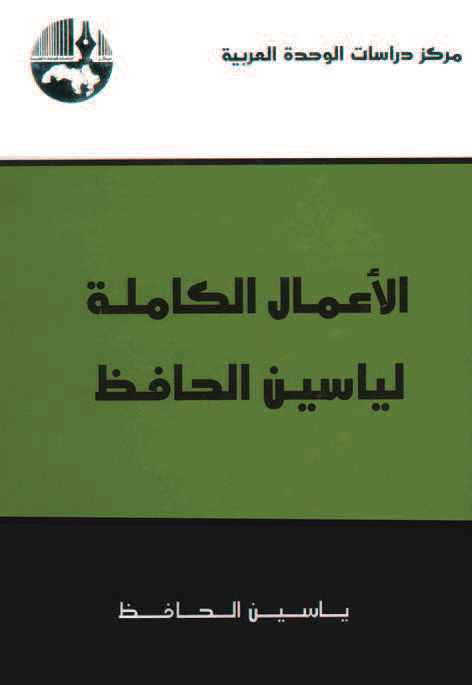 وأخلاطها، طال توقيت ومواضعات بناء النظام الجديد، وروافعه. ولعله مما يذكر في هذا السياق، أن مفكري اليسار الأكثر نقدية: الياس مرقص وياسين الحافظ اعتقدا في حينه أن الخيار الاشتراكي هو أحد بدائل الواقع القائم، ولذلك كتب الأول منهما كراسا نشره عام ١٩٦٣ بعنوان “موضوعات إلى مؤتمر اشتراكي عربي” تلمَس فيه شروط الانتقال الاشتراكي في ساحة قومية رافعتها الوحدة([2])، وتولى الثاني في العام نفسه كتابة نص يتخطى العفلقية ماركسياً، هو “بعض المنطلقات النظرية لحزب البعث العربي الاشتراكي”، الذي أقره مؤتمر البعث القومي السادس([3]).
وأخلاطها، طال توقيت ومواضعات بناء النظام الجديد، وروافعه. ولعله مما يذكر في هذا السياق، أن مفكري اليسار الأكثر نقدية: الياس مرقص وياسين الحافظ اعتقدا في حينه أن الخيار الاشتراكي هو أحد بدائل الواقع القائم، ولذلك كتب الأول منهما كراسا نشره عام ١٩٦٣ بعنوان “موضوعات إلى مؤتمر اشتراكي عربي” تلمَس فيه شروط الانتقال الاشتراكي في ساحة قومية رافعتها الوحدة([2])، وتولى الثاني في العام نفسه كتابة نص يتخطى العفلقية ماركسياً، هو “بعض المنطلقات النظرية لحزب البعث العربي الاشتراكي”، الذي أقره مؤتمر البعث القومي السادس([3]).
ـ بسبب نمط سائد من التفكير، قام على نمذجة التطور، واعتقد أن خبرة الثورة العالمية، الكامنة في ماركسية عصر الإمبريالية والاستعمار، من جهة، وفي الواقع الثوري العالمي والمحلي، من جهة أخرى، تحتم الأخذ ببديل اشتراكي يمكنه وحده قضم الواقع ما قبل الرأسمالي في بلدان التحرر الوطني، التي تتحول نظمها بعد استقلالها إلى نظم معادية للرأسمالية، تتبنى أكثر فأكثر إما خياراً اشتراكياً، أو طريقاً لا رأسمالياً، يتكفل الاتحاد السوفياتي بسد نواقصه، وإنضاجه تدرجياً، بحيث يتطابق في النهاية مع نموذج قدوة ومكتمل، هو النموذج السوفياتي. وقد آمن اليسار، وخاصة المستفيد منه، أن انقلاب ١٩٦٣ سيطبق نظرية الثورة، الصالحة لكل زمان ومكان، بما في ذلك سورية، وإن لم يتعين واقعها الاجتماعي والسياسي بالصراع بين طبقتي البروليتاريا والبورجوازية، ضعيفتي النمو، وسيمر انتقالها إلى الاشتراكية في مرحلتين متعاقبتين/ متكاملتين، يتم في أولاهما تثوير وتحديث السلطة، بعد الاستيلاء عليها وإن بانقلاب عسكري، وتخلي الممسكين بها عن هويتهم كبرجوازيين صغار ينتمون إلى فئات بينية، واكتسابهم هوية بروليتارية بالولاء، تعتبر ضرورية لبناء نظام اشتراكي، اجتماعياً واقتصادياً، ديمقراطي شعبي سياسياً. باكتمال الخطوة الأولى، التي يتم فيها تحديث وتثوير السلطة، تبدأ المرحلة الثانية، وفيها تُثوِّر السلطة وتحدِّث المجتمع، بدءاً بوعيه، مروراً ببناء كتلة تاريخية جامعة من طبقات متألفة تضم عمال وفلاحين ومثقفين ثوريين، تتغير بتكونها العلاقات الطبقية السائدة، ووظيفية ودور قوى المجتمع المنتجة، ويتعين أسلوب البناء الاشتراكي .
ـ هذا ما اعتقده يساريون، شيوعيون وماركسيون، وإن اختلفت قراءاتهم، فعرّبَ المستقلون منهم الماركسية، واعتبروا الرافعة القومية وما يترتب على تطبيقها من سياسات خارجية معادية للإمبريالية، ومستقلة نسبياً عن السوفيات، مدخل العرب إلى الاشتراكية، بينما أضفى الموالون لموسكو من الشيوعيين طابعاً سوفياتياً عليها، والتقى الطرفان عند فكرة رأت أن انفكاك عسكر اللجنة عن عفلق وحزبه، أدخل سورية إلى طور انتقالي، اشتراكي، ربط الشيوعيين نجاحه بغلبة تيار السلطة اليساري على تيارها اليميني، وبانفراده المتزايد بقرارها وتعاونه مع الحزب الشيوعي السوري في الداخل، والاتحاد السوفييتي في الخارج، فضلاً عن عدم تبديد جهوده على عمل قومي/ وحدوي لا عائد له، وخاصة مع اصلاحي تجريبي كعبد الناصر!.
ـ بعد تثوير السلطة في مرحلة أولى، سريعة وحاسمة، ُتطهَر خلالها من أعداء الاشتراكية، وتُغلّب خيار ثورييها على أي خيار برجوازي صغير، أو نصف فلاحي/ نصف عمالي. وبعد حلول شاغليها محل الطبقة الرجعية السائدة، سيكون هناك مرحلة ثانية، تأخذ السلطة الثورية فيها مجتمع سورية إلى طور تاريخي يختلف اختلافاً جذرياً عن أي طور سبقه، تطبيقاً لأطروحة لينين حول “نقل الوعي الطبقي السياسي إلى الطبقة المؤهلة للقيام بالثورة الاشتراكية من خارجها، من الطليعة الثورية المنظمة”([4]).
… إلى واقع “الثورة” الطائفية:
… لم يعلن اركان “اللجنة” التزامهم بتصور اليسار، بل قالوا بلغة عفلقية الايحاءات، تطلبتها معركتهم ضد حزبه: إن النظام البديل الذي سيبنونه بعد “الثورة” يضمر بعداً اشتراكياً سيتم بلوغه من البوابة القومية، التي سيَفْصلونها عن مصر والناصرية. ولم يقل عسكر الانقلاب شيئاً حول مدخل طبقي إلى الاشتراكية، يتفق وما تبناه الحزب الشيوعي والسوفييت، أو مدخل قومي ناصري الخيارات تبناه الماركسيون النقديون. ولم تعبر لغتهم عن خيارات مماثلة لخيارات اليسار، أو متطابقة معها، كما لم تُربط سيطرتهم على السلطة بخيار اشتراكي أو رأسمالي، بل بتصفية التيار الناصري في الجيش والشارع، وتبني مواقف تترك الانطباع لدى مختلف الأطراف بأن “اللجنة العسكرية” معهم، أو بالأصح، ليست ضدهم. كان العسكر، في هذه الفترة، يؤيدون جميع أنواع الخطابات والخيارات، ما دامت بعيدة عن التأثير في الجيش والشارع، ولا تخدم خط عفلق وتياره، أو تعطل معاركهم السلطوية البينية، وتُحدث في الوقت نفسه الانطباع بأن سورية ذاهبة إلى اليسار، ومصممة على تجاوز عبد الناصر، ما دام الانطباع حول ذهابها إلى اليسار يرضي السوفيات، وتجاوز عبد الناصر يسعد الأميركان. ومع ذلك، ولتفادي الالتزام بخيار نهائي، قدم العسكر وعوداً متنوعة، ورفعوا شعارات عديدة منها شعار الاشتراكية.
ـ في صراع سياسي حكمه الاستيلاء على الجيش، كان من المنطقي أن تركز “اللجنة العسكرية” على احتلاله بضباط موالين لها. بما أن هؤلاء كانوا في معظمهم من العلويين، فقد أخذت الأمور منحى الزمها بخيارات لا مفر منها، ليس بينها الذهاب إلى الوحدة أو الاشتراكية، لكون الأولى تغمر ضباطها العلويين بأغلبية من الضباط السنة، في حين تفقدهم الثانية هويتهم الطائفية ووظيفيتها. هذا الواقع، الذي فرض نفسه، حتى تم استبدال الضباط المدينيين، السنة في معظمهم، بآخرين علويين وريفيين، فكان استبدالهم الخطوة الأولى، التي قامت بها “اللجنة”، لتغيير هوية أداتها العسكرية بتطييف مدروس، هو الذي سيقرر نمط النظام السوري.
ـ بهذه الخطوة الأولى، افترق واقع “اللجنة” السياسي عن وعود أقانيمها الثلاثة، ورغبات وتصورات من اعتقدوا أن الاشتراكية تفرض نفسها كخيار لن تفلح في تفاديه. من التطييف فصاعداً، ستتبنى “اللجنة” الخطة ثنائية المراحل، ولكن بمضمون ليس تثويرياً أو تحديثياً، ليتسق مع هوية جيش، قرر الانفراد بالحكم والتغيير، وأن يكون أداتهما. وهكذا، بدأت مرحلة “الثورة” الأولى بالاستيلاء على السلطة والانفراد بها، ولكن ليس من أجل تثويرها وتحديثها، وإنما من أجل طبع جيشها بطابع طائفي، وتطييفها هي نفسها، الذي جعل تثويرها وتحديثها اشتراكياً ضرباً من الاستحالة، ومِثلهما تطبيق مخطط ثوري اشتراكي المضمون أو الميول. هذه المرحلة، الأولى، استمرت قرابة ثلاثة أعوام، قبل أن يلازم فترتها الأخيرة الانتقال إلى تطييف المجتمع، بدل تثويره وتحديثه!.
ـ هذه هي هوية “ثورة اللجنة”، التي انجزتها، ولكن كثورة مضادة، أفادت أكثر فأكثر مما توفر في المجتمع من عناصر أهلية/ جمعية، ما قبل رأسمالية/ ما قبل مدنية، رغم أنها أسست فرعاً اسمته “اشتراكياً” في نظامها، وقطعت علاقاتها بالمشروع القومي، دون أن يتخلى خطابها عن صخبه الوحدوي، أو تبدو قليلة الحرص على قطرية نظامها، الذي ليس رجعياً أو تقدمياً، ديمقراطياً أو استبدادياً، ثورياً أو معادياً للثورة، بل كان هذا كله، واختارت منه ما تشاء لتضعه في خدمة أهداف متناقضة مع وعودها، ولتعزز بواسطته أوضاع نظام أرستهُ على تكوين ما قبل مجتمعي/ ما دون وطني هو الطائفة، ليس في صالحه، أو بوسعه تحقيق ما ليس مطلوباً منه: تثوّير أو تحديّث المجتمع والدولة، أو حمل مشروع ثوري أو وطني، يتنافى مع هويته ما قبل المجتمعية، الجزئية والدنيا، وكذلك مع الهوية الوطنية، الجامعة والعليا، التي اعتُبر توفرها وارتقاؤها وحدوياً شرط التقدم الاجتماعي والسياسي، الذي لم يمتنع أتباع الخيار الطائفي عن التلاعب الدعائي والشعاراتي به، وعن وضعه في خدمة “ثورتهم”.
ـ خلال التحول بين عامي ١٩٦٣و١٩٦٦، استُخدمت الاشتراكية كورقة في يد دوائر مقربة من “اللجنة”، وشاع الاعتقاد بأن العسكر سيُطبقون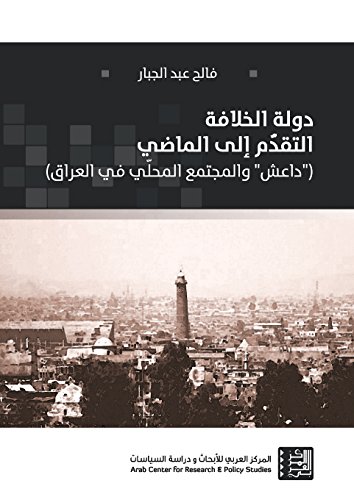 خطة الانتقال الثوري بمرحلتيه، لافتقارهم إلى بدائل من جهة، ولأن تمسكهم بالأقانيم الثلاثة يرغمهم على ذلك، من جهة أخرى. أما عسكر “اللجنة” من القادة، فكان هدفهم حجب الانتقال ثنائي المراحل إلى النظام الطائفي، وإنجاز طوره الأول من موقعهم في الجيش، وطوره الثاني من انفرادهم بالسلطة. يلفت النظر، أن التوجه اليساري داخل الحزب وخارجه، الذي واكب تطورات ١٩٦٣/ ١٩٦٦ وبرز حتى بدا أنه صار مقرراً، خاض صراعاته دون أي تأثير سلبي على تطييف الجيش، الجاري تحت عينيه. وقد تأكد فيما بعد أنه تجاهل مشروع تطييف السلطة، أو غطـاه، رغم أنه كان، كما سبق القول، أولوية اللجنة “المطلقة، بشهادة أدلة موثقة أوردها” نيكولاس فان دام “في كتاب استشرافي مبكر عنوانه: “الصراع على السلطة في سوريا: الطائفية والاقليمية والعشائرية في السياسة، ١٩٦١/ ١٩٦٥”، أكد استبدال ثورة المرحلتين الاشتراكية بـ”ثورة” طائفية مضادة من مرحلتين، انتجت نظاماً تنطبق عليه مواصفات النظام الريعي في تعريف الراحل فالح عبد الجبار، الذي يرى أن :”هناك في الريعية علاقة ثلاثية مترابطة هي: الدولة والاقتصاد والمجتمع، ومعناها بالتحديد حصول الدولة بصفتها جهازاً سياسياً/ قمعياً على موارد اقتصادية مستقلة عن المجتمع، وهذا يعني أن علاقات القوة الناشئة عن الثروة الاجتماعية مفصولة عن المجتمع ومُسندة إلى الدولة([5]). هذا النظام، غير الاشتراكي على الإطلاق، كان ضروريا لفصل الثروة عن المجتمع، وتمويل تطييف السلطة، وتأهيل ريفيين لا خبرة سياسية لديهم لإدارة سلطة لا بد أن تكتسب الخبرة الضرورية لحكمها، وللسيطرة على مجتمع ليس موالياً لها.
خطة الانتقال الثوري بمرحلتيه، لافتقارهم إلى بدائل من جهة، ولأن تمسكهم بالأقانيم الثلاثة يرغمهم على ذلك، من جهة أخرى. أما عسكر “اللجنة” من القادة، فكان هدفهم حجب الانتقال ثنائي المراحل إلى النظام الطائفي، وإنجاز طوره الأول من موقعهم في الجيش، وطوره الثاني من انفرادهم بالسلطة. يلفت النظر، أن التوجه اليساري داخل الحزب وخارجه، الذي واكب تطورات ١٩٦٣/ ١٩٦٦ وبرز حتى بدا أنه صار مقرراً، خاض صراعاته دون أي تأثير سلبي على تطييف الجيش، الجاري تحت عينيه. وقد تأكد فيما بعد أنه تجاهل مشروع تطييف السلطة، أو غطـاه، رغم أنه كان، كما سبق القول، أولوية اللجنة “المطلقة، بشهادة أدلة موثقة أوردها” نيكولاس فان دام “في كتاب استشرافي مبكر عنوانه: “الصراع على السلطة في سوريا: الطائفية والاقليمية والعشائرية في السياسة، ١٩٦١/ ١٩٦٥”، أكد استبدال ثورة المرحلتين الاشتراكية بـ”ثورة” طائفية مضادة من مرحلتين، انتجت نظاماً تنطبق عليه مواصفات النظام الريعي في تعريف الراحل فالح عبد الجبار، الذي يرى أن :”هناك في الريعية علاقة ثلاثية مترابطة هي: الدولة والاقتصاد والمجتمع، ومعناها بالتحديد حصول الدولة بصفتها جهازاً سياسياً/ قمعياً على موارد اقتصادية مستقلة عن المجتمع، وهذا يعني أن علاقات القوة الناشئة عن الثروة الاجتماعية مفصولة عن المجتمع ومُسندة إلى الدولة([5]). هذا النظام، غير الاشتراكي على الإطلاق، كان ضروريا لفصل الثروة عن المجتمع، وتمويل تطييف السلطة، وتأهيل ريفيين لا خبرة سياسية لديهم لإدارة سلطة لا بد أن تكتسب الخبرة الضرورية لحكمها، وللسيطرة على مجتمع ليس موالياً لها.
ـ بتطييف الجيش وسلطته، الذي أبطل الخيارات الثورية: وطنية كانت أو قومية أو اجتماعية أو ثقافية، صار تطييف الدولة والمجتمع المدني الخطوة التالية، وتطلب إخضاعهما لحسابات ومصالح وسياسات كيان جزئي مواجهة السوريين، الذين وعدتهم “اللجنة” بـ”الوحدة والحرية والاشتراكية”، لكنها حققت عكس وعودها، وبنت نظاماً معادياً لهم، ومعادٍ أيضا لمن بُني باسمهم: العلويين السوريين، الذين بدل إخراجهم من ما تتعرض له عادة أقليات المجتمعات ناقصة الاندماج والتبنين من هامشية وانزواء، ونقلهم من الرواسب المللية، التي قد تكون متبقية في أفكارهم وحياتهم، إلى حال المواطنة، التي تلغيها وتعيد إنتاج المنتمين إليها في حاضنة القانون وحقوق الأفراد والجماعات، أعادت إنتاج الدولة والمجتمع بدلالة طائفة جعلتها كبش فداء لها، وزجت بها في مواجهة مجتمع لطالما اعتبرها جزءاً تكوينياً منه، لا تكتمل هويته الوطنية بدونها.
ـ هذا الارتداد، لم تكن نتيجته إفشال مشروع الاشتراكية الافتراضي، وكبح سيرورة اندماج وطني ومجتمعي، كانت جارية بنجاح ملحوظ في سورية، وإلغاء الخيار الديمقراطي، الذي كان يتنامى في سياق نضج وتقدم الاندماج الوطني والتطور المدني والحزبي، بل كانت تكريس المكونات ما قبل المجتمعية في السلطة، وتمكينها من احتلال المجال العام، ومنحها هوية سيادية أضفتها عليها أجهزة الدولة العميقة، بتماهيها المتزايد معها، الذي جعل شرعيتها الفئوية بديلاً للسيادة الشعبية وللشرعية القانونية، وما اتصل بذلك من تقويض متعاظم لفرص تَخَلقْ شعب موحد، تجسده سياسياً دولة يحملها مجتمع مدني، تدعم معاييره وممارساته تطور سورية الطبيعي إلى الديمقراطية .
ـ بنهجها الطائفي، قطعت “اللجنة” هذا المسار وعكسته، وأنتجت نظاماً تسلطياً، مُحدَث فئوياً، وأعادت انضواء السوريين في كيانات بديلة للعمومية المجتمعية والاندماج الوطني، ووضعت أقدارهم في يد سلطة اعتبرت المجتمع الموحد، المتآلف المكونات، خطراً وجودياً عليها، كما استبدلت دولته بدولة/ سلطة، افتقرت على مر تاريخها إلى عمومية وشمول وتجرد دولة المجتمع، وتحولت إلى “دولة” خاصة بمكون ما دون مجتمعي أو حديث، هو طائفة توضعت في دولة عميقة رأت نفسها ووظائفها بدلالتها وانطلاقاً من أولويتها وضرورة تكامل دوريهما في كل ما يتعلق بإحكام قبضتهما على أعناق السوريين، بعد عام ١٩٧٠ خاصة، واحتجاز انخراطهم في حقل سياسي تشاركي ومفتوح، وتفاعلهم الإيجابي كأنداد ينتمون إلى وطن، يضبط حياتهم العامة قانون يخضعون له كمواطنين متساوين في حقوقهم وواجباتهم .
ـ هذا النمط من “الثورة”، الذي أنّجِزَ بمفردات مغايرة نوعياً لأي مفردات عرفها المجال العام في سوريا، ولم يسبق أن أقيم ما يماثله في أي جمهورية عربية أخرى، بخصوصيته التي ارتكزت على تفتيت العمومية المجتمعية وإحلال الجزئية الطائفية محلها، وبناء سلطة أقامت لنفسها مجتمعاً خاصاً، المجتمع، استولت بواسطته على المجال العام، والحقل السياسي، وأسست عمومية مشوهة استمدتها من تقاطعاتها كدولة سلطة مع دولة المجتمع التي قوضتها وسيطرت على ما يخدمها من ممارساتها، بعد إزاحتها، والقضاء على العموميات المحدودة، اللصيقة بأي كيان مجتمعي أو سياسي، والتي تعبر عن حضوره في المجال العام، الذي قررت أن يكون لها وحدها .
ـ واكب هذا التطور ومهد له تدمير ما كان في سوريا من نويات ليبرالية، وأحزاب وطنية، وحقل سياسي مستقل نسبياً عن النظام القائم، وحريات عامة وخاصة، وحكم قانون، ومقدمات ديمقراطية، وعلاقات وتشابكات بينية وطنية ومصلحية، وبؤر مجتمع مدني، وقضاء مستقل نسبياً وممارسات قانونية، واستبدل ذلك بالحجر على الفئات البينية، وتقلدة وعي المجتمع وعلاقاته، وإزالة ما فيه من بؤر تقدم وحداثة، وأزاح تماماً جميع أنماط التواصل العام، الحواري والتوازني والسلمي، واستبدلها بممارسات قامت جميعها على الغلبة والمكاسرة، وأنتجت حكماً تسلطياً/ مملوكياً مُحدثاً أمنياً، رفض حق السوريين في أن يكون لأي منهم تمثيل خاص ومستقل، لذلك أسماه الراحل ياسين الحافظ “النظام الشخبوطي”، نسبة إلى الشيخ شخبوط حاكم أبو ظبي، الذي ازاحه شقيقه الشيخ زايد عن السلطة، بعد أن كان التجسيد المطلق للدولة الشخص، الذي إن نام نامت، وإن أكل طعُمت، وإن شرب ارتوت، وإن أخرج مفتاح خزنتها من جيبه توفر لها شيء من المال، ماله الخاص. وقد رأى الاستاذ الراحل بحق فيه تكثيفا لحقبة قال إنها تكتسح النظم العربية جميعها([6]) .
ـ شرعت “اللجنة العسكرية” تُنفذ “ثورتها” في الفراغ السياسي، الذي أعقب فشـل الوحدة وتهافت وضعف نظام الانفصال. ووطدتها بقوة جيشها، الذي انفرد بالسلطة وأبدى دوماً نزعة عدائية مبالغ بها حيال الآخرين، يحملها عادة من يواجه مصاعب لا يستطيع تخطيها أو التكيف معها، فيعتمد آليات ردع قسرية من الذين لا ينتمون إليه. وزاد من عدوانيته أن هؤلاء لم يكونوا مجرد مجموعات متفرقة، وإنما شعباً ضم قطاعات من العلويين أيضاً. عندما أحس السوري العادي بما كان يجري، صعّد عدد من نخب اليسار مواقفه، ومثله فعل بعض رجال الدين الاسلامي، بينما لفتت صراعات رفاق “اللجنة” وانقلاباتهم بعضهم ضد بعضهم الآخر، تبين كم كان سريعاً فساد سمكة السلطة الجديدة من رأسها في قيادة “اللجنة”، حتى قبل أن يستتب الأمر لها وتنفرد به، وأدركت أعداد متزايدة من السوريين أن هدف ما صار اسمها “ثورة البعث” لم يكن ما وعدتهم به من مجتمع قوي ودولة عادلة، بل كان استبعادهم عن الشأن العام، والقضاء في نهاية الأمر على ما يمكن أن يكون لهم من دور واستقلالية عن دولة “الثورة” العميقة، فلا عجب أن افترق دربهم عن درب السلطة، وذهب الحكام في اتجاه والمحكومون في آخر، في حين فاجأ الوضع الجديد النخب ووضعها أمام إعادة النظر في وظيفتها، بعد أن اغترب معظمها شعبياً وسلطوياً، وتفاقم التباعد بين معارفها وأفكارها وبين الواقع، الذي تكرس بسرعة وواكبه انقلاب الشأن العام إلى شأن محض سلطوي، خاص بمؤسسة عسكرية أفادت في بنائها الذاتي وعلاقاتها مع مجتمعها من الخبرة الستالينية، فقصرت العمل العام على أجهزتها، وانتزعت الحقل السياسي من حزبها، وحولته إلى أداة تنفيذية تغطي ارتكاباتها أيديولوجياً، وألحقت الدولة العميقة برئيسها، بعد أن ألحقت بها كل كبيرة وصغيرة في الدولة والمجتمع، في ظل أولوية الحفاظ على “الثورة”!.
ـ هذا النموذج/ السابقة، الذي تبناه انقلاب عام ١٩٦٣، أقام تناقضاً لا سبيل إلى تخطيه بين الوعي المطيف/ الممذهب، الذي نشره في السلطة والمجتمع، ونمط الوعي الآخر، الذي يثوِّر المجتمع كحامل مفترض لمرحلة أعلى من تطور تشاركي/ عدالي، يتعارض تعارضاً جذرياً مع ما ينتجه التطييف، الذي مكّن “اللجنة” من قلب ترسيمة “ثورة السلطة التي تسبق ثورة المجتمع” إلى تطييف السلطة الذي سبق تطييف المجتمع، وأدى إلى احتجاز التقدم والتحديث في صعيديه الرسمي والشعبي، وبناء ثورة مضادة مكتملة الأركان، أنجزت بواسطة سلطة عسكرية ريفية المنابت، أتبعت مؤسسات الدولة بأجهزتها، القمعية والضبطية، وفصلتها عن مجتمعها، لتضعها في يد طائفة لا تنتمي إلى تشكيلات المجتمع الطبقي أو المدني، أو تتشابك وتتفاعل إيجابياً معها، بل تنظر إليهما بعداء وحذر مفعمين بالتوتر والعنف، وترى في اختلافهما عنها تناقضاً من الضروري أن يكمن ردها عليه دمجهما العضوي، الكتلي، فيها، الذي يجب أن يزيد من انغلاقها، لتحكم إحكاماً متعاظماً قبضتها على الشعب، وتعزز وعيها الإقصائي في مجالها الخاص، للتحكم بما تمليه المغايرة العدائية عليها حيال من هم خارجها، وما تلزمها به من ربط أمنها كطائفة بحماية انكفائها الذاتي وتحصينه ضد الاختراقات، وبجاهزيتها التعبوية لمواجهة أي تحرك يصدر عن أي جهة خارجها، مهما كان مفاجئاً، ولرفض أي انفتاح من طبيعة تشاركية، خاصة إن حدث على أسس ومبادئ يتبناها الآخرون، كتلك التي لم تتوقف هي نفسها عن المطالبة بها قبل استيلائها على السلطة، وصارت تعتبرها بعد استيلائها عليها من المحرمات، كالحرية والعدالة والمساواة والمشاركة في القرار والثروة… الخ، لأن قبولها يعني إلغاء رقابتها على المجتمع، وخروج مصائر الآخرين من يديها، وعودة اقدارها إلى أيديهم، بعد أن انتقلت بالسلطة من أدنى درجات السلم الاجتماعي إلى أعلى مراتب السلّمين السياسي والاقتصادي، وتحولت إلى طرف ينفرد بإعادة انتاج المجتمع.
ـ لم يتوقع أحد أن يفضي انقلاب احتل ضباط “اللجنة” موقعاً هامشياً بين منفذيه، إلى فوزهم بسلطة أخذوا يمارسونها نيابة عن طائفة انقسمت بعد أوائل القرن العشرين إلى تيارين: أقلوي رفض في مذكرة رسمية وقعها ممثلوه الاندماج في الدولة السورية المستقلة، كان بينهم وجه محلي من قرية القرداحة هو على سليمان الأسد، جد حافظ الأسد، وأغلبي مثله الشيخ صالح العلي، الذي عُرف بتغنيه بالوطنية السورية، وبأنه أول من رفع السلاح في وجه الانتداب الفرنسي، وقاتل من أجل استقلال ووحدة الدولة السورية. كما لم يكن في حسبان أحد أن ضباطاً ينسبون أنفسهم إلى حزب قومي، هم الذين سيتولون تطييف الجيش فالسلطة فالحياة العامة، وسينقلبون على كل ما كانت المرحلة تطرحه من خيارات، كالوحدة والتحديث الشامل للسلطة والمجتمع، وتحتمه من انحياز إلى كل من طالته يد التمييز والظلم في مجتمع سوريا، دون نظر إلى هويته ومنبته ومعتقده .
ـ هل كان لدى هؤلاء الضباط مستوى من الوعي الثوري والتجرد عن الذات، يدفعهم إلى بناء مجتمع تشاركي يفقدون فيه انفرادهم بالسلطة ومؤسسات دولتها العميقة؟. وكيف يعقل أن يفعلوا ذلك، إن كانوا قد خططوا لتطييفها؟. ثم، ما الذي كان يرغمهم على تبني نظام إن أيده الشعب، واجهوا مصاعب جدية في ما يتعلق باحتفاظهم بسلطة ذات حامل مجتمعي غير طائفي؟. ومن هو الذي كان يضمن تحويل الطائفة العلوية إلى جهة تحل، في المشروع الثوري، محل الطبقة العاملة، الضعيفة إلى درجة الغياب؟. وهل بلغ الفكر السوفييتي في ستينيات القرن الماضي من الجموح النظري ما يكفي لان يصيب بعدواه ضباط “اللجنة”، الذين تدفق عليهم دعم موسكو العسكري، والأيديولوجي، وجعل منهم حالة على عتبة الاشتراكية، وأغناهم عن اتخاذ خطوات اضافية لخطب ود موسكو؟.
ـ مهما يكن من أمر، فقد ذهبت “اللجنة” إلى خيار معاكس لما اصطلحت لغة اليسار على تسميته ثورة. ورغم ذلك، فقد حظيت بدعم معظم مروجي هذه اللغة، الذين تجاهلوا ما تبناه عسكرها من خطوات مخالفة للرطانة الثورية، التي جرت على ألسنتهم، وتغاضوا عن استيلاء فريق عسكري صغير، طائفي الهوية والخيار، إلى السلطة، بقرار لا بد أن يكون أعضاؤه قد اتخذوه في فترة سبقت انقلاب عام ١٩٦٣، وألزمهم بأخذها ووضع أجهزتها، الحيادية ظاهرياً، في خدمة خطط تمليها القوة ضماناً لاستمرار نظامهم، فإن رفض الشعب “ثورتهم”، خوّنوه وحجبوا حقيقتها بلغتهم الثورية الجامحة.
ـ انتج عسكر “اللجنة” أنواعاً متباينة من الوعي، حسب الجهة التي استهدفها، وترك الرابطة الطائفية وما أملته من نمط علاقات وتماسك لأجهزة دولته العميقة، التي أدارت خراباً داخلياً، بقي سرياً بالنسبة إلى المجتمع، استهدف إقناع منتسبيها الذين ينتمي معظمهم إلى الطائفة العلوية، بأن ولاءهم للسلطة يفترض تمسكهم بالتنافي المتبادل بينهم وبين أي طرف مجتمعي آخر، وخاصة من يقاوم النظام، وأجهزته، التي تشجع ما يقابل هذا التنافي من وعي مذهبي على صعيد الشعب، أدواتي/ وظيفي على مستوى النخب، وما يجعل نتائجهما متكاملة في خدمة السلطة، ويثير، في الوقت نفسه، قدراً من التوتر بين السوريين يسوغ استئثار الدولة العميقة بالشأن العام، وشحن مجتمعهم بالرعب والاقصاء والتمييز، ومن جانب آخر بتنزيه السلطة عن الطائفية، ومنحها شهادات “علمانية” تنكر أن العلويين طائفة، وأنهم يتماهون بصفتهم هذه مع السلطة، ومع سعيها لإحاطة نفسها بحلف أقليات يعزز حاملها المللي، من جهة، ويقسم سوريا إلى كتلتين تنتميان إلى مجتمع متنافيين: مجتمع من هم في السلطة، ومجتمع من هم خارجها، مجتمع المحرومين بمعنى الكلمة، الخاضع للمجتمع الأول، الذي يسيطر على الثروة والقوة والمجال العام والمعرفة، ولا يبقي للثاني من خيار يحد من هامشيته وعجزه غير وعي مذهبي انتشر انتشاراً متسارعاً في دوائر متزايدة منه، تقابل مضامينه التحريضية مضامين الوعي الطائفي، وتتشابه معها من حيث طابعها العدائي والإقصائي، الأمر الذي يسهم في توطين الثورة المضادة في المجتمع، أيضاً.
___________
هوامش:
[2] الياس مرقص: موضوعات إلى مؤتمر اشتراكي عربي، دار دمشق للطباعة والنشر ١٩٦٣.
[3] ياسين الحافظ : بعض المنطلقات النظرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ١٩٧٤.
[4] لينين: ما العمل؟ المسائل الملحة لحركتنا، دار التقدم، موسكو ١٩٦٨، حيث يقول لينين: “لا يمكن ان يتحقق الوعي الطبقي السياسي للعمل من لا شيء، انه يتحقق فقط من خارج الصراع الاقتصادي ومن خارج دائرة العلاقات بين العمال والموظفين”.
[5] فالح عبد الجبار: دولة الخلافة، التقدم إلى الماضي، داعش والمجتمع المحلي في العراق، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الصفحتان ٢٠٨/٢٠٩ ، بيروت ٢٠١٧.
[6] ياسين الحافظ: الشخبوطية في السياسات العربية، من كتاب: العقلانية في السياسات العربية، نقد السياسات العربية في المرحلة ما بعد الناصرية، دار الحصاد١٩٩٧ ، دمشق.
………………..
يتبع.. الحلقة العشرون: (الفصل الثالث) الطائفة كأمة بديلة أو كضد شعب
«ميشيل كيلو»: كاتب وباحث ومحلل سياسي سوري

التعليقات مغلقة.