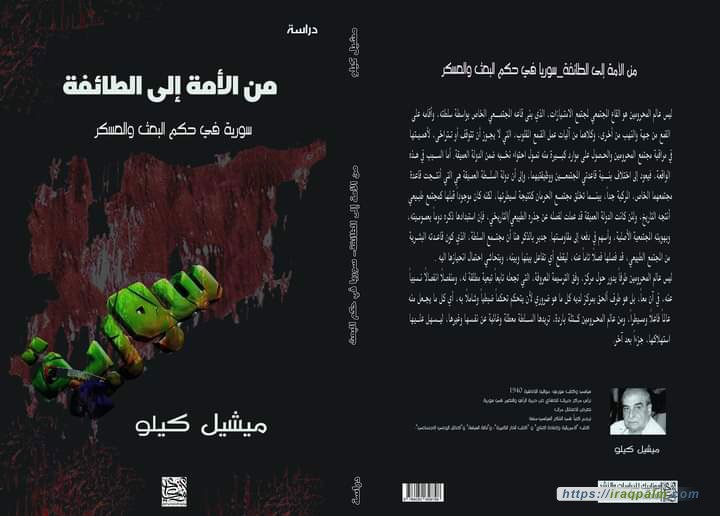
( الحرية أولاً ) ينشر حصرياً كتاب «من الأمة إلى الطائفة، سورية في حكم البعث والعسكر» بأجزائه الثلاثة كاملاً للكاتب الأستاذ: ’’ميشيل كيلو‘‘.. الحلقة السادسة عشر: نتائج الهزيمة
من الأمة إلى الطائفة
سورية في حكم البعث
قراءة نقدية
ميشيل كيلو
باريس ٢٠١٧/٢٠١٩
نتائج الهزيمة
الاحتلال كأداة لإعادة هيكلة المنطقة
ـ كسرت حرب حزيران بصورة نهائية ما كان يعتبر طوقاً عربياً مضروباً حول إسرائيل، الذي بدأ تفكيكه مع انقسامات المجال القومي ومعاركه، التي خاضها طرفاه البعثي والناصري في أعقاب فشل الوحدة، واستمر منذ هزيمة العرب الأولى في حرب عام ١٩٤٦/ ١٩٤٨.
ـ وحسمت الحرب صراع دمشق والقاهرة لصالح الأولى، وصراع التيارين القومي والتقليدي لصالح الثاني، المحسوب على واشنطن. هذان التطوران حدثا بجهود جهة اعتُبرت دوماً “عدو” العرب، استعان عسكر “اللجنة” بها بحجة لن تبارح بعد ذلك خطابهم السياسي، هي “تحرير فلسطين”. كما عززت هزيمة التيار القومي عموماً والناصري خصوصاً دور ومكانة السعودية في العالم العربي، التي كانت عاجزة، شأنها في ذلك شأن البعث العسكري، عن كسب الصراع بقدراتها الذاتية .
ـ وزاد من خطورة هزيمة مصر أنها لم تبدل فقط علاقات الطبقات السياسية الحاكمة في المعسكرين وداخل كل منهما، وإنما قوضت أيضاً الكتلة الشعبية التاريخية التي تخلقت في الوطن العربي، حول خطاب الناصرية ونضالها، فبدأت بتفكيكها إعادتها إلى التشظي والصمت، وخلت الساحة منها كقطاع نشط من التيار الوحدوي العابر للدول، فقابل تراجع ثم تلاشي التيار القومي/النهضوي الرسمي والشعبي، صعود التيارات المحافظة والدينية، التي أعادت طرح القضايا السياسية والاجتماعية والفكرية/المعرفية في حواضن غيرت هويتها، وعكست سياقها، وانتقلت التقليدية من الدفاع إلى الهجوم لملء فراغ تخلَقَ في ساحة لطالما ضجت بامتلاء شعبي وضع الواقع العربي على مشارف حقبة تغيير شامل، انتكست الآن إلى زمن حفل بالقطيعة مع الجهود الرامية إلى انخراط العرب دولاً وشعوباً في العالم المعاصر وقيمه المؤسسة، دون أن يعني خروجها النسبي والسريع منه أنها خرجت وغدت بمأمن من جبابرته، أو نجحت في الابتعاد عن سيطرتهم وسطوتهم، أو قيدت قدرتهم على تشتيته كعالم يوحده انتماؤه إلى أمة واحدة، خاص للتو معركة تاريخية كبرى من أجل امتلاك شروط تقدم من صُنعه، وانكفأ الآن على ذاته، دون أن ينتقل إلى وضع دفاعي يحميه، أو يسمح له بمشاركة فاعلة في قضاياه. بالتطور الذي قوض القوة الرسمية الأكثر راهنية وقدرة على الدفاع عن مصالحها ومصالح العرب من موقع يحمل مفردات هجومية وحديثة، وقوض الحراك الشعبي الموحد والعابر للدول، الذي ارتبط بهذه القوة وواكب صعودها إلى موقع قيادي مارست فيه ادواراً بدا وكأنها تنتمي إلى سيرورة انتقال تاريخية دخل العرب بهذا القدر أو ذاك إليها، تشمل أيضاً دول المحافظة والتقليد، التي وجدت نفسها مواجهة بمسائل من خارج منظومتها لا بد من أن تجيب عليها، بينما يقف شعبها بأغلبيته إلى جانب من طرحها عليها، وانعكست الآية الآن، وأخذت شكل شرّعنة للتبعية والفئوية والكيانات ما قبل المجتمعية المساندة لها، العائلية/القبلية، المحافظة هنا، الطائفية/”الثورية” هناك، التي زجت بالعرب في حلقة مفرغة، يدورون فيها حول أنفسهم، دون أن ينتقلوا من حال الدوران إلى حال التقدم المفتوح.
ـ قلبت الهزيمة علاقات القوى داخل العالم العربي رأساً على عقب، وقلبتها في العلاقة مع إسرائيل، التي نشطت قبل الحرب وخلالها في الصف المعادي للنهوض العربي كمشروع تحققت بعض مفرداته في الواقع، بجعله عامة العرب على مختلف تلاوينهم موضوع السياسة الرئيس، لأول مرة منذ قرون كثيرة. هذا المنعطف المفصلي ترتب على الهزيمة، التي كسرت ما كان يسمى “حركة التحرر الوطني العربية”، التي أخرجت الاستعمار التقليدي من بلدانها، وأعادتها هزيمة حزيران بدلالاتها السياسية والاجتماعية والثقافية والقيمية المرعبة إلى بديله الحديث، الذي تمثل في الامتداد الصهيوني للنظام الإمبريالي من الطراز الأميركي، الذي لا يقوم أساساً على الاحتلال، بل يقوم على الاختراق البنيوي، الذي يحتل الساحة التي يفترض بسلطة وطنية احتلالها، في بلادها، وينتج واقعا بديلاً لها، يتشابك مع السلطة القائمة أو يحتويها كسلطة تابعة تُعرّف نفسها بما تتطلبه سيطرته عليها من موجبات والتزامات. هذا التطور مر بمرحلة أرغمت الهزيمة خلالها مصر على قبول تقسيم عمل تكاملي اندرج في أهداف ومصالح متناقضة، قام بينها كدولة مواجهة وبين السعودية كدولة داعمة، تعين بما كشفته الحرب من هشاشة في بنى المجتمع “الحديثة”، وبرانية للتجربة “التقدمية”، التي بقيت عند سطح المجتمع الخارجي، ولم تنغرس عميقاً فيه، وعوضت عن فشلها في اختراقه بإدارته بطرق تسلطية قوضت دوره المساند له، وجعلته برانياً وسطحياً بدوره، ولذلك تهاوى هو أيضاً بعد الهزيمة، بافتقاره إلى تنظيم ذاتي يمثله ويقوده، وتراجع تمحوره كجمهور واسع حول شخصية عبد الناصر الكاريزمية، التي اكتشفت حاكمات من اعتبروا مسؤولين عن الهزيمة من أهل السلطة وجنرالات الجيش كم كان نظامها غارقاً في الفساد، وكانت حالة معزولة فيه، وكم كانت السلطة منخورة من داخلها بتناقضات وتوجهات متعارضة، ساءها أن عبد الناصر لم يبادر إلى الانفكاك عنها، رغم تهديده في إحدى جلسات الاتحاد الاشتراكي بما أسماه “لبس البدلة العسكرية من جديد”، وبالتالي بالانقلاب عليها.
ـ كما كشفت غربة “الثورات” عن شعوبها هنا، وعداءها لها هناك، وخاصة في سورية والعراق، وكم فشلت في مواجهة مشكلات المشاركة والدمقرطة والتغيير، وفي بناء علاقات طبيعية مع شعوبها، التي انفصلت عنها ولم يعد لديها ما تقدمه لها غير القمع والاستبعاد عن أخص شؤونها، وتشويه حياتها عبر نمط من الوعي لا يتسع لغير سلطتها وأشخاصها، وتحوَّل بمرور الوقت إلى احتجاز أيديولوجي اخترق مختلف جوانب وجودها، زادته تفاقماً ممارسات “ثورية” أقنعت حكامها أن حريتهم يجب أن لا تكون مقيدة بدستور أو قانون أو مصلحة، وأنها لا تستقيم دون تقييد حق رعاياهم في الحرية، لعدم حاجتهم إليها، ما دام النظام القائم لا يستند إلى إرادتهم، ويكمن في دولة عميقة يوجهها قائد معصوم، تستمد قوتها وشرعيتها من تماهيها مع حاملها الطائفي وقواعده، المنظمة فيها وبواسطتها، ولا تستمدها من مجتمعها، الذي يجب أن يبقى ضعيفاً ومهمشاً، ما دام “التقدم” يقاس بحداثة سيارات مسؤولي وقادة أجهزة السلطة، ولأن الدبابة تمنح الوطن من الحصانة ما لا يوفره المنهاج الدراسي العقلاني، والتعليم الجامعي والبحثي الحر والمفتوح، والتقدم الاقتصادي، والتطور المعرفي، والمساواة بين المرأة والرجل، ونظام المواطنة والحريات، والعدالة والمساواة، بينما تعوض صواريخ الطائرات عن ضعف المجتمع وفواته، وما يعانيه من نواقص وعيوب تكوينية في بناه ووعيه، لا حاجة للتخلص منها، ما دامت قوة المجتمعات والدول تكمن في قوة جيوشها.
ـ وكشفت الهزيمة كم هي بعيدة المسافة، التي تفصل الشعوب عن نظمِ”ها”، وتطلعاتها عن ممارسات قادتِ”ها”. وكم كان إدخالها إلى المجال العام بالواسطة وسطحياً، وكان خروجها منه سريعاً وشاملاً بعد الضربة التي تلقاها من احتل الحقل السياسي بالنيابة عنها، دون أن يُسمح لها بالدخول إليه والتوطن فيه، عنها في الحقل السياسي السلطة وجيوشها وحدهما. وبينت كم كان انتقالها من العفوية إلى التنظيم والوعي العقلاني مهماً لوقوع ثورة حقيقية، بدل وهم الثورة، التي تبين أنها لم تتحقق على صعيد السلطة، أو الأحزاب أو المجتمع، ولم تسبقه عقلنة للوعي السائد، فلا عجب أن أفضى قصر الحقل السياسي على الدولة العميقة وسلطتها، إلى ما ظهر من فشل خلال الهزيمة، لكنه في الحقيقة سابق لها، ولولاه لأمكن للحرب أن تأخذ مساراً آخر، حتى إن انتهت في نهاية الأمر بهزيمة.
ـ وكشفت الهزيمة خطأ الاعتقاد بأن العالم العربي كان منقسما بين معسكر قومي حديث ومعسكر محافظ تقليدي. الحقيقة أنه كان منقسماً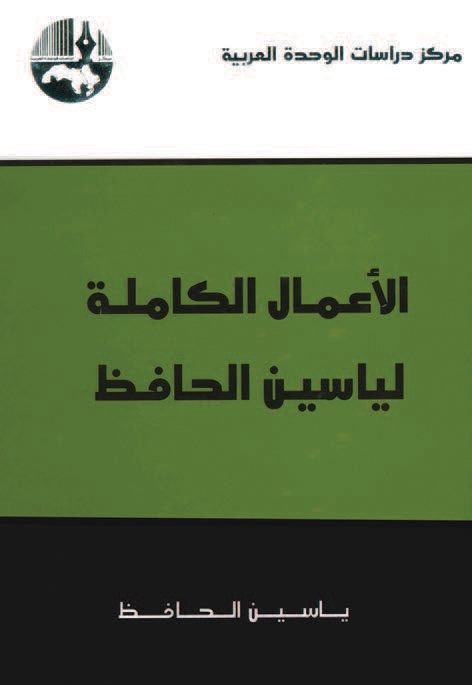 بين ما أسماه “ياسين الحافظ” تقليدية قديمة وموروثة، وتقليدية جديدة، قصرت التحديث على أجهزتها الأمنية، و”تقلدت” مجتمعاتها اشتراكياً، فأنتجت تأخراً من نمط جديد فيها، جعل من نظمها نظماً “تأخراكية”، إلى جانب النظم التقليدية المحافظة، التي انتجت تأخراً رأسماليا، ولذلك اعتبرها نظماً “تأخرالية”(77). كلا النظامين يعيد إنتاج نفسه انطلاقاً من السلطة، وليس من المجتمع، لذلك تقتصر سياساته على هدف رئيس هو البقاء في الحكم، ونشر وعي زائف بالتماهي بينها وبين وطنها الموجود بها، فإن هزمت هزم، وإن ضعفت انهار، أما إذا سقطت، فسقوطها يعني انتفاء قدرته على الوجود والاستمرار. كي لا يحدث هذا، من الضروري أن تستأثر بجميع مصادر قوته، لأن ذلك لن يضعفه ما دام يقويها، ويحصنه عبر تحصينها.
بين ما أسماه “ياسين الحافظ” تقليدية قديمة وموروثة، وتقليدية جديدة، قصرت التحديث على أجهزتها الأمنية، و”تقلدت” مجتمعاتها اشتراكياً، فأنتجت تأخراً من نمط جديد فيها، جعل من نظمها نظماً “تأخراكية”، إلى جانب النظم التقليدية المحافظة، التي انتجت تأخراً رأسماليا، ولذلك اعتبرها نظماً “تأخرالية”(77). كلا النظامين يعيد إنتاج نفسه انطلاقاً من السلطة، وليس من المجتمع، لذلك تقتصر سياساته على هدف رئيس هو البقاء في الحكم، ونشر وعي زائف بالتماهي بينها وبين وطنها الموجود بها، فإن هزمت هزم، وإن ضعفت انهار، أما إذا سقطت، فسقوطها يعني انتفاء قدرته على الوجود والاستمرار. كي لا يحدث هذا، من الضروري أن تستأثر بجميع مصادر قوته، لأن ذلك لن يضعفه ما دام يقويها، ويحصنه عبر تحصينها.
ـ هذا الواقع السياسي تبلور وبلغ كامل نضجه في نظام “اللجنة” الطائفي الثوري، الذي آقيم على احتواء المجتمع وتهميشه وإضعافه كمصدر داخلي لخطر يجب إبقاؤه تحت العين واليد. ومع أن الهزيمة فضحت الرهان على بناء سلطة قوية في مجتمع مهمش وضعيف، فإن السلطة قصرت اهتمامها بعدها على إضعاف مجتمع السوريين إلى درجة الاستنزاف الشامل، باستيلاء أجهزتها السرية على مصادر قوته وموارده من جهة، وإضفاء طابع أمني على ممارساتها، يُثكّنِن الحياة العامة، ويُصعد قدرة الأجهزة على الحؤول دون تخلق قدرته على ممارسة استقلاليه نسبية عنها، وتفاعل متبادل معها، يفضي إلى قيام نظام مشاركة مفتوح بين طرفين متكاملين.
ـ كشفت الهزيمة أيضاً أن النظام رأى في المجتمع السوري عدواً له، ومصدر خطر رئيس عليه، وأنه قرر أن تقوم علاقته به على تحييده الكامل عن الشأن العام وضبطه بالعنف، يستوي في ذلك الموالون والمحايدون والمعارضون، ما دام مصدر قوة اي سلطة يكمن في انفرادها بالشأن العام، وبقصر التعامل معه على أجهزتها وحدها، الرسمية منها والسرية. هذه “الخلفية الاحتلالية، التي رعاها نظام “اللجنة” وطدها إسقاط الجولان وطرّقه في ربط استعادته باستكمال بناء السلطة، وليس بإعادة النظر فيه، وبإضفاء طابع عنفي عليها جعل منها قوة احتلال داخلي تتمتع بكل ما لقوة الاحتلال من مواصفات، وتقوم بكل ما تقوم به من ممارسات. بدل مراجعة نهجه، أمعن العسكر البعثي في تعزيز السلطوية الأشد شمولية، التي لم تعرف مثيلاً لعدد وهوية المنخرطين في أجهزتها دول الاستبداد العربية الأخرى، وغطى انتشارها كل مسام من مسامات الجسد البشري والسياسي والاقتصادي والثقافي السوري، لذلك صارت غاية ذاتها بمجرد أن اخترقته وسَطت على حريات السوريين. وبدل أن تواجه الاحتلال الاسرائيلي بقواهم الموحدة، ذهبت في الاتجاه الذي توقعته إسرائيل، وتَلخَص في قيام كيان سياسي شديد على شعبه ضعيف إلى حد التهافت حيالها، يتجبر عليه ويتحاشى مواجهتها ما دام قادراً على إخضاعه.
ـ هذا الضرب من الرد على الهزيمة، الذي اعتمدته النظم المهزومة عامة، والسوري منها خاصة، استهدف احتواء هزيمتها أمام الخارج بالإمعان في تصعيد الضبط والقسر الداخلي، واحتكار الحقل السياسي التزاماً بنهج تكثف بصورة خاصة بعد انقلاب حافظ الأسد عام ١٩٧٠، أخرج تماماً المجتمع من السياسة والسياسة من المجتمع.
ـ انهت الهزيمة وهماً شاع حول دخول العرب في حقبة ثورية فككت علاقاتهم بالعصر الإمبريالي، وحررتهم من التبعية، فنجحوا في تحدي التأخر والتخلف، وانتهاج سياسات أملتها إرادتهم الوطنية المستقلة، ومصالحهم التي حددوها بملء إرادتهم . وقوضت الاعتقاد بأن الاستقلال يمثل نقطة فصل نهائية بين تاريخين وواقعين، وأنهم ما أن نالوا استقلالهم حتى حمل العصر الإمبريالي عصاه ورحل عنهم، وتخلى عن مصالحه ومواقعه في بلدانهم ونظمهم، وانصاع لسيادتهم، التي قامت على فصل مجالها الداخلي عن خارجه الدولي، ووضعته تحت سلطة حكامها الذين “طردوا” الإمبريالية من بلدانهم! .
ـ أنهت الهزيمة أيضاً أكذوبتين: إحداهما قدرة العرب على تحرير فلسطين عسكرياً، والثانية أن إسرائيل تريد السلام بأي ثمن مع جوارها، وأكدت عكسهما وفاجأتهما بالمدى الذي بلغته قوة إسرائيل الحربية، وحجم الهوة بينها وبين قوة أي جيش عربي من جهة، وبالدرجة التي بلغها استبدال الوطن بالسلطة، وحجم سقوطه في واقعها، الذي لم يعد فيه مكاناً له.
ـ بدل تحرير فلسطين كحد أدنى، بلغة حافظ الأسد، تم من الهزيمة فصاعداً التسليم والاعتراف بأن فلسطين لم تعد عربية، وإسرائيل ليست ضيفاً على جوارها العربي، القريب والبعيد،؛ الثري” والتقليدي، وأنها صارت بالقرارين ٢٤٢ و٣٣٨، واتفاقيات السلام مع مصر والاردن والسلطة الوطنية الفلسطينية، قوة الحسم، التي تقرر مصير المنطقة، التي جعلت، نظمها، من القبول بها قضية أمن وطني وضرورة قومية، فلا غرابة في أن تعقد معظمها اتفاقيات سلام تعاقدية معها، مصر والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية، ويتوصل النظام السوري إلى سلام أمر واقعي تجاري قوته التعاقدية مثيلتها في الاتفاقيات الرسمية مع الدول السابق ذكرها، وتفوقها استقراراً.
ـ خرج الجوار العربي لإسرائيل من الصراع معها، إن كان قد صارعها حقاً في أي يوم، دون أن تخرج هي من الصراع ضد دوله، وفي حين كانت التهدئة التي عرفتها في السابق مرهونة بأسباب عديدة، فإنها ستكون مرهونة من الهزيمة فصاعداً بقوتها وحدها، وبالعجز العربي عن مواجهتها، كما يخبرنا ما نلاحظه في غاراتها على سورية، التي قرر جيشها منذ نصف قرن ونيف الرد على اعتداءاتها و دون أن تسنح له الفرص لذلك، ويعلن بعد كل غارة إسرائيلية أنه سيرد في الزمان والمكان المناسبين، فما عساه يفعل إن كان الزمان لا يأتي، والمكان مجهول الإقامة!. تفاقم العجز حيال إسرائيل، رغم الواقعة التي أبرزتها حرب حزيران، وهي أنها أشد خطراً على العرب مما اعتقدوا في أي يوم، وأكثر تجذراً في النظام الدولي بمعسكره الرأسمالي الحالي والاشتراكي السابق.
ـ وعززت الهزيمة “الفكر” الذي كان يطالب بإدخال إسرائيل إلى الصراعات العربية/العربية، وتكليفها بحسمها. وللأمانة فإن عسكر “اللجنة” كان سباقاً إلى ذلك، لاعتقاده “أن تبني موقف تل أبيب من عبد الناصر، واستخدامها ضده سيساعده على تزعم العالم العربي، فاذا بحساب الحقل غير حساب البيدر، وإسرائيل تنفذ خطة حضَّرتها منذ وقت طويل، هدفها إفراغ العالم العربي من أي زعامة، وتقويض أي مركز فيه، ووضع سورية تحت إشرافها مقابل ما قدمته من ضمانات لها، بعد حرب عام ١٩٧٣، وتحوّل دمشق إلى جهة تُخرب المجال القومي وتطيح بتوازناته، وتجعله، بوعي أو بدون وعي، عاجزاً عن اتخاذ مواقف تتعارض مع مصالح اسرائيل العليا، أو تهدد أمنها.
ـ قوضت الهزيمة أيضا فرص تأسيس مشروع نهضوي عربي، ودمرت ما كان قائماً من مقوماته الأولى هنا أو هناك، بضربها مركزه الذي تفاعل بإيجابية معه، كضرورة تاريخية لخروج العرب من تخلفهم وماضويتهم. ذلك و كان هدف الحرب، التي أفادت من تجريبية المشروع النهضوي، ونواقصه التنظيمية، وعيوبه النظرية والفكرية، وارتباطه بسلطة غيّبت مجتمعها كي لا يكون طرفا فيه، كما ربطته بفرد جاء الى الشأن العام من مؤسسة عسكرية تنضبط بنزعة أوامرية يعاقب من يخالفونها، اعتبرت نفسها الاستجابة التاريخية المطلوبة لتطلعات “جماهير غير مسيسة أو منخرطة في سيرورات فكرية مدنية، عاجزة تماماً عن الخروج من أزماتها وتخلفها، تُغيبُها عن الوعي مؤسسة مشيخية تضم “علماء”، يقتصر علمهم على تغييب الإنسان عن ذاته، وحشو رأسه بغيبيات تدجنه إلى درجة أنه يرفض الخروج منها .
ـ سقط مشروع النهضة الجزئي والسلطوي في مصر، وتبني البعث، بعد انقلاب الأسد بصورة خاصة، بمشروع مناهض لأي نهوض وطني أو أمّوي، سأشرحه بالتفصيل في الجزء الثالث من هذا الكتاب، بينما تعلق الخليج أكثر من أي وقت مضى بنزعته التقليدية والمحافظة، وواجه المشروع القومي، الجمعي، بمشروع إسلامي مقابل، أراده مذهبياً وتجميعياً، ليحصنه ضد أي ميل نهضوي أو مدني قائم أو جديد.
ـ استبدلت الهزيمة، البيئة السياسية العربية ومفرداتها وتوجهاتها الرامية إلى اللحاق بالعصر والحداثة، ببيئة نافية مناهضة لها ولمفرداتها وتوجهاتها، أحلت الاستبداد محل وعد الديمقراطية، وواقع القسر محل مطلب الحرية، والتمزق القومي والوطني محل وحدة المجتمع والدولة، والنهب والإفساد محل العدالة الاجتماعية، والحقل السياسي الذي اقتصر على الأجهزة السرية محل الحياة الداخلية المفتوحة على الشرعية القانونية، والذي استخدم الهزيمة لتحويل خلافاته الداخلية والعربية إلى تناقضات بنى توازناته واستقراره عليها، ولم يتوقف عن تعميقها وتنويعها، في الإطارين المحلي والأمّوي، اللذان شحنهما بعلاقات تنافٍ متبادل، في حين حرص على خلو علاقاته مع الخارج الدولي من تناقضات كهذه، واستبدلها بتنازلات لا حدود لها، أقدم على تقديمها لكل من أراد خطب وده .
ـ أنهت الهزيمة تيار الوحدة العربية الشعبي خارج مصر، والدولوي فيها. ووطدت الميل إلى التجزئة باعتبارها واقعاً لا يمكن تجاوزه والقفز عن نتائجه، ونشرت الاقتناع بأن الدول العربية القائمة نهائية، ووحدة العرب رهان وهمي أثبت فشله وتخطاه الزمن، وأن للواقعية ترجمة واحدة هي التعايش مع نظمهم القائمة والعمل لرفع قبضتها الأمنية عن أعناق مواطنيها، ما دامت مواجهتها عبثية وسترتد على مجتمعاتها، المسؤولة عن الهزيمة، التي انتجها ضعفها، وعليها أن تدفع ثمنها، وتستسلم لدور نظمها، الذي يجب أن يكون استبعادياً بالضرورة، بما أنها لا تستطيع القيام بتحرير أرضها المحتلة من “العدو”، وليس هناك من طرف آخر غير السلطة القائمة يستطيع القيام بمثل هذه المهمة، فلا بأس عليها إن هي أعطت الأولوية في خططها لخطب ود الخارج، وتحولت إلى جسور تصله ببلدانها، بعد أن كانت نقاط فصل عنه. ولا بأس طبعاً إن هي تكيفت مع القوى الدولية المسيطرة، علها تعوضها عن المجال القومي باتباعها لمجالها الدولي المفتوح، في ظرف فقد الاستقلال فيه جل وظائفه، وغدا عبئاً على الشعوب التي يثقل كاهلها ما ترتب عليه من تأخر وإفقار وإفساد، وارتبطت نجاتها بدمجها في السوق العالمية، بعد إخفاق برامج التنمية المستقلة، لأنها انفصلت عنها. إذا كان هذا التوجه الانفتاحي على الخارج يعني الانكفاء عن المجال القومي، فما هو الضرر من ذلك، إن كانت علاقاته تصبح أكثر فأكثر صفرية، وكان الوجه الخارجي مُلزِماً للجميع، بل إنه موضوع تنافس بين الدول العربية، لأن فيه نجاتها. وكانت حدود الأخوة قد اكتسبت بعد الارتداد القومي طابعاً متاريسياً، كذلك القائم بين دمشق وبغداد، وسقوط القيم القومية الجامعة، التي نهض عليها النضال العربي بعد الحرب العالمية الثانية، واستبدلت بفشل الوحدة بقيم طائفية ومذهبية نافية للمجتمع كهيئة عامة موحدة، ما لبثت أن تغذت بمذهبيات جوار ايراني/سعودي انخرط في صراع ضارٍ على ملكية الإسلام الحصرية، وحولت التدين إلى ميدان لتبادل الأحقاد، والدين إلى أيديولوجية تشجع على قتل الآخر والمغاير.
ـ أعادت ارتدادات الهزيمة الوضع العربي عقوداً إن لم يكن قروناً الى الوراء، وطوت صفحة الحدث الذي كشط سطح الحياة العربية، وحمل اسم “الثورة العربية”، وخالَ انصاره أن نظمْ القصائد وإنشاد الأغاني وتنظيم حلقات الدبكة تكفي لتأسيس الوعي الثوري، وفاتهم أن الافتقار إليه كان أهم اسباب تعثر النهضة كحامل لها، وأن الهزيمة، بالسهولة التي حدثت بها، كانت إحدى تجليات غياب الوعي الثوري، المطابق للواقع، والمؤهل لإعادة إنتاجه في معركة تحرره من ركوده وتخلفه. لم تمس “الثورة” هذا العمق، لذلك أعقب انهيار سطحها السياسي البراني بالضربة الإسرائيلية تَخَلُقْ “ثورة مضادة” من داخلها، جسدتها الأسدية السورية على خير وجه، باستنادها إلى واقع الركود والتخلف، وتعميقه باعتماد نمط سلطة معادٍ للمجتمع كحاضنة لأي ثورة، حدث الوعي التقليدي، ودهرنهُ برموز سياسية مقدسة، ولغة شعبوية مفعمة بألفاظ ثورية حجبت الارتداد، فصدّقت بعض النخب المحلية والعربية أن الألفاظ هي الواقع، واحتفت بالنظام الممانع والمقاوم، وتجاهلت أو جهلت أنه أعاد سورية إلى زمن ما قبل وطني أو قومي، ولن تقوم لها قائمة إذا لم تتخلص منه .
ـ لم ينل المعسكر التقليدي، المنتصر، ما كان لمعسكر التقدم المهزوم من شرعية شعبية، وقبول وطني وقومي. ولم ينتصر أحد من العرب على إسرائيل، في الخليج أو غيره، وإنما انتصر بعضهم على بعضهم الآخر، وخرجوا جميعهم مهزومين أمام تل أبيب، فكأنه كان للعرب رأس قطعته الهزيمة فغدا عالماً بلا رؤوس، لا مركز ولا زعيم ولا قيادة فيه، رغم كثرة من تنطحوا لزعامته وقيادته كحافظ الاسد وصدام حسين، ومن ذهبوا في الخطأ كل مذهب، ليحتلوا الموقع الذي شغر بوفاة صاحبه، وانتهى بهم المطاف على المشانق أو بعيداً عن العواصم التي حكموها بالنار والفساد، وخافوا أن يُدفنوا فيها، فيُقتلعوا من قبورهم.
ـ لم توفر الهزيمة أحداً من العرب، أو نظاماً من نظمهم. أو الذين وقفوا وراءها منهم، وطلبوا من “العدو” شن الحرب أو شجعوه عليها بتوفير شروط الانتصار فيها، فلم توفرهم نتائجها الكارثية، أو حالة انعدام الوزن التي طالت دول العرب ومجتمعاتهم، وقادتهم إلى انهيار مفصلي يدورون منذ عام ١٩٦٧ إلى اليوم في حلقاته المفرغة، التي كشفها غياب عبد الناصر، ثم تغييب مصر كدولة/ مركز كانت النموذج الأقرب الى دولة الأمة، ورأى السادات، رئيسها الجديد، خلاصها في التخلص من صفاتها النهضوية في الثقافة والاقتصاد والتنمية المجتمعية والإنسانية والدور العربي والدولي، وإلحاقها بمن سحقوا نهوضها وأعادوها إلى أوضاع تشبه ما كان قائماً فيها عند نهاية القرن التاسع عشر، حين احتلها الاستعمار البريطاني وفيردي يعزف أوبريت عايدة في دار الأوبرا الجديدة، ومواكب الافرنج يضعون بصمتهم على تفرنُج ملاكها الزراعيين واقطاعييها، وعلى هلاك فلاحيها وعمالها بؤساً.
ـ بعد الهزيمة، وسقوط أراضٍ عربية تحت الاحتلال تعادل ثلاثة إلى أربعة أضعاف مساحة إسرائيل، صاغت واشنطن معادلة حدها الأول إعادة الأراضي المحتلة إلى أصحابها، والثاني دخول العرب في طاعة البيت الأبيض، واعترافهم بإسرائيل وتطبيع علاقاتهم معها، بشروطها، والابتعاد عن المجال القومي وعن السوفيات، مقابل استقرار نظمهم تحت إشرافها المباشر وبكفالة إسرائيل، فضلاً عن انسياب إمدادات النفط المنهوبة عبر طرق آمنة تحرسها أساطيلها إلى سوق دولية تسيطر عليها. لا علاقة في هذه المعادلة للانسحاب بتطبيق القرارين الدوليين ٢٤٢ و٣٣٨، وإذا ُطبق، ففي ضوء علاقات القوى بين المعسكرين الدوليين، ومقابل ابتعاد المعسكر القومي عن مواقفه، وتقاربه مع المعسكر التقليدي، واعتماده نظم حكم مرشحة للتحول إلى نظم سلطوية بوليسية، تتمتع باستقرار “قومي” شامل.
ـ قالت واشنطن: بقدر ما تقبلون حد المعادلة الأول، وتنفذون الثاني، بقدر ما تعززون ميل أميركا وإسرائيل إلى إعادة أراضيكم إليكم، ولكن بمواقف جديدة عليكم بناء علاقاتكم ونظمكم عليها من الصلح مع إسرائيل فصاعداً، وليكن في عِلمكم أن السوفيات لن يتمكنوا من مساعدتكم على استعادتها حرباً أو سلماً، ولن يُمكنوكم من تحدي هذه المعادلة، أو وقف فعل الاحتلال التدميري في أوضاعكم، فلا خلاص لكم بغير إطاعة واشنطن، وتطبيع علاقاتكم كطرف مهزوم مع تل أبيب، وقبول ما تضعه من شروط لصيانة أمنها، بواسطتكم.
ـ لم تنطبق هذه المعادلة على الجولان، لأن نظام دمشق كان مشمولاً برعاية أميركا، ولم يطالب بتطبيق معادلتها عليه، ولم يعد منذ اتفاقية فض الاشتباك عام ١٩٧٤ وغزو لبنان في صراع مع تل ابيب، كما نفذ طلب واشنطن بارتداده منذ أواسط الستينات عن القومي والوطني إلى القطري والطائفي، وقلب سلطة الدولة إلى دولة سلطة.
ـ وكانت اسرائيل قد وافقت على معادلة أميركا، وأعلنت تمسكها بالأراضي العربية المحتلة إلى أن تعترف النظم بها، وتقيم علاقات طبيعية معها، ويفقد الاتحاد السوفياتي ما بناه من نفوذ وحضور في مصر خاصة والعالم العربي عامة، ويحدد حلفها مع واشنطن نمط العلاقات المطلوبة لدى العرب، وبنى نظمهم .
ـ حققت المعادلة الأميركية معظم مفرداتها، فقد انهار مشروع مصر النهضوي، وتلاشت أبعاده العربية، ونشأ وضع مضاد له في بلدان عديدة منذ عام ١٩٧٠، أهمها سورية، وسقطت قيادته، وطبق قرار الرئيس الاميركي ليندون جونسون حول “ضرورة تغيير حدود هدنة عام ١٩٤٩”(78) الذي نُفذ في الجولان، والقدس وسيناء، وينفذ منذ عام ١٩٦٧ في الضفة الغربية، وتخلت الدول العربية عن فلسطين وشعبها، وتركتهما وحيدين في مواجهة عدو توسعي استيطاني يلتهم فلسطين متراً بعد آخر، فيتجاهله العرب، حتى لكأن قضاءه على حق شعب فلسطين في دولة حرة ومستقلة لا يعنيهم، رغم أن زحف “العدو” في فلسطين يقربه أكثر فأكثر من بلدانهم. يحدث هذا، لأن واشنطن ربطت انسحاب إسرائيل بها، واعترفت بضم القدس والجولان إليها، وبحقها في تقرير مصير الضفة الغربية، وضربت عرض الحائط بالقانون الدولي وتجريم الاحتلال، وبقرارات الشرعية الدولية، التي تلزمها منذ نيف ونصف قرن بسحب قواتها من الجولان ودولة فلسطين.
ـ وكان النظام قد استبق الحرب بإخلاء الجولان من أغلبية سكانه الساحقة، مدعياً أن قتال الجيوش الحديثة ووحداتها الكبيرة يفرض عليها التحرك في مساحات واسعة من الارض، وبقاء الجولانيين في قراهم سيعرضهم لسلاح “العدو”، الذي سيضغط باستهدافهم على معارك جيشِ”هم” العقائدي، فلا ضير عليهم إن خرجوا من بيوتهم، ما دام جيش العدو لن يتمكن من احتلالها، فإن حدث واحتلها، أعادهم جيش ثورة الثامن من آذار إليها. ما أن بدأ “العدو” الحرب، حتى اكتفى “الجيش العقائدي” من قتاله بالفرار من الجولان، الشديد التحصين، بأمر من حافظ الأسد، الذي قرر توجيه ضربة تأديبية لإسرائيل تحرر في حدها الأدنى فلسطين، ومن الذين كانوا يخوّنون عبد الناصر قبل أيام بسبب إغلاق خليج العقبة، وحمّلوه المسؤولية عن هزيمتهم بعدها، وأعلنوا قبل الحرب أن تحرير فلسطين مسألة أيام، وخلالها أنهم شرعوا يحررونها ووصلوا إلى مشارف صفد، وبعدها أنهم لا يستطيعون مقاتلة العدو بمفردهم، وأن عبد الناصر والشعب السوري المتخلف مسؤولين عن سقوط الجولان!.
ـ احدثت الهزيمة صدوعاً استعصى رأبها في الجسد العربي، كما في كل دولة من دوله. وحققت هدفين اسرائيليين هما: ضرب عبد الناصر في مصر، والمجتمع في سورية. أما الهدف الأول، فتحقق بيد الجيش الاسرائيلي، بينما تحقق الثاني بيد حافظ الأسد، الذي بنى نظاماً مثّل نقلة نوعية في ملاقاة عصر ما بعد الهزيمة، استكمل فيه تطييف دولته العميقة وسلطته، التي ستحكم سورية كبلد محتل، علماً بأن هذا التطور السوري تلازم مع تحقيق هدف إسرائيل في مصر، وأخمد المجتمع الذي كان أكثر مجتمعات العرب قرباً من مشروع عبد الناصر القومي .
ـ أخضعت الهزيمة العرب لسيرورات شد وجذب مارستها إسرائيل وإيران وأثيوبيا، قبل أن تحل تركيا محلها بعد سقوط نظام منغستو هايلي مريم الأثيوبي عام ١٩٩١. بوقوعها بين الدول الثلاثة، وغياب المركز المصري، غدت المنطقة العربية موضوع شد وجذب بين اثنتين منها اتصفتا بنزعة امبراطورية مفتوحة على ذكريات ماضوية توسعية حافلة بمعطيات تنتمي إلى الحقبة السابقة لتشكل الدول الوطنية العربية، بينما مارست الثالثة توسعا استيطانياً نشطاً، لم يتوقف عن قضم فلسطين بالأشبار والأمتار، وتبنت أنقرة العثمنة، وطهران أمجاد فارس بذريعة نصرة الدين وإعادة التاريخ إلى مساره القويم، الذي انحرف بانتزاع حق علي بن ابي طالب في الخلافة، ورأت، شأنها في ذلك شأن تركيا، جوارها المشرقي كساحة نفوذ يسوغ انخراطها فيها، بالنسبة لأنقرة، التاريخ ودورها القيادي فيه، وبالنسبة لطهران: الاحتواء العَقدي وما يوجبه من اختراق لمجتمعات الجوار العربي، وتغيير ديمغرافي وهوياتي فيها، التزاماً من الدولتين الإسلاميتين بنهج يتفق مضموناً مع نهج إسرائيل، ويختلف أسلوباً، ويرمي مثله إلى استغلال لحظة الانحطاط الراهنة لوضع اليد على العرب.
ـ بخلو العالم العربي من مركز يحظى بحد أدنى من توافقهم، تَخَلقَ نظام تراتبي بديل مركزه الدولي واشنطن، والمناطقي إسرائيل، والمحلي نظم تابعة بهذا القدر أو ذاك لواشنطن، يستثنى من ذلك النظام الأسدي، التابع استراتيجياً لواشنطن ووظيفياً لإسرائيل. هذه التبعية المتراتبة، وظفتها واشنطن لتأسيس مراكز فرعية غطت الساحة القومية، وتولت إضعاف السوفيات، وربط العرب بمصالح أميركا، التي استعادت سيطرتها على الجنوب العربي/ الإسلامي بعد هزيمة حزيران عام ١٩٦٧ وانهيار الاتحاد السوفياتي عام ١٩٩١، على أن يتولى كل مركز منها الإشراف على بيئته المجاورة، ويربطها بالغرب، مقابل السماح له بالاستيلاء على قرارها، ولإدارة شؤونها بالتفاهم مع واشنطن، التي أناطت تولي المركز المشرقي، الذي يضم لبنان وفلسطين وإلى حد ما الأردن، بالنظام السوري، فضلاً عن تحييد العراق وإخراجه من الساحة المشرقية. حدث هذا بموافقة إسرائيل، التي تولت عام ١٩٧٦ تقاسم لبنان وظيفياً مع النظام الأسدي، وسمحت له بغزوه مقابل إغلاق باب الصراع معها إغلاقاً نهائياً، وانتهاج سياسات حياد متبادل، فلا هي تمنعه من تنفيذ سياساته في المجال العربي، ولا هو يستخدم علاقاته أو قدراته لاستئناف صراعه معها، أو تهديد أمنها، وسلام الأمر الواقع . في هذا التراتب، تغدو سيادة الدول التابعة للمركز المحلي محدودة، وتنضوي في أطره الخارجية.
ـ هذا النمط من توزيع القوى في العالم العربي، اعتمدته واشنطن بعد تجربتها في فيتنام، واتفق مع خطة العسكر البعثي ضد المركز الناصري، قبل أن يتولى نظام الأسد تنفيذه، لاتفاقه مع رغبته السابقة له بوضع يده على لبنان ومنظمة التحرير، قبل عام ١٩٧٦ ثم مباشرة بعده، وبإخراج العراق من معادلات السياسات العربية، ليضمن عدم سحب توكيل واشنطن منه، وتفويض بغداد به.
ـ بهزيمة حزيران، اختل التوازن الدولي بدوره، وبدأ حضور موسكو يتلاشى في منطقة كانت أهم مناطق نفوذها خارج معسكرها الاشتراكي. كانت موسكو مصدر سلاح سورية ومصر، الذي لم تُسددا أثمان ما فقدتاه منه خلال الحرب، وقُدر بما بين ٧٠و٨٠٪ مما كان لديهما من سلاح”(79). بالانسحاب من سيناء في مصر، بأمر من المشير عامر، ومن الجولان، بأمر من حافظ الأسد، خسر الجيشان أسلحة ثمنها مليارات الدولارات، وتلقتا أسلحة بمليارات أخرى زودتهما بها بعد الهزيمة. هذه الخسارة، اكتسبت أهمية خاصة في الصراع الدولي، سُجلت في رصيد واشنطن، التي كانت قد بلورت منذ عام ١٩٦٣ خطة لزج موسكو في سباق تسلح يستنزف مواردها المالية، ويبددها على السلاح، بدل استخدامها لتنمية اقتصادها، ورفع مستوى معيشة شعبها، وتحاشي الفخ الأميركي، الذي أودى به.
ـ في الخامس عشر من ايار عام ١٩٧١، قام السادات بما اسماه “ثورة التصحيح”، التي عرفت أيضاً بأحداث مايو، وتماثلت أهدافها مع أهداف “حركة تصحيحية” أخرى قادها الفريق حافظ الأسد، زعيم الانقلاب العسكري الذي وقع في سورية، وانضوى في الارتداد الشامل، الذي اجتاح الوطن العربي في السبعينات، وأجهز على حقبة بدأت باستقلال الدول العربية، ومرت بنشوء حركات شعبية، وأحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، ونظم برلمانية عرفت حريات نسبية، وأجهزة قضائية مستقلة بهذا القدر أو ذاك، وصحافة حرة أو شبه حرة، وبلغت ذروتها في وحدة مصر وسوريا، والنهوض الشعبي، الوطني والقومي الذي سبق قيامها. هذا الارتداد، مر بضرب منظمة التحرير وإخراجها من الأردن عام ١٩٧٠، وبالمجزرة التي أودت بعشرات آلاف الشيوعيين في السودان، وما تلى ذلك من حكم عسكري انقلب إلى نظام إسلامي التوجه، وبانقلاب حافظ الأسد في سوريا، الذي أقام نظاماً طائفياً، وانقلاب العراق الذي أطاح بأحمد حسن البكر، وانتخاب سليمان فرنجية رئيساً للبنان، واخيراً، بانقلاب السادات في مصر.
ـ لعبت هزيمة حزيران دوراً مفصلياً في تراجع علاقة السوفيات مع ما كان يسمى حركات التحرر الوطني، وكشفت خطأ تنظيره لثورة عالمية ثلاثية الركائز، إحداها هذه الحركات، التي تلقت ضربة زلزلتها وأطاحت بركنها المصري، وأدخلت المعسكر السوفياتي في أزمة أسهمت بانهياره، بينما كانت حركة الطبقة العاملة في الدول الرأسمالية تتهاوي بدورها، وكانت البلدان الاشتراكية تدخل في أزمة مستعصية، وتتمزق بالخلاف الصيني/السوفياتي.
“اللجنة ” والحزب قبل وخلال الحرب:
ـ رأى قادة “اللجنة” أن انهماكهم بالأوضاع الداخلية يستهلك معظم وقتهم وقواهم، ويعطّل تفعيل سياساتهم السورية في المجال العربي، ويحول بينهم وبين ما يتيحه لهم من أدوات لخدمة أغراضهم، وتوطيد اقدامهم في التنافس على زعامة العالم العربي مع جمال عبد الناصر، وتعظيم تأثيرهم على الخليج، وتعزيز مكانتهم الخارجية لدى الدولتين العظميين: أميركا والاتحاد السوفياتي. صحيح أنهم أداروا ظهرهم للوحدة، لكنهم لن يتخلوا عن ما في المجال القومي من فرص تزيد قدرتهم على كسب المنافسة، والتمتع بدعم شعبي عربي واسع، يمكنهم الإفادة من خزينه المفعم بدلالات ثورية قد يستطيعون قلب التوازنات العربية القائمة بواسطتها، كالقضية الفلسطينية، التي يجب استغلال رمزيتها لتخميد ما في الداخل السوري من مشكلات معقدة من جهة، وتخطي الرفض الواسع لنظام “اللجنة” من جهة أخرى، فإن عرفت كيف تتفاعل مع التعطش الشعبي إلى نصرة فلسطين والدفاع عن شعبها وقضيتها، أسهم جهدهم في تبرئة البعث ونظامها من تهمتي الغدر بالوحدة، والتآمر على عبد الناصر.
ـ بدل مُماشاة النهج العربي العام، الذي كان يدعو إلى إرجاء معركة فلسطين، ريثما يتقدم بناء الدول في المجال غير العسكري أيضاً، ويسمح بتوفير المقومات الضرورية لمعركة تعد بنتائج إيجابية، دعت “اللجنة” إلى معركة فورية لتحرير فلسطين، وأمرت جيشها بالاشتباك مع الجيش الاسرائيلي، وفتح الحدود السورية مع فلسطين أمام فدائيي “حركة فتح”. وتمسكت بانخراطها العسكري رغم تفوق العدو والتحذيرات العربية والسوفياتية من حرب خاسرة، الأمر الذي أثار أسئلة حول أهدافها سرعان ما حولها إلى شكوك التصعيد العسكري الذي خشي الجميع من أن يورط العرب في حرب لا يريدونها، وليسوا بالتالي مستعدين لها، وتمثل تهديدا جديا “للجنة” ونظامها، فلماذا تتمسك بنهج لم يعد هناك اي شك في انه سيقود الى حرب؟. أتراها كانت تعلم أن الحرب لن تطيح بنظامها، ولذلك ذهبت في القتال إلى تصعيد قربه يوميا من حافة الحرب؟. وهل كان ما قررته هو حقا الأسلوب الوحيد المناسب لبناء نظام سلطوي/شمولي يغير بنية الساحة السياسية، ويقوض أطرافها، ويجبر السوريين على العيش تحت السقف المنخفض الذي ستحدده لهم، ويكون القبول به والانتماء إليه معيار الوطنية والقومية والثورية؟.
ـ أفاد النظام في خططه وأفعاله من اختلافه عن أي نظام سبقه، ومن خديعة استراتيجية مررها عسكره على السوريين وغيرهم، بأن وجهوا أنظارهم نحو أهداف غير تلك التي قرروا تحقيقها، وأوهموهم أنهم سيحققون بأسلوبهم الصِدامي الأهداف التي فشلت النظم الأخرى في تحقيقها، ويتوقف على النجاح المؤكد فيها تحقيق الوحدة والحرية والاشتراكية. تلك كانت الوعود الخادعة، ولكن الفاعلة، فالسوريون انتظروا في اغلبيتهم نظاماً يستأنف سيرهم إلى الوحدة، فكيف لا يؤيدونه إذا كان يعدهم بالحرية والاشتراكية أيضاً؟. بوعود العسكر ومعركتهم المفتوحة مع إسرائيل، بدا وكأن الرد على الانفصال سيكون في فلسطين، وسيجتث الكيان الغاصب الذي يجثم كالكابوس على صدر العرب، ولعب دوراً خطيرا في كبح تقدمهم ووحدتهم. وقد أضفى ملمحاً ثورياً على الصراع وواقعة أن من يقومون به ضباط قوميون اشتراكيون، وينتمون إلى بيئات شعبية متواضعة تقربهم من شعب يرغب مثلهم في تحرير مجتمعاته بعد تحرير فلسطين.
ـ تبين حجم الخديعة، عندما انقلبت الوعود إلى نقيضها . لكنه كان قد سبق السيف العزل، وصار من الصعب التخلص من نظام اختلفت مفرداته التطبيقية وبنيته عن أي شيء سبق لهم أن عرفوه، وتحدى قدرتهم على فك رموزه أولاً، ثم على مجابهته، فيما بعد. هذه الخدعة، تم تمريرها لأسباب منها أن أحداً من السوريين، مواطنين وأحزاباً، لم يكن يتوقع نجاح فريق سياسي، فما بالك بضباط لا خبرة سياسية لهم، في بناء نظام يمكن أن يأتي بالقدر الذي خبروه لاحقاً من الاختلاف عن النماذج السياسية التي قدمت لهم، وانضوت جميعها في أحد النظامين الدوليين السائدين: الرأسمالي أو الاشتراكي، واستندت إلى أسس ومبادئ اختلفت في بعض التلاوين، لكنها لم تخرج عن خيارات الاقنوم الثلاثي، التي قيل لهم إن النظام سيبنى بأسلوب يتكفل بتحقيقها، انتظر الشعب أن تقيمه “اللجنة”، لكن ما حدث هو أنه سقط فريسة وعود استهدفت صرف أنظاره عن البنية التي أرادت “اللجنة” إقامتها، وكان نجاحها في ما قصدته هو الخديعة الأكبر التي تعرض لها الشعب السوري وقواه السياسية في تاريخهما الحديث والمعاصر، وأنّجزت على مستويين: ظاهري يشبه ما اعتمده غيرهم فيما يتعلق ببناء السلطة والسياسات التي اتبعوها، وخفيّ وبالتالي سري، يعتبره عامة السوريين “باطني”، تبين لاحقاً أنه المستوى الذي قرر هوية النظام الجديد، ومثل وعده الحقيقي. صحيح أن الشعب توجس من العسكر، إلا أنه ثمّن موقفهم من عفلق، وقال مهدئا هواجسه: “اللجنة” عسكر، لكنهم سيعملون في النهاية كسياسيين، وسيكون لدينا الوقت لمحاسبتهم، انتخابياً أو انقلابياً، ثم أنهم اطاحوا بأعداء الوحدة وعبد الناصر، الذي لا بد أن يكونوا متفقين معه على الشروع في معركة فلسطين، رداً على “مؤامرة” الانفصال. وهكذا، لم يفكر حتى أكثر المراقبين تشدداً حيال البعث و”اللجنة” أن عسكرها سيبادرون إلى تركيز عملهم على المستوى الخفي، وسيقيمون بنية دولوية وسلطوية مغايرة جذرياً لما عرفته سورية بعد استقلالها، وتُنافي بأشد الصور جذريةً مع الوحدة والحرية والاشتراكية، وكل ما كان عسكر “اللجنة” يعدون به، من خلال مفرداتهم المؤدلجة سياسياً، والتي بزت في ثوريتها وكثافة خطابها ما تبنته الأحزاب السورية خلال الحقبة شبه الليبرالية بين عامي ١٩٤٦ و١٩٥٨، بما في ذلك أحزاب الفئات البينية، وأقنعت قطاعات واسعة من المواطنين باستحالة أن تكون لهم مقاصد خفية أو خاصة، في ظل اللغة التي يستخدمونها والالتزامات التي يقطعونها على أنفسهم، ومبادرتهم إلى تنفيذ وعدهم الفلسطيني، فإن حدث ووقع خطأ أو خداع ما، أو حادَ النظام الجديد عن النهج الذي تمليه الأقانيم الثلاثة ومرحلة الانتقال التي تمر بها المنطقة عامة نحو نظام يتفق مع وعود سلطة العسكر، أمكن التصدي له وإصلاحه، بما للتيار القومي/الاشتراكي، الذي يتجاوز “اللجنة” وعسكرها، من انتشار وجهود منظمة، منها نظام المؤتمر الذي عقدته أطراف الثورة الجزائرية في طرابلس عاصمة ليبيا عام ١٩٦٢، لبلورة مشتركات سياسية/مجتمعية تقبل التطبيق في الجزائر وغيرها من البلدان العربية، و”لرسم سياسة تتبنى الاشتراكية كوسيلة للتنمية الشاملة، وتشييد دولة عصرية على أسس ديمقراطية”(81)، ثم المؤتمر الذي عقد عام ١٩٦٧، عام الهزيمة، في عاصمة الجزائر، وحضرته “أطراف شيوعية واشتراكية وبعثية يسارية استبعد عنها بعث عفلق في العراق بتهمة يمينيته”(82). وقد لعب ممثلو بعث “اللجنة” دوراً نشطاً في اللقاءات التحضيرية، وأداروا اسطوانتهم الثورية والوحدوية والاشتراكية، فقد أسهم دورهم “القومي” هذا في خداع السوريين وأحزابهم.
ـ ومع أن أغلبية السوريين قاطعت نظام “اللجنة”، بسبب قمع الشارع الناصري، وانكشاف موقفها من عبد الناصر والوحدة، الذي كان ضد نظام الانفصال دون أن يكون مع الوحدة، كما خال مراقبوه في حقبة سيطرته الأولى، فإن السلطة التي واجهتهم لم تكن سلطة حزب، بل كانت سلطة جيش يتطيف، تلاعبت بضعف المجتمع، الذي خرج للتو من تجربة وحدوية ساندها بما يشبه الإجماع، لكنه خرج مهزوماً منها، مثلما هزمه فيما بعد النظام الانقلابي، وقوض البنية السياسية التي مثلت فئاته، وانفرد بالحكم وجعل لإخراجه من السلطة ثمناً فادحاً، لأن خروجه لن يقتصر على عدد محدود من الضباط، بل سيتطلب الإطاحة بمجموعة بشرية كبيرة نسبياً تشاركهم السلطة، وتتمسك بحكمهم لاعتقادها أن الضرر الذي يترتب على أخطاء “اللجنة” هو أقل بكثير من الضرر الذي سيلحق بها، في حال خرجوا أو أخرجوا من الحكم. بذلك، صار بقاء السلطة مسألة تتخطى المجال السياسي إلى المجال المجتمعي، لأول مرة في التاريخ السوري المعاصر، وغدت وسيلته الوحيدة معركة بين السوريين وضمن مجتمعهم، وليس فقط بينهم وبين جماعة من العسكر على السلطة السياسية.
ـ ومع ان سياسات “اللجنة” في المجال القومي أقنعت أغلبية السوريين أنها أشد سوءاً من “بعث” عفلق، فإن استعادة الحراك المجتمعي الواسع، واستئناف النشاط الحزبي والإعلامي الذي سبق وحدة عام ١٩٥٨، كان قد غدا ضرباً من الاستحالة، بعد قمع حركات الاحتجاج في دمشق وحمص وحماه وحلب بين عامي ١٩٦٣و١٩٦٥، واقتناع القطاعات الأوسع من السوريين أنهم أمام وضع لن يحجم عن استخدام القوة المسلحة ضدهم، وإن مواجهته تتطلب إعادة نظر جدية في أفكارهم وخبراتهم، وإيجاد طرق فاعلة لمغادرة ساحته السياسية إلى ساحة بديلة تكون من صنعهم، لن ينجحوا في اقامتها ما لم يبنوا أحزاباً وتنظيمات تستطيع قيادتهم، في ظل امتلاء الساحة العامة بأجهزة المخابرات وحاضنتها ما قبل المجتمعية وجيشها وحزبها، على أن تطور بنجاح خططاً عملية تستهدف إحباط الممارسات التي تشرعن حرمان المواطنين من حقهم في أن يكون لهم حقوق، وتحميهم من سجون غصت طيلة أعوام بعشرات الآلاف منهم، وترد عنهم غائلة دولة عميقة تمنع تنظيم المجال العام بالعنف، الذي اعتمدته دوماً كأداة وحيدة لضبطه(83) .
___________
هوامش:
(77). ياسين الحافظ: الهزيمة والايديولوجيا المهزومة، دار الحصار ، دمشق ١٩٩٧، الصفحة ١٧٤.
(78). جان دزيد زيك وتادوز والشنوفسكي : الاسرار والخفايا السياسية لحرب الايام السنة ، ترجمة منصور ابو الحسن، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٢، صفحة ١٨٧.
(79). محمد عبد العاطي: الخسائر البشرية والعسكرية لحرب ١٩٦٧. موقع الجزيرة نت.
(80). منيف الرزاز: التجربة المرة، الصفحة ١٢١.
(81). نجدة فتحي صفوة: هذا اليوم في التاريخ، مؤتمر طرابلس ، المجلد الأول، دار الساقي، بيروت، ٢٠١٦.
(82). جلال الطالباني، حوار العمر ، موقع كسيبير ٢٤، ٨/١/٢٠١٩.
(83). على عكس الوضع في البلدان الحرة حقا، حيث تخلى الفرد عن حقه في العنف للدولة، فأخرجته من المجالين الفردي والعام، واستبدلته بتقنيات سلمية كالتسويات والمصالح المتبادلة والحوارات والتوازنات والالتزام بسيادة القانون كسيد وحيد يخضع له جميع من في الدولة، وخاصة ذوي المسؤوليات العليا، الذين هم قبل وبعد كل شيء موظفون عامون.
………………..
يتبع.. الحلقة السابعة عشر: ارتدادات الهزيمة والصراع على السلطة وهي الأخيرة من الجزء الثاني
«ميشيل كيلو»: كاتب وباحث ومحلل سياسي سوري

التعليقات مغلقة.