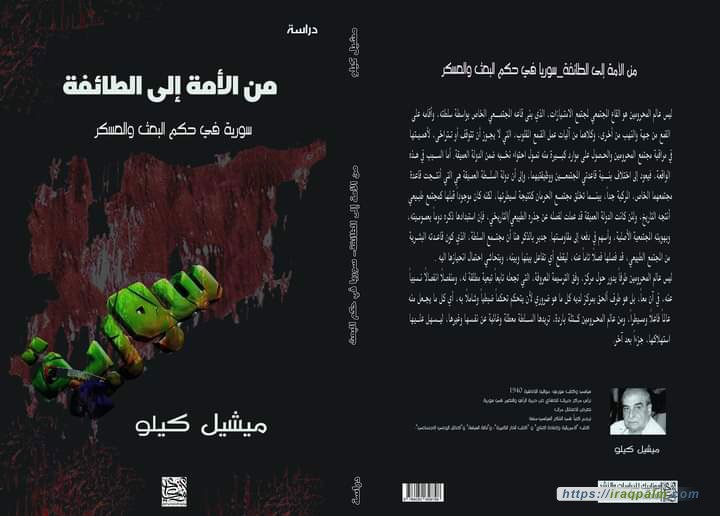
( الحرية أولاً ) ينشر حصرياً كتاب «من الأمة إلى الطائفة، سورية في حكم البعث والعسكر» بأجزائه الثلاثة كاملاً للكاتب الأستاذ: ’’ميشيل كيلو‘‘.. الحلقة الثانية عشر: تطورات سبقت الحرب (“ب ـ عربياً” و”ج – دولياً“)
من الأمة إلى الطائفة
سورية في حكم البعث
قراءة نقدية
ميشيل كيلو
باريس ٢٠١٧/٢٠١٩
ب ـ في المجال العربي
١ـ السعودية والخليج:
ـ بقصر خط وسياسات الوحدة العربية على “البعث” وما أدى إليه من انقسام نهائي في ما كان بالأمس “الصف القومي”. وبانصراف عبد الناصر إلى شؤون مصر الداخلية، لمواجهة الأخطار التي أخذت تحيق بنظامه، راقب المعسكر التقليدي بارتياح تصاعد الصراع بين حزب يمسك بدولتين هما عماد المشرق، وتربطهما حدود مشتركة مع بلدانه، وبين مصر بسياساتها التي مثّلت تهديداً داخلياً لنظمه، وبصورة خاصة لنظام المملكة العربية السعودية، التي أيقن قادتها أنهم أمام فرص جدية للفوز على خصميهما، إن أعطوا الأولوية لمواجهة الناصري منهما، لكونه مصدر الخطر الأكبر عليهم، ويمكنهم الاستقواء بنظام “البعث” عليه، والعمل لتقويض تماسك مصر الداخلي، بإقامة علاقات خاصة مع أطراف من نظامه، والإفادة من نقاط ضعفه التي كشفتها الهزيمة، وأدت إلى تنامي حركة شبابية تطالب بإصلاح يقيّد الحكم الفردي ويطلق الحريات العامة، وصولاً إلى علاقة جديدة بين معسكر تقليدي متماسك وثري، ونظام ناصري تلقى ضربة عسكرية زلزلته سياسياً واجتماعياً، ويمكن استغلال هزيمته لدفعه إلى خيارات تبعده عن الخط الذي اعتمده قبل فشل الوحدة، وتقربه من مواقف مشتركة مع دوله التي يحتاج إلى دعمها المادي وعلاقاتها الوثيقة مع واشنطن، ومن الخطأ أن تضن عليه بما هو بحاجة إليه، لأنه قد يسهم بتنامي نفوذ الإسلاميين في الشارع المصري، إن رعته المملكة أمكنها اختراق مصر، بعد عقد ونيف من محاولاتها اختراق الخليج باسم ثورة لم يبق منها الكثير، أفقدها سقوط الوحدة زخمها، وكادت تسقطها هزيمة حزيران.
ـ وزاد من اتجاه السعودية إلى انتهاج سياسات تتراوح بين المجابهة الدينية الواعدة، والاختراق الودي بذريعة إخراج مصر من مأزقها، وجذبها إلى مسارات تضع زمام المبادرة في يد المملكة، وتخرجه من يد عبد الناصر، عبر طرده بالقوة من اليمن، والإمعان في تفكيك المعسكر القومي، واستبدال ما كان يجمع أطرافه بصراع يتصاعد بقدر ما ينخرط “البعث” في “تحرير فلسطين”، و”بناء الاشتراكية”: ميداني المعركة السياسية، التي فتِحت ضد عبد الناصر قبل حرب حزيران، وينأى بنفسه عن المشاركة بالخيانة في حرب الاستنزاف، التي بدأها في الأيام الأولى من شهر تموز عام ١٩٦٧.
٢ـ سورية والعراق:
ـ بالنهج الذي اختطه عفلق بعد الوحدة، وشجع خصومه في “اللجنة”، وتلامذته في العراق على مصادرة “البعث” باعتباره “الحزب الوحيد المؤهل لقيادة الأمة العربية، ورفض الأحزاب والأنظمة الحاكمة لأنها رجعية، والتيارات اليسارية والشيوعية لأنها ترتوي من نبع غير عربي”(4)، ويتحمل عبد الناصر المسؤولية عن الانفصال، بالنظر إلى أن “علاقته المركبة بالبعث هي التي أدت إلى وقوع الانفصال على أيدي عسكريين سوريين”(5).
ـ تلقف ضباط “اللجنة” فكرة عفلق وطبقوها ضده ولسان حالهم يقول: إذا كان “البعث” هو الحزب الوحيد المؤهل لقيادة الأمة، لماذا لا يكون مؤهلاً لقيادة سورية، وما حاجته عندئذ إلى عفلق، الذي أثبت افتقاره إلى أهلية قيادته خلال الوحدة والفترة القصيرة التي تفاقم خلافهم معه خلالها بعد “ثورة” الثامن من آذار، وانتهت بحكم الإعدام الذي صدر عليه، تأكيداً لنهائية القطيعة معه كشخص وفكر، ومع حزبه كتنظيم.
ـ لكن التلامذة في الدولتين البعثيتين اللاحقتين ورثوا رغبة عفلق في ما اتهمه عبد الناصر خلال محادثات الوحدة الثلاثية به عام ١٩٦٣، وأوردته الدكتورة هدى عبد الناصر في الجزء الخامس من كتابها عن والدها، وهو “تقسيم مناطق النفوذ واحنا عندنا منطقة نفوذ في مصر، وهو عنده منطقة نفوذ في سوريا”(6) وأن يكون الحزب بالتالي نداً لعبد الناصر وحاكماً للإقليم الشمالي، كما كان اسم سورية خلال الوحدة، على أن يحكم رئيس دولة الوحدة الإقليم الجنوبي (مصر)، أو يكون الحزب ما أسماه سامي الجندي في كتاب “البعث”: “عنصر فوضى، ويشدد تهجمه على حكم الجمهورية العربية المتحدة”(7).
ـ تبنت “اللجنة” نهج عفلق الذي أحل الحزب محل الوحدة واعتبر مجرد وجوده تجسيداً لها، فأحل قادتها سلطة دولتهم العميقة محلهما، قبل أن يقدموا قائمة مطالب لخص سامي الجندي نتائجها بالقول: “إن محاسبة المسؤولين عن حل الحزب، والمطالبة بإفساح المجال لبروز قيادة جديدة كان يعني فصل الأساتذة الثلاثة من البعث، بينما عنى رفض التعاون مع من تعاون مع الوحدة إن ضباطها اصبحوا هم وحدهم الحزب”(8).
ـ ترتبت نتيجتان على استيلاء البعث على السلطة في سورية والعراق، هما:
ـ أولاهما: الفصل النهائي لمجال الدولتين الداخلي عن بعده العربي، ولبعدهما الوطني عن تشابكه القومي. وتبني سياسات تعزز البعد القطري للسلطة كساحة قائمة بذاتها، وكحامل نهائي للدولة البعثية ليس توطيد نظاميه ممكناً دون فصله عن أي بعد شعبي داخلي حر، أو أمّوي عربي، ما دام القطري يجب أن يبقى حاضنة وحيدة لسلطة يقتضي ترسيخها الامتناع عن إرسائها على ما كان عفلق يدعو إليه قبل الوحدة من أولوية الوحدوي والقومي، وإسنادها إلى كيانات ما قبل مجتمعية، تنبثق عنها روابط محلية وهويات دنيا على صعيد حواملها الداخلية، دون أن تمس بوحدة أجهزتها في مستوى السلطة العليا، الضرورية لإقامة نظام سياسي من طبيعة نوعية يتغذى من قطريته، التي ستنضوي في بنى شمولية وتسلطية تفكك الهيئة المجتمعية العامة كجسد موحد، وتعيد إنتاجها بجهود دولة عميقة مُطيّفة، تختلط فيها مكونات جهوية، وقبلية، وأسرية، وعشائرية … الخ، تتبنى آليات عمل مغايرة لما عرفته دولة ما قبل البعث، الرجعية والانفصالية، ومن أساليب في الحكم والإدارة، التواصلية والمفتوحة على حقل سياسي تعددي .
ـ بالهوة بين القطري والوطني، التي لن تسمح أجهزة الدولة العميقة لأي جهة بتجاوزها، وبالارتداد من الأمّوي إلى ما قبل القطري كبيئة سلطوية مُطيّفة وموحدة، سيغلق النظامان العراقي والسوري إغلاقاً تاماً دروب الوحدة بين قطريهما وحزبيهما “الوحدويين”، وستحول سياساتهما دون تطبيع علاقاتهما، وستقطع ما يربط مواطنيهما من أواصر ومشتركات تاريخية وراهنة، وستغلق في النهاية حدودهما .
ـ لنتذكر الآن أن عفلق رفض دوماً القطري وأدانه لكونه يحتجز القومي. وها هو الجيل الجديد الذي علق آماله عليه يعيد العراق وسورية إلى حال ما قبل مجتمعية، بسلطة قطرية حواملها كابحة ونافية لما يناهض القطرية كخيار استبدادي عنيف ومغلق، يخشى المجتمع لأنه يحمل نزوعاً طبيعياً إلى التفاعل الاندماجي، ويكون منفتحاً بالتالي علي نزعة وطنية وقومية طبيعية. الغريب، أن عفلق تعامى تماماً عن هذه الاحتمالات الواقعية، التي كان يمكن أن تترتب على ارتداده عن القومي وتجاهله للوطني في البدائل والسياسات القطرية القائمة، ولم ير غير الاتجاه من القطري إلى القومي، بينما كان القطري يقاوم وينتكس في كل مكان. وحين فقأ الانحراف الأعين، لم ير في ما يجري أحد تطبيقات أفكاره في فترة ما بعد الوحدة، بل اعتبره بكل بساطة انحرافاً عنها، انخرط فيه “خونة” الحزب في سورية، ونجا منه المخلصون له في العراق، متغافلاً عن التماهي شبه المطلق بين نظاميهما.
ـ هذا “الانحراف”، الذي ترتب على ترجمة أفكاره في الواقعين السوري والعراقي، كان الضربة الثانية التي تلقاها عفلق بعد فشل الوحدة، واستهدفت ما تعلمه من دروسها وعِبَرها، وأظهرت كم كان مخطئاً فيها أيضاً، وفي حساباته السابقة للوحدة، التي وجه فشلها ضربة أولى مؤثرة إليه، بينما قضت الثانية عليه بأيدي تلامذته المنحرفين والمخلصين، الذين خرجوا عن نصه، الذي قال في مقالة “عهد البطولة”: “الآن تنطوي صفحة من تاريخ نهضتنا العربية وصفحة جديدة تبدأ، تنطوي صفحة الضعفاء، الذين يقابلون مصائب الوطن بالبكاء، وصفحة النفعيين… والجبناء، وتبدأ صفحة الذين يجابهون المعضلات العامة برودة العقل ولهيب الإيمان، ويجاهرون بأفكارهم ولو وقف ضدهم أهل الأرض جميعاً، ويسيرون في الحياة عراة النفوس… هؤلاء هم الذين يفتتحون عهد البطولة… لأن النشأ الذي يتأهب اليوم لدخول هذه المعركة له صدق الأطفال وصراحتهم، فهو لا يفهم ما يسمونه سياسة، ولا يصدق أن الحق يحتاج إلى براقع، والقضية العادلة إلى تكتم وجمجمة”(9). كتب عفلق مقالته هذه عام ١٩٣٥، في الفترة التي ولد فيها “جيل البطولة”، الذي جزم أنه سيدشن عهدها، لكنه وجد نفسه يقول بعد ثلاثين عاماً، إثر انقلاب عام ١٩٦٦، الذي قام بها ضباط من هذا الجيل: “إن ما فعلوه هو انحراف خطير وعدوان على شرعية نضال لا يجوز أن يُبرر أو يُفسر إلا من خلال الظروف العربية والدولية الراهنة، ظروف الردة الاستعمارية، لذلك ليس حكم (هؤلاء) المنحرفين حكم البعث، وليست ثورتهم ثورة البعث، ولا أهدافهم أهداف حزبنا وشعبنا، ولا أخلاقهم أخلاق حزبنا وشعبنا”(10).
ـ وثانيتهما: تشظي المجال المشرقي وخروجه عن ما كان بين دولتيه السورية والعراقية من علاقات تاريخية وطبيعية، وامتلائه بنقطة ارتكاز مَثّلَها النظام السوري، أريد بها موازنة ثقل العراق وتحييد قدراته، وزيادة وزن البعث السوري بحيث يتمكن من تأسيس وزن مقابل له، يسهم في تفكيك المشرق وزجه في صراعات مفتوحة على عنف شامل، حال بين دولتيه وبين إقامة جبهة شرقية تضم الدولتين والأردن وفلسطين، وتنسق مع جبهة مصر الغربية، وتسهم في بناء ميزان قوى يعزز فرص تطبيق القرارين الدوليين ٢٤٢ و٣٣٨ حول انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام ١٩٦٧، وأسهم غياب فرصها في فتح ابواب الدولتين والمشرق أمام الخارج، الذي استعاد بعد سقوط الوحدة وحرب حزيران كثيراً مما كان قد فقده بعد الحرب العالمية الثانية، في حين كان من شأن إقامة هذه الجبهة أن يفيد من ما تمتلكه الدولتان من قدرات بشرية يناهز عددها الخمسين مليون، وعسكرية تضم جيشين يبلغ عددهما قرابة مليون جندي وضابط، ومن ثروات طبيعية وزراعية، وخبرات لدى طبقاتهما البينية، المتعلمة والحديثة، ومن ما بين الدولتين والشعبين من تكامل في كل ما هو ضروري لمعركة تساند في سورية حرب الاستنزاف الدائرة على قدم وساق بين مصر وإسرائيل، وتمثل نقلة نوعية في الكفاح الوطني الفلسطيني، الذي مر بلحظة تحولية بعد معركة الكرامة، التي وقعت يوم ٢١ آذار من عام ١٩٦٨، وتلقت إسرائيل خلالها ضربة مؤلمة أسهم الجيش الأردني فيها، الدور البارز في مواجهة العدو منذ عام ١٩٦٨، لكن القيادتان العراقية والسورية اكتفتا من التحرير ورد العدوان بحربهما الكلامية ضد المتصهينين العرب، الذين توعدهم النظام السوري يومياً بحرب تحرير شعبية لا تبقي ولا تذر، في حين كانت طائرات إسرائيل تتنزه باطمئنان في الأجواء السورية.
ـ هذا التطور الانحداري الشامل والعميق، الذي استند إلى ايديولوجية واحدة تستخدم لغة واحدة، وتقرأ الواقع العربي بطريقة واحدة، وتتخذ مواقف واحدة حيال الآخرين، وأحدهما حيال الآخر، حملت سمات محيرة طرحت علامات استفهام مفعمة بالغموض، جعلت بعثياً قديما كسامي الجندي يقول في وصف نظام البعث السوري: “مُحال أن يحيط العقل بأحداث حكم آذار وتطوره، لأنه ضد كل عقل وكل منطق، وأزال كل القيم وكل ما يحدد الروابط الاجتماعية”(11)، ولو أن طبق قولته على “ثورة الثامن من شباط عام ١٩٦٣” في العراق، لما جانبه الصواب .
ـ بانقلابه على الوحدة، وبالصراع بين حكومتي “البعث” في العراق وسورية، نشأ نظام ليست “الوحدة والحرية والاشتراكية” بين رهاناته، وانصرف بكامل طاقته إلى فرض خياراته على المجال القومي، بما في ذلك على عبد الناصر، الذي وجد نفسه أسير قطيعة كتلك التي تبناها البعث بين وطنيته وقوميته، وفي مواجهة تحديات معادية للعرب أهمها نزعة هوياتية فرعونية، وتعزيز أوضاع نظم الخليج بقطرية “البعثين”، التي انضمت إلى ردها على الزمن القومي، وأسهمت في تراجع دور مصر العربي، وأضعفت ما كانت قد اكتسبته من مناعة نضالية، ومكانة عبد الناصر في السلطة، وحرضت قطاعات مؤثرة من دولته العميقة ضد نهجه القومي، وما اقترن به من خسائر بشرية وتكلفة مادية ومعنوية في اليمن بصورة خاصة .
ـ هذا التحول الاستراتيجي والعميق، الذي أعاد طرح مسائل السياسات الوطنية على أسس مغايرة لما اعتمدته بعد الحرب العالمية الثانية وتكون النظام العربي، وأتاح للتقليدية أن تعيد إنتاج نفسها في حاضنة “قومية” جديدة، سرّعه موقف واشنطن العدائي حيال القاهرة، الودي تجاه العسكر السوري، الذي بدا أن تل أبيب وعواصم الغرب تدعمه، لسبب أفصح عنه رئيس وزراء إسرائيل ليفي أشكول بقوله: “إن إسرائيل ترفض قيام وحدة أو اتحاد بين الاقطار المجاورة”(12)، يرى أن ترسيخ الانسداد القومي سيوقع عبد الناصر في مأزق لن يخرج منه دون تخليه عن دوره خارج مصر، في الوقت الذي تخرجه “اللجنة” خلاله من المشرق، وتُسّحق الحركة الشعبية الموالية له، وتُغلق حقبة العمل القومي، وتنتهج سياسات تسهل اقتناص الدول العربية كل واحدة منها على حده، وتفاقم انقسام العرب إلى دول يكاد بعضها يكون خالٍ من السكان، لكنه يمتلك نفطاً وثروات طائلة في مصارف الغرب، وأخرى غارقة في فائض سكاني لا يني يتزايد، مع أنها تفتقر إلى الموارد اللازمة لإطعام مواطنيها، ويعني عزلها عن بيئتها العربية ممارسة ضغط مزدوج عليها، من داخل بلدانها، ومن خارجها العربي بقطاعيه البعثي والتقليدي، الذي حول بيئتها القومية إلى ساحة تشتعل بصراعات قوى متنافية/ متعادية، وأطفأ ما كان في بيئتها الشعبية من تفاعل ايجابي مع القضايا العامة عامة، وعبد الناصر خاصة، رغم أنه لم يبدِ أي اهتمام بتنظيمها ووضع خطط عمل وبرامج لها، تجعل منها قوة داعمة له، ومدافعة عن حقوقها.
ـ نجح البعث في إلزام عبد الناصر بخياراته، فأخضع المسألة القومية لأولوية نظامه، وأوقف التفاعل الإيجابي بين السياسات الوطنية ومآلها الوحدوي، وارتد عن وطنيته العربية الأبعاد إلى قطرية إقصائية ونافية لأي نزوع أمّوي، وتعايش مع التطورات الانكفائية في المجال السياسي، التي لعبت دوراً مباشراً في إفشال رده الاشتراكي على تكيفه مع تخليه عن نهجه الوحدوي وسياساته الاشتراكية والعدالية المرفوضة من بيروقراطيته الغارقة في الفساد، والمتمترسة في مواقع دعمت من خلالها ما كان نظامه ينتجه من طبقة سلطة سئمت مغامراته العربية، ومعاركه الدولية، ونمت سلطتها وثرواتها، التي كانت تتنامى طرداً مع تعاظم فقر عشرات ملايين المواطنين .
ـ بالتحول “البعثي” في مصر، الذي لم يُقدِر عبد الناصر خطورته، بل انصاع له؛ وإرساء سلطة “اللجنة” في دمشق على أرضية طائفية، والصراع البعثي/البعثي بين سورية والعراق، دخل الوطن العربي في حقبة انكسار واحتجاز سياسي متعددة الأبعاد والمظاهر، وتلاشت بذور ما كان يبدو تحولاً نهضوياً نسبياً، وتجمعت عوامل انخراط العرب في مشروع ضد نهضوي، بدأه عسكر دمشق، وانضم إليه انور السادات بمجرد أن طويت صفحة الناصرية بضربة خارجية فرطتها من الداخل. بتصعيد مواقف بعث “اللجنة” ضد عبد الناصر، انتقل مركز ثقل التناقضات العربية إلى المحور السوري/المصري، فاستخدم طرفاه أشد أساليب الإقصاء في صراعهما، الذي تراجعت هدنه الظاهرة أمام معاركه الخفية، بعد ان دعم عفلق نظام الانفصال واشرك حزبه في حكوماته، وانصرفت لجنة “الثورة” العسكرية للإيقاع بمصر، قبل أن تتعاون مع خصومها دون تمييز، مثلما اتضح خلال التحضير لحرب حزيران وبعدها، عبر تطابق مواقفها وخطابها مع مواقف وخطاب بلدان الخليج، وتعاونها معها على عزل مصر وتضييق الخناق عليها، وعملهما الذي قُلِب سياقاً تراجعياً دشنه الانفصال، إلى مسار انهياري عَرّضَ مصر، رافعة العالم العربي السياسية والعسكرية، والطرف الأكثر قدرة على قيادته وتسوية منازعاته، لهزيمة أودت بالناصرية، وأسقطت القاهرة في بئر سيكون خروجها منه مستحيلاً بقدراتها الذاتية، واحدثت انهياراً متتابعاً طال جميع دول ومجتمعات العرب، بما في ذلك نظام “اللجنة”.
ـ بانطفاء شمعة النهضة التي غمر نورها الخافت العالم العربي بالأمل، وعبأ ملايين المواطنين وراء قيم حداثية وتجديدية عابرة للدول، لأول مرة منذ ألف عام في التاريخ العربي/الإسلامي، تقلص حضور ونفوذ مصر العربي، وبعد أن كانت مركز إشعاع سياسي تحديثي، تحولت منذ سقطت الوحدة إلى نقطة تكثفت فيها ضغوط وتحديات مارسها عليها الغرب والشرق، وشارك فيها طرفان عربيان ودوليان متناقضان إلى أبعد الحدود، تلازم توافقهما مع تصعيد عسكري سعودي/ إمامي في اليمن، حوّل دورها فيه إلى مصدر خلاف صامت في أروقة سلطتها، لكنه عميق ومتربص، تجلت قسماته بوضوح بعد غياب الرجل الذي كان يحجب بقامته الكبيرة ما في نظامه من تهافت وفوات .
ـ بقصر المجال القومي علي كل حزب منهما، شارك البعثان في تقويض فرص التفاعل التكاملي بين دولتي سورية والعراق الجارتين، ومع العالم العربي، وقاسا أي علاقة ببعضهما ومع العرب بمعيار وحيد، منطلقه ومآله تعزيز سلطة كل منهما، وتمسكا بتطور واحدي الاتجاه، يجب أن ينطلق منهما ويبقى متمحوراً حولهما في جميع الظروف والأحوال. بذلك، واجها خيارات ملزماً فيه نجاتهما هو انكفاؤهما على ذاتيهما، واتخاد مواقف متوجسة تجاه الآخر العربي، وخاصة منه ذاك الذي أرادوا انتزاع زعامة الأمة منه، وانقذته الشعوب العربية من فخ حزيران، وأحرجهما بحرب الاستنزاف ضد المحتل الإسرائيلي، بعد أيام قليلة من وقف إطلاق النار، وتوصل في مؤتمر القمة بالخرطوم إلى ما بدا أنه تهدئة مع السعودية، بقي البعث السوري خارجها، مستقوياً بشعاراته الصارخة، بينما غرق بعث العراق في صراعات تخللتها انقلابات دعمتها تياراته المتناحرة، وتعاونت فيها مع اطراف معادية لمختلف فئاته واجنحته، كعبد السلام عارف وشقيقه عبد الرحمن .
ـ أي تقدم من الطائفية إلى القومية سيكون ممكناً، في تغييب المجتمع عن الحقل السياسي، وإسقاط المرحلة الوطنية من العمل العام وخياراته؟. ومن سيمنع انحدار النزعة القطرية إلى نزعات احتجازية من نمط تفتيتي يطال المجتمعات والدول، في ظل تنكر “البعث” للمواطنة والحريات الديمقراطية، والدستور والقانون، والسيادة الشعبية كمصدر ومرجعية للشرعية، و”الإرادة العامة” كمعيار لصوابية القرارات السياسية، التي أدرجت البعد القومي بالأمس القريب ضمن مسؤولية الشعب الوطنية؟. وكيف ينفتح القطري الجزئي على القومي الكلي، إن أغلقت الطائفية جسور العبور التي تصلهما جدلياً أحدهما بالآخر، ولم يعتبر التحرر القومي معيار سياسات الأقطار وعلاقاتها؟. وكانت أهداف ومواقف البعث تنحدر مذ أمسك بدولتي سورية والعراق إلى ما دون مستوى من دأب على إدانتهم بحجة أنهم انفصاليون ورجعيون، قبل أن يتبين أنه أشد انفصالية ورجعية في موقفه من السياسة ومبادئها وقيمها وفاعليها منهم، وأنه قوض ما كان إيجابياً في نظمهم، وخاض معركة وجود ضد من تكيف السوريون منهم معه: حراك المجتمع المستقل وجمال عبد الناصر: معبود عفلق، الذي كان سَيَكل إليه قيادة “البعث” بالأمس القريب، وأخذ يصارعه بضراوة وحقد منذ عام ١٩٦٠، متجاهلاً ما قد ينجم من كوارث عن إضعافه أو إسقاطه بالنسبة للمنطقة بأسرها، بما في ذلك أوضاع نظامي دمشق وبغداد.
ـ كان انهيار الوحدة حدثاً داخلياً، ولم يكن فقط نتاج المؤامرات الخارجية، ولم يكن الذين أسقطوها من الضباط قوة متماسكة، أو مسؤولة عن أخطاء الوحدة ونظامها، الذي أعلن عبد الناصر مرات عديدة تعرضه لمؤامرات خارجية، لكنه تجاهل تحصينه ضد موقف أميركي وصلته اصداؤه من تصريحات وزير خارجية واشنطن، الذي كتب رسالة إلى الرئيس أيزنهاور، قال فيها: “هذه الوحدة خطرة، وهناك تصور كبير أنها مدعومة من الروس، فاذا تحقق هذا فإن الأردن ولبنان سيُبتلعان، وستضع هذه الوحدة السعودية والعراق في خطر”(13)، بينما دعا بن غوريون، رئيس وزراء إسرائيل، في رسالة بعث بها يوم ١٨ تموز عام ١٩٥٨ إلى الرئيس الأميركي أيزنهاور، إلى “تشكيل “حلف أطراف” من إسرائيل وتركيا وإيران وأثيوبيا” لمواجهة جمهورية الوحدة الجديدة “المرجع نفسه(14)” .
ـ هذا التطور، المتباين بين سورية ومصر، سرّعهُ موقف عدائي تبنته واشنطن حيال القاهرة، أملاه اعتقادها أن فشل عبد الناصر في تخطي الاحتجاز القومي، الذي فرضه “البعث” على الوحدة، وعززه بضغوط “اشتراكية”، سيدخله في مآزق لن يخّرُج نظامه سالماً منها، وسيعمقها تهاوي عمقه المشرقي وتبعثر الحركة الشعبية الواسعة الموالية لها، وحاجته إلى مصادر قوة يفتقر إليها، وإلى دعم دولي ليس من يقرره، وقتاله بمفرده ضد القوة التي سحقت جيشه قبل أسابيع، وستتكفل بتحطيمه، ودمرت مدنه الرئيسة الثلاث على جبهة السويس بما فيها من مرافق وصناعات، وشردت الملايين من سكانها .
ج ـ في المجال الدولي
ـ لم يكن البعث بحاحة إلى بذل جهود خاصة في واشنطن، لإقناعها بعزل عبد الناصر وإضعاف مكانته الدولية. ولم تكن علاقات عبد الناصر
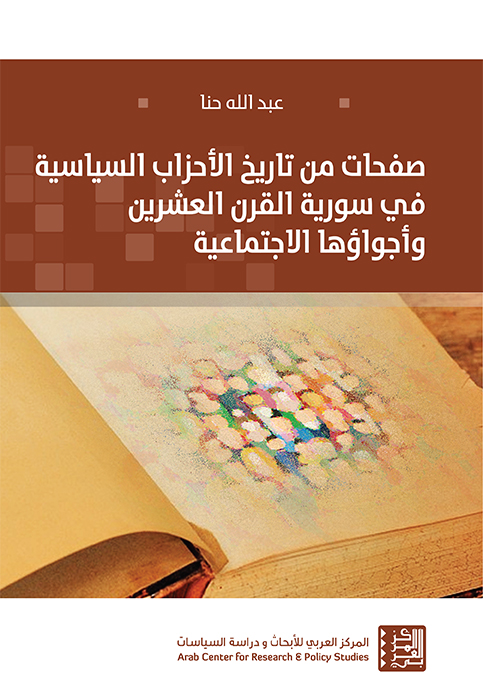
مع أميركا طبيعية منذ قتل الرئيس كنيدي. لذلك، لم يركز نظام دمشق جهوده عليها، بل انصرف إلى إحداث تبدل في الموقف السوفياتي منه كزعيم لعب دوراً حاسماً في إدخال موسكو إلى أفريقيا والعالم العربي.
ـ ذهب عسكر البعث إلى هدفهم عبر طريقين: أحدهما داخلي والآخر خارجي: عربي ودولي .
ـ أما الطريق الداخلي فأخذ صورة تأميمات مبالغ في تطرفها، يقول الدكتور عبد الله حنا: “إنها طالت رأس المال الكبير (والأمر نسبي)، بينما وزع قانون إصلاح زراعي جديد أراضي كبار الملاك على الفلاحين، فبعد تأميم البنوك عام ١٩٦٣ جرت سلسلة تأميمات عامي ١٩٦٤و ١٩٦٥ تناولت القطاعات الصناعية الرئيسة. كما ظهرت عام ١٩٦٥ شركة استيراد وتصدير خلصَت البلاد من احتكار كبار التجار”(15). ويُفّصح سامي الجندي في كتاب “البعث عن السر الذي وقف أساساً وراءها، بقوله: “إن شعار التأميم والإصلاح الزراعي كان دائماً: يجب أن نسبق عبد الناصر”(16). كي يسبقوا عبد الناصر، غطى العسكر تأميماتهم بلغة مفرطة في يساريتها وعدائها للإمبريالية والرأسمالية، تشبه ما كان يستخدمه الحزب الشيوعي الموالي لموسكو، المعادي لعبد الناصر، الذي كثيراً ما اتهمه بتبني نهج اجتماعي وسطي يكبح الاشتراكية: مطلب الجماهير الكادحة والطبقات العاملة في المدينة والريف العربي والمصري، الذي استجاب “البعث” له في إعلامه، ليدفع “القضية الطبقية والثورية” إلى الأمام، رغبة منه في إقامة نظام اشتراكي سوفييتي القسمات.
ـ صدق السوفييت لغة البعث، وتناسوا تاريخه مع العمال والحركة العمالية، وإمعانه في رفض مطالبها زمن الوحدة “عندما كانت وزارة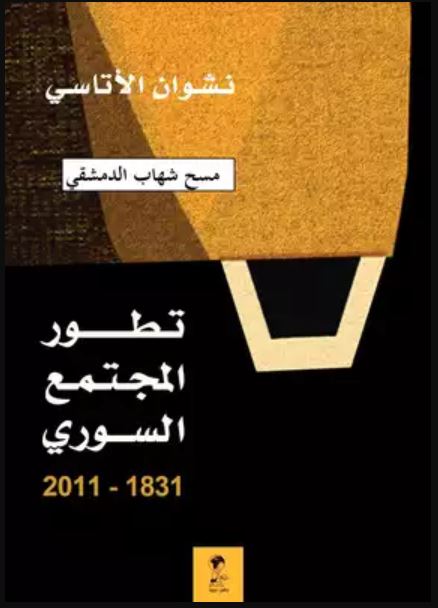 الشؤون الاجتماعية والعمل تابعة له، وتناسوا إسهامه في قمع الحركة العمالية، بعد أن قرر السيطرة عليها، اذ شنت الوزارة حملة ضد النقابات والتنظيمات العمالية، التي لا توالي الحزب، وألغت تراخيص اتحادين عماليين لشُبهة وقوعهما تحت نفوذ شيوعي. وبعد الثامن من آذار عام ١٩٦٣، استغل البعث التأميمات وازدياد حجم القطاع العام لتنظيم الموظفين في نقابات تتبع له، وعلى هذا كان في سورية منذ أوائل الستينات اتحاد عمالي واحد”(17).
الشؤون الاجتماعية والعمل تابعة له، وتناسوا إسهامه في قمع الحركة العمالية، بعد أن قرر السيطرة عليها، اذ شنت الوزارة حملة ضد النقابات والتنظيمات العمالية، التي لا توالي الحزب، وألغت تراخيص اتحادين عماليين لشُبهة وقوعهما تحت نفوذ شيوعي. وبعد الثامن من آذار عام ١٩٦٣، استغل البعث التأميمات وازدياد حجم القطاع العام لتنظيم الموظفين في نقابات تتبع له، وعلى هذا كان في سورية منذ أوائل الستينات اتحاد عمالي واحد”(17).
ـ إذا كان عبد الناصر قد قام بـ”الخطوات الاشتراكية” رداً على انهيار الوحدة، ولرغبته في احتواء تداعياتها داخل مصر، والانتقال من الدفاع إلى الهجوم على الصعيدين العربي والدولي، فإن البعث قام بتأميماته لقطع الطريق على عودة الوحدة، التي سيعتبرها السوفيات خطوة ستطيح بـ”الاشتراكية” وسيرفضونها ويرون فيها نكسة رجعية!. وقد ابتلع السوفيات الطعم، فكتب أحد منظريهم: “أما في البلدان السائرة في طريق التطور اللارأسمالي كسوريا، فتجري تهيئة القاعدة المادية الضرورية للاشتراكية، وتنمو الطبقة العاملة ولكن لا يتمركز رأس المال ولا تولد البورجوازية الصناعية الكبرى، التي تم خلعها من السلطة، ولهذا فالانتقال إلى بناء الاشتراكية لا يقتضي خلع سلطة الديمقراطية الثورية، بل يمكن الوصول إلى قيادة الطبقة العاملة على أساس الماركسية/اللينينية من خلال التعاون مع هذه الديمقراطية الثورية، وبالاستناد إلى التمايز الذي يحصل فيها، واقتراب فئات منها من موقف الاشتراكية العلمية”(18) .
ـ بهذا “التنظير”، كان من الطبيعي أن يُخفق السوفيات في فهم الهدف الحقيقي من التأميمات، الذي تمثل في الاستيلاء على وسائل الانتاج المتوفرة لطبقة مالكة ساندت تقليدياً النخب السياسية المحافظة، ووضع يد السلطة على مصادر ثروتها، تعزيزاً لقدرتها على تمويل طبقتها الجديدة السريعة التنامي، ودولتها العميقة، وإضعاف المجتمع عموماً، والتحكم برزق المواطنين، ودعم “الثورة” بتحويل تدبير ظاهره اشتراكي إلى أداة في صراعات ليست العدالة الاجتماعية موضوعها أو هدفها، أريد بها التغطية على تغييب الحرية، وإلغاء الحياة السياسية، وتوفير موارد لأجهزة متزايدة الضخامة يستدعي تمويلها مد يد السلطة إلى ناتج عمل ومداخيل السوريين، وربط غالبية قطاعات المجتمع بالنظام، المتحول إلى رب العمل وموزع الأرزاق الرئيس، الذي بيده حياة وموت ملايين العاملين في الدولة ومؤسساتها . أخيراً، كان استيلاء العسكر على الثروة، وتقرير طرق توزيعها ضروريا لإعادة هيكلة المجتمع طبقياً، في ضوء معايير سياسية تتصل بتقوية السلطة، وتبيَن في العقود التالية أنها لم تنشر أي نوع من العدالة الاجتماعية، بل أخمدت مجتمعاً مسيساً لعب قبل أعوام دوراً وازناً في إقامة الوحدة مع مصر !.
ـ قرر عسكر البعث خوض معركة تُكَتِل أطراف الساحة العربية ضد زعيم مصر: يساراً بحجة أنه رجعي اجتماعياً، ويميناً بتهمة تطرفه قومياً، وصاحب سياسات تمصير استعمارية طامعة بثروات العرب ومعادية لهم . بعد عزله عن الموالين له في سورية، عمل نظام “اللجنة” لتشجيع النظم العربية تفكيك عمقه الشعبي العابر للدول، على أن يتحقق ذلك في مرحلة أولى، تعقبها مرحلة ثانية يزاح فيها عن موقعه وتحتلها هي، كلياً أو جزئياً. لإنجاز هاتين الخطوتين، كان الضروري بناء كتلة مناوئة له تعد الظروف الملائمة لخوض معركة حاسمة معه في الميدان القومي. بما أن هذا كان صعب التحقيق، فقد صار من الضروري لعب ورقة إسرائيل، لإرغامه على الانخراط في مناورات “البعث” الفلسطينية، وتطبيق اتفاقية الدفاع المشترك، التي استخدمت كفخ سيصعب عليه تحاشيه، إن أراد المحافظة على زعامته وريادته القومية.
ـ هل خشي الغرب عامة وواشنطن خاصة مصالحة سوريا مع العراق وانخراط البلدين مجتمعين أو منفردين في صراع مع اسرائيل، يهمش دور مصر، ويبتز الخليج؟. هذا الاحتمال لن يُحيّده غير إدامة وتوسعة الصراع بين قيادتي الدولتين العقائديتين، الدائر بقرار يبدو وكأنهما اتفقتا على اتخاذه، واكتسب أبعاداً داخلية وعربية ودولية، أبقت العراق بعيداً عن دمشق، التي اعتمدت نهجاً لحمته وسُداه التصعيد اليومي لاشتباكات الحدود مع اسرائيل، وللصراع مع بغداد، التي لا يجوز بحال من الأحوال أن تشاركها في “تحرير فلسطين”، لأنها قد تسرق عائده منها، ولا بد من اتهامها بالتآمر مع العدو على من يقاتلون وحدهم، بينما يتفرج عبد الناصر ونظام العراق عليهم، رغم ما يكابدونه من خسائر جسيمة تَهون ما دامت تقدَم في معركة الحسم، التي ستبقي قصب السبق لدمشق في العراك مع الإمبريالية والصهيونية .
___________
هوامش:
(4). ميشيل عفلق : في سبيل البعث، الجزء الخامس، الصفحة ٢٧٠.
(5). المرجع السابق .
(6). هدى جمال عبد الناصر: الرئيس جمال عبد الناصر، المجلد الخامس، المكتبة الاكاديمية ٢٠٠٧، الصفحة ٦٤٥.
(7). سامي الجندي : البعث، دار النهار للنشر والتوزيع، بيروت١٩٦٩، الصفحة ٨٣.
(8). سامي الجندي : البعث، دار النهار للنشر .بيروت ١٩٦٩ ، الطبعة الثانية، الصفحة ٨٦.
(9). ميشيل عفلق: في سبيل البعث، الجزء الأول، الصفحة ١٥.
(10). ميشيل عفلق، في سبيل البعث، نضال البعث، الجزء الثاني، الصفحة ٢٦٢.
(11). سامي الجندي، مرجع سابق، الصفحة ١١٣.
(12). سامي الجندي، مرجع سابق، الصفحة ١٥٥.
(13). سامي الجندي، مرجع سابق، الصفحة ١٥١ .
(14). المرجع نفسه.
(15). د. عبد الله حنا: صفحات من تاريخ الاحزاب السياسية في سورية القرن العشرين واجواؤها، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، بيروت ٢٠١٨.
(16). سامي الجندي، كتاب البعث، دار النهار بيروت ١٩٦٧، الصفحة ١٥٢.
(17). نشوان الأتاسي: تطور المجتمع السوري من ١٨٣١ إلى ٢٠١١. نشر دار اطلس ، بيروت ٢٠١٥، الصفحة ٢٢٥.
(18). الشيوعيون الامميون: طريق التطور اللارأسمالي ، موقع آر ـ آر على الفيسبوك.
………………..
يتبع.. الحلقة الثالثة عشر: اسرائيل كأداة في الصراع “القومي” ضد مصر الناصرية
«ميشيل كيلو»: كاتب وباحث ومحلل سياسي سوري

التعليقات مغلقة.