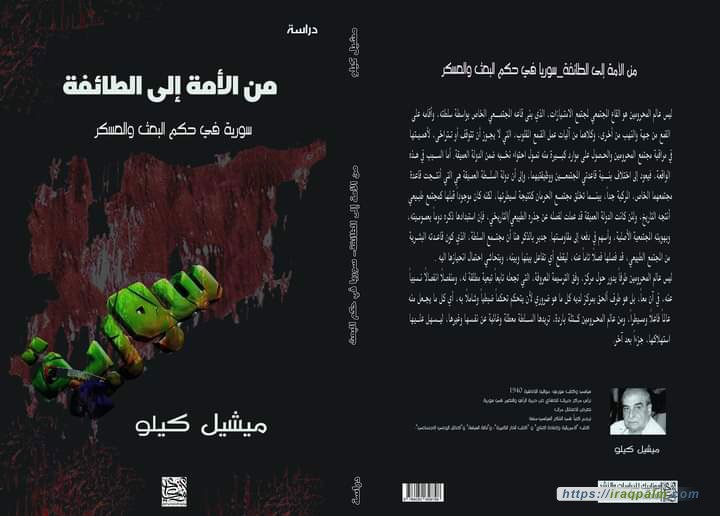
( الحرية أولاً ) ينشر حصرياً كتاب «من الأمة إلى الطائفة، سورية في حكم البعث والعسكر» بأجزائه الثلاثة كاملاً للكاتب الأستاذ: ’’ميشيل كيلو‘‘.. الحلقة الحادية عشر: تطورات سبقت الحرب (آ ـ داخليا)؛ وهي الأولى من الجزء الثاني
من الأمة إلى الطائفة
سورية في حكم البعث
قراءة نقدية
ميشيل كيلو
باريس ٢٠١٧/٢٠١٩
الجــزء الثـــانـي
١٩٦٦ ـ ١٩٧٠
تطورات سبقت الحرب:
هذا المفترق المفصلي، سبقته ورافقته تطورات تصعيدية ستكون لها نتائج بالغة الخطورة على العالم العربي، أهمها:
آ ـ داخليا:
ـ بحسم الصراع ضد العفلقية وإخراجها من الحزب، بدأت قيادة “اللجنة” تقيم نظامها الجديد، وتبنت نهجاً انقلابياً في الداخل السوري، الذي شهرت سيف الثورة على دولته ومجتمعه، واعتمدت، بالتلازم مع ذلك، سياسة تقوم على فورية المعركة لتحرير فسطين في المجال العربي، على أن لا تتوقف عند القضاء على النظام الصهيوني، وإنما تستهدف أيضا المستسلمين والمتخاذلين من العرب، وفي طليعتهم جمال عبد الناصر. وكما في كل معركة تتخطى مقاصدها قدرات الداعين إليها، يغطي هؤلاء عجزهم بمبالغات إيديولوجية يحجب ظاهرها أهدافها المضمرة، التي استهدفتها “اللجنة” عبر تصعيد معاركها “الثورية”، وتغذيتها بإدانات تخوينية نثرتها في جميع الاتجاهات، ودعمتها بأحكام قيمة حولت الاعتدال إلى خيانة تضمر تنازلاً عن مبادئ تهون في سبيلها التضحية… بالآخرين .
ـ عندما تستخدم الايديولوجيا في معارك تكون هي أداتها وميدانها وغايتها في آن معاً، فإنها تعزز ثقة من يستخدمونها بأنهم على حق وغيرهم على باطل، وبأن عليهم منع الآخرين من “خيانتها”، بتبني معايير ثورية تؤكد إخلاصهم لها، واستعداداهم لدفع ثمن تمسكهم بها مهما كان مرتفعاً، فالمسألة في نظرهم مسألة مبدأ يخلو من الغموض، ويتنافى مع أي هدف خفي يكمن وراءه، ولئن كان يخاطب من يتجه بخطابه إليهم، فلكي يفعّل ما في نفوسهم من مشاعر وطنية وقومية نبيلة، كالدعوة إلى تحرير فلسطين، الذي قررت السلطة الثورية الالتزام به في المدى المباشر، وتحويله على المدى البعيد الى معركة داخل الصف القومي، إلى أن يتحرر الوطن العربي من نظمه، وتطرد الامبريالية، بعد الصهيونية، من دول العرب الرجعية، بجهود تبذل من سورية وتنضم إليها مصر، التي ترفض الالتزام بهدف التحرير، رافعة الثورة الجديدة، رغم أن بلوغه في متناول العرب، بدءاً بمرحلته الأولى: تحرير فلسطين، الذي ستنجزه “اللجنة”، بعد أن طهرت صفوفها من أعدائها، وأخرجتهم من “البعث”، وبنت “جيشاً عقائدياً” لخوض المعركة الفاصلة والقضاء على الأعداء!.
ـ في صراعه مع “اللجنة”، راجع عفلق موقفه من عبد الناصر، وميز نفسه عن الذين استولوا على خطه السياسي من ضباطها، ونافسوه على العدد القليل من أعضاء حزبه، ونجحوا في تشويه سمعته كمناضل وقائد سياسي. غيّر عفلق موقفه السلبي من عبد الناصر، وأعلن انه لا شيء في أخطائه يبرر جريمة الانفصال(1)، بينما واصل عسكرها تمسكهم بفورية تحرير فلسطين، دون أن يتخلوا عن رؤية عفلق حول إمكانية قيام نظام وحدوي في قطر واحد، إن كان “البعث” هو الذي يتولى الحكم فيه .
ـ بما ان “اللجنة” قررت تأسيس حزب بعث خاص بها، يقوم على أنقاض بعث عفلق والبيطار، فإنها قررت أيضاً الاستيلاء على اسم “البعث” وأقانيمه، التي صارت مشاعاً، بعد طرد عفلق من حزبه، ووضع حد من خلال ذلك للازدواجية التنظيمية والقيادية، التي نشأت بعد ثورة الثامن من آذار، وحسمتها “اللجنة” بأساليب اختلفت أشد الاختلاف عن الأساليب المألوفة في الصراعات داخل الأحزاب وبينها، وخلت من السلمية والميل إلى التسويات والحوار، والأقنية الجانبية والأبواب الخلفية، التي تبقى مفتوحة بين الاطراف المتصارعة. ما إن قررت “اللجنة” إنهاء الصراع ضد عفلق وتياره، حتى تبنت طرقاً عسكرية في إخراجهم من المعركة، طبقتها في انقلاب يوم الثالث والعشرين من شباط عام ١٩٦٦، الذي أرغمهما على الاستسلام للقوة، والرضوخ لما فرضته عليهم كمهزومين طالهم تطهير شامل ابعدهم عن جيشها وبعثها، وعزز انفراد صلاح جديد وحافظ الأسد بالساحة السياسية والعسكرية، التي سيكون “البعث” فاعلاً فيها، بقدر ما يغدو حزباً أدواتياً ووظيفياً، ويمارس دوره ككتلة متراصة تنقاد لأجهزة تحجب شرعيتها السلطوية ما دأبت على القيام به من أعمال غير شرعية، وعلى خوض معارك كسر عظم ضد ما ومن يخالفها الرأي، أو يعارضون ما تقرره من سياسات، بما فيها تلك السرية منها، أو التي شرعت تنفذها دون الالتزام بأي اعتبار قيمي أو حزبي، انطلاقاً من اعتمادها مبدأً يرى أن “الهدف يحدد الوسيلة ويبررها”، وأن المعارك تملي أساليبها على الذين يخوضونها. وبما أن معارك “اللجنة” عسكرية وسياسية، فإن الأساليب السلمية أو الحوارية لا تنفع فيها، وتفضي إلى فشلها في بلوغ هدفها المضمر، الكامن في انتقالها من شريك صغير لمصر، الى دولة/مركز، ونقطة جذب “قومية” بديلة للقاهرة أو موازية لها، يحصنها دورها الحاسم في المشرق ضد عودة الوحدة مع القاهرة، ويخرجها من العلاقة غير المتكافئة معها .
ـ بعسكرة الشأن العام، الضرورية لبناء أداة حزبية تنفذ خطط “اللجنة”، تعسّكرت الساحة السياسية أيضاً، وانتقلت من طور كان يتم تنظيمه وضبطه بالتوافق وما يتطلبه التعايش من أطر ليبرالية نسبياً، إلى حال نقيض، سرعان ما أخذت تستبعد الآخرين والمختلفين عن المجال العام والحقل السياسي بالعنف: سواء كانوا من المنتمين إلى صفها الخاص، أم كانوا خارجه.
ـ بهذه البيئة السياسية والعلائقية الجديدة، أصاب الحقل السياسي تبدل جوهري، إذ بينما كانت أحزاب فترة ما قبل انقلاب الثامن من أذار تتصارع بوسائل علنية يراقبها رأي عام مسيس نسبيا، لأنها كانت جميعها أحزابا علنية، أدى استيلاء “اللجنة” بوسائل عسكرية على الحقل السياسي، وانهماكها في تطييف الجيش، إلى تخلق صراع سياسي ليس لطرفها الرئيس: الدولة العميقة، وجوداً معلناً أو معترفاً به فيه، فلا عجب أن أخذت الأحزاب تواجه أجهزة سرية على درجة من التنظيم والقدرات تفوق ما يتمتع به أي حزب في الساحة، تقتصر علاقاتها مع كيانات السياسة والمجتمع على اختراقها واحتوائها وفق خطط مدروسة تطال مجمل الحياة العامة، والأحزاب القائمة فيها، وتستهدف أتباعها بها بعد درجة من تفكيكها والتحكم بمفاصلها، تقبل معها سياسات السلطة وترتبط بها، كي لا يتم تطويقها وتفتيتها من داخلها، وملاحقة جهازها العصبي وقواعدها، والعمل لإلغائها.
ـ هذا التبدل الجوهري في بنية الساحة السياسية والسلطة، بدل طبيعة العلاقات السلمية والصراعية بين تمثيلاتها، فلم تعد تنافسية، أو تعايشية، كما لم تعد أطرافها، منذ الثامن من آذار، متعادلة أو متمتعة بحقوق متساوية ومحمية دستورياً وقانونياً، ولم يعد الشارع، أو ما يسمونه الرأي العام، طرفاً في تجاذباتها التي فقدت طابعها المدني، واكتسبت طابع نزاعات عنيفة بين وحش سلطوي مجهول الملامح، وبين ضحاياه المساكين، الذين يلتهمهم واحداً بعد آخر، وجماعات وأفراداً، بقدراته التنظيمية وموقعها في السلطة، فإن حاورهم فلكي يتوطن داخلهم ويشق صفوفهم، أو تمهيداً للانقضاض عليهم واعتقالهم، كما فعل دوماً بعد كل حوار مع الأحزاب والهيئات المدنية، التي وضعها بين خيارين: قبول الاحتواء أو تلقي ضربات تطيح بها، وتقوضها بملاحقات واعتقالات لا تتوقف، تدب الرعب في قلوب من لا ينتمون إلى الاحزاب أو يمارسون أي نشاط سياسي أو عام من أبناء الشعب العاديين، الذين يتعرضون بصورة دائمة لسياسات الردع الوقائي، وللضغوط، التي تبقيهم بعيدين عن الشأن العام: تأييدا أو رفضا .
ـ صارعت دولة “اللجنة” العميقة، بما لديها من قدرة على إقامة تفوّق ساحق على أي خصم تقرر الإجهاز عليه، دون أن يجد، غالباً، أي عون أو تعطف عملي لدى الأحزاب الأخرى، بينما ينّفض أعضاؤهم عنها واحداً بعد الآخر.
ـ لمّ يَطَلْ الصراع الأحزاب وحدها، بل تخطاها إلى الفاعلين الثقافيين والمدنيين. وتشير الطريقة التي طبقها نظام “اللجنة” على أحد مؤسسي “البعث”، الراحل ميشيل عفلق، إلى الأسلوب الذي قررت اعتماده ضد المثقفين والتنظيمات المدنية غير السياسية كالنوادي واتحادات الكتاب والصحفيين، وسواهم من الذين لم يعد يتسع لهم الفضاء العام، لأن “اللجنة” قررت إغلاقه والانفراد بالحقل السياسي لإعادة هيكلته، بتطهيره من عوالق الحقبة “البرجوازية”، التي قبلت الآخر، واتسمت سلطتها بطابع تفاعلي نسبي مع من لا ينتمون اليها، وخضعت لرقابة البرلمان والرأي العام، وكان الإجهاز على بقاياها ضرورياً لاستقرار النظام الجديد واستخدام قدر مفتوح من العنف يضمن ملكية “اللجنة” وأجهزتها للمجال العام، ويبقي موازين القوى الداخلية وقفاً عليها، ولصالحها.
ـ بالشروع ببناء الدولة العميقة كحزب سري وأداة ضاربة للسلطة في الداخل السوري، تبدلت معادلات السياسة، وتغيرت الأطراف المشاركة فيها، ووجدت نفسها أمام واقع لم يسبق لها أن أخذته في حسبانها أو فكرت فيه كاحتمال، طيلة الفترة شبه الليبرالية التي تلت الاستقلال، ودامت إلى قيام الوحدة عام ١٩٥٨. من أهم مظاهر هذا التبدل ما تقدم به النظام من عروض تعاون لبعض الأحزاب القائمة، وتمحور أساساً حول تبنيها خط النظام وسياساته باعتباره يغطي مختلف جوانب الواقع السياسي وما يطرحه من مهام عليها، ويلزمها التعاون بتخليها عن خطها السياسي الخاص، السبب، دور السلطة الغالب لدورها في المعارك مع الامبريالية والصهيونية، والميدان العربي العام، والذي يتطلب رص صفوفها حول النظام: رافعة الصراع ضدهما، التي يستحيل تحقيق انتصارات بدونها. بالسلطة كمحور ومركز للسياسة وقضاياها، صار من الطبيعي أن يكون استقلال الأحزاب والكيانات السياسية والمدنية سبباً لإضعاف “الوحدة الوطنية” والوطن، وأن يكون التنوع في خطوطها تهديداً للنظام يتناقض مع رغبتها في مساندته، لذلك، يجب أن تتعامل الدولة العميقة معها بصفتها تجمعات أفراد، وليست تنظيمات تمثل فئات مجتمعية وطبقية مشروعة المطالب، وليس لها الحق في أن تتقدم إلى السلطة بإسهامات سياسية خاصة حول القضايا المتصلة بالشأن الوطني العام، لأن مسؤوليتها عنه ليست مساوية لمسؤولية السلطة، التي أعلنت دوماً انفرادها بالمسؤولية عن القضايا العامة، وبتحديد المسموح والممنوع في التعامل معها، إذا ما يتعلق الأمر بصراعات طرفها الآخر قوى خارجية تحتم الوطنية إلزام الآخرين بالاصطفاف وراء قيادتها، وتبني مواقفها دون تحفظ أو اعتراض.
ـ هذا التوجه الذي انصب على احتكار المجال العام واحتواء تمثيلاته السياسية من خلال الدولة العميقة أو إلغاءها، اندرج في إطار نظرة كان الراحل عفلق قد بلورها حول حزب “البعث” كأمة استباقية تتجسد فيه وحدتها وشخصيتها الفريدة، ورسالتها الخالدة، لكن “اللجنة” عزت هذه الصفات إلى دولته العميقة وأجهزتها، التي اعتبرتها الأمة الاستباقية ذات الصفات التي نسبها عفلق إليها، وحولتها إلى كيان متعال، من غير المعقول أو المقبول انتقاده أو معارضته أو مشاركته وظائفه وأدواره، فذلك يشوش هوية الأمة، ويمثل ضرباً من عدوان عليها، يفقد القائم به حقه في الانتماء إلى مجتمع الأمة ودولتها . صحيح أن الدولة العميقة استندت إلى حاضنة ما قبل مجتمعية، لكن وظائفها ارتقت بها إلى مستوى من المحال أن يبلغه كيان سياسي آخر.
ـ هذه الأدلجة لم يكن هدفها ستر التماهي بين الدولة العميقة وسلطتها المُطيّفة وحسب، وإنما رسم الحد أيضاً، الذي لا يسمح لأحد بالاقتراب منه، والخط الأحمر الذي يهلك من يحاول تخطيه، لكونه يضع الأجهزة السرية وحاضنتها الطائفية خارج متناول فئات الشعب، سياسية كانت أو مدنية أو ثقافية. بذلك، لم تعد السلطة مسألة من الجائز أن تكون محل اهتمام الرأي العام، أو أن تتفاعل معه ويتفاعل معها بأي صورة من الصور، فكيف أن أراد لتفاعله معها أن يتسم بالندية أو التكافؤ، ويقوِّض دورها كمركز تصدر عنه أقوال ويقوم بأفعال لا يحق لأحد مناقشتها، أو التدخل فيها، ناهيك انتقاد ماهيتها ومبادئها المؤسسة للشأن العام، التي اختلفت بعد “الثورة” اختلافاً جذرياً عن كل ما سبقها، سواء من حيث تعييناتها، أم ترجمتها إلى وقائع، أم مآلاتها ونتائجها.
ـ استقلت السلطة، بهذا التطور، عن المجتمع، واحتل مُسيّروها وقادتها مواقع تنطلق المواقف والخيارات منها أو تتقاطع فيها، ولذلك أقلعت السياسة عن أن تكون شأناً مجتمعياً، وصارت فاعلية ميدانها الدولة العميقة وما ينتمي إليها من تمثيلات سياسية. هذه النقلة النوعية غير المسبوقة إلى الشمولية كان من الطبيعي أن تلغي ركائز السياسة “البرجوازية والرجعية”، كالمواطنة، وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، والمجتمع المدني كهيئة عامة لمواطنين أحرار، والتداول السلمي على السلطة، والانتخابات الحرة، وتخرج السياسة من المجتمع، والمجتمع من السياسة.
ـ بهذا الانتقال، الذي بدأ تباشيره بعد ثورة عام ١٩٦٣، وتسارع واكتمل بعد عام ١٩٧٠، انتقلت سورية من سيطرة حزب سياسي يتّبَع له عسكر إلى نظام يتولاه عسكر يمارسون السياسة، اتبعوا بهم حزباً اخضعوه لسلطة تحمل اسمه، يفترض أنها سلطته وأنه قائدها !.
ـ حُلّت الأحزاب السورية خلال حكم الوحدة، وعانت الحياة العامة من اضطراب شديد خلال الفترة التي فصلت انقلاب عام ١٩٦١ عن انقلاب الثامن من آذار عام ١٩٦٣، ولم تنجح الأحزاب السياسية التقليدية، التي تولت السلطة خلالها، وكانت أقرب إلى جماعات ضغط منها إلى قوى مُهيكلة تمارس حياة حزبية منظمة، فكان من تحصيل الحاصل أن تتلاشى بعد حلها بصورة تكاد تكون تامة، وأن يخضع “البعث” لهذا المصير، ويتقلص إلى درجه جعلته تجمعاً افتراضياً من مناصرين سابقين لعفلق والبيطار، واجهوا بعد فشل الوحدة صعوبات عديدة في استعادة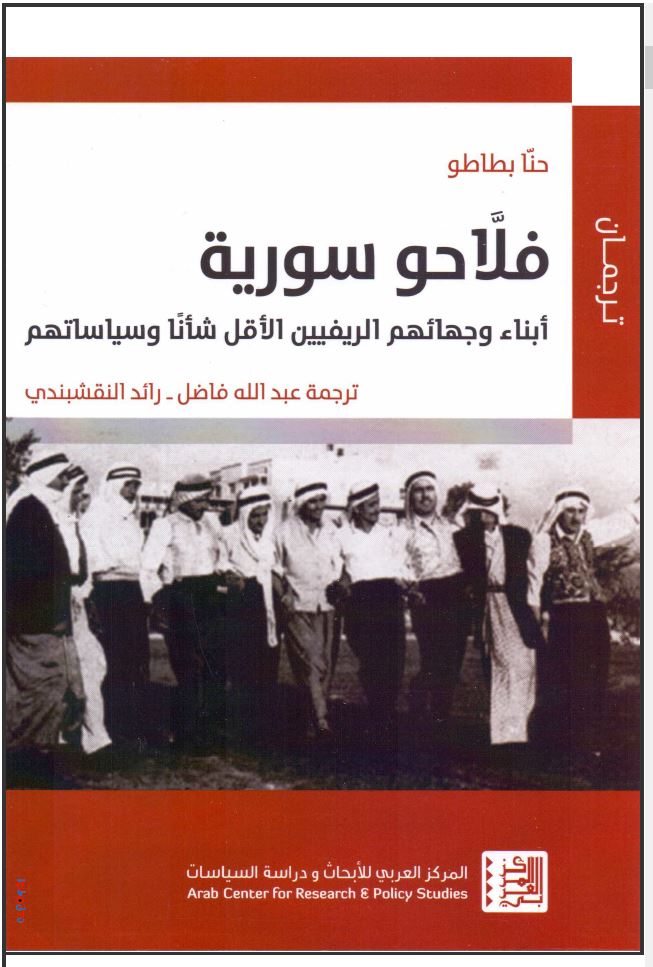 وضعهم السابق كحزب منظم يمكنه استئناف نضاله من النقطة التي توقف عندها، عندما تقرر حله، علما بأن حافظ الأسد اعترف بعد استلائه على السلطة أن “تنظيم الحزب في مدينة حلب لم يكن يضم عام ١٩٧٠ أكثر من سبعين عضوا”(2)، بينما اعترف تيار “صلاح جديد” في مراجعة نقدية لتاريخ البعث “إن وجود الحزب كان ضعيفاً جداً في المدن الكبرى، وأن معظم قادة الفروع فيها كانوا من مناطق أخرى، وكانوا عاجزين عن بناء تنظيم حزبي حقيقي قادر على تحريك وقيادة تلك المدن”(3). كان هذا وضع البعث قبل الوحدة، وبعد استيلائه على السلطة . أما الحزب الشيوعي، الذي تلقى ضربات قمعية قاسية في الفترة بين نهاية عام ١٩٥٩ والانقلاب على الوحدة بعد نيف وعامين، فكان أكثر الأحزاب ترابطاً، بالنظر إلى أن قيادته نجت من الملاحقات، بسفَر أمينه العام خالد بكداش إلى موسكو، وخروج عدد مهم من قادة الصف الأول فيه إلى الدول العربية والاشتراكية، فضلاً عن الفترة القصيرة نسبياً، التي امضاها كوادره وأعضاؤه في السجون، وما أن استعادوا حريتهم نهاية عام ١٩٦١، أو رجعوا من الخارج، حتى عاد معظمهم إلى العمل الحزبي والسياسي، وأعادوه إلى الحياة كحزب تم دوماً إنتاجه انطلاقاً من هيئاته العليا، ممثلة في لجنته المركزية ومكتبه السياسي. ومع أن الحزب كان في حال لا يستهان بها من الضعف قبل الوحدة، بسبب خلافات سادت صفوفه حول أسلوب قيادته وخطه، ثم حول الموقف من الوحدة، فإنه استعاد نشاطه بعد فشل الوحدة، وسط إرباكات تنظيمية وسياسية تجعل من الصعب القول: إنه كان يمثل ثقلاً مقابلاً لحزب “اللجنة”، أي لدولتها العميقة، التي كانت جزءاً من مؤسستها المسلحة، التي لعبت الدور الرئيس في بناء تجربة حولت السياسة من الحزب إلى جهاز دولة سري وقمعي، أسهم أيما إسهام في تلاشي تمثيلات المجتمع الحزبية والمدنية المستقلة، التي عبرت بالأمس بهذا الفدر أو ذاك عن مصالح وتطلعات فئات الشعب المختلفة، وحملت جميعها طابعاً نخبوياً قليل الانغراس في المجتمع، ومرت بحقبة الوحدة الصعبة، وحقبة الانفصال المضطربة، قبل أن تواجه جهازاً عسكرياً / مخابراتياً على درجة رفيعة من المركزية والتنظيم والانتشار والقدرة على البطش والفئوية، لن تنجح خلال أي فترة لاحقة في بناء قدرات تمكّنها من مواجهته.
وضعهم السابق كحزب منظم يمكنه استئناف نضاله من النقطة التي توقف عندها، عندما تقرر حله، علما بأن حافظ الأسد اعترف بعد استلائه على السلطة أن “تنظيم الحزب في مدينة حلب لم يكن يضم عام ١٩٧٠ أكثر من سبعين عضوا”(2)، بينما اعترف تيار “صلاح جديد” في مراجعة نقدية لتاريخ البعث “إن وجود الحزب كان ضعيفاً جداً في المدن الكبرى، وأن معظم قادة الفروع فيها كانوا من مناطق أخرى، وكانوا عاجزين عن بناء تنظيم حزبي حقيقي قادر على تحريك وقيادة تلك المدن”(3). كان هذا وضع البعث قبل الوحدة، وبعد استيلائه على السلطة . أما الحزب الشيوعي، الذي تلقى ضربات قمعية قاسية في الفترة بين نهاية عام ١٩٥٩ والانقلاب على الوحدة بعد نيف وعامين، فكان أكثر الأحزاب ترابطاً، بالنظر إلى أن قيادته نجت من الملاحقات، بسفَر أمينه العام خالد بكداش إلى موسكو، وخروج عدد مهم من قادة الصف الأول فيه إلى الدول العربية والاشتراكية، فضلاً عن الفترة القصيرة نسبياً، التي امضاها كوادره وأعضاؤه في السجون، وما أن استعادوا حريتهم نهاية عام ١٩٦١، أو رجعوا من الخارج، حتى عاد معظمهم إلى العمل الحزبي والسياسي، وأعادوه إلى الحياة كحزب تم دوماً إنتاجه انطلاقاً من هيئاته العليا، ممثلة في لجنته المركزية ومكتبه السياسي. ومع أن الحزب كان في حال لا يستهان بها من الضعف قبل الوحدة، بسبب خلافات سادت صفوفه حول أسلوب قيادته وخطه، ثم حول الموقف من الوحدة، فإنه استعاد نشاطه بعد فشل الوحدة، وسط إرباكات تنظيمية وسياسية تجعل من الصعب القول: إنه كان يمثل ثقلاً مقابلاً لحزب “اللجنة”، أي لدولتها العميقة، التي كانت جزءاً من مؤسستها المسلحة، التي لعبت الدور الرئيس في بناء تجربة حولت السياسة من الحزب إلى جهاز دولة سري وقمعي، أسهم أيما إسهام في تلاشي تمثيلات المجتمع الحزبية والمدنية المستقلة، التي عبرت بالأمس بهذا الفدر أو ذاك عن مصالح وتطلعات فئات الشعب المختلفة، وحملت جميعها طابعاً نخبوياً قليل الانغراس في المجتمع، ومرت بحقبة الوحدة الصعبة، وحقبة الانفصال المضطربة، قبل أن تواجه جهازاً عسكرياً / مخابراتياً على درجة رفيعة من المركزية والتنظيم والانتشار والقدرة على البطش والفئوية، لن تنجح خلال أي فترة لاحقة في بناء قدرات تمكّنها من مواجهته.
ـ تمسكت “اللجنة” بموقفها المعادي لمصر وزعيمها، وأمعنت في تطهير صفوفها من الذين يخالفونها الرأي، بمن فيهم مؤسسها محمد عمران، وعملت، في الوقت نفسه، لإلزام عفلق بما كان قد نَظَّر له حول قومية العمل في إطار قطر واحد، إذا كان بقيادة “البعث”.
ـ ساندت “اللجنة” هذه الفكرة وقررت تنفيذها بعيداً عن عفلق وضده، على أن يتم ذلك بواسطة تنظيمها الخاص، المناهض له ولحزبه. وخاضت صراعها ضده بوصفه جزءاً من معركتها القومية، التي تتجاوز سورية، وترى فيه خصماً لها وحليفاً لعبد الناصر، يجب إخراجه من مركز القرار، ولا بأس أن يخرج أيضاً من الحياة السياسية باعتباره جزءاً من ماضٍ لا بد من تجاوزه، ليكون باستطاعتها بناء تنظيم عسكري/ حزبي منفصل عنه ومعادٍ له، يعمل كوحدة منضبطة من وحدات الجيش، ولكن بقدرات قطاع مدني من الضروري إن أُمر أن يطيع وينفذ دون اعتراض، ويكون فاعلاً بقدر ما يكون أدواتياً ووظيفياً، ويمارس دوره ككتلة مندمجة تقودها أجهزة تضفي شرعيتها الإسمية على ما ترتكبه الأجهزة من أعمال غير شرعية، كخوض وكسب معركة كسر عظم ضد أي ميل وحدوي في صفوفها، وأي رأي مغاير أو مخالف لرؤيتها، ولما تقرر تنفيذه دون مراعاة لأمر أو لمبدأ أو لشخص، إذا ما تعلق الأمر بالزعيم المصري، الذي اعتبرته حالة سورية داخلية أيضاً، ومنافساً لن تتعايش مع ولاء قطاعات واسعة من السوريين له، لما سيعنيه ذلك من انقسام يشطر النظام إلى سلطة معادية لعبد الناصر وشعب تؤيده أغلبيته الساحقة، يمكن لخصمها المصري الضغط عليها بواسطته، وإضعافها في عقر دارها، وثلم قدرتها على التحول إلى مركز “قومي” بديل أو موازٍ له ولمصر !.
ـ سطت “اللجنة” على ما يخدمها من رؤية عفلق، وهي تتمرد عليه وتنكل به وبمحازبيه. والغريب أنه ما أن أحتلت الحقل السياسي، وبنت سلطتها ونظامها فيه، حتى تماثل أداؤها مع اداء بعث العراق العفلقي، وتبين كم صار عفلق ظاهرة برانية بالنسبة إلى تلامذته، المخلصين والمتمردين منهم، وكم تماهى نظاما “البعث” في كل ما يتعلق ببناهما ووظائفهما، رغم ما بدا من تناقض ظاهري في انتمائهما إليه، كما في خطابيهما كميدانين مفتوحين لحرب كلامية رأت دمشق خلالها في بعث العراق (العفلقي) تنظماً يمينياً وفاشياً، وبالمقابل رأت بغداد في بعثها تنظيماً قومياً وبالتالي ثورياً، وفي غريمه السوري “عصابة” طائفية متصهينة.
ـ وقد بدأ يتخلق في دولتي البعث السورية والعراقية، من خلال العفلقية ونقيضها، نظام سلطوي/ شمولي متماثل، أعاد إنتاج مجتمعيه بوسائل إقصائية وعنيفة، وجعل مرجعيتهُ الوحيدة الممسكين بسلطته، الذين استمدوا شرعيتهم من دولة عميقة انتشرت فوق كامل المساحة المجتمعية للدولتين، وتولت الانفراد بتمثيلها دون أن تعود إليها أو تسمح لها بالتعبير عن أي أمر أو شأن من أمورها وشؤونها، مع أنها قلبت علاقاتها بالمجال العام رأساً على عقب، فلم تُعِد التوطن فيه بل الخروج منه لأنه أسلم الأوضاع وأكثرها أمناً بالنسبة لها، كما قصرت وظائفهما على ما تقرره الدولة العميقة لهما، بما في ذلك تفكيكهما وردهما إلى جماعات متراصفة في ما كان بالأمس القريب مجتمعاً تتنامى وحدته وتتقارب مكوناته، وانقسمت جماعات إلى جمعات متناحرة غالباً، أشرفت الأجهزة على غربتها إحداها على غيرها، وتعطيل أيَ ميلٍ اندماجي يبدو عليها، وردها إلى طور ملّي مقيد في بغداد، طائفي مفتوح في دمشق، معدل ومحدث أمنيا في الحالتين.
ـ توقف البعث، بعد استيلائه على السلطة في دولتي المشرق المجاورتين، عن النضال ضد “التجزئة والنظم الانفصالية/الرجعية”. ولو لم يتوقف لكان وحّد العراق وسوريا، ولما خاض طرفاه صراع وجود باسم وحدة زعم كل منهما أن الطرف الآخر غيبها، وأنها تتجسد فيه، ولما شنا حرب وجود أحدهما ضد الآخر باسم وحدة الوحدة ضد التجزئة، والحرية ضد الاستبداد، والاشتراكية ضد الاثراء غير المشروع والفساد، وأخضعا علاقاتهما لحسابات سلطوية، أملتها خشيتهما المشتركة من نهج وحدوي ترفضه واشنطن وموسكو، وتكون عواقبه خطيرة عليهما.
ـ خاض المتنازعان على الشرعية البعثية في بغداد ودمشق صراعاً مصيرياً بالأدوات عينها التي صارع العسكر عفلق بواسطتها، وتنتمي مثلها إلى فن الحرب بمكائده وقسوته واسلحته، وإخراج الآخر من المعركة وإجباره على الاستسلام بأي ثمن، ومن خلال عنف لا يعرف هدنة أو وقف اطلاق نار. ويلفت النظر أن معارك البعثين لم تكن خارجية بالنسبة لأي منهما، ولذلك لم تتوقف عند المجال السياسي، وبالأحرى السلطوي، بل امتدت إلى دولتيهما ومجتمعيهما، وملأت علاقات شعبيهما بضغائن وأحقاد متبادلة عمقتها أجهزتهما بأعمال تخريب وتآمر وقتل متبادلة، وباحتراب متبادل شاركت الأسدية فيه إلى جانب إيران، وغير مباشرة بالنسبة لبغداد، التي دعمت تمرد الأخوان المسلمين ضد النظام الاسدي في ثمانينات القرن الماضي.
ـ بانتفاء المجال القومي كحقل سياسي جامع، وسيطرة عسكر هنا ومتعسكرين هناك على دولتي المشرق، وتبنيهم أدلجة اقصائية، وانتقالهم من الصراع بالكلمات إلى تجاذبات عنيفة طالت مؤسساتهما الظاهرة والخفية، كان من الطبيعي أن ينتفي منها ذلك النمط من الوطنية، المرتبط بالشعب وبالفسحة الديمقراطية التي يمارس فيها دوره المباشر في الشأن العام، ناهيك عن انتفاء الفسحة الوحدوية، التي دفع غيابها كلاً منهما إلى صب جهوده على إضعاف الآخر، وتحريض شعبه عليه، والعمل في النهاية لإسقاطه.
ـ شنت “اللجنة” حربا علنية وسرية على عبد الناصر، الذي تحول في إعلامها إلى خائن مثلث الجرم: لشعبه أولاً، بسبب استبداده وإجراءاته الاجتماعية المخادعة وغير الثورية، وخياراته الاستسلامية في فلسطين، ومماطلته في تحريرها ثانياً، وخيانته ثالثاً للمعسكر السوفييتي والثورة العالمية عبر حياده الإيجابي ورفضه الانحياز إليهما، وتمسكه بسلطة ليس غير مجرد واجهة لها، تخفي دولة سرية (أسماها عفلق بيروقراطية) تحركه كيفما شاءت، وتستخدم شعبيته للدفاع عن امتيازاتها وأجهزتها الفاسدة.
ـ هذه التحولات الجذرية وغير المسبوقة في سورية والعراق، كانت الترجمة العملية الوحيدة “للبعث” التطبيقي بنسختيه المتناقضتين شكلاً المتطابقتين مضموناً، اللذان سقطا من علياء مثالية البعث الأول اللفظية إلى درك واقع ما دون قطري، ما أن بدأت “اللجنة” تبني نظامها فيه، حتى تولت السلطة حجب تبعيته للدولة العميقة، والحؤول بين هيئة المجتمع العامة وبين وعي ذاتها ككيان مستقل نسبياً عن تمثيلات السلطة السائدة، يستطيع تنظيم نفسه لتحقيق أهدافه ومصالحه، التي لا تتطابق بالضرورة مع مصالح النظام، وتعريفها بطرق تساعده على الانخراط في الشأن العام، من الموقع الذي يختاره.
ـ بتحول “البعث” من حال حزبية ذات أبعاد مجتمعية إلى حال سلطوية أمنية استبعادية الممارسات، ثكّنَنِة نفسها وأجهزتها، وازدادت آليات اشتغالها وأوضاعها غموضاً بقدر ما تقادم بها الزمن، ونجحت في احتواء المجتمع وإتباعه بسلطتها، وأفقدته هويته الأصلية وخصائصه المستقلة نسبياً، واخترقته، وقطعت صلات فئاته وشرائحه البينية، وصلات مواطنيه بعموميتهم كذوات حرة، ولها الحق في ممارسة السياسة كفاعلية مجتمعية عامة.
ـ بعد إدراج “البعث” في الأجهزة، وما ترتب على ذلك من تحول هيكلي في علاقاته بالمجال العام، ودوره في الاستئثار بالحقل السياسي وشؤونه، وفي إبعاد غير البعثيين عنه، وبعد تبني “اللجنة” ولاحقاً مكتبها العسكري، السياسة كفن صراع ومغالبة في الداخل والخارج، جاء الدور على أحزاب سورية الأخرى، فكُبح نشاطها وقسمها إلى فريقين: تقدمي احتواه، وبذلك ألغاه، ورجعي منع تنظيماته ولاحقها، بغض النظر عن التطابق بين هويتها وتصنيفاته. بما أن خطاب الفريق التقدمي تقاسم معظم مفرداته مع نظام الدولة العميقة، وانتمى إلى بنيتها المجتمعية كأحد ممثلي الفئات البينية، فإن التلاعب به كان ميسوراً، وإرضاخه لعلاقات تعزز قدرة الأجهزة على إثارة أزماته أمراً متاحاً على الدوام، خاصة بعد قيام الجبهة الوطنية التقدمية عام ١٩٧٢، وطي صفحة الأحزاب المستقلة بإدماجها فيها، والتلاعب الرسمي بوحدتها، وشقها المرة تلو الأخرى، كما سيرد في الجزء الثالث من هذا الكتاب، وتحولها من أجسام معارضة إلى مزق سياسية مهشمة، برز موالون للسلطة في صفوفها تسابقوا على خطب ودها، والتحول إلى أدوات في يدها!.
ـ ابتعد عسكر “اللجنة”، الذين أوصلوا الطائفية إلى موقع من السلطة غيّبت بواسطته كل ما هو وطني وقومي، وأطلقت سيرورة “تقلِدة” طالت جميع فئات السوريين، وكبحت ما اعتمدته نخبة بعد الاستقلال من تطورات وسياسات، لعبت دوراً وازناً في الوحدة السورية/ المصرية. بعد توطيد سلطتها، عملت الدولة العميقة لإقناع الشعب بقدرة فاعل طائفي سابق للمجتمعية ونافٍ لها على بناء “الوحدة والحرية والاشتراكية”، بينما تولت شحن مجالها الداخلي بمشكلات وتعقيدات قوضت وجوده، ومارست سياسة القبضة الحديدية فيه.
___________
هوامش:
(1). ميشيل عفلق : نكسة الانفصال، مرجع سابق.
(2). بطاطو: مرجع سابق، ص ٣٤٤.
(3). حنا بطاطو: المرجع السابق، الصفحة ٣١٢.
………………..
يتبع.. الحلقة الثانية عشر: تطورات سبقت الحرب (عربياً ودولياً)
«ميشيل كيلو»: كاتب وباحث ومحلل سياسي سوري

التعليقات مغلقة.