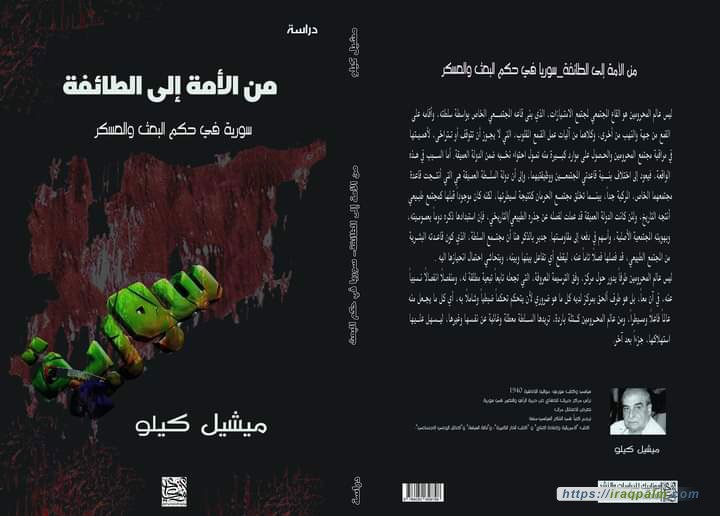
( الحرية أولاً ) ينشر حصرياً كتاب «من الأمة إلى الطائفة، سورية في حكم البعث والعسكر» بأجزائه الثلاثة كاملاً للكاتب الأستاذ: ’’ميشيل كيلو‘‘.. الحلقة السابعة: (عفلق والوحدة، و البعث: حزب الأمة، و نتائج رؤية عفلق)
من الأمة إلى الطائفة
سورية في حكم البعث
قراءة نقدية
ميشيل كيلو
باريس ٢٠١٧/٢٠١٩
عفلق والوحدة:
تبنى عفلق تصوراً واحدي الاتجاه للتطور العربي، ذهب من تجزئة بغيضة إلى توحيد خلاصي، ومن كيانات قطرية رجعية إلى كيان وحدوي مؤسطر: هو دولة/ أمة مفتوحة نحو الداخل مغلقة نحو الخارج، تقع بين المحيط الاطلسي والخليج العربي وجبال زاغروس وأرارات. هذا التصور، غذاه إيمان بنضج شروط الوحدة قومياً، بالقدر نفسه في كل مكان من بلدان العرب: من أكثرها تأخراً إلى أشدها تقدماً، وبأن الدينامية الذاتية للفكرة القومية كفيلة بكنس الظروف الموضوعية لواقع التجزئة المتخلف/ المتأخر، الذي لن ينجح في صدها. بافتقاره إلى استراتيجية ركيزتها حامل وحدوي، لم يهتم عفلق بما يمكن أن يترتب من احتمالات على تفاعل الداخل/ الخارج من انتكاسات ارتدادية وتفكيكية تصيب الدول القطرية القائمة، فتفتت ما يجمع مكوناتها، وإن حافظت على إهابها الخارجي، فالتقدم الوحدوي عند الاستاذ صاعد، ولا يعرف التراجع، رغم كارثة فلسطين، التي انتزع خلالها مئات آلاف المهاجرين اليهود قلب الوطن العربي الاستراتيجي والرمزي من عشرات الملايين العرب في البلدان المجاورة، وما لعبته كارثتها من دور في فكر وخيارات عفلق، ثم في حزب “البعث” قومي التوجه. يطرح هذا السؤال حول ما إذا كان عفلق قد تعلم حقاً درس مأساتها وعبّره الحقيقية!.
ـ هناك سببان وقفا وراء مواقف عفلق والحزب من قضية الوحدة، هما:
ـ أولاً: أن العرب، الذين رأى فيهم العامل المقرر الوحيد في قيام دولة الأمة، كانوا أمة خاماً، غائبة عن الفعل السياسي الذي يؤهلها لتوحيد نفسها أولا، ثم بلوغ وحدة دولوية، بفضل ما سبق لها أن بلورته من وعي وتنظيم وإرادة. إلى هذا، لم يكن لدى العرب مركز قيادي يمارس دوراً مرجعياً يحركهم بالتناغم الذي تتحرك به الأعضاء في جسد واحد. صحيح أن عبد الناصر كان يتمتع بحظوة لا شك فيها لدى الجماهير العربية الواسعة، التي بقيت غير منظمة، بينما جعلها الافتقار إلى الوعي براهنية الوحدة عديمة الاهتمام بما يؤهلها من مصالح وخطط للشروع في ممارسات سياسية، وتبني خيارات تقود إلى الوحدة. يفسر هذا، لماذا بقيت الجماهير المؤيدة لعبد الناصر دون مستوى الأمة، ولماذا خضعت لخيارات ومصالح متناقضة، لم تكن الوحدة على جدول أعمالها؟. أحل عفلق أمته المتخيلة او الافتراضية، التي لم تكن أمة سياسية أو ثقافية أو وحدوية، محل أمة الواقع الملموسة، التي كان عليه بلورة برامج تنقلها من حال الطبيعة وضمور وعيها بالواقع، إلى حال مدنية تنقلها من وضع خام تعطّلها فيه الفطرة، إلى طور نوعي تصير فيه أمة لذاتها؛ فارقت حالة الطبيعة.
ـ لو تأملنا المجال القومي، لوجدنا أن أقرب الدول إلى دولة الأمة كانت الدولة المصرية، وأكثر الشعوب قدرة على نقل الطور الوطني إلى طور أمّوي، وأكثرها انتقالاً من حالة الطبيعة إلى الحال المدنية كان المجتمع السوري، الذي كان في الوقت نفسه الأكثر نضالاً من أجل دولة الأمة، وما أن تعرّف على نواتها في مصر الناصرية، حتى منحها صوته في انتخابات حـرة سبقت قيـام “الجمهورية العربية المتحدة”: الدولة، التي التقت عندها دولة/ الأمة النواة مع حاملها الشعبي، الوطني/ القومي، بعد أعـوام من تفـاعل يومي بين جمال عبد الناصر وجماهير سورية رأت فيه قائدها، بينما كانت معظم النخب السياسية مؤيدة للمحور المصري/ السوري، البعيد عن العراق: قطب العالم العربي الآخر.
ـ بفهمهم كأمة متخيلة، كان من الطبيعي أن يبدو العرب ككيان مسطح يخلو من التراتب، وبالتالي من مصالح متناقضة أو متعارضة، ولذلك ينتمي إلى فكرة عفلق عن أمة ديدنها “الهرب من الحاضر والانسحاب إلى الماضي، حيث أثبت العرب وجودهم وتفوقهم”(38). هذه الأمة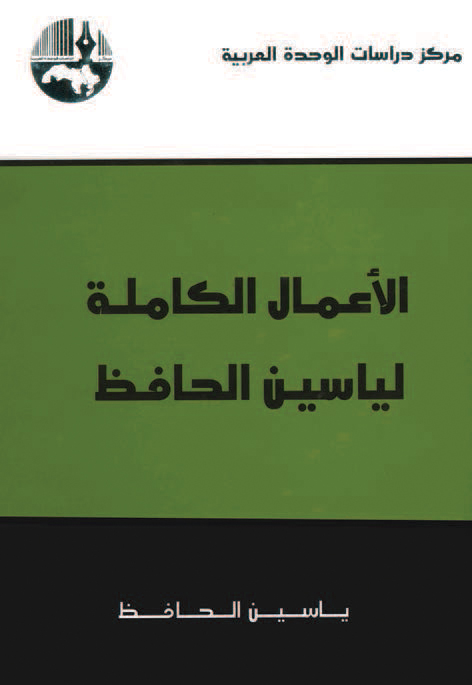 الوهمية، التي تفتقر إلى تجسيد مجتمعي/ سياسي، أو ثقافي، وحضور مستقل أو منفصل نسبيا عن الأمر القائم، رأى عفلق في حزب “البعث” بديلها المثالي، الحاضرة فيه، وسيتولى بعثها وتوحيدها انطلاقاً منه وبفضل نضاله، علماً بأنه لن يأتي بجديد، بالنظر لأنها متحققة في “تراث الأمة الروحي والحضاري، الذي ظل أشد حضوراً بين البعثيين من الحضور نفسه، كما أن المستقبل العربي الذي صاغوا صورته من عصارة فكرهم، وصدق معاناتهم، تحول لديهم إلى حاضر حي يستلهمون قيمه، ويطبقون مقاييسه. وهكذا استطاعوا ان يكوِّنـوا وسط الضياع والجمود والاصطنـاع تلك النواة الحية ذات الجذور الأصيلة والطاقة الخلاقة، التي كُتب لها من بين شتى المحاولات أن تنمو وتستمر، وتكتسب الملامح المميزة، والقدر الخاص الذي يلتقي في الأعماق بقدر الأمة، وينصهر فيه، ويخفِق مع نبضاته”(39).
الوهمية، التي تفتقر إلى تجسيد مجتمعي/ سياسي، أو ثقافي، وحضور مستقل أو منفصل نسبيا عن الأمر القائم، رأى عفلق في حزب “البعث” بديلها المثالي، الحاضرة فيه، وسيتولى بعثها وتوحيدها انطلاقاً منه وبفضل نضاله، علماً بأنه لن يأتي بجديد، بالنظر لأنها متحققة في “تراث الأمة الروحي والحضاري، الذي ظل أشد حضوراً بين البعثيين من الحضور نفسه، كما أن المستقبل العربي الذي صاغوا صورته من عصارة فكرهم، وصدق معاناتهم، تحول لديهم إلى حاضر حي يستلهمون قيمه، ويطبقون مقاييسه. وهكذا استطاعوا ان يكوِّنـوا وسط الضياع والجمود والاصطنـاع تلك النواة الحية ذات الجذور الأصيلة والطاقة الخلاقة، التي كُتب لها من بين شتى المحاولات أن تنمو وتستمر، وتكتسب الملامح المميزة، والقدر الخاص الذي يلتقي في الأعماق بقدر الأمة، وينصهر فيه، ويخفِق مع نبضاته”(39).
ـ من الطبيعي أن لا تكون أمة عفلق الافتراضية متراتبة بنيوياً، أو أن تضم تكوينات متنوعة، وتعترف بهوية غير العرب فيها. ومن المسَلم به أن تنكر ما بين شعوبها من تطور متفاوت، وتلح على أنها شعب/ أمة واحدة تلزمه وحدته الصماء بإقامة دولته الموحدة. وتخلو أمة عفلق المتخيلة من تناقضات، داخلها وبين مكوناتها، لكونها مجردة، وإذن، مندمجة وكتيمة، وعصية على التمايزات الطبقية أو الفئوية أو المصالحية، فالعربي عربي لكونه عربياً وكفى، أما غير العرب فشعوبيون وعنصريون ومعادون للعروبة، ومن غير الجائز إشراكهم في قضايا الأمة المصيرية، كوحدتها. من غير الجائز أيضاً قبول رأي معارضي الوحدة، لما لها من أهمية وجودية تفوق أهمية حق أي طرف في التعبير عن رأيه، ولأن الأمة تحتاج إلى تمثيل سياسي متجانس ومندمج، يستهدفه “الشعوبيون” بذريعة حقهم في الحرية. من غير المقبول أيضاً، أن يكون الموقف من الوحدة حزبياً، والولاء لها جزئياً، او تابعاً لأي ولاء سواه، يستثني من ذلك “البعث” لكونه يجسد الأمة في ذاته، وليس حزبا بمعنى الكلمة المألوف.
البعث: حزب الأمة
ـ ثانياً: مثّلنَ عفلق الأمة، وشطرها إلى شعب مجزأ تجافي التجزئة والقطرية طموحاته، وأمة متعالية، موحدة ونقية: متوطّنة في فكر “البعث” كما صاغه قلمه، وفي تنظيمه، ضامن وحدتها وعودتها إلى حالتها الطبيعة: أول حالة طبيعة نوعية في التاريخ لسببين: ارتباطها بالإسلام، ونشره رسالتها الخالدة. بهذا الفهم، تعني حالة الطبيعة لدى العرب عودتهم إلى مستقبل يستعيد ماضياً يتعين من الآن فصاعداً بـ”الوحدة والحرية والاشتراكية”. مثّلنَ عفلق حزب البعث أيضاً، وآمن أنه التجسيد المادي لأمته الروحانية، التي تبطل من خلاله غيابها عن ذاتها تحت وطأة التجزئة، وتحافظ على مثاليتها الكامنة في هويتها من جهة، وفي فكر “البعث” من جهة أخرى، وبالتالي في مواقفه، التي تزيل ما في الواقع من تناقض بين تجزئة مفروضة ووحدة إنقاذية، وواقع مصطنع وعابر، وأصالة روحية ثابتة. هذه التباينات بين الواقع والمثال، التي أكدتها رؤية عفلق، توطنت في حزب تجاوز تجزئة الأمة إلى وحدتها، لذلك يصح اعتباره أمة عربية استباقية كونها أعضاؤه المنتشرون في الفضاء العربي، عبر إلغاء التجزئة في نفوسهم، الذي يستبق إزالتها من واقع ووجود أمتهم، بوحدة يجسد “البعث” نفحة من رسالتها، تتصف بمثالية لا تشوبها شائبة، فكراً وتنظيماً، وإلا لما ناب عن الأمة المغيبة في واقع العرب، ولما انبعث من رحمها وانبعثت من فكره ونضاله، الذي تقلِع بسببه عن أن تبقى أمة متخيلة، أو افتراضية، وتغدو مثله ملموسة وراهنة، تجعلها الرسالة الخالدة فريدة في تاريخ الأمم، بشّرَ البعث بها ودعا لها وحققها في تنظيمه، وحمل رسالتها التي أملت عليه رسالته، وأعاد إنتاجها سياسياً وقيمياً وأخلاقياً: بدءاً من الماضي وصولاً إلى الحاضر والمستقبل، في وعي استباقي تحفزه قيم الإسلام الخالدة في القرآن، المعاصرة في فكر عفلق، التي جعلت من العرب “خير أمة أخرجت للناس”، في غابر ديني أفصح “البعث” عن حضوره الأبدي، المتطابق تمام التطابق مع نضاله اليومي، الذي “يجدد القيم الروحية والاخلاقية التي عرفتها أرض العروبة في عصرها الذهبي”(40).
ـ حدد الحزب هويته القومية، وموقعه من القطرية والتجزئة والنزعة الانفصالية والرجعية، وأعطى للعروبة مفهوماً عبّر عن تصميمه على ممارسة سياسة مزدوجة، تلزمه بتوسيع أنشطته وتنظيماته القومية، فيتطابق وجوده الافتراضي مع وجود أمة العرب، وبجلب الأمة إليه عبر ترقية وعيها الوحدوي وبلوغه مستوى وعيه، علماً بأن الأمة كحزب لا تتجسد في الأمة ككيان طبيعي وملموس، دون تكامل توجهين، يذهب أحدهما من ذات يمثلها “البعث” إلى الأمة، وثانيهما من الأمة المتحولة إلى حزب هو “بعثها في الروح والفكر والاخلاق والإنتاج والبناء”(41). البعث هو حزب الأمة، الذي ينقلها من التشتت والتجزئة والقطرية إلى حال “يبشر بالبطولة ويستلهم تراثها كأمة خالدة، ويعمل بمقاييس الخلود وبهدي المُثول الدائم أمام تاريخها”(42)، وهو تحققها في الأقطار التي ستزول بجهوده، فينحل هو عندئذ فيها، أو يعود إليها ولا يبقى ثمة من مسوغ لاستمراره كحزب تماهى معها .
ـ لئن كان قد قيل إن الثورة تتم على مرحلتين، تنجز أولاهما في الوعي، وثانيتهما في واقع البشر والمجتمعات، فإن الوحدة العربية أنجزت في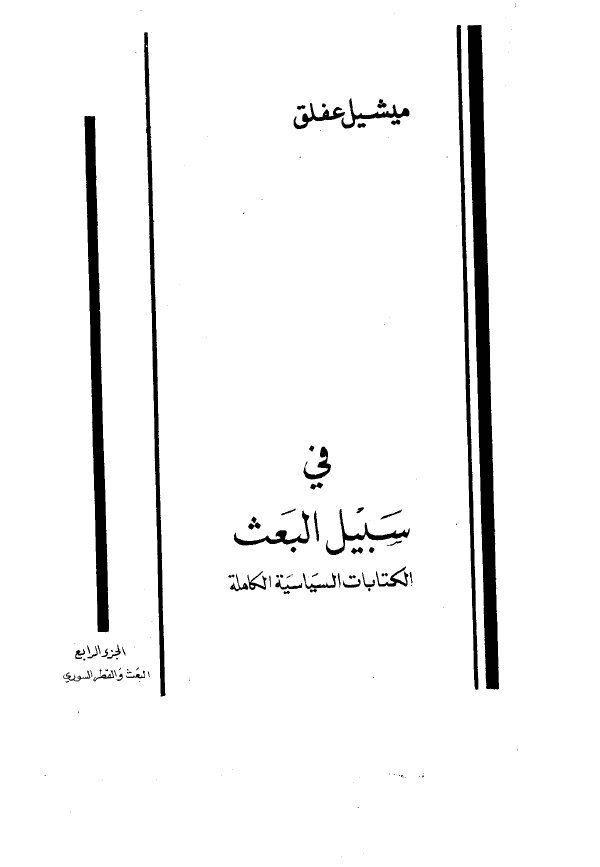 وعي “البعث” كحزب، سيتكفل بتحقيقها في الواقع. أما إليه تخلق الأمة في إهاب الحزب، فتعود إلى إنه وعي الواقع بفكر عفلق، وعمل دون كلل أو ملل لتثويره لأنه “جاء متجاوباً مع يقظة في الروح العربية، ومع حاجة عميقة في روح أمتنا إلى الانطلاق وإلى الخلق، فلا يجوز أن ننظر إليه غير نظرة حية… كما ظهر في حياة العرب الحديثة وفي وسط الجمود والجحود والنفعية والانحلال كحركة إيمان عميق تستقطب النفوس النقية السليمة، وتجتذب الإرادات القوية الصادقة، وتجمع حولها الأفراد المشبعين بحب الأمة العربية، المؤمنين بعظمتها، الذين لم يعمهم ما طرأ عليها من فساد عن رؤية جوهرها… ولم تستطع مغريات الواقع ومصاعبه أن تغلب فيهم إرادة العمل للكشف عن هذا الجوهر، فنشوء البعث العربي إنما هو دليل ساطع على الإيمان، وتوكيد للقيم الروحية التي ينبع منها الدين”(43). “البعث” في رؤية عفلق “حزب يجسد الجيل العربي الجديد، ويحمل رسالة لا سياسة، إيماناً وعقيدة لا نظريات وأقوالاً، ولا تخيفه تلك الفئة الشعوبية المدعومة بسلاح الاجنبي، المدفوعة بالحقد العنصري على العروبة، لأن الله والطبيعة والتاريخ معه”(44).
وعي “البعث” كحزب، سيتكفل بتحقيقها في الواقع. أما إليه تخلق الأمة في إهاب الحزب، فتعود إلى إنه وعي الواقع بفكر عفلق، وعمل دون كلل أو ملل لتثويره لأنه “جاء متجاوباً مع يقظة في الروح العربية، ومع حاجة عميقة في روح أمتنا إلى الانطلاق وإلى الخلق، فلا يجوز أن ننظر إليه غير نظرة حية… كما ظهر في حياة العرب الحديثة وفي وسط الجمود والجحود والنفعية والانحلال كحركة إيمان عميق تستقطب النفوس النقية السليمة، وتجتذب الإرادات القوية الصادقة، وتجمع حولها الأفراد المشبعين بحب الأمة العربية، المؤمنين بعظمتها، الذين لم يعمهم ما طرأ عليها من فساد عن رؤية جوهرها… ولم تستطع مغريات الواقع ومصاعبه أن تغلب فيهم إرادة العمل للكشف عن هذا الجوهر، فنشوء البعث العربي إنما هو دليل ساطع على الإيمان، وتوكيد للقيم الروحية التي ينبع منها الدين”(43). “البعث” في رؤية عفلق “حزب يجسد الجيل العربي الجديد، ويحمل رسالة لا سياسة، إيماناً وعقيدة لا نظريات وأقوالاً، ولا تخيفه تلك الفئة الشعوبية المدعومة بسلاح الاجنبي، المدفوعة بالحقد العنصري على العروبة، لأن الله والطبيعة والتاريخ معه”(44).
هل في هذه الرؤية خطة نظرية أو عملية يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف الحزب الطموحة، التي جرى عرض الجدلية التي تسم علاقاتها بالأمة، حين بنى موقفه على مُسَلمة تقول: “إن المراحل، التي تأخذ بها حركتنا، هي إلحاح على ناحية أكثر من غيرها، والمرحلية في نظرنا تكون في التطبيق ولا تكون في الوعي، فالوعي لا يجزأ”(45)؟. أراد أمين عام “البعث” القول: إن حزبه امتلك الوعي الضروري للتغيير، وصار عليه تطبيقه في الواقع ككل لا يتجزأ، فكم كان حظ رؤيته من الواقعية، وهل توافقت مع الواقع وبدائله؟.
ـ ألقى عفلق نظرات متباعدة على الواقع العربي، فاتها تحليله ودراسته بطرق تتجاوز وصفه البراني/ التصنيفي، الذي يستخدم لغة الوجوب الأخلاقية غالباً، وتتفحص ما فيه من تيارات ومصالح جاذبة إلى الوحدة وأخرى نابذة لها، وقوى لها مصلحة فيها وأخرى تعاديها، ووعي يكفرها وآخر يمثلنها ويقدسها. كما عالج ضرورته في إطار رَغَبي أقنعه أن تعداد خصائصها المتخيلة هو الوعي المطلوب لتحقيقها في عالم عربي غارق في التأخر والتخلف، الاشكالية التي لم ير فيها مسألة جديرة بدراسات تتفحص مضامينها وتقاطعاتها مع المجال السياسي، ودور البعث في إيجاد الحلول لها، لاعتقاده أنها مجرد فرع من مسألة التجزئة، سيزول بزوالها، اي أنه سيستمر إلى قيام الوحدة!. بذلك، فاتته الجوانب الجدلية في العلاقة بين تفاقم التخلف والتجزئة، ودور كل منهما في تعزيز الأخرى، وحجم إسهام التأخر في انقسامات العرب وسياسات فئاتهم الحاكمة وكياناتهم الدولوية. اعتبر عفلق أن رؤيته متماهية مع الوعي القومي في أنقى حالاته، وتغطي كافة جوانبه، وأن “البعث” كفيل بتوحيد أمة يسمو نزوعها الوحدوي على المصالح، وتتعالى قوميتها على موازين القوى المحلية والدولية، لذلك اكتفى بملامستها ملابسة وصفية وبرانية. يرجع ذلك إلى وضع العرب أمام خيار وحيد، هو أن يكونوا أمة في دولة واحدة، أو يبقوا دولاً رجعية/ انفصالية دون أمة، أو دولاً بأمة مغيبة، سيقاومها “البعث” كحزب، وسيعمل للإطاحة بها بجميع الوسائل، بما فيها الانقلاب، الآلية النضالية، التي نجدها في المادة السادسة من دستور الحزب، التي تقول: “حزب البعث العربي الاشتراكي هو حركة قومية شعبية انقلابية، وهو يؤمن أن أهدافه الرئيسية… لا يمكن أن تتم إلا عن طريق الانقلاب والنضال، وأن الاعتماد على التطور البطيء والإصلاح الجزئي السطحي يهددان الأهداف بالفشل والضياع”(46). هذا الطابع الانقلابي، يبدو جلياً في ما اقترحه عفلق من أساليب لإقامة الوحدة، ويشمل “الانقلاب العسكري، والثورة المسلحة، والتدخل العسكري المباشر لإيجاد حكومات بعثية أو لضم الأقطار أو بعضها”(47)، بما أن دولة البعث ستستحضر دولة الأمة من العالم الافتراضي إلى الواقع، بقوة ثورة بعثية ستقوِّض الأقطار ودولها، لأنها تغيِّب الأمة بقدر ما تتقاسمها، لكنها ستزول بقدر ما تتحد الأمة: في الحزب أولاً، ثم على صعيدها الذاتي، وانتصار إرادته المتماهية مع إرادتها، وتحررها من أوضاعها الرثة ومعوقات وحدتها، وتقويض ما فات عفلق الوقوف عنده من عوامل تفككها: بدءاً بتبعيتها لمراكز خارجية، مروراً بتفاقم تأخرها وتشتتها قطرياً وقومياً. بافتقار فكر عفلق إلى نظرية تربط النزعة الوطنية بالأمّوية، وتشرح ما يؤثر فيهما هبوطاً كالركود الاقتصادي/ الاجتماعي، والتخثر الثقافي والعقدي، تحول كل ما قدمه من تصورات إلى كلمات تظهر حبه للأمة، وعجزه عن لعب الدور الذي يتمناه في مصيرها.
ـ هل كان واقعياً ما أضفاه عفلق من جوهر مثالي ثابت على البعث كحزب والعرب كأمة، وقاله حول حتمية اسقاط النظم القطرية كسبيل أوحد إلى دولة العرب الموحدة، وما كتبه حول الارتباط السببي بين الوحدة وإلغاء التنوع الدولوي في الساحة القومية؟. وهل صحيح أنه لا توجد مراحل وسيطة بين التجزئة والوحدة، فإما هذه أو تلك، ومن الخيانة حتى مجرد التفكير بقبول أوضاع انفصالية بذريعة أنها نقيض الوحدة، ومن غير الممكن أن تسهم في تنمية اوضاع وميول وحدوية، حتى إن كانت أوضاعها وطنية وانّصبَ نضال أحزابها وحركاتها الشعبية والمجتمعية على الوحدة القومية، بعد أن سمح ببلورة مشتركات بين المجال القطري والفسحة الأمّوية، وبإنضاج النزوع الوطني إلى أن يكتسب طابعاً يأذن بتخطي التجزئة والتخلف؟. ألا يُحتمل أن تتخلق على أرضية المشتركات الوطنية قومية الأبعاد وحدوية النزوع مؤسسات ومصالح ترسي، بالتدريج، أسس عمل قومي تنجزه الدول القائمة، كجزء من مهام دولة الأمة، فإن استحالت إقامتها، يصبح من الضروري إيجاد بدائل لها في الواقع القائم، تُطوِر الدولة القطرية، ما دام العمل لإضفاء طابع وطني عليها، يحمل أبعاداً أموية، خياراً حتمياً لا خيار غيره؟.
ـ فيما بعد، وفي مناسبة متأخرة جداً هي الذكرى الثانية والأربعين لتأسيس “البعث”، والاحتفال بانتصار العراق في الحرب مع إيران، قال عفلق كلاماً خالف مواقفه السابقة تجاه القطرية: “هذا النصر… لن يكون آخر ما يملكه شعب العراق، وتزخر به أعماق الأمة العربية، من قدرات ومفاجآت، فالحالة التي يعيشها العراق هي أبعد ما تكون عن القطرية، لأنها تجربة بعثية، بفكر قومي، وبروح قومية، ولأن الأمة في حالة التجزئة لا بد أن تتمثل، بين حين وآخر، في قطر يكون مستجمعاً لعدد من الشروط الجوهرية الضرورية، لكي تجد فيه الأمة مجالاً للتعبير عن روح النهوض فيها”(48). هذا التطور القطري/ الوطني ذو الأبعاد القومية، الذي كان يجري في سورية، وطن “البعث” الأصلي، وأفضى إلى الوحدة، لم يُدرجه “الاستاذ” في رؤيته، التي حددت مسار التطور الذهاب حكماً إلى الوحدة ولا خيار له في الذهاب إلى غيرها، رغم ما كان يتم تحت عينيه من ميول تفتيتية وتباعدية عمقت التجزئة وقربتها من الصفات التي قرنها عفلق بها.
ـ لم يفكر عفلق بوحدة لن تذوب بالضرورة الدول القائمة وتدمجها في دولة الوحدة العتيدة، تبين بالتجربة أن قيامها ليس حتمياً، كما أوهم نفسه، وأن الذهاب إلى الوحدة سيكون تدريجياً ومتقطعاً، وسيمر في أشكال شديدة التنوع، ومسارات معقدة أشد التعقيد، ستعبر عن رغبة العرب في الوحدة وعجزهم عن إقامتها، وانصياعهم لواقع انتقالي يذهب في منحى انحداري، كان من الوحدوية العمل لوقفه، وتحويله إلى اتجاه يعزز الوطنية كحاضنة لعوامل وحدوية عديدة، يرجح تفاعلها مع سياسات العرب اليومية الخيار الأمّوي، وينمي ميل الأقطار الوحدوي، ويرجحه على ميولها الأخرى، المرتبطة بمصالح بعض الفئات الحاكمة، وآليات عمل الخارج، الذي يريد المزيد من تجزئة داخل عربي منقسم على ذاته، ومشحون بنزعات عدائية.
ـ تبنى عفلق رؤية سياسية ثورية التعابير مطلبية الغايات، أخذت صورة أقرب إلى ردود الأفعال على الواقع العربي المزري منها إلى خطط وبرامج تغيير ثوري/ قومي مدروس، لذلك حفلت كتاباته بالإدانة اليائسة من جهة، والتبشير المتفائل من جهة مقابلة، وغلبت نزعتها الأخلاقية على طابعها الفكري/ المعرفي. لذلك، قصُرت مفرداتها على حديث متكرر عن أمة اكتمل تكوينها قبل آلاف السنوات، افترضت استباقياً، ودون أي دليل، أن لديها رغبة وحيدة هي تخطي عقبات وكوابح تجزئتها، بذريعة لا إثبات لها هي مخالفتها لطبيعتها، ولأنها خيار لا يجوز، ولا يمكن، أن يكون لديها خياراً غيره، بالنظر إلى أن تجزأتها مصطنعة، ولا علاقة لها بهوية الأمة الأصيلة، كما أنها لن تستمر، فإن بحثت عن دليل يثبت حدسه، لم تجده في كتاباته، وستجد من المحال بقاؤها في مواجهة تاريخ خياره الوحيد أخّذُ العرب إلى وحدتهم، التي تمثل حركته الحتمية الملزمة لهم، وتمتلك في ذاتها من القوة ما يتكفل بكسر إرادات الانفصاليين حكاماً و”شعوبيين” ونظماً محلية، بما أن “البعث”، قوة هذا التوجه الارتقائي، لن يسمح بفصله عن الحركة التي تستجيب لفطرته التوحيدية، رافعة تحرر الأمة من أوضاعها الانفصالية وطبقاتها وفئاتها الرجعية، وأحزابهما: إسلامية كانت أم شيوعية أم ليبرالية.
ـ بهذا الالتزام، يرتكب “البعث” خيانة موصوفة إن هو تخلى عن قيادة الحركة القومية، وسمح لأي حزب آخر بالتدخل فيها، أو بالفصل بينه كتنظيم وكانقلاب تاريخي شامل، خاصة وأنه أداة تحقيق الوحدة، وحامل اسمها، ومجسد “الشخصية العربية”، التي يقودها بفكره ويقاد بفطرتها!.
نتائج رؤية عفلق:
ما الذي ترتب على هذه الرؤية بمكوناتها المختلفة؟.
ـ بالنسبة للأمة: بقي مفهوم “العرب” و”الأمة” دون تحديد، ولم يعرّفه عفلق أو يبين خصائصه التي استند إليها في بناء رؤيته لأمته، التي وجدت كفكرة دون تجسيد ودون تاريخ وبنية، ناقضَ واقعها العياني مثلنتها، التي أفرطت في إضفاء الغموض عليها، في الماضي والحاضر، وجعلتها أمة حدسية، أورد شذرات تفتقر إلى الترابط عن صفاتها، التي افترض أنها تُنتج قوانين تطور خاصة بها، تتسم بالحتمية وتلزم أبنائها، دون أن يقدم من الأدلة ما يؤكد مزاعمه. لهذا السبب، لم يرتق البعث فكرياً ومعرفياً إلى المستوى، الذي كان من شأنه أن يمكنه من تقديم دراسات حول مادته السياسية الرئيسة: الأمة العربية ووحدتها، مما يمكن مقارنته بما أصدرته الحركات السياسية والثورية الكبرى عن المسألة القومية في بلدانها.
– لم يحدد عفلق أيضاً مقومات وجود الأمة في حاضنتها التاريخية الشرقية، المطبوعة بطابع الأديان السماوية عامة، والإسلام خاصة، وبسيطرة الدولة على الحياة العامة، لامتلاكها الأرض كوسيلة إنتاج رئيسة، وتحكُمِها بالتشكيلات الفئوية في “مجتمعاتها”. وفاته أيضاً التفكير بتنوع وتناقض مآلات الحراك القومي والوحدوي المحتملة، في عصر يعج بعوامل تختلف جذرياً عن تلك التي أقامت في ماضٍ بعيد امبراطورية متعددة الأقوام متنوعة الهويات، حكمها العرب قروناً، من خلال رؤية غيرت عالمهم، والعالم من حولهم، أتى بها الإسلام كدين كوني أحدث تفاعلاً روحياً ومادياً عميقاً بينهم، ومع الأقوام التي اعتنقته وتلك التي رفضته، ولعب في الحالتين دوراً مؤثراً في نظرتها إلى نفسها والعالم، بينما بدل أنماط عيشها وعلاقاتها، وكياناتها السياسية، قبل أن يدب التفكك والتشظي في الامبراطورية العربية/ الإسلامية، وتدخل مجتمعاتها في ركود اقتصادي وجمود اجتماعي وتراجع حضاري، وتفقد وحدتها وتخضع لمراكز سياسية/إدارية ومذهبية متنوعة، شطرتها إلى ثلاثة كيانات كبيرة ومتناحرة، هي خلافة بغداد، وخلافة القاهرة، وإمارات الأندلس.
ـ بتحويله الموقف من الأمة إلى مسألة شعورية، تتعين بمضمونها الديني، كتب عفلق: “بقدر ما أقول عروبة، تعرفون أنني أقول الإسلام أيضاً، لا بل الإسلام أولاً، وإذا كانت العروبة قد وجدت قبل الإسلام، فإنه هو الذي أنضجها، وهو الذي أوصلها إلى الكمال، وهو الذي أوصلها إلى العظمة، وإلى الخلود… فالإسلام كان وهو الآن وسيبقى روح العروبة وسيبقى قيمها الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية”(49). بهذه القفزة عن واقع لعبت فيه عوامل ومؤثرات عديدة وجديدة دوراً متزايداً إلى جانب الدين وعلى حسابه، اكتسب وعي “البعث” بالتاريخ طابعاً ماضوياً ومؤدلجاً، افترض أن العرب هم اليوم أمة الماضي، أو أنهم كانوا دوماً أمة راهنة، أي فوق زمنية، رغم تفاوت التشكيلات الاجتماعية/ الاقتصادية التي عرفوها في تاريخهم العاصف، الذي حفل بتحولات جذرية، مرت بتفككهم وخضوعهم لقوى احتلال أجنبية، وما ترتب على سيطرتها من معضلات لازمت إمبراطوريتهم متعددة الأقوام والثقافات واللغات والأديان، فلا عجب إن كان وعي عفلق كيفياً ومجافياً لما يكون عليه الوعي الثوري من مطابقة للواقع من جهة، وكونية من جهة أخرى، ولا غرابة في أن سِمته الأيديولوجية أخرجته من واقع التاريخ إلى تاريخ متخيل، وهمي، تكراري وسكوني، لا تقدّم فيه ولا تأخر، ولم يتفاعل مع العصور والأزمنة المختلفة، التي حقق العرب خلالها انتصارات باهرة، ومنوا بهزائم ونكبات أودت في النهاية بدولتهم الموحدة، وهمشت أو قوضت عديداً من مراكزهم الحضرية، وغيبتهم عن ما كانوا قد حققوه من كشوف وفتوحات كونية بعد الرسالة المحمدية وفي عصرهم الإمبراطوري، وما واجهوه في العالم الحديث من استعمار كولونيالي أعاد إنتاج تأخرهم وعمق ووطد تبعثرهم في حاضنته الكونية، التي لم يعرفوا مثيلاً لها في الفاعلية والتأثير.
ـ بقيت الأمة أمة مكتملة الأركان، وبقيت بنيتها فوق سياسية لم تغيرها تطورات أخضعتها طيلة مئات السنين لأغراب وأجانب ومحتلين، بل رآها عفلق بمنظار أبقى الدين ديناً سواء تقدم أو تراجع، تمسك المؤمنون به أو شوهوه وهجروه، أو تغيرت بيئته ووظيفته وتبدلت، ولم يرها بمنظار تاريخ عرف مراحل تأثر العرب خلاله بغيرهم، وفقدوا إرادتهم المستقلة، فكان من الطبيعي أن تختلف هويتهم بسببها إلى درجة التعارض، وتنتقل من طور أمّوي إلى آخر معاكس، هم فيه مشروع يتوقف اكتماله على النجاح في مواجهة تحديات يمليها عصر تختلف مفرداته أشد الاختلاف عن كل ما سبقه وعاشوه.
ـ بهذا النوع من الفهم، أقنع عفلق نفسه أن “أمته” لم تتبلور أو تتكون، بل دخلت التاريخ مكتملة، وستبقى على حالها من الاكتمال بفضل جوهر ديني متعالِ، ثابت ولا يحول أو يزول، ليس من منشأ أرضي أو تاريخي، ومع أنه تنزل في التاريخ، فإنه بقي مستقلاً عنه ومتعالياً عليه… لذلك “لا خوف أن تصطدم القومية بالدين فهي مثله تنبع من معين القلب وتصدر عن إرادة الله، وهما يسيران متآزرين متعانقين، خاصة إذا كان الدين يمثل عبقرية القومية وينسجم مع طبيعتها”(50)، و…”إن حركة الإسلام المتمثلة في حياة الرسول الكريم … لعمقها وعنفها واتساعها ترتبط ارتباطاً مباشراً بحياة العرب المطلقة، أي أنها صورة صادقة ورمز كامل خالد لطبيعة النفس العربية وممكناتها الغنية واتجاهها الأصيل”(51) و … إن قوة الإسلام قد بعثت وظهرت بمظهر جديد هو القومية العربية … ولسوف يجيء يوم يجد فيه القوميون أنفسهم المدافعين الوحيدين عن الإسلام، ويضطرون لأن يبّعثوا فيه معنى خاصاً، إذا أرادوا أن يبقى للأمة العربية سبب وجيه للبقاء”(52). وأخيراً: “إن حركة الإسلام المتمثلة في حياة الرسول ترتبط ارتباطاً مباشراً بحياة العرب المطلقة، أي أنها صورة صادقة ورمز كامل خالد لطبيعة النفس العربية وممكناتها الغنية واتجاهها الأصيل فيصح لذلك اعتبارها ممكنة التجدد دوماً في روحها، لا في شكلها وحروفها، فالإسلام هو الهزة الحيوية التي تحرك كوامن القوى في الأمة العربية، فتجيش بالحياة الحارة، جارفة سدود التقليد وقيود الاصطلاح، مرجعة اتصالها مرة جديدة بمعاني الكون العميقة … ولا تعود من نشوتها قادرة على التزام حدودها الذاتية، فتفيض على الأمم الأخرى فكراً وعملاً، وتبلغ هكذا الشمول”(53).
ـ هذا الدور، الذي يلعبه دين احتضنته أمة مكتملة الأركان، نزل مكتمل الأركان بدوره انسجاما مع طبيعتها، ليمدها برسالتها الخالدة ويضفى خلوده عليها. يقول عفلق: “ولد البعث وهو يبشر بالبطولة ويستلهم تراث الأمة الخالدة ويعمل بمقاييس الخلود … خيارات البعث الفكرية وضعت بالمقاييس التاريخية لا الظرفية، وعلى ضوء قيم التراث الخالد … نحن الجيل العربي الجديد نحمل رسالة لا سياسة، إيماناً وعقيدة لا نظريات وأقوالاً … إن اصطلاح القومية العربية هو خليط من أفكار واتجاهات سياسية وعواطف، ومن رواسب وانحرافات، عارضة ومبتذلة، جعلته بعيداً عن المسعى الصادق الخلاق الذي يوحي به، وهو أن القومية وحدها الخالدة والثابتة الشاملة … والفكرة العربية بديهية خالدة، وقدر محبب، وحب قبل كل شيء”(54). سيعدل عفلق رأيه حول هذه المسألة، ومسائل كثيرة غيرها، بل ويتبنى عكسه في مقالة كتبها عام ١٩٧٤ بعنوان “القومية العربية والنظرية القومية” قال فيها: “… والعرب اليوم لا يريدون أن تكون قوميتهم دينية، لأن الدين له مجال آخر، وليس هو الرابط للأمة بل هو على العكس قد يفرق بين القوم الواحد، وقد يورث نظرة متعصبة وغير واقعية”(55).
ـ بالتمييز بين مستوى المبادئ، الذي تداخلت وتشابكت فيه أهداف مثالية لا تقبل التعيين الفكري أو المنطقي، ومستوى الواقع الدنيوي، الذي تضبطه قيم دينية انفرد “البعث” بتجسيدها في حال من النقاء المحض، وحافظ عليها وعليه، بغض النظر عن واقعه القائم وأنماط تفاعله معه، ما دام ارتباطه ليس مع الواقع، بل مع “الروح القومية” و”الرسالة الخالدة” و”الشخصية العربية”، المفاهيم غير المفهومية، التي أقام تصوره عليها في سياق غلب عليه نهج تديني، قصر عصر العرب الذهبي على ماضيهم، ونفر من حاضرهم، المحكوم بانحطاط يفسره عامل وحيد هو خضوعهم لكيانات انفصالية، ستقوضه مبادرة “البعث” إلى إعادة إنتاج ماضيهم في حاضرهم ومستقبلهم، ونشر رسالته الخالدة في العالم.
ـ هذه النظرة، التي رأت عصر العرب الذهبي في ماضيهم، ووظيفتهم التاريخية في استنساخه، تبناها عفلق والإسلاميون، شركاؤه في هجاء الحاضر والهروب من مشكلاته، التي تحدت قدراتهم، فلم يجدوا ما يواجهونها به غير أدلجة رغباتهما الشعبوية، التي خاطبت اللاشعور الجمعي لأمة مهزومة، قالا لها إن سبب نكباتها يعود إلى هجر قيمها القومية/ الدينية هنا، الدينية المعادية للقومية هناك، ولكنها في الوقت نفسه مشتركة المنشأ والوظيفة.
ـ هذا الموقف، الذي أملاه اليأس من إصلاح واقع فاسد فر ضحاياه إلى ماضٍ زاهٍ، توهموا أنه قابل للاستعادة في حاضرهم، لمجرد أنه كان قائماً في الماضي، وأن استعادته هي في نظرهم العلاج الوحيد، الذي سيخرجهم من مشاكلهم ويضعهم خارج قبضتها، ما أن يتناولون جرعاته الشافية، حتي يبرؤوا من أوصابهم القاتلة، دون أن يقولوا أو يعرفوا كيف سيحدث ذلك، رغم إيمانهم المطلق بنجاحه. يقول عفلق: “لا يحتاج العرب إلى تعلم شيء جديد ليصبحوا قوميين، بل إلى إهمال كثير مما تعلموه حتى تعود إليهم صلتهم المباشرة بطبعهم الصافي الأصلي. القومية ليست علماً بل هي تذكر، تذكر حي”(56). سيكون العرب غير قوميين، إذا لم يتذكروا قوميتهم، ويحققوها في واقعهم، انطلاقا من جوانيتهم وليس منه، أو إذا قرروا أن يطبقوا عليها بعض ما لا ينتمي إليها من فكر الآخرين، الذي يحسنُ بهم أن لا يتعلموه!.
ـ طبق عفلق هذه الترسيمة على المجال القومي، بمفردات معظمها من الفكر الديني، كالفطرة الثابتة والأبدية، والرسالة الخالدة، التي تحافظ على حصانتها ضد الواقع، مهما بلغ من الانحطاط والتخلف، لكونها “إيمان قبل كل شيء، ولا يعيبها هذا أو ينتقص من قدرها، فالحقيقة العميقة الراهنة هي أن الإيمان يسبق المعرفة الواضحة، وأن من الأشياء ما هو بديهي لا يحتاج إلى براهين ودراسات، إنه يدخل القلب ويمتلك العقل دفعة واحدة”(57)، بينما الشخصية العربية المؤمنة فهي لا تحول ولا تزول، والقدر القومي ثابت لا يقبل التحديد، والاشتراكية، التي “لو سئل عن تعريف لها، فإنه لن ينشده في كتب ماركس ولينين، وإنما سيجيب: إنها دين الحياة، وظفر الحياة على الموت(58). بالإيمان الذي يسبق التعقل حسب مبدأ كَنَسي حكم نضال “البعث”، وبتعريف للاشتراكية لا يُعرّف شيئاً، تذهب الفاعلية الإنسانية الضرورية لتحقيقها، إلى مجهول تنتجه استحالة اسمها “ظفر الحياة على الموت”. أما جدل الارض والسماء، فهو يتلخص في أن “خسارة الأرض أدت إلى خسارة السماء وخسارة السماء إلى خسارة الارض”، وفي السؤال: “هل القومية محصورة بالأرض كما يُظن، بعيدة كل البعد عن السماء، حتى يعتبر الدين شاغلاً عنها مبذراً لبعض ثروتها، بدلاً من اعتباره جزءاً منها مغذياً لها ومفّصحاً عن أهم نواحيها الروحية والمثالية؟”(59).
ـ تواجه الرسالة العربية خطرين، أولهما: “القومية التي تأتينا مع الكتب والمجلات التي تهددنا بنسيان شخصيتنا وبتشويهها، وتسلبنا واقعنا الحي وتعطينا بدلاً منه ألفاظاً فارغة من جهة، وثانيهما: الإيغال في التفكير المجرد، واستعارة النظريات القومية والفلسفية الأجنبية وتكديسها بعضها فوق بعض ليُركبوا منها القومية العربية من جهة أخرى”(60). لذلك: “عبثا ينشد العرب قوميتهم بتحليلها من الخارج إلى عناصرها، وتركيبها تركيباً صنعياً مستوحى من الكتب والتفكير المجرد ومثال الأمم الأجنبية. أنهم لن يجدوها إلا في داخلهم مركبة وواحدة”(61). تتميز قومية عفلق بتماهيها مع تاريخ صنعه الدين، وقام خلاله بغرسها في النفس العربية. كما تتميز باكتمال تشكلها في زمن غابر عيّن الاسلام هوية العروبة فيه، لن يكون للحاضر من وظيفة غير العمل لبعثها من كمونها في “الشخصية العربية”، لتتكفل بعدئذ بالباقي، بما أنها “ليست نظرية بل مبعث النظريات، ولا هي وليدة الفكر بل مرضعته، وليس بينها وبين الحرية تضاد، لأنها هي الحرية”(62).
ـ آمن عفلق بوجود حالة خاصة في الحياة العربية اسمها “العروبة”، حددت علاقة العرب بالإسلام، بعد أن أنجبته. لذلك، يجب اعتبار قوميتهم حالة اتسمت بالفرادة والخصوصية في ماضيهم، وستكون خاصة وفريدة بين الحركات القومية في حاضرهم ومستقبلهم، بالنظر إلى أن خصوصية العروبة وفرادتها هما نتاج اختلافها المطلق عن أية حالة قومية أخرى!.
ـ لئن كان هناك إجماع بين المفكرين على عدم ربط واقع شديد التعقيد بعامل وحيد، خاصة إن كانت جوانب عديدة منه تتعين بإرادات ومصالح أجنبية أو خارجية وتخضع لها، فإن عفلق خالف هذا الإجماع وفعل العكس: بربطه ما في الواقع العربي من تبعثر وتأخر بعجز العرب عن تذكر قوميتهم الثاوية في أعماقهم، وبإخراجها من ذواتهم، فلا غرابة في أنه عزا استمرار واقعهم الانفصالي/ الرجعي إلى كبت حقيقتهم أو حجبها عن أعينهم، فإن آمنوا بقومية تشبه غيرها من القوميات، أصبحت قوميتهم كغيرها: “عنصرية أو دينية”، وفشلت في أن تكون “مظهراً جديداً للإسلام”(63).
___________
هوامش:
(38). ياسين الحافظ ، مرجع سابق، الصفحة ٤٢.
(39). ميشيل عفلق: المؤامرة والرد التاريخي ، في سبيل البعث، الجزء الثالث، الصفحة ١٥٦.
(40). ميشيل عفلق، في سبيل البعث، الجزء الثالث، الصفحة ١٠٠.
(41). ميشيل عفلق، المرجع السابق، الجزء الخامس، الصفحة ١١٥.
(42). ميشيل عفلق : المرجع السابق، الجزء الأول، الصفحة ١٤٨.
(43). ميشيل عفلق، في سبيل البعث، الجزء الأول، نظرتنا الحية للحزب، الصفحة ٥٥.
(44). ميشيل عفلق، في سبيل البعث، من اقوال عفلق حول حركة البعث ، الجزء الأول الصفحة ١٥٠.
(45). ميشيل عفلق: الشعب العربي الواحد، في سبيل البعث، الجزء الأول، الصفحة ٢٥٥.
(46). دستور حزب البعث العربي الاشتراكي . منشورات البعث العربي الاشتراكي، المادة السادسة، الصفحة ٣.
(47). خالد عبد المنعم العاني : موسوعة العراق الحديث، الدار العربية للموسوعات ، ١٩٧٧، الصفحات ٤١١/٤١٢.
(48). ميشيل عفلق: الديمقراطية والوحدة عنوان المرحلة الجديدة ، في سبيل البعث، الجزء الثالث، الصفحة ٢٦٠.
(49). ميشيل عفلق، في سبيل البعث، الجزء الاول ، الصفحة ١٤٣.
(50). ميشيل عفلق: في سبيل البعث ، الجزء الاول ، صفحة ١٣٤.
(51). المرجع السابق ، الجزء الأول، الصفحة ١٤٢.
(52). المرجع السابق ، الجزء الأول، الصفحة ١٤٢.
(53). ميشيل عفلق: في ذكرى الرسول العربي ، في سبيل البعث ، مرجع سابق، الجزء الخامس الصفحة ١١٥.
(54). ميشيل عفلق: القومية العربية والنظرية القومية ، الجزء الأول الصفحة ١٨٦.
(55). في سبيل البعث ،الجزء الأول، الصفحة ١٨٦.
(56). ميشيل عفلق: في القومية العربية ، في سبيل البعث ، الجزء الأول، الصفحة ١٤٠.
(57). ميشيل عفلق: في سبيل البعث، حول الرسالة العربية، الجزء الأول ، الصفحة ١٠٥ .
(58). في سبيل البعث، ثروة الحياة، الجزء الأول ، الصفحة ١٩.
(59). المرجع السابق، الجزء الأول، الصفحة ١٣٧.
(60). المرجع السابق، الجزء الأول ، الصفحة ١٣٨.
(61). المرجع نفسه ، الصفحة ١٤٠.
(62). المرجع نفسه ، الجزء الأول، ١٣٩.
(63). ميشيل عفلق: القومية العربية والنظرية القومية، في سبيل البعث، الجزء الأول، الصفحة ١٨٨.
………………..
يتبع.. الحلقة الثامنة: (“البعث” والسياسة، و“البعث” والوحدة)
«ميشيل كيلو»: كاتب وباحث ومحلل سياسي سوري

التعليقات مغلقة.