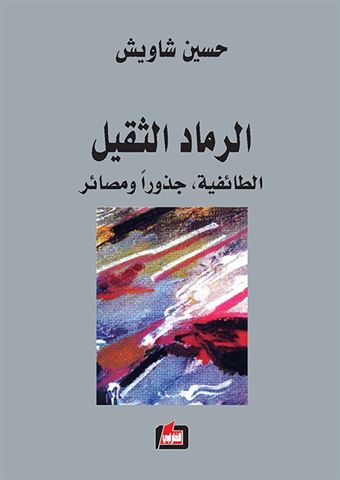
راتب شعبو *
لموضوع الطائفية جاذبية خاصة في ثقافتنا، جاذبية الدخول في أرض محرمة ينكرها، بشكل خاص، أولئك الذين يبنون قصورهم فيها. وربما جاءت جاذبية الحديث في الطائفية من النزوع القوي إلى تأثيم الآخرين وفق آلية الإسقاط النفسي المعروفة، لكن تبقى حيوية الهوية الطائفية الناجمة بدورها عن فشل بناء مؤسسات دولة حديثة تبلور هوية وطنية في مجتمعاتنا، هي السبب الأول للانشغال الدائم بالموضوع.
يساهم في هذا الموضوع الكاتب (حسين شاويش **)، في كتاب يبحث في “الطائفية، جذوراً ومصائر“، اختار له عنوان “الرماد الثقيل“. يقول القارئ في نفسه: ليكن “ثقيلاً” شرط أن يكون “رماداً”! لكن الواقع أن موضوع الطائفية لا يترمد في مجتمعاتنا إلا لكي يشتعل من جديد.
من البداية، ينسج ’حسين‘ علاقة طيبة مع القارئ، أسلوب جميل في العرض يضيف الأدب إلى الفكر، لغة حوارية حية، إلمام وسيطرة على الموضوع، ما يجعل من قراءة الكتاب متعة وتحريضاً على التفاعل، على التفكير والفهم.
يوسع ’حسين‘ قوس تناول الظاهرة المدروسة، يحاول التحرر من ثقل شروط الحاضر، فينظر إلى الظاهرة عبر مجال زمني واسع يعود إلى الانشقاق الإسلامي الأول (الخوارج) وصولاً إلى (داعش) التي يصفها خصومها “بالخوارج” أيضاً. كما يوسع القوس المكاني للخروج من حدود الشروط المحلية ولاسيما في سوريا والعراق، مكان الالتهاب الحديث لخطوط التماس الطائفية.
البساط الفكري للكتاب واسع، سأتناول منه بضع نقاط تبدو لي بحاجة إلى المزيد من التأمل.
بين الايديولوجيا الدينية والايديولوجيا الطائفية:
الهم الأساسي لكتاب “الرماد الثقيل” هو نقد نزعة التسييس في تناول موضوع الطائفية، “إن اعتبار أن الطائفية هي مجرد قناع تستخدمه السلطة السياسية (أو من يصارعها على السلطة) للاحتفاظ بتلك السلطة أو للوصول إليها هو ابتسار علمي بل إنه نوع من الإدراك الانتقائي للواقع المعقد”.
يريد ’حسين‘ إعادة الاعتبار للمستوى الايديولوجي والاقتصادي في ظاهرة الطائفية، وهو محق في هذا، لكن هناك فارق حساس يبدو للقارئ أن حسين يغفله أو لا يعيره الأهمية اللازمة، هو الفارق بين الايديولوجيا الدينية بوصفها النشاط الذهني الذي يصون العقيدة ويحدد التخوم مع الآخر الديني، وبين الايديولوجيا الطائفية التي يمكن أن تسعى لتوظيف “الوعي الديني”، والأصح “الهوية الدينية”، في الصراع السياسي ضد الآخر “الديني”. هذان النشاطان الايديولوجيان مختلفان حتى لو مارسهما الرجل نفسه. والحق إن رجل الايديولوجيا الطائفية قد يكون لا دينياً أو حتى ملحداً.
في الصراع ذي البعد الطائفي، يتراجع الدين بوصفه كذلك، وتتقدم الهوية الدينية بوصفها عصبية، يبدو ذلك جلياً في تراجع حضور العنصر الديني وكثافة حضور العنصر الطائفي. على سبيل المثال، لم يكن حضور الشيخ عدنان العرعور وأمثاله، في سياق الثورة السورية، حضوراً دينياً بل طائفياً. والحال كذلك فيما يخص حضور الشيخ موفق غزال وأمثاله في الساحل السوري.
حين يقول كاتبنا “إن رجل السلطة يحتاج إلى (شغيلة ايديولوجيين) يحولون الطوائف الخاملة سياسياً إلى التحزب الطائفي (…) يجب البحث إذن فيما يفعله هؤلاء (الشغيلة) وسنجد أنفسنا إذن في صميم البحث في المستوى الايديولوجي، لا السياسي”، فإنه يطمس الفارق ويدفع القارئ للخلط بين الفكر الديني، بحصر المعنى، والفكر الطائفي. الأول فكر ميتافيزيقي سلمي، والثاني فكر دنيوي صراعي. صاحب الفكر الأول هو رجل دين أو مثقف ديني، وصاحب الفكر الثاني هو رجل سياسة أو مثقف طائفي.
على سبيل المثال، وقوف جمعية علماء دمشق في ثلاثينات القرن الماضي، ضد محاولة المفوض الفرنسي فرض الحرية الدينية، يندرج في سياق مقاومة المؤسسة الدينية للتحديث، هذه المقاومة الدينية لا تنتمي إلى الصعيد نفسه الذي ينتمي إليه نشاط جماعة التوحيد والجهاد في العراق ضد “الروافض” واعتباره أولى من العمل ضد الجيش الأمريكي.
حين يبارك رجل الدين ممارسات رجل السياسة فيغذي سياسة هذا الأخير بطاقة “غير نظيفة سياسياً”، أو حين يصور لجمهوره الديني صراعاً سياسياً على أنه صراع بين مذاهب أو أديان، يخرج رجل الدين هذا من دائرته الدينية، ونكون فعلياً “في صميم البحث في المستوى الايديولوجي”، ولكن في مستوى الايديولوجيا السياسية.
“الجهاز أو المؤسسة الايديولوجية” للطائفة، بحسب المفهوم الذي يستخدمه حسين، لا علاقة مباشرة له بالطائفية، بوصفها شكلاً من أشكال الصراع السياسي. ورجال الدين، بحصر المعنى، ليسوا “شغيلة ايديولوجيين” يدفعون باتجاه التحزب الطائفي إلا حين يخرجون من معناهم الديني إلى المعنى الطائفي. وبالمناسبة، يستخدم حسين مفهوم “الطائفية” بمعنى وجود الطوائف، وليس فقط بمعنى الصراع الطائفي، وهذا يثير التباساً لدى القارئ. وأخشى أن يكون لهذا الالتباس حضور ما لدى حسين الذي يتكلم عن “الطائفة كوجود كامن” و”الطائفة كوجود واع” أو ببساطة “طائفية كامنة” و”طائفية واعية”، أن تكون الطائفية كامنة، هذا أمر يمكن فهمه على اعتبار أن الطوائف يمكن أن تُستقطب في صراع فيما بينها، أما أن تكون الطائفة ذات وجود كامن، فهذا غير مفهوم. على الأقل توجد الطائفة في طقوسها. هذه السهولة في شرح عبارة “الطائفة كوجود كامن” على أنها “ببساطة” “طائفية كامنة”، يؤشر على الالتباس الذي ذكرناه. وقد يكون هذا الالتباس هو ما دفع حسين إلى البحث في “الطائفة في ذاتها” بحسب عنوان الفصل الأول، وإلى تكريس قسم مهم من كتابه لدراسة نشوء طوائف ومآلاتها. ومن باب أولى أن نقول إن هذا ربما ما جعله يختار العنوان الفرعي لكتابه (الطائفية، جذوراً ومصائر).
أي مثقف وأي فكر “مغشوش”؟ يقول ’حسين‘، (أقتبس ببعض التصرف): “إن الفكر الطائفي هو بضاعة مغشوشة أو مسمومة ولكنها تجد ملايين الزبائن، وإن دور المثقف أن يكشف هذا الغش الفكري، رغم أن المثقف قد يكون أول التائهين”.
الفكر الطائفي بضاعة مسمومة، لا شك، فهو لم يقد، ولا يقود إلا إلى الدمار، ولكن لماذا هو بضاعة مغشوشة؟ يجيب الكاتب: “لأنه يجري تقديم (الحرب من أجل الطائفة) على أنها (حرب من أجل العدالة الطائفية)”. يوحي كلام حسين هنا أن “العدالة الطائفية” هي بضاعة غير طائفية تستر بضاعة طائفية هي “الحرب من أجل الطائفة”، وهذا هو الغش. والحال إن الحديث عن عدالة طائفية ينطوي على صياغة طائفية للوعي العام وهو مقدمة للحرب الطائفية. البضاعتان طائفيتان، لا يوجد أي غش هنا، اللغة مطابقة لمضمونها، لا توريات ولا مجازات ولا غموض.
المثقفون الذين ينتجون هذه البضاعة صادقون مع أنفسهم ومن الخطأ أن ننتظر منهم “كشف هذا الغش الفكري”، ببساطة لأنه لا يوجد غش من منظورهم. لا يضع حسين في اعتباره أن هناك نخبة مثقفة ترى في الثورة السورية مثلاً صراعاً طائفياً تريد به أكثرية سنية أن تستعيد حقاً سياسياً مسلوباً على يد أقلية علوية، ونخبة ترى من جهة أخرى، أن مضمون الصراع هو إعادة العلويين إلى الهامش مجدداً. بحسب هذه النخب الطائفية، فإن كل كلام آخر عن حرية وكرامة وشرعية سياسية ..الخ إنما هو “غش فكري”. أي إن الغش الفكري معكوس من منظور هؤلاء المثقفين. الكلام السياسي غير الطائفي هو كلام مغشوش، لأن الحقيقة، من منظورهم، طائفية دائماً. على هذا فإن فشل “المثقف” في كشف “الغش الفكري” ليس توهاناً بل مقصداً وهدفاً، أو قل إنه نجاح وليس فشلاً. في نظر حسين إن المثقف بالتعريف معاد للطائفية (ليته كذلك!)، فهو يبرئه مبدئياً من المشاركة في إنتاج تلك “البضاعة المغشوشة”.
الحق إنه يجب التمييز بين مثقفين دينيين يشتغلون على صيانة “عقيدة” الجماعة وتأدية الوظائف الدينية فيها من طقوس زواج ودفن وأعياد ..الخ، ما يسميه حسين “المؤسسة الإيديولوجية”، وبين مثقفين دينيين أو لا دينيين، ولكن طائفيين، يستثمرون سياسياً في المادة الأساسية (الطائفة) التي يعمل المثقفون الدينيون على صيانتها. هناك تكامل في عمل هذين النوعين من المثقفين لإنتاج “البضاعة المسمومة” بما يضمن تسويقها الأعظمي في لحظات الصراع المحتدم، لكن السم الفعلي يبدأ مع المثقف الطائفي وليس الديني. والواقع إن أعتى الطائفيين لا يفقهون من دينهم شيئاً في الغالب.
جاذبية الهوية الطائفية:
يظهر لنا الواقع أن الطائفية لا ترتبط حصراً بفشل الدولة، ذلك أنها لا تكف تعبر عن نفسها حتى في الدول الديموقراطية الراسخة والغنية وغير الفاشلة مثل أمريكا، ولكن ظهورها هنا يتكيف مع مستوى تطور الدولة ويسير وفق آليات مكرسة لإنتاج الشرعية السياسية. التعاضد الانتخابي لليهود أو للمسيحيين الانجيليين أو للمسلمين في أمريكا هو ممارسة طائفية “قانونية”. تجد الطائفية محلاً “مشروعاً” لها حتى في دولة المواطنة إذن. لا يمكن القول إن التعاضد الانتخابي هذا لا يتجاوز كونه ممارسة “نقابية” تحمي الجماعة بها مصالحها، ببساطة لأن هذه الجماعة ليست متجانسة اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياً حتى، والحديث عن مصلحة واحدة لملايين الناس لا يجمعهم سوى الانتماء الديني في بلد مثل أمريكا، هو حديث في الطائفية. هذا الواقع يثير الشكوك حيال تأكيد كاتبنا “نحن لن نعثر على وعي طائفي عندما لا يكون مقياس توزيع السلطة والامتيازات طائفياً”.
يوجد “وعي طائفي” حتى في ظل الدولة الديموقراطية، ولكن عدم وجود آلية مستقرة لإنتاج الشرعية السياسية في مجتمعاتنا تجعل “الطائفية” عندنا أشد حضوراً وتجعلها منفلتة وعنيفة حين يخرج الصراع السياسي عن الضبط.
المشكلة ليس في وجود الطوائف، ويمكن أن أغامر فأقول إنها ليست حتى في العصبية الطائفية التي يصعب حذفها بالكامل، المشكلة هي في عجزنا عن إقرار آلية محددة ومطردة لإنتاج الشرعية السياسية. الوجود المستقر لمثل هذه الآلية سوف يخفف من العصبية الطائفية، وسوف يرغم ما يتبقى من هذه العصبية أن يسير عبر قنوات قانونية وشرعية إذا شاء أن يؤثر في المجال العام، ما يجعل الانتماء الطائفي خاضع حكماً للانتماء الوطني.
* طبيب وكاتب سوري ومعتقل سابق
** طبيب وكاتب أكاديمي فلسطيني- سوري
المصدر: الحوار المتمدن

التعليقات مغلقة.