
غسان ناصر *
ضيف مركز حرمون للدراسات المعاصرة، هذا الأسبوع، هو الكاتب الصحافي والناشط في المجتمع المدني فاروق حجّي مصطفى، وهو معتقل رأي سابق، اعتقله جهاز الأمن السياسي في حلب مرتين، في عامي 2009، و2010، ومُنع من مغادرة القطر منذ عام 2005، ويعمل الآن في حقل المجتمع المدني السوري، حيث يشغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة “برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام” الفاعلة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كُردستان، وكذلك في شمال شرق سورية وفي المناطق الكُردية.
وُلد مصطفى في بلدة عين العرب (كُوباني) شرق الفرات عام 1968، ودرس المراحل التعليمية الأولى في ريف حلب، ثمّ في لبنان ودمشق، وكان طالب دبلوم دراسات عليا في جامعة “أونور” في بيروت، ودراسته الجامعية في العلوم السياسية والقانون الدولي. انخرط مصطفى في الشأن العام منذ أن كان بعمر 14 سنة، وذلك من بوابة انخراطه في العمل الحزبي، ويحمل قيم اليسار، وسرعان ما تحوّل إلى لبرالي، وهو يعرّف نفسه بأنه “ناشط لا عنفي”.
يعمل في الحقل الكتابي والصحافي منذ عام 1999، وباشر تجربته الصحافية والكتابية في الصحف والمجلات اللبنانية، مثل “الحياة”، و”السفير”، و”النهار”، و”المستقبل”، و”صدى البلد” و”نداء الوطن”، و”الآداب”، وكتب في أغلب الصحف والمجلات الكُردستانية، وفي الصحف الخليجية مثل “الشرق الأوسط”، و”الوسط” البحرينية، و”البيان” الإمارتية، و”السياسة” الكويتية، وفي الصحافة الإلكترونية مثل “منبر الحرية”، و”الأوان”، وغير ذلك. صدر له مؤلفات عدة نذكر منها: «المجتمع المدني السوري: الواقع والمأمول»، و«الكرد السوريون والحراك الديمقراطي»، و«قيامة كوباني»، إضافة إلى كتاب قيد الطباعة بعنوان «أي دستور يحتاج السوريون»، إضافة إلى مجموعة مهمة من أوراق البحث والدراسات حول المجتمع المدني.
وهذا نصّ الحوار:
– بداية، ينتظر قرّاء (مركز حرمون للدراسات المعاصرة) أن يعّرِفوا عن فاروق حجّي مصطفى المزيد.
= أعمل منذ ما يقارب 37 عامًا في الشأن العام، وأوّل ما فتحت عيني على النضال، انخرطتُ في إطار الحيّز التفاعلي الوطني، وأسهمت في بناء المساحات للنضالات الوطنية المشتركة، تعرّفت على المناضلين من الحزب الشيوعي، والحزب القومي الاجتماعي، والأحزاب الناصرية، واكتسبتُ الخبرة النضالية معها، لذلك أقارب كل حدث سياسي أو طارئ من منظار “الصالح العام”. ومع أني كنت شرسًا في أثناء النقاشات والصراعات الحزبية، استقررت مع الزمن على مبدأ “تغليب التناقض الرئيسي على الثانوي”، ثمّ أزلتُ من بالي مقولة “العدو”. ولم أعد أرى في أي إنسان “عدوًا”، مهما كانت أيديولوجيته، ولذلك أصرّ على أن تكون القيم التي يحملها الفاعلون في المجتمع المدني قيمًا إنسانية، وأنا مؤمن بـ “شرعة حقوق الإنسان” و”أجياله الأربعة”، كما أؤمن بمحو مفردة “العدو” في الخطابات اليومية.
وفي عملية الدستور، أقف إلى جانب أن يكون الدستور انعكاسًا فعليًا لسورية التي نعرفها، وأن نرمي خلفنا نمط “كوبي – بيست”، إذ لكل قضية لونها وخصوصيتها وميزتها، ولذلك فإنّ حامل قيم حقوق الإنسان وعالمه هو من يستطيع إنجاز “دستور” يرضي الجميع، ويصنف بـ “الجيد”، لأنّ الدساتير تُصاغ للحاضر والمستقبل.
الدستور هو أمّ القضايا:
– ما الذي دفعك إلى التوجّه إلى مدينة أربيل؟ وما الدور الذي تؤدّيه اليوم من خارج سورية؟
= هناك أمران دفعاني نحو أربيل (هولير): الأول هو الوضع الأمني، والبحث عن الحاضنة؛ والثاني هو سهولة التواصل مع العالم الخارجي الرسمي ومع المنظمات الدولية. في العامل الأول، لم أنتقل بشكل مباشر إلى أربيل، إذ دخل تنظيم (داعش) الإرهابي إلى مدينتي (كوباني)، فاضطر أهلها، ومنهم أهلي، إلى اللجوء إلى تركيا، وسرعان ما التحقتُ بهم، بيد أنني قررت الاستقرار في أربيل، والتردد إلى شمال شرق سورية، عند الحاجة إلى ذلك. أما العامل الثاني، فإني أرى في أربيل مساحة للحرية، وأشعر بتوفر إمكانات العمل بشكل جيد، وهي مدينة ملتقى المنظمات التي تستجيب لاحتياجات شمال شرق سورية، فضلًا عن السفارات ومسألة “الفيز”، ووجود مطار دولي، إضافة إلى المسائل اللوجستية البحتة. نحن نعمل في “المناصرة” و “المدافعة”، ومن يعمل في المناصرة، يتحرك بشكل أوسع، ونحن بحاجة إلى من نوصل صوتنا إليهم، كما نحتاج إلى الذهاب إليهم، وهذا ما توفره أربيل لي. أضف إلى ذلك أن في إقليم كُردستان نحو (275) ألف لاجئ، وعشرات الآلاف من المقيمين السوريين، وفي ذلك مساحة مهمة للاستجابة والمشاركة في نشاطاتنا المدنية، والبحث معًا عن الحلول وطرح البدائل. وأعتقد أنّ هذين العاملين كافيان، ويوضحان سبب اختياري لأربيل، فضلًا عن تعامل مسؤوليها معنا بشكل جيد، وتقديم الخدمات بما فيه فائدة لأهلنا.
– خبرتَ سجون بشار الأسد مدة من الزمن، بوصفك معتقل رأي، في عامي 2009 و2010. ما الذي يمكن أن تخبرنا به عن الآلة الجهنمية الوحشية لأجهزة النظام الأمنية، التي اعتقلت بشكل غير قانوني عشرات الآلاف من السوريين، وعذبتهم، وقتلت بعضهم تحت التعذيب من دون أي رادع إنساني أو قانوني؟
= لم أدوّن إلى الآن ما جرى معي في الاعتقال، مع أني كثيرًا ما أفكر بالأمر، ودائمًا أفكر بأنّ “الاستبداد يختزل كل شيء”، فلا داعي للشرح، إذا سألك أحد ما “أكنت معتقلًا في سورية؟”، وإنْ أجبت بـ “نعم”، برأيي، لا داعي للشرح، بدءًا من خرق الدستور الذي صنعه الاستبداد نفسه، وهو الاعتقال بسبب “رأي”، وانتهاءً بتحويلك إلى المحكمة العسكريّة.
ما بين اعتقالك من دون إذن من النيابة، وإطلاق سراحك من المحكمة العسكريّة، ثمّة قبرٌ. إنْ كُنت معتقلًا في أقبية المخابرات فهذا يعني أنك في القبر، أنت ميت مع وجود روح، وكلّما فتح عليك السجّان الباب فكّرت بـ “عزرائيل”، وهو نفسه يشبّه نفسه بعزرائيل. وفوق كل ذلك، السجناء أنفسهم لا يرحمون بعضهم البعض، هناك غياب للثقة بشكل تام، لا تعرف الذي ينام بقربك، أهو عنصر أمن، أم هو مثلك “معتقل”، وما إن ترفع عينيك للأعلى حتى تخاف من كل المناظر، تشعرُ بأن كل الجدران تراقبك، وتراقب مناماتك، مع العلم أن المنامات في السجن “هي الحرية”، عندما تنام وترى المنامات تشعر بأنك كنت في الخارج والتقيتَ بمجتمعاتك. أعتقد أنّ هذا السؤال بحاجة إلى كتابٍ خاص، بعنوان “عندما كنت معتقلًا وحرًا في المنام”. قصة التعذيب ليست خبرًا، فما إن تستقر في المهجع حتى يُتلى عليك أنّ “فلانًا” مات في الساحة في سجن الفيحاء. “زئير الأسد أنغام موسيقاك”، فبعد منتصف الليل، لا صوت غير صوت “زئير الأسد”.
– لك كتاب سيصدر قريبًا، عنوانه “أي دستور يحتاجه السوريون اليوم”؛ وسؤالنا هو سؤال العنوان ذاته: أي دستور يحتاج إليه السوريون اليوم، بعد نحو عقد من ثورة الحرية والكرامة؟
= نعم، صدر البحث إلكترونيًا، وأشرح فيه موجبات العمل الدستوري، وعقد الحلّ والآفاق، هذا كان قبل انطلاق “اللجنة الدستورية”، وحينذاك كان اسمي مرشحًا لقائمة المجتمع المدني التي رشّحها مكتب المبعوث الخاص إلى سورية، لكن، في اللقاء الأخير بين قادة أستانا في أنقرة أزيلُ اسمي. على كلٍّ، ليس هذا حديثنا، حديثنا حول أي الدستور بعد كل هذه التضحيات، بعد كل هذه العذابات، وبعد كل ما حدث.
بدايةً، أنا أرى أنّ الدستور هو أمّ القضايا، وإذا لم نصل إلى دستورٍ جيد، وإلى مقومات التطبيق، فإننا سنخسر الكثير الكثير، مضى 50 عامًا من الاستبداد، وعشر سنواتٍ من النزاع والحرب والوقائع والمعطيات التي أفرزتها كل هذه الأعوام، لذلك، يجب أن ينصب الحرص في خانة العمل لأجل الدستور المناسب لسائر المكوِّنات السورية.
برأيي، الدستور الجيد هو الدستور الذي يحقق شرط الدولة الرشيدة، وهو لا يتحقق إلّا بـ “فصل السلطات”، والعناية الخاصة بمسألة المحكمة الدستورية العليا، ومسألة الجيش الوطني، فضلًا عن النظام المختلط في مسألة الرئاسة، ومؤسسات التشريع بغرفتين، وأن تعبّر عن الكلّ إن كنت فردًا أو جماعة، وأن تزيل عن الدولة سمة “العنصريّة”. ولأن مجتمعاتنا متنوعة ومتعددة، فإنّ دستورنا بحاجة إلى التوافق على عدد من “مبادئ فوق الدستورية “، أو إلى أن تصاغ مواد غير قابلة للتعديل، وهي مواد مثل حقوق الإنسان ومسائل وحقوق القوميات، والأقليّات والنساء.
هذه فرصتنا، لا سيما أنّ الصياغة ستتم برعاية الأمم المتحدة، لذا علينا استغلال ذلك لصياغة أمرين:
الدستور، والأحكام الدستورية الانتقالية (قيمتها قيمة الدستور إلى حين عدم لزومها، وهذه هي الأحكام التي لها علاقة بالانتخابات، والعدالة الانتقالية، وإصلاح المؤسسات، والمصالحة، وتوفير شروط تطبيقية تنفيذية على النحو السليم.. إلخ).
الكل وقف ضد مشاركة المجتمع المدني في بناء مستقبل سورية:
– هل ترى أن الدستور يشكّل فعلًا أولوية في الأزمة السورية، ضمن المعطيات السياسية المستجدة؟
= منطقيًا، إنّ الدستور أحد السلال الأربع التي نراها بوضوح في القرار الأممي رقم (2254)، وبرأيي، الدستور هو في قائمة الأولويات، ولعل السبب يكمن في أنّ السوريين قدموا ملايين الضحايا، وشهدت البلاد حربًا أهلية أيضًا، وهناك معطيات خلقتها السنوات العشر؛ لدينا شباب لا يعرفون سورية، يعرفون “الإدارة الذاتية”، وشاهدوا أعلامًا ونشيدًا وطنيًا محليًا، ولا يتقنون العربية ،لأنهم عندما انطلقت الثورة كانوا أطفالًا، والآن أصبحوا شبابًا، لا يمكن أن تُعيد هذا الشاب الذي يملك قراره بنفسه، إلى سورية من دون أن يرى هو بنفسه مستقبله وحقوقه فيها.
في بحثي حول الدستور، ركزت على نقطةٍ مفادها أنّ “الدستور ينهي الحرب”. بنظري، إذا رأى الجميع أنّ الدستور المُصاغ الجديد يضمن حقوقهم ويدفعهم إلى التمتع بها، فإن ذلك سيُسرّع الوصول إلى تطبيق هذا الدستور، ومن هنا يشكّل الدستور أبرز أولويات السوريين.
– ما أثر (غرفة المجتمع المدني) في جنيف، في العملية السياسية التفاوضية؟ وما إنجازاتها الحقيقية؟ وأي دور يمكن أن يؤديه المجتمع المدني السوري في هذه العملية المتعثرة بسبب تعنت نظام الأسد ومراوغته؟
= لا بدّ من القول إنّ “غرفة دعم المجتمع المدني”، والثلث الأوسط، مختلفان عن بعضهما، وأعتقد أنّ بعض أعضاء “اللجنة الدستورية” غير راغبين في مراقبة الغرفة لأدوارهم وما يقومون به من الوظائف والمسؤوليات. ثمّة معضلة من قبل انطلاق “اللجنة الدستورية” إلى الآن: كيف بوسعنا، نحن المجتمع المدني، أن نؤدي دورًا ما في العملية الدستورية، لإيماننا المطلق بدورنا في صياغة مستقبل مريح للسوريين؟ ومن الطبيعي أنّ المجتمع المدني يفضّل الصالح العام على الخاص، وهذا ما تحتاجه سورية الآن.
في العموم، إننا لا نستطيع لعب دور يليق بنا في العملية الدستورية، وهناك معوقات وتحديات كثيرة، بيد أننا ما زلنا نبحث عن أدوات التواصل، وكيف لنا أن نكون إلى جانب الثلث الأوسط، وهو الثلث المتنوّع، وله انتماءات ولقاءات مختلفة، ولذلك نراهم يخفقون في لعب دور مهم في “اللجنة الدستورية”. الكل وقف ضد المجتمع المدني في مشاركته في بناء مستقبل سورية، وعلى الرغم من ذلك، نحن نقاوم ونحاول أن يكون للناس العاديين دور.
في الجولة الأخيرة، أخفق المجتمع المدني في تقديم أمر مهم، وفشل في دفع الجميع للحديث عن الدستور والمبادئ لا عن الشعارات. إذا كان يقع على عاتق المجتمع المدني بناء السلام والجسور، قبل إطلاق “اللجنة الدستورية”، فإنّ من مسؤولية الثلث الأوسط الدفع بالجميع للحديث في الدستور شكلًا ومحتوى. النظام فشل في مؤتمر اللاجئين بدمشق، وأراد أن يجلب النجاح من جنيف، غير أنّ البعض من “الثلث الأوسط” انزلق وحوّل النقاش إلى أهمية التحدث عن “عودة اللاجئين”. المعضلة تكمن في فهمنا لأدوارنا ومسؤولياتنا وما علينا فعله، ومع الأسف، هذا ما لم يبرز بعد. نتحدث منذ مدة طويلة عن “هوية المجتمع المدني”، لأننا ندرك أنّ تلك الهوية ستسهم في معرفة أدوار المجتمع المدني، في أي استحقاق.
– ما تقويمك لتفاعلات ما يجري على صعيد هذه العملية ما بعد جولتها الثالثة في جنيف، وإلى أين تسير مآلات التفاوض بحسب رؤيتك؟
= مبدئيًا، ستباشر “اللجنة الدستورية” اجتماعها الخامس في نهاية هذا الشهر، بحسب إحاطة المبعوث الخاص الذي تحدث عن تطورٍ مهم، وتبيّن أنّ هذا التطور كان خاصًا بالتزام اللجنة المصغرة باللائحة الداخلية. لم يحدث حتى الآن أي تطور على مستوى المحتوى الدستوري، وبحسب ما فهمنا، فإنّ الجولة القادمة ستبدأ بصياغة الدستور. لكن السؤال: كيف ستبدأ بالصياغة في حين أنّ وفد النظام لم يخرج من إطار الشعارات، والمعارضة تُبحر في كلام عام، وكتلة المجتمع المدني غير متناسقة؟
أعتقد أنّ أمام المبعوث الخاص أمرين اثنين: الأول استعادة دور للأمم المتحدة في عملية التسيير والرعاية ومنع أي تدخل لأي قوة إقليمية أو دولية، وفرض الجديّة في الأداء، ويبدأ هذا الاستحقاق بإجراء إصلاح “اللجنة الدستورية”؛ والثاني فتح مسارات النقاش على محاور عدة لبلورة الثقة، أو فضاء عام لبناء أفكار توافقية، وإشراك كل من أُقصي من المشاركة في بناء المستقبل السوري عبر مسار جنيف.
– بتقديرك، هل يمكن للجنة الدستورية واجتماعاتها في جنيف، أن تُحدث تغييرًا جذريًا شاملًا للنظام السوري، وانتقالًا سياسيًا حقيقيًا؟
= إذا تم تنفيذ القرار الأممي رقم (2254) كاملًا، وما يتعلق بـ “اللجنة الدستورية”، فسيحدث تغيير كبير في حال النظام.
أميركا ما تزال تسيطر على سماء المنطقة:
– لك أيضًا كتاب بعنوان “المجتمع المدني السوري الواقع والمأمول”. سؤالنا هنا: أيّ دور يمكن أن يؤديه المجتمع المدني السوري في المرحلة الراهنة؟
= هناك سعي للفاعلين في المجتمع المدني السوري لأن يكون لهم دور في مستقبل سورية، والحق أنّ دور المجتمع المدني بات معروفًا إلى حدٍّ ما، وهو المساهمة الفعالة في العملية الدستورية، وفي عمليات بناء الثقة وكسر جدران العزلة بين الجغرافيات والسكان، وتفعيل وبناء الجسور بين المكونات المجتمعية، وأن يكون جاهزًا لأي استحقاق سوري لاحق. بيد أن هناك معوقات وتحديات جمّة لأداء هذا الدور، وليس هناك ملامح واضحة للمجتمع المدني، إنما هناك مجتمع إنساني ومدني. وهناك رغبة لدى عدد من الأطراف المتدخلة بحال سورية في عدم إعطاء أي دور للمجتمع المدني، وقد رأينا كيف امتعض النظام من مفردة “المجتمع المدني”، وفضّل ذكر “المجتمع الأهلي”، مع أنّ القول بالمجتمع الأهلي يعني أنّ الدولة كانت عاجزةً عن بلورة مساحة المجتمع المدني، فغياب المجتمع المدني في أي دولة يُعدّ عيبًا. بالعموم، إنّ هناك حراكًا فعليًا لبلورة واقع اسمه المجتمع المدني، وهذا أمرٌ جيد.
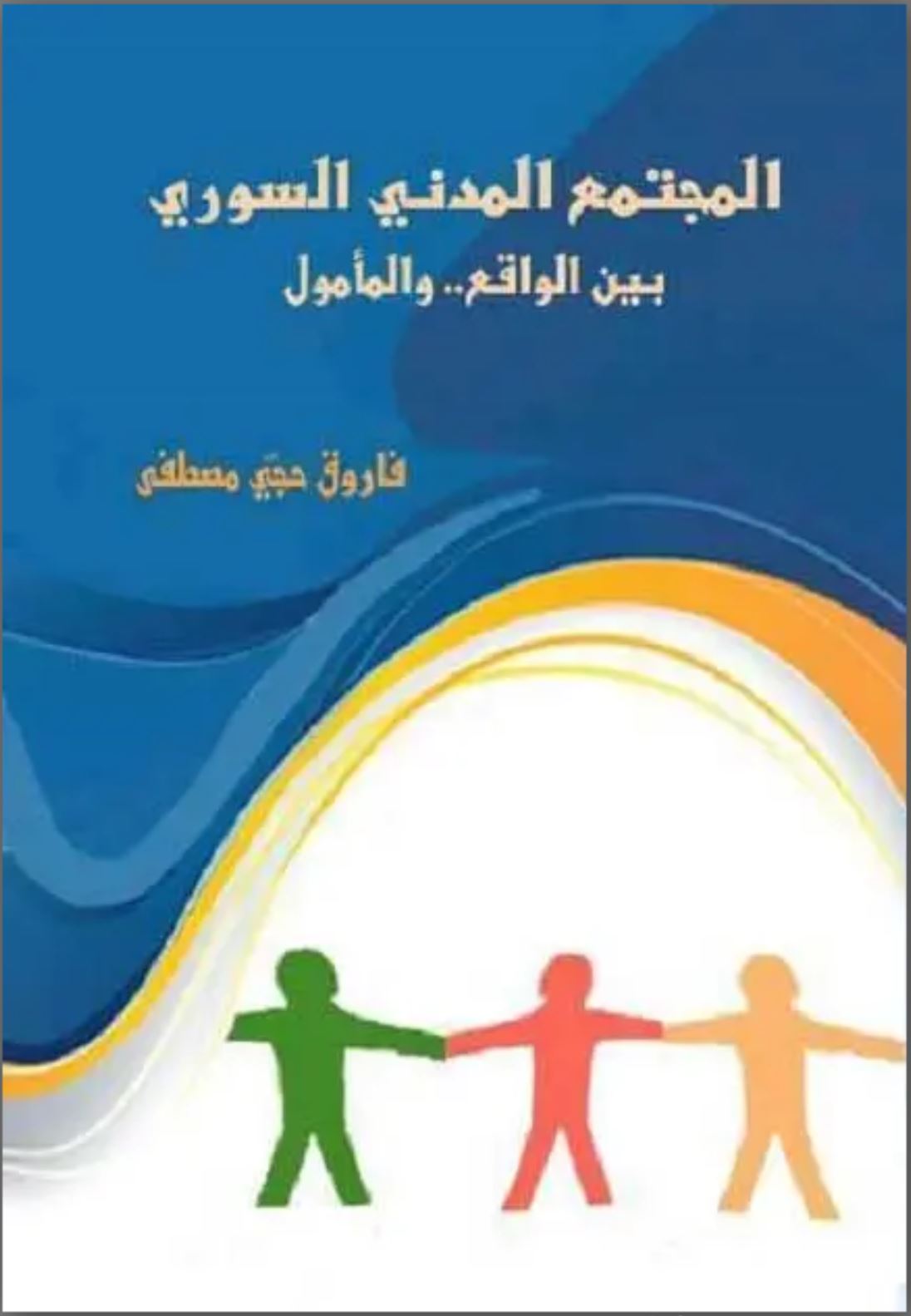 – من خلال ما توصلت إليه من نتائج في كتابك “المجتمع المدني السوري الواقع والمأمول”، هل يوجد حقًا مجتمع مدني ناضج ومستقل في سورية؟ وما الذي ينقصه ليكون قادرًا على تقديم العون للسوريين في الداخل؟
– من خلال ما توصلت إليه من نتائج في كتابك “المجتمع المدني السوري الواقع والمأمول”، هل يوجد حقًا مجتمع مدني ناضج ومستقل في سورية؟ وما الذي ينقصه ليكون قادرًا على تقديم العون للسوريين في الداخل؟
= مقارنة مع المجتمع المدني قبل الثورة، حيث كان هناك خطاب للمجتمع المدني، ولم يكن هناك مجتمع مدني إجرائي، المجتمع المدني اليوم في حالة جيدة، على الرغم من عدم تسخير القدرات في تعزيزه، لأن التمويل صُرف للحيّز الإنساني لا للمجتمع المدني. نعم، هناك مجتمع مدني قريب من المعارضة، وهناك مجتمع مدني قريب من النظام، وهناك مجتمع مدني قريب من الأحزاب الكردية، وهذا مشهد انقسامي غير صحي. بحسب رأيي، المجتمع المدني يجب أن يكون متناسقًا، والاستقلاليّة أحد أهم شروط هذا التناسق، وكذلك ضرورة الحياد في مسائل الاستجابة مثلًا. إن ما ينقص المجتمع المدني اليوم هو جملة من القيم يتوافق عليها كل المجتمع المدني أو غالبيته، بالإضافة إلى التشاور والتحاور الفعّال، والحيادية تجاه الخلافات الحزبية، وأن لا يكون المجتمع المدني جزءًا من الأجندة الحزبية، بل يتوافق مع الأحزاب في إطار الشأن العام.
– أنت من أبناء مدينة عين العرب (كوباني)، وترأست بين عامي 2013 و2018 رئاسة مجلس إدارة منظمة “برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام” الكردية. ما وضع المدينة اليوم، وخصوصًا بعد إعلان الأميركان أن مناطق نفوذهم تقتصر على مناطق النفط في الحسكة ودير الزور؟
= لا أظن أنّ النفوذ الأميركي يقتصر فقط على المناطق النفطية. أميركا موجودة في السماء وفي القاع المجتمعي، حيث ما تزال تسيطر على سماء المنطقة، ومنظماتها تستجيب لاحتياجات الناس في كل مناطق شرقي الفرات. أما عن الوضع في كوباني، فهو شبه مستقر، باستثناء القليل من “التراشق الإعلامي” بين أطراف النزاع. شخصيًا، أعتقد أنّ هذا الوضع سيستمر، وذلك لأسباب عدة: أولها أنّ الوضع العام في سورية يتّجه نحو فرض “وقف إطلاق النار”، وثانيها أن ثمّة حوارًا سياسيًا من خلال “اللجنة الدستورية” قائمًا على قدم وساق، وثالثها أنّ العقوبات الأميركية تفعل فعلها وتؤثر في أداء النظام وقدرته على البقاء، رابعها وجود اتفاقيتين على مستوى دولتين عظميين (أميركا، وروسيا) مع تركيا حول هذه المنطقة والمناطق الأخرى من الجزيرة، ونحن في منظمة (برجاف)نسعى، من خلال “المناصرة ” أو “المدافعة”، لأن لا تتفاقم الأزمات في كوباني أو في أي مكان. إنّ الاستحقاق الأول هنا، في كوباني وغيرها، هو العمل على تجهيز أنفسنا للمرحلة المقبلة، وهي المرحلة التي ستكون الفيصل بين حقبتين: حقبة الاستبداد والحرب والإرهاب، والأخرى حقبة العمل على تحقيق شرط أو موجبات البناء؛ بناء السلام.
الاستبداد جلب كل هذه القوى الاستعمارية:
– من وجهة نظرك، ما فائدة وجود الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سورية المدعومة بالاستثمارات والمشاريع الأميركية والغربية وهي معزولة عن محيطها السوري؟
أفهم أنّ وجود الإدارة ضروري لتنظيم أحوال الناس، في ظل الفوضى والأزمات في المنطقة، وهذا الأمر يختلف عن وجود الاستثمارات الأميركية، فالإدارة الذاتية تنظم شؤون الناس وتحقق شرط الأمان إلى حدّ ما، وتسدّ الطريق أمام الفوضى، ولو لم تكن هذه الإدارة لكان الناس قد أسسوا كيانًا يدير شؤونهم، لأن ذلك ضرورة، بغض النظر عن شكل ومحتوى الإدارة. في الأزمات والطوارئ والكوارث والحرب، تصبح مسألة “إدارة المجتمع لنفسه” أمرًا مشروعًا، وأعتقد أن هناك تلميحات لهذا النوع في القوانين السورية. أما بخصوص المشاريع الأميركية والاستثمارات، فهي مفيدة للناس أيضًا، على مختلف خلفياتهم العرقية والدينية – المذهبية، والثقافية، ويمكن هنا اللجوء إلى الصيغة القانونية، أو يمكن تشبيه ذلك بمبدأ “الاستثمارات مقابل الغذاء”، وبخاصة أننا نخضع للعقوبات الأوروبية والأميركية، وفي مقدمتها “قانون قيصر”. أما الحديث عن أن المنطقة معزولة عن محيطها السوري، فأنا أتفق معك إلى حدٍّ ما، لكن شمال شرق سورية أقل حدةً من العزل الموجود في الجغرافيات السورية الأخرى.
هناك معطيّات عدة لا بدّ أن نذكرها، وهي أنّ الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية ليست أمرًا طارئًا بقدر ما أنّ كل الجغرافيات السورية استخدمت نمط إدارة الذات في ظل الحرب، ففي مناطق المعارضة “المجالس المحلية”، وفي منطقة النظام “حكومة”، وفي المناطق الكردية وفي مدن شمال وشرق سورية “الإدارة الذاتية”. نحن هنا لا نتحدث عن سيادة الدول، لأنّ أمر السيادة أصبح محل لبس بعد أن خسرت الحكومة السورية مساحات واسعة، وخسرت المعابر مع الدول المجاورة، وبعد عدم تمكنها من السيطرة على الأرض، وهناك عامل آخر وهو الثورة أو الانتفاضة، وهذا ما يوحي بأنّ الحكومة لا تعبّر عن الناس، وفي ظل هذه الأوضاع، لا يمكن الحديث عن السيادة، فسورية عضو في الأمم المتحدة، وكل الجغرافيات هي جغرافيات سورية، وهذا ما يضع الكل أمام استحقاق الحفاظ على الاتحاد واستقلالية الدولة، وهذا ما يضع الأطراف السياسية السورية بتنوعها أمام بناء السلام والتسوية السياسية عبر الانتقال الديمقراطي إلى سورية لكل ناسها أفرادًا وجماعات. ثمّ إنّ الاستثمارات وتنوعها وانتشارها يكون تبعًا لمناطق النفوذ، فشمال غرب سورية حيث نفوذ تركيا، تجد فيه المستشفيات والمولات، حتى العملة المتداولة هي تركية، وتجد أيضًا المدارس والجوامع والمشاريع بتنوعها. وفي الشمال الشرقي مشاريع واستثمارات أميركية، مع ملاحظة أنّه لم يُنفذ حتى الآن أي مشروع أميركي على الأرض. أما في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، حيث الروس وإيران، فإن هناك استثمارات على مستوى المطارات والموانئ والنفط ومشاريع البناء والعقارات وهي متنوّعة، هذه هي حالة سورية اليوم.
– ما دور منظمات المجتمع المدني وتأثيرها في تطوير دور المرأة السورية وتعزيزه في المرحلة الراهنة، ولا سيما أن منظمة (Christian Aid) ذكرت في دراسة لها، العام الماضي، أنّ عدد المنظمات المدنية السورية منذ عام 2000 وصل إلى أكثر من 550 منظمة، وأنّ كثيرًا من هذه المنظمات يعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع السوري، وبخاصة مع تصنيفها من قبل الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة ضمن (أكثر نساء العرب قهرًا)؟
= إنّ عدد المنظمات المدنية، ومن ضمنها الإغاثية والصحية والنسوية، يفوق 1500 منظمة، بغض النظر عن كون هذه الهياكل تحقق شرط “منظمة” أم لا، أي إسقاط مفهوم الحوكمة على المنظمات وهيكلتها ومدى قيامها بما يقع على عاتقها. أرى أنّ انخراط النساء في المشهد المدني أمر طبيعي، وإن كان على مستوى خجول. مع الأسف، وجود المرأة ليس بالوجود الفعلي، إنما هو لتحقيق شرط الندرة في كل منظمة، وهذا يعني أننا أمام مسؤولية الانخراط الفعلي للنساء، وبخاصة أنّ حقوق الإنسان كلٌّ لا يتجزأ.
من حق النساء السوريات علينا أن نعمل معهنّ للخروج من هذه الظلمة، ونحن، بصفتنا سوريين، بحاجة ماسة إلى إمكاناتهنّ وقدراتهنّ في عملية المشاركة، وإلى تحقيق شرط المساواة، ورفع الغبن عنهنّ، وتحريرهنّ من الاستثمار الشكلي لحضور النساء في المناسبات والمؤسسات. هنّ نصف المجتمع، بل صرن أكثر من النصف، والحق أنهنّ لعبن أدوارًا مهمة في بعض أماكن وجودهنّ، مثل “المجلس الاستشاري النسائي” في جنيف، وفي انخراطهنّ في العملية الدستورية، وفي المجالات الأخرى مثل قيامهنّ بإنجاز الأبحاث في مراكز البحوث والدراسات، وفي عملية بناء السلام. أما بخصوص تصنيفهنّ بأنهن “أكثر النساء قهرًا”، في مثل هذه الدراسات المهمة التي تلفت النظر إلى مسائل مهمة وشائكة من خلال البحث والتقصي، فيمكن الإجابة هنا على صيغة كيف بالإمكان أن يلعبن أدوارًا مهمة في المجتمع، مثل مسائل التنمية؟
من الضروري الاهتمام بالجيل الرابع من حقوق الإنسان، وهذا ما يضع السوريين والسوريات أمام أهمية العمل على “تشجيع حقوق الإنسان”، ونشر ثقافة “الحق في التنمية”، إضافة إلى الإعلانات والاتفاقيات الأخرى والخروج من بوتقة “شمولية وجزئية حقوق الإنسان”، بحجة قانون الأحوال المدنية والشخصية والأعراف المحلية. إنّ تحرر المرأة أحد أهم مهام العمل الثوري، ولا يمكن أن تكون سورية الجديدة معبرة عن الكل، إن كان هناك امرأة واحدة فاقدة لحقوقها الكاملة.
– سورية اليوم تقع تحت انتداب روسي وحضور إيراني كبير النفوذ، كما أنها تحت سيطرة أميركية ونفوذ تركي في شمال وشمال شرقي سورية. برأيك، كيف السبيل إلى استقلالها وتخلّصها من كل هذه القوى المتنازعة على مقدراتها وثرواتها؟
= مع الأسف، هذه هي حال سورية، ولا أظن أن يكون قول “اخرجوا من بلادنا” ذا جدوى، إنْ لم يكن هناك “انتقال ديمقراطي”، سيادة الدول وحدها تجبر الجميع على “الخروج”، وهذا ما يقوله القانون الدولي، إن ما جلب كل هذه القوى هو الاستبداد والحرب، والخلاص من هذه القوى الاستعمارية يكون بإنهاء هذين التصنيفين. إنّ لوجود بعض الدول في سورية (روسيا على سبيل المثال لا الحصر) تعقيدات قانونية، لكن التسوية ستكون أقوى من كل هذه التعقيدات، وفي النهاية، سورية دولة، وعندما حدثت الحرب كانت سورية واضحة بحدودها الجغرافية، والاتفاقيات بين “الحكومة السورية” والروسية “اتفاقيات الدفاع” تحتاج إلى قراءة أو اجتهادات قانونية، لنعرف هل هي “اتفاقيات شرعية كاملة الأوصاف”، بالنظر إلى مسألة شرعية الحكم؟ وهناك أيضًا أمر يتعلق بسؤال: “متى تنتهي هذه الاتفاقيات؟” وهل بوسع الحكم الجديد أن ينهي مثل هذه الاتفاقيات أم لا؟ ما أعرفه هو أنّ السوريين أمام مسؤولية بناء سورية الجديدة خالية من الاستبداد والإرهاب، وتأسيس نظام حكم ديمقراطي، وتعزيز دور المجتمعات المحلية من خلال المؤسسات الشرعية، في إطار اتّحادي يحقق شرط المواطنة الكاملة.
– سؤالي الأخير، هل أنت مع المطالبين، ممن هم في صفوف قوى الثورة وأطياف المعارضة السورية، بضرورة إقرار “عقد اجتماعي مدوّن” في الدستور الجديد؟ وفي حال كان الجواب نعم؛ ما رؤيتك لهذا العقد الاجتماعي؟
= طبعًا، نحن بحاجة ماسّة إلى “عقد اجتماعي مدوّن”، وعلى الرغم من اللغط الذي يحدث في أحيان كثيرة حول أنّ الدستور هو نفسه “عقد اجتماعي”، أقول على عكس هذه الرؤية: إنّ السوريين بحاجة إلى “مؤتمر وطني عام”، يجتمع فيه ممثلو كل المكوّنات والتيارات الحزبية، للخروج بعدد من المبادئ الأساسية التي تُصنّف ضمن “المبادئ فوق الدستورية”، فإذا كنا نلجأ إلى برلمان للتشريع، كما هي العادة، ومعرفة ما هو مسموح له (برلمان) دستوريًا، فيمكن لهذا التشريع أن يُطرح على مجلس آخر إلى جانب البرلمان، (مجلس الشيوخ)، أو (مجلس المكوّنات)، أو (مجلس المقاطعات)، أو (مجلس الأقاليم).. إلخ، لمعرفة مدى انسجام هذا التشريع مع “المبادئ”، أو “عقد اجتماعي”.
كنت على أمل أن يُعقد هذا المؤتمر العامّ، قبل انطلاق “اللجنة الدستورية”، لكن لم يُفكر به أحد، وما أتمناه الآن هو أن يُعقد بعد الانتهاء من صياغة “اللجنة الدستورية” للدستور الجديد. وأختم بالقول: إنّ “المؤتمر الوطني العام” الذي أتمنى عقده سيسهّل عملنا في مرحلة العملية الانتقالية، وربما يسهّل الإجراءات من الناحية التنفيذية أيضًا.
* صحافي سوري – فلسطيني
المصدر: حرمون

التعليقات مغلقة.