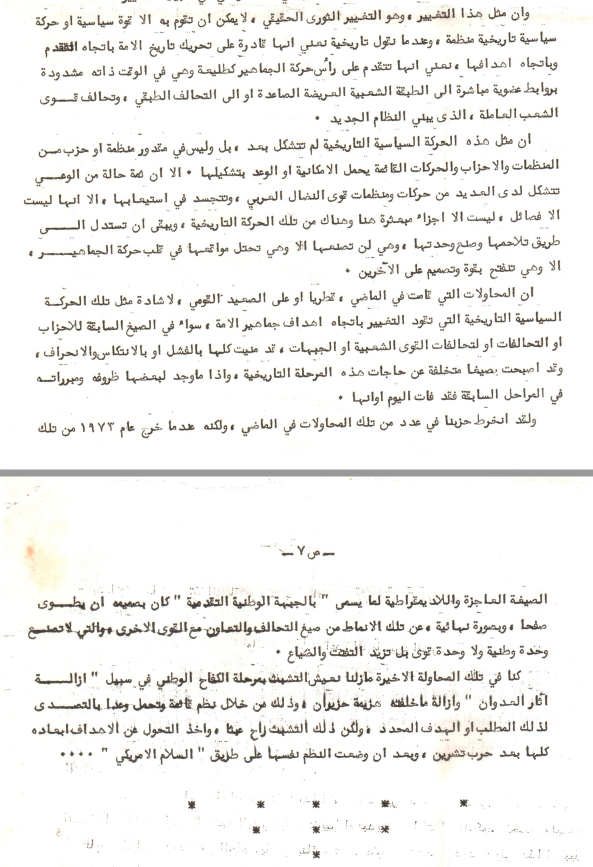
حزب الاتحاد الاشتراكي العربي حرية ☼ اشتراكية ☼ وحدة
في سورية
نشرة داخلية خاصة بالاعضاء
الحـــريّــة أولاً
الحريّـة … إنها الكلمة الأولى والهدف الأول من أهداف نضالنا السياسي، وهو الذي يحدد الطريق إلى أهدافنا الكبرى ويعطيها معناها. وفي الميثاق الناصري يأخذ هذا الشعار، وتأخذ كلمة الحرية معانيها المباشرة والبسيطة، إنها حرية الوطن وحرية المواطن، إنها الديمقراطية في صيغة الدولة والحكم وفي توزيع السلطات، إنها حرية الفكر وإنها تحرير الجماهير وانعتاق إرادتها من قيود القسر والظلم والتخلف والاستغلال ليكون الحكم حكم الشعب والدولة دولة الجماهير، ممارسةً وفعـلاً، فهي الحرية السياسية متقدمة بالتحرر الاجتماعي والاقتصادي والفكري، وذلك ما نريده ونعنيه حين نقول بالديمقراطية الشعبية. إنها هي التي تعطي لقضيتنا الكبرى، قضية القومية العربية، طريقها الصحيحة ومضمونها، فبدونها، أي بدون وضع الحرية في أساس فكرنا القومي وفي مقدمة العمل لها، تصبح القومية تصوراً مجرداً، أو تصبح تعصباً وشوفينية وعدوانية، ليتحول التعصب إلى عدوان ضد أنفسنا وتمزيقاً لمقومات تقدم وعي جماهيرنا ووحدتها الوطنية وتحطيماً لإرادتها، ولا طريق اليوم إلى الوحدة القومية إلا بتحرير إرادة جماهيرنا. إنها هي التي تعطي للاشتراكية أيضاً طريقها وشروطها لا العكس، لتكون الاشتراكية في الديمقراطية ولمصلحة الجماهير العريضة وبمبادراتها… وإلا تتحول الاشتراكية، لا صعوداً للطبقة الكادحة ولا تذويباً للفوارق بين الطبقات ولا إنهاء للقسر والاستغلال ولا حكماً للشعب، بل حكماً للبيروقراطية وسيطرة لطبقة جديدة ونمواً لألوان جديدة من الاستغلال وتعطيلاً لذلك النزوع الكبير القائم في أساس الفكر الاشتراكي، وهو النزوع إلى التحرير الكلي للإنسان .
إننا حين نضع هذا التأكيد على الحرية في البداية، كمنطلق لا بد منه، سواء في بناء حركة النضال أو في بناء تلاحم القوى الوطنية والقومية أو في تصور طريق النضال وطريق البناء وفي تصور النظام الذي نطالب به ونريد أن نبنيه، تصدياً لهذه المرحلة من التحول التي تمر بها أمتنا على يد نظم الاستبداد والردة، والتي تنقلها من مواقع التحرر والتقدم إلى مواقع التابعية والتخلف، ومن مواقع العداء للإمبريالية ومحاربتها إلى مواقع الخضوع لها والاستسلام، ومن مواقع الدفع على طريق التحويل الاشتراكي إلى أبشع ألوان الاستبداد والاستغلال وسحق إرادة الجماهير وإيقاعها في التبعثر والضياع، فلأننا ندرك اليوم وأكثر من أي وقت مضى ضرورة مثل هذا التأكيد، التأكيد على الحرية، أي على الديمقراطية سياسة وتفكيراً وممارسة، لأن عدم تقديمها كحجر أساس لا بد منه في أي عمل سياسي أو بناء، ولأن التهاون فيها أو تعطيلها أو تحريفها، كان هو المدخل إلى تمكين قوى الردة ونظم الردة من طعن حركة التحرر وقوى التحرر ومن التحكم برقاب الجماهير .
لقد أعلنت قوى التحرر وأحزاب التقدم كلها، كلمة الحرية ومطالب الديمقراطية بين مبادئها وشعاراتها ومطالبها، ولكنها كلها أيضاً وفي مراحل صعودها نحو التغيير أو نحو الحكم أو نحو الإحاطة بحكم أو تأييده، تساهلت في تلك المبادئ والمطالب أو أغفلتها، باسم استعجال التقدم والتحرر، أو باسم حرق المراحل على طريق الثورة، أو باسم حماية الحرية ” من أعداء الحرية ” أو باسم حماية الكادحين من المستغلين، فقبلت نظم الاستبداد والقهر، وقبلت بسيادة أو حكم الأقلية تحت ستارة النخبة والطليعة، وقبلت أن تمتد وتتطاول الظروف والعهود الاستثنائية، وقوانين الطوارئ والدساتير المؤقتة المصاغة من فوق، أي اللاقانون ولا دستور، وقدست حكم الفرد وأبوية الزعيم والقائد وأعطته التفويض المطلق … ولكنها في هذا كله لم تختصر طريق التحرر ولم تختصر طريق الثورة، بل فسحت مجال التراجع والنكوص، ومجال الهزائم والردة، إنها حرمت بذلك نفسها كأحزاب وقوى وحرمت جماهير الأمة من المناخ الديمقراطي، أي من المناخ الضروري لكي يتقدم فكرها وممارساتها، ولكي تتنامى في صفوف الجماهير فعلاً وتفاعلاً وتنظيماً، ولكي تتقدم حركة الجماهير ويتقدم وعيها ومشاركتها ومبادراتها .
إننا لن نُخّدع بشعار ” لا حرية لأعداء الحرية ” ولن نَخّدع جماهيرنا به، فأعداء الحرية هم الذين يحكموننا، وهم الذين استغلوا هذا الشعار، لتعزيز سيطرتهم، وحماية مصالح طبقتهم الجديدة المتسلطة على الحكم، ولتشويه كل مقومات الحرية والديمقراطية ومؤسساتها وتنظيماتها، فلا شرط على الحرية إلا الحرية، ولا شرط على الديمقراطية إلا الممارسة الصحيحة لها، والديمقراطية هي حكم الشعب ورقابة الشعب وتجسيد إرادة مجموع الشعب، فلا تفويض لقائد إلا في حدود الدور الذي يؤديه والمهمة التي يضطلع بها في إطار القيادة الجماعية والعمل الجماعي، ولا تفويض لحزب ولا هيمنة لمنظمة سياسية، إلا بمقدار الدور الذي يحتله في قلب حركة الجماهير، وما تعطيه له حركة الجماهير، من رافد ودعم وتأييد، ومن قوة في تمثيلها وتجسيد مصالحها وتطلعاتها، فلا حزب قائد ولا رسالة خالدة ولا خلود لأي حزب أو أية قوة سياسية، والحزب بالضرورة حزب الطبقة أو التحالف الطبقي، وهذا عندما يعي حقيقته ودوره ولم يخادع نفسه ويخدع الجماهير.
لهذا كله يأتي تأكيدنا اليوم: الحريـة أولاً … فليكون المدخل إلى التغيير والمدخل إلى تنظيم السلطات والحكم ديمقراطياً، لا بد أن يكون المدخل إلى النضال والمداخل إلى التصدي لنظم الارتداد والاستبداد ديمقراطياً أيضاً، وهذا لا يعني رفض العنف في النضال، فذلك ما تحدده طبيعة القوى المعوقة والمضادة وطبيعة الطبقات الحاكمة وأساليبها، ولكنه يعني رفض التسلط والاستبداد في أية حال، وتعني أن نعيش الديمقراطية في فكرنا ومناهجنا وعملنا، في طبيعة تنظيمنا لحزبنا وبنائه، في طبيعة علاقاتنا مع القوى الصديقة والحليفة، وفي توجهاتنا باتجاه جماهيرنا، لتعيش الديمقراطية في حياة هذه الجماهير وفي وعيها وتطلعاتها وفي مطالبها اليومية، ولتصعد باتجاهها ولا تسمح مستقبلاً بالارتداد عنها. فبالديمقراطية تتحرر الإرادات وتتفتح العقول، وبالديمقراطية نكنس رواسب المجتمع القديم بتخلفه وعصبياته وطوائفه، وبالديمقراطية يتقدم الوعي الطبقي والوعي السياسي، وبالديمقراطية نقف في وجه حكم الأقلية والاستبداد وفي وجه أي لون جديد من ألوان الحكم المطلق .
☼ ☼ ☼
في محادثات الوحدة التي جرت في نيسان عام 1963 بين قيادة عبد الناصر والقيادات البعثية كان السؤال الأساسي والأول الذي طرحه عبد الناصر على ممثلي البعث، يتكرر هذا السؤال ثم يتكرر في المحادثات: ما هو مفهوم البعث للحرية وما هو طريقكم إليها؟. وكان مضمون السؤال في سياق الحوار، يتركز بالتحديد على مفهوم الحكم والدولة والقيادة السياسية والعلاقة بين القوى السياسية وتمثيل إرادة الشعب والتنظيم السياسي ودور الحزب وما يعني الحزب ثم العلاقة بين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية .
وجاء الجواب عفواً من أحد البعثيين ( وهو أحد الذين كانوا على التصاق بالقيادات العسكرية البعثية الصاعدة إلى السلطة ) قال ما معناه: إن الحرية أن يحكم الحزب ويمسك بزمام السلطة ليطبق سياسته ومبادئه. والواضح من هذا الجواب، أن مفهوم الحرية مفهوم نخبوي وفئوي ولاديمقراطي، فالحرية عنده حرية البعث لا حرية الشعب. وعند هذا الجواب جاء السؤال من عبد الناصر أكثر تحديداً، قال: ماذا يمثل البعث في سورية كحزب وما هو حجمه بالنسبة لمجموع القوى ولحركة الجماهير؟. واستمر الحوار والجدال وتراجع البعثيون عن مثل هذا المنطق ليصلوا مع عبد الناصر إلى اتفاق 17 نيسان، إلا أن هذه العقلية ظلت هي المتمكنة من القيادات الصاعدة إلى السلطة، وهكذا سقط اتفاق 17 نيسان للوحدة الثلاثية وظل الانفصال وتمكن .
وأمسك ” بعث ” بالسلطة، أمسك بها في سورية والعراق وتفرَّد، وأصبحت الحرية حريته، ولكن على حساب حرية الشعب وعلى حساب تاريخ الأمة ومستقبلها، وجاء تطبيق المبادئ مغامرات في المجهول. كان المفروض لو أن الاحتكام للمبادئ والأهداف، أن تحكم الحرية البعث وتحدد مساره، لا أن يتحكم البعث بالحرية وبإرادة الجماهير . وعندما تحكم ” بعث ” بالحرية، أضاع فرصة تاريخية كبرى متاحة للأمة، فرصة تجديد المسار الوحدوي، فرصة الدفع على طريق وحدة قوى التقدم العربي، وأخذ مساراً ضد التاريخ، أي ضد حركة الجماهير وما نضجت إليه إرادة هذه الحركة، فأخذ يشتم عفويتها، ويستخف بإرادتها وفرض نفسه وصياً عليها، ومن خلال وعد خادع، ليس للآخرين فحسب، بل ولنفسه أيضاً، بأنها مرحلة انتقال، وأن كل شيء سيعود لمساره الصحيح بشكل أضمن وأوثق .
ولكن الذي تجاهلوه وأغفلوه، أن الأمة كانت أمام فرصة تاريخية للتقدم على طريق وحدتها، وفوتوا عليها بنزوعهم السلطوي هذه الفرصة، وفتحوا الباب للردة، فعندما لا يمتلك الحزب أو القوة السياسية الصاعدة إلى الحكم والسلطة، حس التاريخ والإحساس بإرادة الجماهير، ولا تملك دعم الجماهير يصبح حكمها بالضرورة، وبمنطق التاريخ، استبداداً وحركة ارتداد بالأمة إلى الوراء، أياً كانت الشعارات التي ترفعها والمسميات التي تتسمى بها، بل والإنجازات التي تحققها .
لقد حكم ” بعث ” سورية والعراق، ونظّم وغيّر، وشرّك وأمم، ولكنه عجز عن أن يسير خطوة واحدة على طريق وحدة سورية والعراق، وعجز عن بناء أية قاعدة للديمقراطية أو للوحدة الوطنية، فهو إذا جاء كسلطة أقلية فرضت نفسها بالقوة وضد إرادة الجماهير العريضة وضد ما تبلورت عليه إرادة غالبية الشعب، فقد حكمت مغلقة على الشعب، لا تفعل في الجماهير ولا تفعل الجماهير فيها، بل أصبحت تحكمها قوانين السلطة وحدها والحفاظ على السلطة والصراعات من أجل السلطة وما أخذ ينمو من خلال السلطة وداخلها من تشكّل طبقي جديد ومن مصالح جديدة وما يتفرع عن ذلك من سياسات وأفكار وتنظيمات .
إن قوى الرجعة والاستغلال، ولو أن حكم البعث جاء في البداية يدمّر مصالحها ومؤسسات استغلالها وشركاتها، فهي لم تَخفّ من حكم البعث بمقدار ما كانت تخاف من أن تحكم إرادة الشعب وتدفع إلى عودة الوحدة مع مصر تحت قيادة عبد الناصر، فقد كانت تعي من خلال مصالحها الإقليمية وصلاتها بالسوق الإمبريالي، أن الوحدة تسد الطريق نهائياً أمام عودتها وأمام عودة مصالحها، أما حكم الأقلية وراء أسوار الإقليمية والانفصال وضد نهوض إرادة الجماهير، فذلك مجال يمكن أن تراهن على التأثير فيه وتحويله .
وهكذا فان قوى الرجعة والاستغلال والانتهاز أخذت كلها، وبشكل أو بآخر، وبدفع من هنا ومن هناك، تغري البعث بالانفراد والتفرد، ومن هنا كانت بداية التحول الذي أخذ يفرض نفسه شيئاً فشيئاً وصولاً إلى ما نحن عليه اليوم، والتحول لا بعيداً عن طريق الوحدة ومطالب الجماهير فحسب، بل والتحول في طبيعة حزب البعث وتكوينه ومساره وتشكّلاته السلطوية وحكمه وانقساماته. فمن خلال السلطة أخذ الحزب صورته الجديدة وتشكّله، ومن خلال مصالح السلطة أخذ امتداداته ودوره، انه لم يعد حزب الجماهير والمعبر عن إرادتها وعن مصالح الطبقات العاملة، بل أصبح حزب السلطة والمعبر عن مصالح الطبقة البرجوازية الجديدة الصاعدة من خلال الحكم، بل وأخذ تشكّله من خلالها ليصبح أداة قمعية بيدها وأداة رقابة على حركة الجماهير وأداة تفتيت وقسر .
وعندما يصبح المسار محكوماً بمنطق السلطة والحفاظ على السلطة وأمنها وعلى مصلحة رجال السلطة واستمرارهم، وبالنمو والتنمية من خلال السلطة ومن خلال هذا التشكّل الطبقي الجديد في المصالح والروابط، من خلال السلطة وفي أحضانها، إمكانياتها ومتعها، بعيداً عن رقابة الجماهير وفي الخط المعاكس لمطامحها وحريتها بل وضد حركة الجماهير وباستغلالها وقسرها، فان أي إنجاز تحققه تلك السلطة، ولو جاءت في البداية ضرباً لمواقع الرجعية ولاستغلال الطبقة التي كانت سائدة فيما مضى، فان هذا الإنجاز لا يلبث أن يضيع ويستهلك، فتدمير مواقع الرجعية والاستغلال والتابعية، وتدمير البنى الاقتصادية التحتية التي كانت تستند إليها في فرض هيمنتها، لم يوظف في صالح تقدم تحرر الجماهير من التبعية والاستغلال، وفي صالح تقدم وعيها وصعود إرادتها وسلطتها، ولا في صالح أهداف الجماهير، بل وضع في خدمة مصالح السلطة ورجال السلطة ومن يلوذ بهم أو ينشّد إليهم بالعصبية والانتهاز، ووضع ركيزة لتشكّل رأسمالي جديد لرجال السلطة والحكم، وليبقى الباب مفتوحاً لما يعتمل داخل السلطة، انغلاقاً بها عن الجماهير وتشكلاً فئوياً وعصبوياً وصولاً بها إلى حكم الفرد والى السلطة المطلقة، وما قامت الثورة الديمقراطية في الماضي إلا لتدمير السلطة المطلقة للإقطاعيين والملوك .
إنها طبقة تشكّلت من فوق بقوة السلطة ومن خلالها، كما شكلت نظامها وعلاقاتها وروابطها، وأفرزت أيديولوجية ضمنية لها وسارت في سياسة، إذا ظلت تفاصيلها مغطاة عن الجماهير ومكتومة، فان نتائجها دامغة على أرض الواقع، فالفساد والإفساد والثراء الفاحش والسريع ليس انحرافاً لأفراد أو عناصر من تلك الطبقة المتشكلة بل عماد من أعمدة بنائها وقوتها، والعصبيات التي تتكتل من حولها وتمزق الوحدة الوطنية وتبعثر كيان الأمة، لم تأت مصادفة ًوراسباً من رواسب الماضي، بل صنعته وتصنعه هذه الطبقة بيدها دعامةً لوجودها وأمنها، فالانفتاح على أموال النفط ودول النفط وعلى الإمبريالية وسوقها وشركاتها وسلعها وصولاً إلى ربط الوطن بالتابعية لها ولسياساتها، ما كان إلا المآل الطبيعي للمسار الذي أصبحت هذه الطبقة محكومة به من خلال حركة تشكّلها ومصالحها .
وما كان لهذا أن يحصل ولا يمكن أن يستمر إلا بسحق حركة الجماهير وفي غيبة هذه الجماهير وبانعدام إرادتها الجماعية، أي في غيبة الديمقراطية وبسيادة الاستبداد المشرقي .
إنها طبقة حاكمة ومسيطرة ولكنها محكومة أيضاً، تحكمها قوانين تشكّلها ومصالحها وما قادتها له هذه المصالح والتشكّلات من روابط وتحالفات جديدة وعلاقات، إنها وقفت بالأساس ضد تاريخ الأمة وضد إرادة الجماهير، وهي اليوم تنحرف بتاريخ الآمة إلى الوراء وتسقط إرادة الجماهير، ولكنها وهي الحاكمة للأمة والمتحكمة فيها تجر الأمة معها إلى مواقع التابعية، وتشدّها بعيداً عن أهدافها، باتجاه حركة أموال النفط والسياسات الإمبريالية.
أمّا كيف اشتغلت وتشتغل فينا وفي تشكيل معالم هذه المرحلة الجديدة من تاريخنا وفي تشكيل حركة النظم والحكام، حركة أموال النفط وحركة الأجهزة والسياسات الإمبريالية، فذلك موضوع آخر، وما جاء حديثنا اليوم إلا مقدمة .
لقد بدأنا من التأكيد: الحريّة أولاً، وسنظل عند هذا التأكيد، والديمقراطية التي ننشدها، هي الديمقراطية المباشرة، الديمقراطية الكليّة لجماهير الشعب، بحيث لا تسلبها أو لا تسخرها لمصالحها، دكتاتورية طبقة جديدة ولا دكتاتورية فئة أو فرد .
هذه الديمقراطية تعترض بالضرورة طريق الليبرالية الاقتصادية وسيطرة الرأسمالية، ولكن تعارضها الكامل وتصادمها المباشر إنما هو اليوم مع هذه النظم الاستبدادية المطلقة، فهي الديمقراطية الجماعية والكلية والتي تنزع إلى النهوض الكلي بحرّية الجماهير ووعيها واسهامها في السياسة والحياة العامة، في مواجهة هذا الاستبداد الكلي والجماعي أيضاً الذي يبسط سلطانه في الدولة والمجتمع والسياسة والعلاقات العامة .
ولكن الحرّية تؤخذ ولا تعطى كما كان يقول آباؤنا في نضالهم الوطني ضد السيطرة الأجنبية، وللصعود على طريق الديمقراطية في مواجهة نظم الاستبداد وهيمنة الطبقة الجديدة وتنظيمها الجماعي لهذه الهيمنة عبر مؤسساتها وأجهزتها وتنظيماتها الشعبية المغلولة الإرادة ، فان الدعوة والتبشير لا يكفيان، فلا يكفي اليوم أن تقنع الناس بفساد النظام وانحرافه لتتحرك الجماهير لإنزال الطبقة المسيطرة عن مواقعها وتسلطها، باسم الديمقراطية وباسم إرادة الأغلبية، فالكشف والإدانة لا بد أن يتحولا إلى موقف عام وحركة منظمة والى قوة تغيير حقيقية، تبني نفسها في قلب حركة الجماهير بحيث تلتحم عضوياً ومصيرياً، وتجسد إرادة واعية لقاعدة شعبيّة عريضة .
إن نظام الاستبداد لا تنزله إلا القوة، ولكن نظام الأقلية المسيطرة لا تزيحه لصالح الديمقراطية وصالح التقدم، قوة أقلية جديدة، ولا حزب أقلية، أياً كانت صلابة تنظيم تلك القوة أو ذلك الحزب، بل ولو أتيحت لتلك القوة بشكل أو بآخر فرصة للتغيير أو وسيلة تضرب بها، فان الاحتمال الأكبر أمامها، أن تتحول إلى استبداد جديد واستغلال جديد .
إن الطبقة المسيطرة على الحكم، تعمل على فرض سلطانها بالاستبداد على المجتمع كله وعلى القوى العاملة جميعها، لتحاصر حركة الجماهير فلا تنهض ولتشل مبادراتها وتحبسها في القوالب الشكلية التي تفرضها عليها، ومن هنا فان المهمة الأولى في العمل الوطني الديمقراطي، هو التوجه إلى حركة الجماهير لسحبها من أطر سيطرتها، لتبقى تلك الطبقة المتسلطة مكشوفةً أمامها، مكشوفة بتركيبها، مكشوفة باستغلالها، معزولة على صراعاتها الفئوية والمصلحية وعلى تناقضاتها مع مصلحة الأمة وحركة التقدم، أي لا بد من التوجه بقوى التقدم لتنظم صفوفها ولتحتل مواقعها في قلب حركة الجماهير، هناك حيث تستطيع أن تبني بالديمقراطية، وأن تبني بالوعي والتنظيم، تلاحمها الوطني وصلابتها وفعلها في حركة الجماهير، لتصبح قادرة ولتتقوى بتلك الحركة، ولتصعد على طريق التصدي فالتغيير .
فالنضال في سبيل احتلال المواقع في قلب القاعدة الجماهيرية العريضة، وحيث يتجمع البشر في علاقات واقعية مباشرة، في علاقات إنتاجية وروابط اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، وحيث يعانون مباشرة وبصورة مشتركة أزمة حياتهم في ظل نظام القسر والاستغلال والظلم والتمايز الطبقي، هو المطلوب اليوم بالنسبة لأية قوة من قوى التقدم، انه هو السبيل لخلخلة هيمنة الطبقة الحاكمة وكشف هويتها ومواقعها وارتباطاتها وحلفائها، كما وأنه هو الطريق لبناء القوى، وبناء التلاحم الوطني بين القوى، وهي على ارتباط مباشر بحركة الجماهير .
ثم لا بد أن يكون ماثلاً أمام الجميع منذ البداية، أن التغيير المطلوب هو تغيير جذري في بنية الدولة والنظام وفي العلاقات بين البشر، وليس تغييراً أو تبديلاً في الاتجاه الحكومي فحسب، ليس في تناوب قيادات جديدة على الحكم، بل في بناء مجتمع ديمقراطي تقدمي جديد، وفي هذا السبيل لا بد أن تكون البنية الجديدة المطلوبة ماثلة في تفكيرنا وواضحة وكذلك الطريق إليها، أي لا بد أن تنمو وتتوضح داخل تكوين الحزب الذي يتقدم إلى الجماهير بإرادة هذا التغيير وفي بنيته وتفكيره وسياسته وعلاقاته، أو بالأحرى في تكوين مجموعة الأحزاب أو التنظيمات السياسية والتي ترفع راية التقدمية وتنزع إلى التصدي إلى إقامة تحالفها الوطني الديمقراطي في سبيل التغيير .
وإن مثل هذا التغيير، وهو التغيير الثوري الحقيقي، لا يمكن أن تقوم به إلا قوة سياسية أو حركة سياسية تاريخية منظمة، وعندما نقول تاريخية نعني أنها قادرة على تحريك تاريخ الأمة باتجاه التقدم وباتجاه أهدافها، نعني أنها تتقدم على رأس حركة الجماهير كطليعة وهي في الوقت ذاته مشدودة بروابط عضوية مباشرة إلى الطبقة الشعبية العريضة الصاعدة أو إلى التحالف الطبقي، تحالف قوى الشعب العاملة، الذي يبني النظام الجديد .
إن مثل هذه الحركة السياسية التاريخية لم تتشكل بعد، بل وليس في مقدور منظمة أو حزب من المنظمات والحركات والأحزاب القائمة يحمل الإمكانية أو الوعد بتشكيلها، إلا أن ثمة حالة من الوعي تتشكل لدى العديد من حركات ومنظمات قوى النضال العربي، وتتجسد في استيعابها، إلا أنها ليست إلا فصائل، ليست إلا أجزاء مبعثرة هنا وهناك من تلك الحركة التاريخية، ويبقى أن تستدل إلى طريق تلاحمها وصنع وحدتها، وهي لن تصنعها إلا وهي تحتل مواقعها في قلب حركة الجماهير، إلا وهي تنفتح بقوة وتصميم على الآخرين .
إن المحاولات التي قامت في الماضي، قطرياً أو على الصعيد القومي، لإشادة مثل تلك الحركة السياسية التاريخية التي تقود التغيير باتجاه أهداف جماهير الأمة، سواء في الصيغ السابقة للأحزاب أو لتحالفات القوى الشعبية أو الجبهات، قد منيت كلها بالفشل أو بالانتكاس والانحراف، وقد أصبحت صيغاً متخلفة عن حاجات هذه المرحلة التاريخية، وإذا ما وجد لبعضها ظروفه ومبرراته في المراحل السابقة فقد فات اليوم أوانها .
ولقد انخرط حزبنا في عدد من تلك المحاولات في الماضي، ولكنه عندما خرج عام 1973 من تلك الصيغة العاجزة واللاديمقراطية لما يسمى ” بالجبهة الوطنية التقدمية ” كان بصميمه أن يطوي صفحاً، وبصورة نهائية، عن تلك الأنماط من صيغ التحالف والتعاون مع القوى الأخرى، والتي لا تصنع وحدة وطنية ولا وحدة قوى بل تزيد التفتت والضياع .
كنا في تلك المحاولة الأخيرة ما زلنا نعيش التشبث بمرحلة الكفاح الوطني في سبيل ” إزالة آثار العدوان “، وإزالة ما خلفته هزيمة حزيران، وذلك من خلال نظم قائمة وتحمل وعداً بالتصدي لذلك المطلب أو الهدف المحدد، ولكن ذلك التشبث راح عبثاً، وأخذ التحول عن الأهداف أبعاده كلها بعد حرب تشرين، وبعد أن وضعت النظم نفسها على طريق ” السلام الأمريكي ” …..
صدرت ونُشرت عام 1978

التعليقات مغلقة.