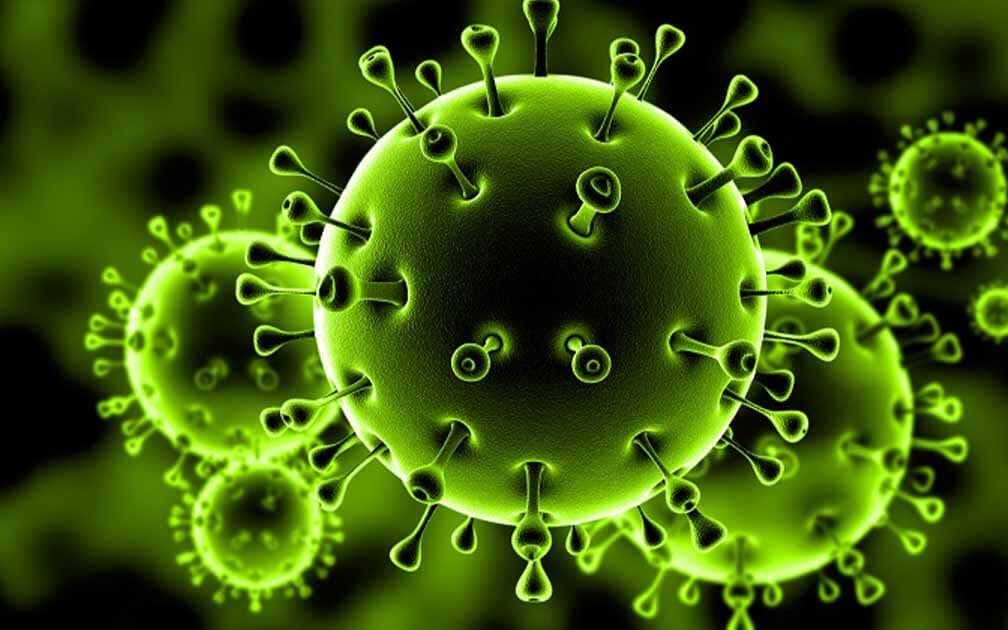
سوسن جميل حسن *
ليس الوباء الأول في تاريخ البشرية، ولن يكون الأخير. دائمًا هناك ناجون عايشوا الوضع بأعتى حالاته، وحملوا الآثار الرهيبة النفسية والاجتماعية، وعلى مدى أجيال، كانت بواسطتها تتناقل الذاكرة المؤلمة من جيل إلى آخر، عن طريق السرديات الشفهية أو الأمثال أو العادات التي أحدثها الوباء في سلوك الأفراد والجماعات، وعن طريق الأدب والفن. فالأوبئة مثل الحروب والكوارث الطبيعية، بما تشكّله من تحوّلات كبرى في طبيعة الحياة والمجتمعات، وبما تنتجه من قيم وأفكار وأنماط مختلفة للحياة الإنسانية، واهتمام الدارسين والباحثين في مجالات العلوم المختلفة، وبشكل خاص في العلوم الاجتماعية، أدّى إلى ما تسمى سيكولوجيا الأوبئة، مثلما هناك سيكولوجيا الحروب التي تهتم بقضية الانعكاسات النفسية التي تخلفها الحروب والكوارث في نفوس الأشخاص الذين يتعرّضون لها ويعانون منها، فكيف إذا اجتمعت الحرب مع الوباء، كما هو حاصل اليوم في سورية وغيرها من بلدان عربية؟ بل يمكن القول إنها سلسلة من القمع والتعذيب والسطو على الحياة، آخر حلقاتها كانت الحرب، ثم الوباء.
تعاني المجتمعات في الداخل السوري، وفي كل مناطقه، سواء الخاضعة للنظام أم الأخرى الواقعة تحت سيطرة قوى أخرى، محلية أو خارجية، من مشكلات تفوق التصور، لتناقضها البالغ مع قيم العصر التي يفترض أن تكون منصفةً ومتوفرةً لكل شعوب الأرض، عصر الحقوق الإنسانية. وإذا ما رصدنا سلوك الأفراد في تلك المجتمعات، فإننا نلمس أنماطًا منها جديرة بالتوقف عندها ودراستها. لكن العالم كله لم يكن على المستوى المطلوب من الجدّية والاهتمام بهذه الظواهر قبل كورونا، فكيف بعدها، وقد صار الوباء المتغوّل في حياة البشرية يزداد جبروتًا، ويهز أعتى العروش وأقواها في العالم؟ الوباء اليوم يكشف عن وجه آخر زيادة عمّا كشفته وعرّته الحرب خلال السنوات العشر، ممّا كان مخفيًّا تحت أقنعةٍ راكمتها عقود من القهر والتسلط والاستلاب، فتجلّت المشكلات البنيوية المتجذّرة في اللاوعي الجمعي، والتي جعلت النسيج المجتمعي مهترئًا سهل التمزق والتهتّك، وعدم الاعتراف بهذه المشاكل مكابرة لا تخدم القضايا بشيء، بل تعرقل محاولات العلاج والتعافي والنهوض.
أخطر ما مرّ على الشعب السوري هو الحرب النفسية، مدعومة بالضخ الإعلامي من كل الجهات المسيّسة، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي تحطّم الشخصية، وتشيع فيها التحلل، فيضطرب سلوكها، وتصبح شخصيةً غير سويّة، ما يؤثر بشكل خطير على سلامة المجتمع وفعاليته، وهذا ما صار واضحًا في تعامل المجتمع، بغالبية أفراده مع مبادئ (وإجراءات) الوقاية من الوباء، على الرغم من أن انتشاره سريع، وضحاياه كثر، أمام أعين الجميع. النسبة العظمى من هؤلاء لا تكفّ عن التشكيك بالتصريحات الحكومية عن هذا الأمر حول عدد الإصابات اليومي إلى عدد الضحايا إلى التباهي بالإمكانات التي تقدّمها الحكومة، وعلى الرغم من ظروف الحرب والحصار الأميركي والأوروبي على سورية “الممانعة” التي تتعرّض لأكبر مؤامرة في العصر الحديث والمعاصر.
فقد الشعب السوري، في غالبيته، ثقته بالحكومة والنظام. وكذلك في المقلب الآخر، حيث تسيطر فصائل مرتهنة للخارج بقوة السلاح، وتفرض شرعها وأجنداتها على الساكنين، لكن هؤلاء الخاضعين لسيطرتها يعانون من المشكلات ذاتها والتسلّط والتشبيح عينهما والفقر والحرمان والاستغلال، كما لو أن كل الأرواح التي زهقت لم تغيّر شيئًا في حياتهم، بل على العكس ازدادت بؤسًا. ولكن هل يمكن قبول هذا السلوك غير المسؤول الذي يؤدي إلى كارثةٍ أخرى بحق هذا الشعب، بدعوى أن الناس فقدوا الاهتمام وشغف الحياة من شدّة المظالم والانتهاكات التي يتعرّضون لها؟ اللامبالاة والسلوك العبثي لا ينمّان عن عدمية فقط، بل ينمّان عن انهيار منظومة القيم والأخلاق والمعرفة والوعي. في تعريض صحة الآخرين للخطر، بحجّة أنني لم أعد آبه بالموت، طالما الحياة لا تكفّ عن قضم روحي وبطني وجسدي، حدّ كبير من الأنانية وعدم الإحساس بالجماعة الإنسانية، ولكن الانزياح الأخلاقي والقيمي وانحدار الوعي كانا قد بلغا الذروة قبل الوباء، بسبب عشر سنوات من الجحيم السوري، أدّت إلى ترسّخ ملامح المجتمع العميق وإشهاره من دون مواربة، فما كان مستبطنًا تحت قشرة الواقع من تغلغل النسغ الحامل موروثا صاغ هويّة عميقة متشبثة بروح المجتمعات، كشفته الحرب وعرّته بالكامل أزمة كورونا.
يوميًّا، هناك حفلات افتتاح محلات تجارية أو خدمية أو مطاعم أو مقاهٍ، في وقت تضرب المجاعة أطنابها بين حوالي 90% من الشعب، حفلات يتزاحم فيها الناس من دون ارتداء الأقنعة أو التباعد، تقام مبارياتٌ رياضيةٌ، ويغزو الجمهور المدرّجات متلاصقين يصرخون ويهتفون طول الوقت، حتى يتطاير من أفواههم رذاذٌ يمطر حقولًا واسعة، ثم يضرمون معاركهم بعد المباريات. المطاعم مفتوحة، المدارس تفتقر للحد الأدنى من مستلزمات العملية التربوية والتعليمية قبل كورونا. وازدادت، بعدها الأعراس والحفلات والتجمعات بكل طريقة، ولكل سببٍ يمكن أن يخطر على البال، والنتيجة أعداد كبيرة من المصابين ومن الضحايا. لكن الضحايا التي تدفع الثمن الأكبر هي عناصر القطاع الصحي، خصوصا الأطباء، في وقتٍ تعاني منه سورية من قلة الأطباء، بسبب الحرب التي إمّا هجّرتهم خارج البلاد، أو قذفت بهم إلى المواقع القتالية لتلبية نداء الواجب “الوطني”، ومن بقي يحصده وباء كوفيد – 19، والناس غير مبالين بكل هذا الكم من الموت.
المتابع لواقع الحياة السورية سوف تربكه الملاحظات التي تنسف معظم استقراءات (ومدونات) سيكولوجيا الأوبئة التي جهد الباحثون والمتخصصون في تشكيلها. فالعناوين العريضة التي استخلصتها الأبحاث لا تصحّ على الحياة السورية الموّارة بأنماط سلوكية مغايرة، فمقولة سقوط العقلانية الهشّة الناظمة للفعاليات اليومية تفيد بأن غالبية البشر قادرون على الحفاظ على قدرٍ من العقلانية في الفترات الهادئة من حياتهم، بمعنى أن هناك روتينًا يضبط إيقاع الحياة، وأن الأزمات من هذا النوع تهدم هذه القدرة، بدافع القلق والخوف، فإن السوري لم يملك ترف صياغة روتين لحياته منذ عقود، فلم يكن يحظى بحق اختراع حياته كما يريد من الأساس، حتى يؤسس لها روتينها الخاص. ثم نسفت الحرب ما بقي من حلمٍ في هذا المجال، وصارت حياة السوري في حالة تحوّلٍ دائمٍ من أجل التكيّف مع الشروط المتبدّلة الماشية نحو الانهيار. أما مقولة الخوف من العيش في المجهول الذي يفجّره الوباء في صدور الناس، ويجعلهم في حالة قلق وجودي، وخوف على حياتهم، وخوفهم من الآخر الذي سيجلب له العدوى، فإن السوري تجاوزه، منذ جاوره الموت بأشكالٍ لا تحصى، ولم يحتملها شعب قبل اليوم، والشك بالآخر ورفضه ومحاولة إقصائه عن مجال حياته الآمن، والذي لم يعد آمنًا، فقد استشرى واستباح حياة السوريين منذ بداية العقد الماضي، وباكرًا في عمر الانتفاضة التي تحوّلت إلى حرب.
وبالنسبة إلى الاضطراب والتذبذب بين الشك واليقين، بين الإيمان والإلحاد فقد أظهرته أيضًا سنوات الحرب، وأدّى العنف غير المسبوق الممارس بحق الشعب من قبل النظام، ومن كل أطراف الصراع، إلى تجذّر الانتماء الديني، والجنوح نحو بناء المواقف من السياسة والحياة وقضايا العيش من خلال الدين والشريعة ورأي المرشدين أو الفقهاء ومشايخ الدين. أكثر من ذلك، جرى الالتصاق المتين بجسد الجماعة، طائفيًا أو مذهبيًا أو قوميًا إلى درجة الإيمان. لكن يمكن القول إن هناك نزوعًا بدأ ينمو نحو اللادين، أو بمعنى أدق نحو الإلحاد، وهو من أشكال الإيمان بعقيدةٍ ما، لكن كورونا ليس السبب، بل سبقته الحرب وويلاتها وانسداد الأفق.
أما القول بالانجراف نحو الشائعات وتبنّي نظرية المؤامرة، فهو من أهم ملامح الأزمة السورية التي نادى بها قسم كبير من الشعب، ودعمه الخطاب الرسمي. لذلك صارت لدى الشعب السوري خبرة في هذا الأمر، وصار قادرًا، في غالبيته، على توسيع مدونته حول موضوع المؤامرة، ومنها جائحة كوفيد – 19 التي هي بالفعل مؤامرة كونية في رأيهم، وأن كورونا مفبركٌ في المخابر، والإعلام ضخّمه في لعبةٍ قذرةٍ من لعب الأمم الرامية إلى السيطرة على العالم. ولا يستبعد، بل من المؤكد، بالنسبة لبعضهم، أن تكون أميركا، ومن خلفها الصهيونية العالمية، خلفها، وليس اللقاح أكثر من سلعةٍ كانت مجهزة مسبقًا ليومٍ كهذا، باعتباره من أسلحة السيطرة الاقتصادية والمالية. ومن هذا المنطلق، اللقاح الذي هو ليس في متناول دول ضعيفة متهالكة تعضّ على بطنها مقاطعة كسورية، لا مبرّر له وغير مرحب به من كثيرين، وإن غريزة القطيع ماشيةٌ بعزم وحزم، عند شعبٍ لم يعرف إلى اليوم سياسة غيرها، أو أسلوب حياة مخالفا. إنها حياة القطيع الذي فطمته الأنظمة عليها، وباركها رجال الدين وسطوة الأعراف والثقافة الموروثة، فلا ضير من متابعة حياةٍ لا تشبه الحياة، همّها وغايتها الحصول على رغيف الخبز تحّدّيا مغوارا لغول العصر كورونا، والنوم بالاتكاء على تعويذة “سوريا الله حاميها”، بعد أن تحوّل الشعب، في غالبيته، إلى كائنات منطفئة.
* كاتبة وروائية وطبيبة سورية
المصدر: العربي الجديد

التعليقات مغلقة.