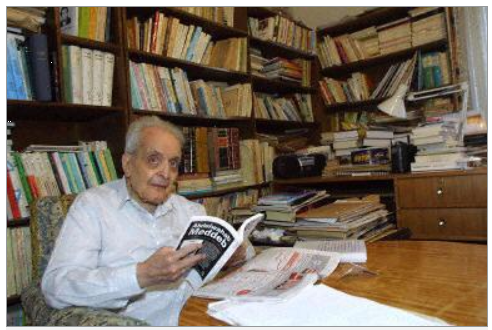
بدرالدين عرودكي *
الإعادة أم الاستعادة؟ ألم يكن علينا أن نطرح هذا السؤال ما إن بدأنا نطفو على سطح الزمان بعد غياب عن مسرح التاريخ دام ما لا يقل عن ستة قرون، أي منذ أن بدأنا ما أطلقنا عليه من بعد النهضة العربية اعتباراً من منتصف القرن التاسع عشر؟
ربما. وربما حاول البعض طرحه، وقد حدث ذلك بالفعل في لحظات استثنائية من تاريخنا الحديث، لكنه ووجه بكل المفاهيم وزوايا الرؤية التي سادت في ما يعتبر عصر ازدهار الفكر وإشعاع الحضارة العربية الإسلامية، أي قبل أكثر من عشرة قرون. وهي مفاهيم اعتبرت عند صياغتها بدعة تارة وكفراً أو خروجاً على الإجماع تارة أخرى، لكنها استطاعت الازدهار زمناً لاستجابتها إلى حاجات زمنها وإلى مقتضياته، ثم استحالت بفعل الكسل الفكري إلى ثوابت جامدة عفا عليها الزمان وباتت شواهد ماض لا علامات تمهد طرق الحاضر أو المستقبل. وهي على ذلك كله، أي على جمودها وقصورها اليوم، وجدت من يحاربها كبدعة لابد من تخليص “الأصل” من آثارها بالعودة إليه وإليه وحده من جديد تحت عناوين التجديد والأصالة.
الإعادة أم الاستعادة؟ سؤال كان يطرح نفسه بصورة أو بأخرى، صراحة أو ضمناً، عند بدء كل مشروع جماعي، أياً كان مداه، أو شموله، أو ميدانه. أجاب ويجيب عنه على الدوام في تاريخنا القديم والحديث والمعاصر طرفان. كل طرف فيه يشير إلى رؤية محددة للتاريخ خاصة به وإلى نهج تفرضه هذه الرؤية على صاحب المشروع لا يستطيع بفعل مقتضياته أن يحيد عنه.
ومن الممكن القول إن إجابة كل طرف من طرفي هذا السؤال قد طبعت حقباً من تاريخ الثقافات في العالم ولاسيما الثقافة العربية الإسلامية خصوصاً لكنه لم يكن وقفاً عليها. سنلاحظ خلال نظرة سريعة نلقيها أنَّ الإعادة كانت على الدوام شعار كل عصر من عصور النكسات والانهيار أو التدهور الحضاري، وأنَّ الاستعادة كانت نهج كل مشروع مستقبلي يحاول الاستجابة إلى أسئلة الحاضر والمستقبل على الأصعدة كافة.
ولكن ما الإعادة؟ وما الاستعادة؟
يستقرئ مفهومُ الإعادة عموماً حقبة أو مرحلة من الزمان والتاريخ، واقعية أو مفترضة، دينية أو قومية، كما لو أنها دائرة مغلقة ووحيدة تكوّنت في لحظة ما واكتملت، لا يمكن أن تتعايش مع دوائر أخرى أو أن تنفتح عليها أو أن تتقاطع معها، لكنها تقتضي أو تتطلب ديمومة تكاد تتسع للأبدية. ويَرى فيها عالماً قائماً متكاملاً مكتفياً بذاته وضعاً وشروطاً، دائم الحضور، عصياً على التغيير بما أنه يمتُّ إلى المطلق بصلةٍ وثيقة إن لم يكن يزعم أنه المطلق بعينه. عالمٌ يعتمد قواعد وصفات ومصطلحات تتماهى فيه وتصير جزءاً لا يتجزأ منه. يقوم على خدمة هذا المفهوم سدنة أشداء وجدوا في كل العصور بلا استثناء، قدموا أنفسهم تارة خلفاء الله على الأرض، وتارة الناطقين باسمه، المتواصلين معه، القادرين على فهم مرامي كلماته ومعانيها، الساهرين على تفسيرها وفرض فهمهم لمعانيها المباشرة، معانٍ لا تحول لا في الزمان ولا في المكان، ولا تزول مهما اقتضت ضرورات الحياة.
باستثناء بعض المراحل التاريخية القصيرة بين القرن الثامن والعاشر الميلادي، لم يكفّ سدنة مفهوم الإعادة على اختلاف صِيَغِهِ عن التواجد على امتداد التاريخ العربي الإسلامي. ففي وجه محاولات المجددين من الفقهاء والعلماء مثلاً بإعادة القراءة في ضوء حاجات زمنهم ومجتمعهم من أجل صياغة إجابات تستجيب للمشكلات المطروحة، وقف هؤلاء لا دفاعاً عن القول الأصل، أو ما اتفقوا على اعتباره كذلك، بل عن كل ما يوافق هواهم فيه مما يزعمون أنه يعيد ألق العصر الذهبي كما يرونه بعد أن رسموا له صورة نمطية مثالية، خالية من أية تضاريس تعكس واقعيتها أو حقيقة وجود موضوعها، إذ لا وجود لها إلا في خيال من فرض عناصرها وحدّدَ ألوانها!
ذلك ضرب من الإعادة طبع قروناً عديدة من التاريخ العربي والإسلامي. لكن نموذجاً آخر من الإعادة، ظهر حديثاً مع نهاية النصف الأول من القرن الماضي، ابتكر مرجعيته مع قوامها “الفكري” و”تاريخها” المزعوم وقدَّمها مسلمة لا تحتاج إلى أي برهان. ولأنها كانت خالية من النصوص فقد كتب نصوصها، ولأنها كانت خالية من الأساطير فقد أنشأ لها أساطيرها، ولأنها كانت بلا قاعدة تاريخية فقد سعى بكل قواه خلال ربع قرن إلى تجسيدها عقيدة حزب وجيش ودولة ونجح في ذلك نجاحاً كارثياً بكل ما تعنيه كلمة الكارثة من معنى.
سعى دعاة الإعادة في كلٍّ من الصيغتيْن المشار إليهما إذن إلى جعل مضمونها عقيدة الدولة. كان على الأولى التي بقيت مخلصة لأصوليتها الأساس أن تغلق أبواب الدولة والمجتمع على العالم الحديث إلا في مظاهره المادية المباشرة: كالعمارة خصوصاً ووسائل الرفاه. أما دعاة النسخة الثانية وهي الأقل قوة ونفاذاً بما أنها بدعة كلها، فقد زعموا الحداثة والرفاه والعلمانية في بناء الدولة وفي تنظيم المجتمع، وتظاهروا بالانفتاح على العالم بكل ما فيه على كل الأصعدة، بما في ذلك الصعيد السياسي، لكنهم فرّغوا الدولة والمجتمع من مضامينهما الحديثة فلم يبقيا إلا هيكلاً يتلألأ في الخارج ويسوده النخر في الداخل.
أسهمت في تكريس الصيغة الأولى من الإعادة عوامل عدة أساسها تراث كامل من الفهم للنصوص اكتسب مع النقل والتكرار قدسية نصوص الأصول فاعتبرت كلُّ محاولة نقد أو تفنيد أو اجتهاد يخرج عنها استجابة لضرورات مكانية وزمانية لم تكن معروفة في عصرها خروجاً على الإجماع يؤدي بصاحبها إلى العزل الكامل إن لم يؤدِّ إلى سجنه أو قتله أو حرق كتبه. والأمثلة، على تغييبها أو السكوت عنها أو تبريرها، في التاريخ العربي الإسلامي، لا تحصى.
ولعل أهمَّ عنصر أساس نجح سدنة هذه الإعادة في ترسيخه واعتباره قانوناً مطلقاً هي مسألة الناسخ والمنسوخ في القرآن من جهة، وما عرف بالسنة النبوية من خلال الصحاح الستة التي اعترف بمرجعيتها التاريخية. تعني المسألة الأولى إلغاء مفهوم التاريخانية إلغاءً كاملاً في النص القرآني الذي تكامل خلال ثلاثة وعشرين سنة، وتطور نصاً وغرضاً وصياغة مع تطور الدعوة المحمدية من مرحلتها المكية حتى نهاية مرحلتها المدينية.
وقفت معظم النصوص عند التفسير الحرفي للآية الذي لم يرَ فيها سوى استبدال آية بآية أخرى خيراً من الأولى، مع غض النظر عن دلالة هذا النسخ أو السكوت عن معناه الحقيقي “ما ننسخ من آية نأت بخير منها..” الذي فهمه صحابة النبي في عصره وعملوا به من بعده وعزف عنه وعن الأخذ به بعد قرن من ذلك أكثر الفقهاء الذين بدأوا سيرة الإعادة منذ ذلك الحين.
أدّى إلغاء التاريخانية هذا الذي كان واضحاً أشد الوضوح وموضع تطبيق ثريّ في عصر النبي وفترة تكامل القرآن من ناحية إلى إلغاء مفهوم التغيُّر والتطوّر الحاصل في الزمان وفي المكان، ومن ناحية ثانية إلى إغلاق النص القرآني ذي التاريخانية الواضحة في تكامله على امتداد ثلاثة وعشرين عاماً منجماً ومستجيباً لتطور نواة المجتمع الإسلامي الوليد، ومن ناحية ثالثة إلى إلغاء الزمان والمكان بحيث صار ما عاشه مجتمع القرن السابع الميلادي في منطقة جغرافية محددة هو المرجع الأول واجب التطبيق في كل زمان ومكان. لا بل إن بعض محاولات وضع هذه الإعادة موضع التطبيق في مراحل تاريخية معروفة ولا سيما في بدايات القرن الماضي بدا وكأنه في صراع مع الأصل ذاته حين عمل مثلاً على ما يمكن أن نطلق عليه “تنزيه التنزيه” حينما هدمت بيوت ومساجد بل وقبور ذات دلالات تاريخية شديدة الإيحاء في منطقة الحجاز من الجزيرة العربية.
الذين فهموا القرآن في تسلسل آياته الزمني في عصره أدركوا على سبيل المثال معاني ودلالات تغيير وجهة الصلاة أو القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة، مثلما أدركوا معاني ودلالات تقرير مناسك الحج السنوية التي كان العرب يقومون بها سنوياً وهم الذين مارسوها قبل الرسالة المحمدية واستأنفوا ممارستها عند تقريرها ركناً من أركان الدين الإسلامي وبات إلههم، بعد أن كانت آلهتهم أشتاتاً، إلهاً واحداً.
ولقد سار توظيف “الحديث النبوي” في شرعنة هذه الإعادة على نهج الفهم الحرفي للنص القرآني. فإذا كان إلغاء التاريخانية في النص القرآني الأساس الذي قامت عليه الإعادة، فقد قامت أساساً، في ما يخص “السنة النبوية”، في اعتبار صحة نسبة الأحاديث إلى النبي، لا على إلغاء التاريخ فحسب بل وكذلك على تجاهل الظروف السياسية والاجتماعية والصراعات السياسية العنيفة التي حفل بها عصر تدوين الحديث. وكان تنسيق الأحاديث وتصنيفها في صحيح وحسن وضعيف اعتماداً على سلسلة النقلة والرواة وما إليها من القواعد التي اعتمدها مدونو الأحاديث يكفي في نظر سدنة الإعادة لشرعنتها ثم لإضفاء القداسة عليها واعتبارها مرجعاً أساسياً وعلى مستوى النص القرآني نفسه في التقنين وفي الحكم وفي القضاء.
ولعلَّ ما فاقم من تداعيات شرعنة الإعادة واعتبارها الهدف الأساس (إذ ها نحن نشهد بعد قرن من سقوط السلطنة العثمانية دعوة جديدة إلى “العودة” إلى الخلافة في مشرق العالم العربي كما في مغربه!) ضروب التحريم التي طالت كل محاولة لتكييف النصوص مع متطلبات الأزمنة الجديدة في مختلف اصقاع العالم العربي والإسلامي. فمن المحرمات الدائمة القيام بدراسات تتناول تاريخ القرآن، أو كيفية تدوين القرآن، أو كيفية نقل القرآن، أو دراسة مختلف الروايات الصحيح منها والمزيف حول تدوينه ونقله وروايته؛ ومن المحرمات أيضاً قراءة القرآن مثلما قرأه معاصروه خلال ثلاثة وعشرين سنة بين مكة والمدينة واستخلاص الدلالات والمعاني التي تؤدي إليها مثل هذه القراءة؛ ومن شبه المحرمات اجتهادات تتجاوز تلك التي تم تكريسها باسم المذاهب الأربعة والتي ألغيت منها، هي الأخرى، تاريخانيتها، على وضوحها وصراحتها في مضامينها ولاسيما لدى الإماميْن: أبي حنيفة والشافعي . لا بل إن القاعدة الفقهية المُدرجة مثلاً في مجلة الأحكام العدلية التي كانت بمثابة القانون المدني في الإمبراطورية العثمانية “لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان” والتي كانت تأخذ على وجه التدقيق بمستلزمات الاستجابة إلى الظروف الزمانية والمكانية في استنباط الأحكام الشرعية سيراً على نهج أئمة الفقهاء الأولين اعتبرت من قبل البعض باطلة من أساسها لأنها، كما وصفوها، “قاعدة مستوردة”، يراد بها تكييف الشريعة وفق الحضارة الغربية من ناحية، ولأنها تكسر في نظر هذا البعض ديمومة الأحكام الإلهية وصلاحيتها في كل زمان ومكان، رغم أن هذه القاعدة لم توضع لتتناول الأحكام الخاصة بشؤون العقيدة بل من أجل تلك التي تطال شؤون الحياة اليومية المادية، من ناحية أخرى.
وعلى أن تجسيد هذه الإعادة في عقيدة بعض الدول العربية كان قائماً على نحو صريح أو ضمني، إلا أن دعاتها وسدنتها متواجدون في كل البلدان العربية بلا استثناء سواء من خلال بنىً حزبية سياسية علنية أو سرية، أو عبر فضائيات لا تحصى ديدنها اليومي تعميم هذه الدعوة بشتى وسائل الترغيب والترهيب، أو من خلال مفكرين اتخذوا من الدعوة إلى الإعادة وفلسفتها وتبريرها واستنفار الجماهير من حولها عملاً يومياً دعاوياً لهم. يسهل مهمتهم جمهور عريض لا يزال يرزح تحت سيطرة البؤس والجهل والأمية مؤلفاً بذلك بيئة حاضنة، ولاسيما أوساط الشباب الذين يمثلون نسبة كبيرة من سكان معظم الدول العربية ولا يزالون يشكون التهميش فضلاً عن البطالة والحرمان من بناء مستقبلهم.
تتفق الصيغة الأخرى من الإعادة مع الصيغة السابقة في المنهج وتختلف عنها في المرجعية وفي الأهداف وفي السلوك وفي الإنجازات كما في الانكسارات. ذلك أنها اصطنعت مرجعية “تاريخية” لم يكن لها من وجود حقيقي على النحو الذي قدمت به، بل كانت توليفاً من مجموعة عناصر متباينة إن انتمت إلى مراحل من التاريخ متباعدة إلا أن بينها قواسم مشتركة أتاحت صياغة صورة نمطية لمرحلة مثالية في التاريخ العربي. ولأنها كانت استجابة ـ متأخرة رغم كل شيء لكنها تندرج ضمن ما عرف بالوعي القومي الذي عرفته المنطقة العربية في نهاية العصر العثماني ـ واستمراراً للحركة القومية العربية التي ظهرت للعلن تعبيراً سياسياً واضحاً منذ بداية القرن الماضي من خلال العديد من الجمعيات والمؤتمرات والدعوات الفكرية، فقد بدت حركة جديدة مُجَدِّدة تحاول التكيف مع معطيات العصر الحديث ومقتضياته سواء من خلال التنظيم السياسي أو الاجتماعي. لا بل إنها بدت في تعبيرها الأول وكأنها محاولة “استعادة” لصورة أولى تجسّدت في النبي العربي مع بدايات القرن السابع الميلادي.
غير أن غياب رؤية فكرية وتاريخية متماسكة سرعان ما أدى إلى النظر إلى هذه الصورة كحلم مثالي أمكن التخلي عنه مع الأيام لصالح صورة أخرى إن بقيت على الدوام أساس هذه الإعادة إلا أن ملامحها كانت تتغير وتزداد تشوهاً مع مرور السنوات ولاسيما حين استحالت أداة أيديولوجية في خدمة العسكريتاريا اعتباراً من منتصف الخمسينيات من القرن الماضي.
لن تكون ثمة إذن مرحلة محددة تاريخياً بكل ما تنطوي عليه من فكر ومشروع وإنجاز يمكن الاعتماد عليها من أجل العمل على إعادتها ، بل مجرد صورة حلم ضبابي يعتمد قراءة للتاريخ لا تحتفظ منه إلا بلحظاته المزدهرة أو المجيدة أو الوردية، وتتجاهل أو تلغي منه كل ما اعتوره من صفحات سوداء.
ولقد جُسِّدَت هذه الصورة النمطية في شعار يلهب مشاعر البعض ويصيب باليأس والخيبة البعض الآخر. وهو ما سمح لا بتأجيل التفكير أو البت في مشكلات اجتماعية ذات بعد قومي وتاريخي إلى أجل غير مسمى فحسب بل إلى عدم الاعتراف بوجودها أو العمل على طمسها من خلال محاولات دفنها حية.
لكن الهدف الأول والأساس كان الوصول إلى السلطة. كل الوسائل مباحة: العنف والتصفيات والنفاق والكذب. ولم تكن الأيديولوجية القومية التي وضع أسسها مثقفون مثاليون حالمون وآمنوا بها حقاً إلا اداة بين أدوات أخرى لتحقيق هذا الغرض. كان الوعد بالحداثة والتقدم وبالوحدة وبالحرية وبالاشتراكية للوصول إلى مجتمع يعيد أمجاد الماضي وهو يحقق القطيعة مع التخلف ومع هيمنة القوى الاستعمارية في أشكالها السياسية والاقتصادية والثقافية؛ لكن السلطة العسكرية التي وقفت في البداية وراء سلطة مدنية لم تكن تملك مهما كانت نواياها في الحقيقة من أمرها شيئاً ما لبثت أن انقلبت على هذه الأخيرة وأزاحتها وحلت مباشرة محلها لتقوم بعملية إخضاع للمجتمع وهيمنة عليه قلّ أن شهدت البلدان العربية الأخرى مثيلها. ولقد تبدّى منذ اللحظات الأولى لاستلامها السلطة أنها تسعى إلى شخصنتها على الصعيد الفردي في البداية ثم إلى جعلها ملكاً شخصياً يورّث سيراً على خطى أول من كرس وراثة السلطة في الإسلام، معاوية بن أبي سفيان، ضاربة عرض الحائط بكل ما تعنيه مفاهيم الدولة أو الجمهورية أو الديمقراطية أو الحداثة التي استخدمتها في مشروعها لتحقيق هدفها.
هذه الإعادة التي يمكن وصفها بالانتقائية، التي لم تعترف بمرجعية تاريخية ما سوى تلك التي اصطنعتها، سارت في تحقيق ما أرادته على نهجها في ابتداع هذه الأخيرة. فقد نبذت منذ البداية الصيغة الأولى من الإعادة بعد وسمها بالرجعية وبالتخلف، وطفقت تبني اعتماداً على ما اصطنعته وبالتدريج نظاماً كل ما هو معلن فيه على الملأ يشير إلى ما يمكن أن يرضي “الخارج” في تبنيه دولة مؤسسات حديثة ومجتمعاً مدنياً يستمدان عناصرهما من “خصوصية” هي الأخرى مفترضة. فمن يبحث عن السلطات الثلاث سيجدها قائمة في مجلس للشعب “منتخب” وفي حكومة تنفيذية وفي قضاء “مستقل”، ومن يبحث عن المجتمع المدني سيجد الأحزاب السياسية المتباينة في أيديولوجياتها والنقابات المهنية المختلفة، ومن يسأل عن الصحافة سيعثر على الصحف الحكومية والحزبية وصحفاً أخرى تحاول التظاهر بالاستقلال. ومن ثم فلا يمكن لمراقب خارجي إلا أن يقرّ وهو يطوف بنظره في بنى النظام الخارجية بحداثة النظام بالمقارنة مع الأنظمة التي اعتمدت الصيغة الأولى من الإعادة، وأن يغض النظر عن خصوصية حداثة تبقى مبررة في الدول النامية “ريثما تقوم بقفزة نوعية” تقترب بها من حداثة الغرب.
لكن خصوصية هذه الإعادة الحقيقية لا تتجلى في اللعب على المفاهيم وتوظيف مختلف الوسائل الفكرية والسياسية والتاريخية لبناء ديمومة ملكية السلطة والبلاد فحسب، بل كذلك في مجموعة من ضروب السلوك والمواقف تجلت أساساً من ناحية، في الطريقة التي برع في استخدامها سدنة هذه الصيغة من أجل وضع اليد حرفياً على سلوك وعمل وتفكير ومستقبل أي مواطن داخل البلاد، طريقة لا تضاهي في اعتمادها وفي سلوكها إلا النظم الشمولية التي قامت في بداية القرن الماضي في الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية؛ ومن ناحية ثانية وعلى غرار تفريغ مؤسسات الدولة والمجتمع من وظائفها الأساس ووضعها في خدمة السلطة الحاكمة، في تفريغ المجتمع في مجموعه من السياسة بعد القضاء سجناً أو تشريداً أو قتلاً على بقايا الطبقة السياسية التقليدية في البلاد ومن الثقافة بعد سجن المثقفين والمفكرين أو تهجينهم وتطويعهم بمختلف الوسائل؛ وأخيراً في اتباع سياسة خارجية سواء على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي لا تخرج عن النهج السابق: يروَّجُ لها في السوق المحلية باعتبارها سياسة صمود وتصدٍّ في يوم ثم سياسة ممانعة في يوم لآخر، في الوقت الذي تكرس فيه ضرباً من التعاون الضمني مع القوى المؤثرة إقليمياً ودولياً من أجل تأمين ديمومة السلطة ونظامها مجسدة في الفرد أولاً ثم في العائلة لاحقاً.
هكذا آلت الصورة النمطية المصطنعة لأمة “عربية واحدة ذات رسالة خالدة” التي برَّرت في البداية إعادة ضرب من مجد تليد في ثوب حداثي إلى كارثة سياسية واجتماعية وتاريخية لا تزال تجري وقائعها وتنتج آثارها في البلدين اللذين تمت فيهما هذه الصيغة على ما بين الممارستيْن من تباين وتفاوت.
لا يعني ذلك بالطبع أن الصيغة الأولى من الإعادة التي سبق ذكرها قد آتت أكُلها المرجوة. يكفي عرض بعض المشكلات التي تطرح في مجتمعاتها اليوم مما يعتبر من المكتسبات التي عفا عليه الزمن وتجاوزها كي تُقَدَّرَ المسافات اللامتناهية التي عليها أن تقطعها لتعيش عصرها كما كان يجب أن تعيشه.
وكما كشفت كتابات مجموعة من الأطفال على جدران مدرستهم هشاشة البنيان الذي شيد خلال نصف قرن حجراً فوق حجر، فلم يجد بناته وسدنته بداً من اللجوء إلى العنف الموصوف وغير المسبوق للدفاع عما كانوا يعتبرونه ملكاً شخصياً لهم، كذلك يمكن لحركة ما أن تؤدي إلى الكشف عن ضروب الخلل وأنماط القصور السياسية والاجتماعية والثقافية والنفسية في نظام اتخذ من قدرات الموارد الخيالية جداراً حامياً ـ حتى حين ـ من إمكان هبوب عواصف مفاجئة تنطلق من واحد من مكامن الخلل أو القصور، يعضده في ذلك أصحاب المصالح في بقائه مثلما عاضدوا وحالوا من قبل دون انهيار النظام الآخر نظراً للخدمات الجوهرية التي كان يؤديها لهم.
هكذا تتجلى صيغ الإعادة وكأنها النهج الوحيد الذي سارت بموجبه مشروعات النهضة العربية منذ ما يقارب القرنين من التاريخ العربي الحديث. صيغ كرست قدسية الماضي وقوانينه ورؤاه وهيمنته على مختلف جوانب الحياة اليومية والعامة.
لقد حاولت صيغ الإعادة وهي تدعو للماضي أن تحرِّم استخدام أي نهج غير نهجها في النظر إليه، مغلقة على غرار الغزالي لا أبواب الاجتهاد فحسب بل أبواب التفكير في غير ما تراه وتفسره أو تؤوله أو تأمر به. ومن هنا لم يكن ثمة فرق في التحجّر على الصعيديْن الفكري والعملي ما بين الإعادة إلى ما يراد اعتباره المجتمع الديني الأمثل أو العصر الذهبي لمجد تليد مُتخيّل.
يكفي التأمل ملياً في الكيفية التي تطورت بموجبها كبرى المشروعات التاريخية للتحقق من أنها لم تنكر الماضي ولم تقطع معه لا واقعياً ولا معرفيّاً، بل بدأت بوضعه في زمانه وفي مكانه عاملة على احتوائه ضمن حركة تتطلع نحو المستقبل وترمي إلى البناء من أجله. تستلهمه، فتستوحي قيمه ومثله مادامت تستجيب لمتطلبات الحاضر أو تجيب عن أسئلته التي يطرحها وتستبعد أو تهمل كل ما لا يمتّ إلى المشكلات الآنية بصلة.
وهذا على وجه الدقة ما يمكن تسميته مفهوم الاستعادة. وهو مفهوم لا يسمح بقراءة دقيقة لبعض التحولات التاريخية الكبرى التي عرفتها الإنسانية في الماضي البعيد مثلما هو الأمر في الماضي الأقل بعداً أو في الماضي الحديث فحسب، بل يتيح كذلك فهم العديد من الأعمال الفكرية في مجال الفلسفة والتاريخ والآداب وقراءتها في ضوئه. والأمثلة لبيان ذلك عديدة ومتاحة يمكن في عجالة ذكر بعض منها.
أول وأهمُّ مثل يجدر الحديث عنه أو قل يفرض نفسه في هذا المجال هو الدعوة الإسلامية في بداياتها على وجه التحديد. إذ يتيح مجرد إلقاء نظرة سريعة على الكيفية التي بدأت بها هذه الدعوة إلى الدين الجديد في القرن السابع الميلادي ملاحظة عمل هذا المفهوم خلال الأعوام الثلاثة والعشرين التي شهدت ترسيخ الدعوة واكتمال القرآن. ففي الحاضرة التي كانت قبل الإسلام قبلة العرب الدينية والتجارية والثقافية والتي كانت تغلي خلال مواسمها بنشاط ديني ودنيوي لا مثيل له في غناه وفي خصوبته في أنحاء الجزيرة العربية الأخرى كلها، استطاعت الدعوة أن تفرض نفسها حين بدا للعرب جميعاً أنها تستعيد شيئاً فشيئاً كل هذه الخصوبة الدينية باحتوائها بادئ ذي بدء الديانتين اليهودية والمسيحية جاعلة نفسها في آن واحد امتداداً لهما واكتمالاً بهما في جوهريهما ـ التوحيد ـ .
ثم بعد ذلك وللتخصيص باستيعابها أكبر وأهم تقاليد العرب الدينية على اختلاف آلهتهم، الحج، بتبني شعائره التي كانت مُتَّبَعة قبل الإسلام جملة وتفصيلاً مع التغيير الجوهري والأساس المتمثل في التوحيد: “وإلهكم إله واحد”. كان لهذه الدعوة أن تنفي نفسها بنفسها لو أنها اعتمدت الإعادة طريقاً: إعادة اليهودية إلى أصولها الأولى أو المسيحية إلى جذورها في عهد عيسى بن مريم. وحين أعلنت النبي إبراهيم أب الجميع وباني الكعبة، كانت تشمل الجميع تحت ظلها: يهوداً ومسيحيين ووثنيين.
بإعمال هذا المفهوم يمكن، فضلاً عن ذلك، إدراك معاني ودلالات تغيير قبلة الصلاة من المسجد الأقصى بالقدس إلى المسجد الحرام بمكة الذي تمَّ ـ تاريخياً ـ بعيْد القطيعة مع يهود المدينة، أو تلك الخاصة بالناسخ والمنسوخ في الآيات القرآنية التي كانت باستثناء تلك الخاصة بعقيدة التوحيد وبالإيمان تستجيب لقضايا المجتمع الجديد وتتكيف في استجابتها مع ما كان يطرحه من تساؤلات أو يواجهه من مشكلات كان من الضروري حلها لا اعتماداً على ما كان سائداً من أعراف وتقاليد وعادات، بل بناء على ما تقتضيه طبيعة الدعوة بما لا يخالف العقل والمنطق أو يصدم كذلك في جوهرها ثقافة كانت منفتحة على حضارتين كبيرتين قائمتين كانت الدعوة الجديدة تتطلع إلى احتوائهما بل وإلى الحلول مكانهما.
سيكون ممكناً أيضاً استخدام هذا المفهوم في دراسة الكيفية التي تمت بها ظروف النهضة الأوربية اعتباراً من القرن السادس عشر. لم يكن العصر آنئذ على غرار القرن السابع الميلادي في الجزيرة العربية عصر دعوات دينية أو تحقيق نهضة من خلال دين جديد. كما لم يكن مشروعاً فرديا وما كان يمكن له أن يكون. بل مشروع مجموعة من نخب أمم حاولت أن تستعيد (وللفعل هنا معناه الكامل) المبادرة التاريخية التي كان العرب قد استحوذوا عليها عدداً من القرون. وكان الإرث الفني والفكري والأدبي والسياسي اليوناني خصوصاً ثم الروماني هو الذي سيستعاد قراءة وترجمة واستلهاماً وعلى الأصعدة كافة. سينظر إلى هذا التراث بوصفه معجزة تاريخية فريدة، لكن هذه النظرة لن تبلغ حدّ التقديس. ستستعاد الملاحم والفنون النحتية والتشكيلية والمسرحية مثلما ستستعاد نشراً ودراسة مبدعات الفكر الفلسفي بتجلياته كلها، أي من المنطق إلى الميتافيزيقا، بما في ذلك ما حظي به من تأويلات ودراسات قام بها العرب من قبلهم، ولاسيما ابن رشد (الذي كان مصدراً اساساً في تفسير الفلسفة الأرسطية حتى نهاية القرن التاسع عشر في فرنسا). وستدرس الديمقراطية الأثينية والقوانين الرومانية وسيكونان حاضران على الدوام خلال عصر التنوير خصوصاً في فكر وعمل النخب الفرنسية والإنكليزية والألمانية والإيطالية عند تكريس النظم الديمقراطية وصياغة القوانين الحديثة التي لم تقم في ما حققته بقطيعة مع الماضي بقدر ما احتوته استيعاباً ثم تجاوزاً. ولا تزال.
بهذا المفهوم أيضاً، أو في ضوء مقتضياته، يمكن دراسة جهود الفلاسفة الإسلاميين العقلانيين، المتكلمين منهم في المشرق وابن رشد في الأندلس في العصور الوسطى العربية مثلما يمكن دراسة الجهد الكبير الذي حاوله في بدايات القرن الماضي وعلى امتداده كل من عبد الرحمن الكواكبي وطه حسين وعلي عبد الرازق ونصر حامد أبي زيد على سبيل المثال لا الحصر. لقد واجه هذا المجهود الذي تمَّ بذله على صعيد الفكر من أجل التمهيد لحركة واسعة كي يستعيد العرب بها زمام المبادرة التاريخية من جديد كلَّ ما يمكن تصوره من عنت ورفض واستنكار ومقاومة وعدوان مسَّ الأشخاص في حياتهم اليومية مثلما لا يزال يطالهم في ذكراهم. إذ لم يكن محض صدفة بالطبع أن يتجه طه حسين على سبيل المثال إلى التراث الثقافي العربي بامتياز، الشعر الجاهلي، فيضعه على محك التحليل والتفنيد مستعيناً بأدوات العقل لا بأدوات التقليد والنقل، أو أن يتجه علي عبد الرازق إلى أصول الحكم في الإسلام كي يفتح أفقاً جديداً لم تكن السلطة الحاكمة آنئذ ترضى به وهي التي كانت تعمل على “إعادة” إنتاج نظام الخلافة الإسلامية لا في صيغته الراشدية على الأقل بل في صيغته العثمانية بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية مع نهاية الحرب العالمية الأولى. لن يتراجع طه حسين عن قناعاته وسيعمل بصورة أخرى على بث قناعاته سواء من خلال كتبه في استعادة العصور الأولى من التاريخ الإسلامي دراسة وتمحيصاً، أو من خلال مشروعاته وزيراً على وجه الخصوص؛ وسيصر علي عبد الرازق على قناعاته دافعاً الثمن الأكبر الذي يمكن لمفكر أن يدفعه: تهميشه وإرغامه على الصمت. بعد نيف وخمسين عاماً من هاتين المحاولتيْن، سيحاول نصر حامد أبو زيد أن يسير على الطريق الذي شقه طه حسين، من خلال قراءة جديدة للتراث الإسلامي بدءاً بالقرآن. وسرعان ما تضافر ضده سدنة الإعادة من كل حدب وصوب وحالوا بينه وبكل الوسائل الرخيصة وبين إتمام مشروع بدا هو الآخر واعداً.
وفي ضوء هذا المفهوم أخيراً يمكن إدراك الأسباب الأعمق لرفض أية محاولة للإعادة أياً كان مصدرها ولا سيما للذين لا يزالون يتشبثون بإمكان إلغاء الزمان والمكان والاستعاضة عنهما بتخييل عصر ذهبي لم يكن له وجود أصلاً. ومن ثمَّ، وبعد أن سقطت صيغة الإعادة “العلمانية” سقطتها المريعة في نسختيها اللتين سادتا منذ ستينيات القرن الماضي طوال نصف قرن، لا بد خصوصاً للذين ينادون بانتمائهم للدين الإسلامي وإلى تراثه الفكري والفقهي والسياسي أحزاباً وجماعات ومفكرين من أن يعودوا إلى بداية الإسلام الأولى لا لكي يعيدوا إنتاجه على النحو الذي عرفه المجتمع العربي في القرن السابع، بل لكي ينعموا النظر طويلاً وملياً في الكيفية التي سار عليها نبي الإسلام نفسه في إدارة مشروعه الهائل. لاشك أنهم سيفتقرون إلى وحيه الإلهي، لكنهم يستطيعون على الأقل أن يستوحوا نهجه، أي طريقته في العمل وفي التفاعل مع ما سبقه ومع ما كان يتطلع إلى بنائه.
* كاتب أكاديمي وصحفي ومترجم سوري
المصدر: صفحة الدكتور “بدر الدين عرودكي” على وسائل التواصل

التعليقات مغلقة.