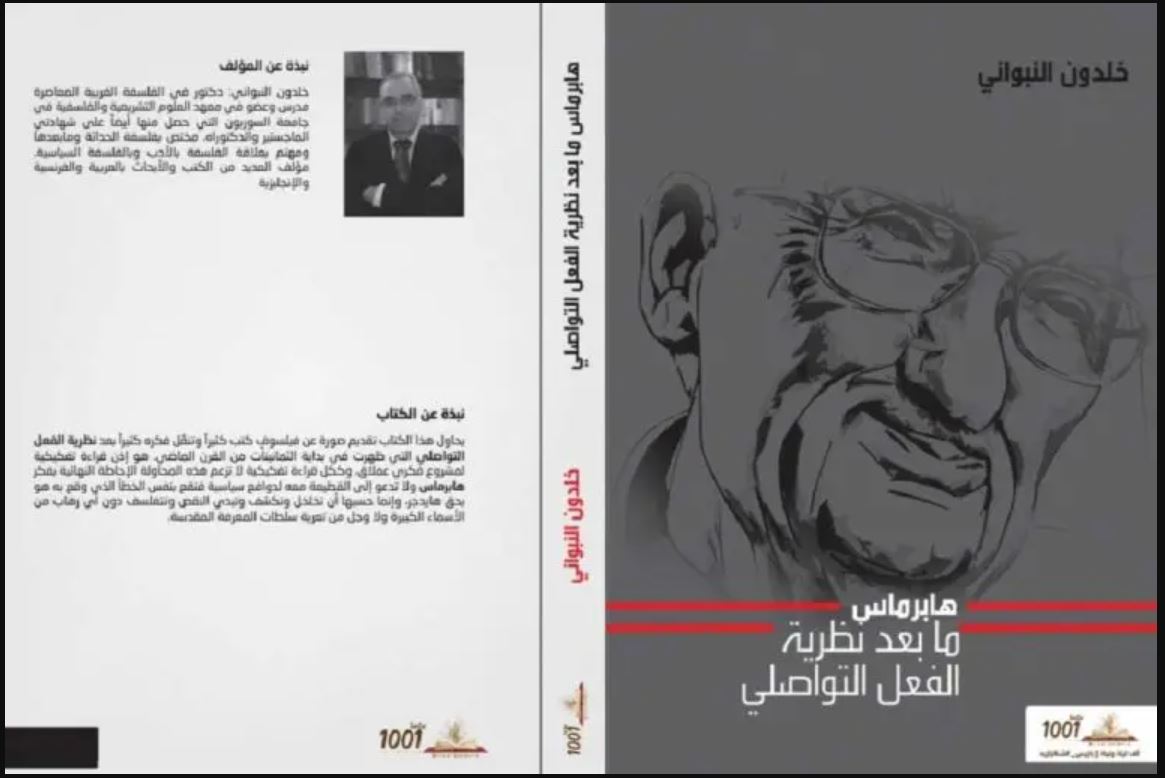
غسان ناصر *
يستضيف (مركز حرمون للدراسات المعاصرة) اليوم، الباحث والأكاديمي الفيلسوف السوري الدكتور خلدون النبواني، المختص بفلسفة الحداثة وما بعدها، والمهتمّ بعلاقة الفلسفة بالأدب وبالفلسفة السياسية.
ضيفنا من مواليد بلدة جرمانا من ضواحي دمشق عام 1975. تخرج من كلية الفلسفة في جامعة دمشق عام 1999، وحصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في الفلسفة الغربية المعاصرة من “جامعة السوربون”، وهو يعيش في فرنسا منذ عام 2004.
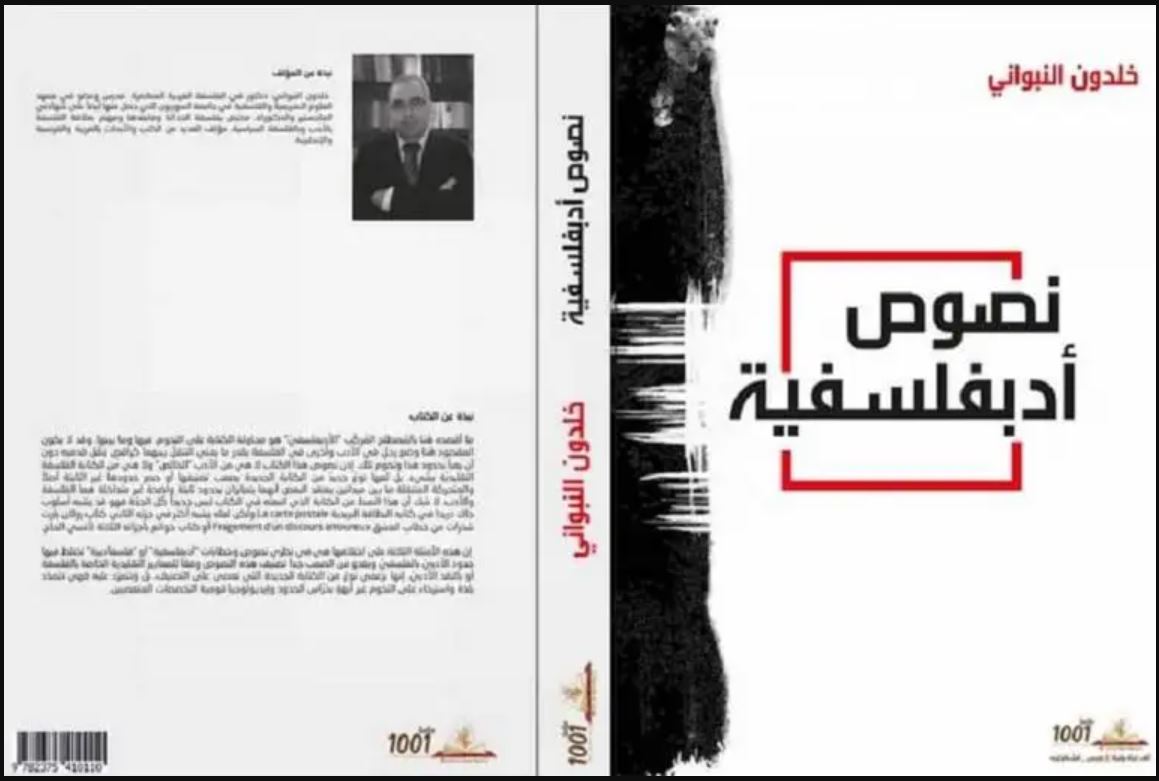 صاحب «قصاصات»، مدرّس وعضو في “معهد العلوم التشريعية والفلسفية” في “السوربون”، ومنذ بدايات ثورات الربيع العربي، اهتمّ بتحليل الأحداث وبمتابعة مجرياتها، داعيًا كل السوريين للانضمام إلى ثورة الحرية والكرامة في آذار/ مارس 2011، التي كان ينتظرها منذ سنوات طويلة لخلاص البلاد والعباد من حكم آل الأسد الاستبدادي، وسيطرة الحزب الواحد الشمولي الذي أنهك سورية وشعبها.
صاحب «قصاصات»، مدرّس وعضو في “معهد العلوم التشريعية والفلسفية” في “السوربون”، ومنذ بدايات ثورات الربيع العربي، اهتمّ بتحليل الأحداث وبمتابعة مجرياتها، داعيًا كل السوريين للانضمام إلى ثورة الحرية والكرامة في آذار/ مارس 2011، التي كان ينتظرها منذ سنوات طويلة لخلاص البلاد والعباد من حكم آل الأسد الاستبدادي، وسيطرة الحزب الواحد الشمولي الذي أنهك سورية وشعبها.
من أبرز مؤلفات النبواني: «نصوص أدبفلسفية – في بعض مفارقات الحداثة وما بعدها»، و«جاك دريدا فيلسوف الهوامش» (مشترك)، و «في بعض مفارقات الحداثة وما بعدها»، و «هابرماس – ما بعد نظرية الفعل التواصلي». وترجم عن الإنكليزية والفرنسية كتبًا فلسفية مهمّة إلى اللغة العربية، من أشهرها: «الفلسفة في زمن الإرهاب».
 في حوارنا مع صاحب «التباسات الحداثة – هابرماس في مواجهة دريدا»، تطرقنا إلى ما يجري في سورية الآن، لمعرفة العوامل والأسباب التي أفرزت هذا الوضع الاستثنائي الذي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم. كما تطرقنا في حديثنا هذا إلى المحنة التي تعيشها ثورتنا اليوم، وإلى تأثير الطائفية في النسيج الاجتماعي السوري ومستقبل سورية، وإلى واجب المثقف السوري اليوم تجاه القضية السورية، وإلى ما شهدته وتشهده المنطقة من حراك ثوري ومستجدات سياسية، وما تشهده فرنسا اليوم من أحداث إرهابية وتداعياتها.. فكان هذا الحوار:
في حوارنا مع صاحب «التباسات الحداثة – هابرماس في مواجهة دريدا»، تطرقنا إلى ما يجري في سورية الآن، لمعرفة العوامل والأسباب التي أفرزت هذا الوضع الاستثنائي الذي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم. كما تطرقنا في حديثنا هذا إلى المحنة التي تعيشها ثورتنا اليوم، وإلى تأثير الطائفية في النسيج الاجتماعي السوري ومستقبل سورية، وإلى واجب المثقف السوري اليوم تجاه القضية السورية، وإلى ما شهدته وتشهده المنطقة من حراك ثوري ومستجدات سياسية، وما تشهده فرنسا اليوم من أحداث إرهابية وتداعياتها.. فكان هذا الحوار:
بداية، كيف تنظر إلى ما يجري في سورية الآن؟ وما العوامل والمسببات التي أفرزت هذا الوضع الاستثنائي في سورية؟
اسمح لي أن أبدأ بالاعتذار عن ردودي التي لعلها تكون صادمة، وقد تسبب لك وللقارئ خيبة أمل في كشخصٍ يفترض أنه “مثقف سوري”. فأنا أنظرُ إلى سورية الآن من بعيد، من بعيد جدًا بحيث أتقصد ألا أرى التفاصيل لأستمر حيًا، على الأقل على المستوى النفسي والإنساني. بل إني بصراحة أكثر أحاول أن أشيح بوجهي عن سورية، وأحاول أن أقتلها في داخلي وأحيلها نسيًا منسيًا، لكن عبثًا. فنداءاتها أقوى من غناء السيرينيات ولستُ -مع الأسف- ببراغماتية “عوليس” ودهائه لأستطيع مقاومة ذلك النداء المميت.
 سورية اليوم هي اللعنة التي أهرب منها، فأجدها أمامي كما لو أن الماضي هو المستقبل، وأن الذكريات الماضية تولد في الغد. موقفي مما يحصل من سورية اليوم هو إذن موقف الجبان، لا موقف البطل الملحمي أو المثقف الملتزم.
سورية اليوم هي اللعنة التي أهرب منها، فأجدها أمامي كما لو أن الماضي هو المستقبل، وأن الذكريات الماضية تولد في الغد. موقفي مما يحصل من سورية اليوم هو إذن موقف الجبان، لا موقف البطل الملحمي أو المثقف الملتزم.
أما عن العوامل والأسباب التي قادتنا إلى هذا الجحيم، فقد كُتب في ذلك -كما تعلم- أطنانٌ من الأبحاث والدراسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الممتازة، لكن دعني من موقعي الفلسفي الذي أحفر فيه أن أقول لك بشيء من الحسم غير العلمي إن السبب الأساسي لكل ما نحن فيه ثقافي تاريخي، قبل أي شيء آخر. أو بمعنى آخر: من بين كل تلك العوامل الكثيرة وشبه اللانهائية: من الصراع الطائفي العتيق جدًا، والاستبداد كممارسة سياسية تأخذ شكل هوية الحكم، وتدخلات الخارج، وصراع المحاور الإقليمية والدولية، وأمن إسرائيل، وعقود الرعب الأسدي، وخنق الحريات إلى آخر ما هناك من أسباب مهمة وفاعلة ومسببة في تعفن الحالة السورية، إلا أن ما يهمني من بين كل ذلك هو القالب الثقافي للاستبداد الذي تتفاعل فيه وضمنه وعليه وبسببه كل تلك العوامل. وحين أُشير إلى الاستبداد كثقافة، فإني أعني أن حل الصراع في سورية يتم بالخروج من قالب الاستبداد مرة واحدة. أتحدث هنا (بشيء من القطيعة غير التاريخية، والتي لا يمكن أن تكون تاريخية على كل) عن paradigme shift بالمعنى الذي قدمه توماس كوهن عن ثورات العلم، لكنه بتطويعه هنا ليتناسب مع ثورات السياسية. دون مثل هذا التغيير الثوري، لن تكون هناك ثورة بالمعنى الانقلابي، وإنما سيكون هناك استمرار لنمط تاريخي في الحكم والحياة عصيّ على التغيير. دون مثل هذا التغيير الكلي للنموذج؛ لا تكون الثورات إلا عمليات جراحية تطيل في عمر النموذج الثقافي الذي يُنتجُ كل هذه الاستبداد الذي لم نقدم بديلًا له، معارضةً ونظامًا، فنحن جميعًا نستقي مفرداتنا وتصوراتنا السياسية من نبع الاستبداد الثقافي نفسه.
نعيش حالة إحباط موضوعية:
بتقديرك، هل الثورة السورية الآن في محنة، خاصة أننا على مشارف وضع جديد بعد الإشكالية الطائفية وما عنته في سورية وما كشفت عنه الثورة؟ وما تأثيرها برأيك على المستقبل السوري؟
لا شك في أن الثورة السورية اليوم في محنة كبيرة، ليس فقط بسبب دمار الدولة والفقر والانهيار الاقتصادي والتحكم الخارجي الكامل بالقرار السوري معارضاتٍ ونظامًا، ولكن أيضًا بسبب الانهيار القيمي والفوضى وفقدان الثقة والأمل بالثورة نفسها ومآلاتها. مع غياب البوصلة وعدم قدرة السوريين اليوم على خلق قيادات قادرة على الخروج من مأزق انسداد الآفاق الذي تواجهه الثورة، ومع تسليم النظام مفاتيح سورية بالكامل تقريبًا إلى إيران وروسيا، هناك حالة إحباط موضوعية، فلا أفق واضحًا ولا مستقبل قريبًا أو على المدى المتوسط يمكن أن يبعث الأمل. القراءة الواقعية للمشهد السوري اليوم تثير الخوف على مستقبل البلد وإمكانية التعايش فيه لسنوات طويلة قادمة، لكن على المدى البعيد يمكن دائمًا التفاؤل؛ إذ ليس علينا تأبيد الحالة الراهنة وتعميمها على كل ما سيأتي. لكي يكون مستقبل الديمقراطية والحرية والتعايش السلمي ودولة المواطنة والقانون ممكنًا، لا بد من البدء الآن، وهنا، ليس في إصلاح الماضي فهو بارديغم (نموذج) فاسد الآن، وإنما في خلق بارديغم سياسي جديد يقوم على المواطنة والدولة المدنية والعدالة الاجتماعية وحرية التفكير.. نفكر بكل هذا بشكلٍ جديد، لا كشعارات فارغة أفرغت من محتواها وصارت تنتج نقائضها فقط. يبدو هذا الكلام أضغاث أحلام. هذا صحيح لكن العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة وحكم الشعب ومحاكمة مجرمي الحرب كانت في يوم من الأيام مجرد أضغاث أحلام. وحده العمل المثابر والعنيد دون استسلام أو يأس هو ما جعلها ممكنة، بالرغم من كل نواقصها.
ما الذي يجب علينا فعله تجاه مجموعات أهلية موجودة في سورية ولا يجب قمعها، لكنها أيضًا بالشكل السياسي التحاصصي الذي تقتضيه تستجلب نوعًا من الرعاية الأجنبية وعدم الاستقرار الموسمي؟ وما هو الحل؟
بكلمة واحدة: “المواطنة” هي الحلّ. التحاصص الطائفي هو آفة الديمقراطية، بل هو أخطر من الدكتاتورية والاستبداد على الديمقراطية. لماذا؟ لأن الدكتاتورية والاستبداد يناصبان الديمقراطية العداء بشكلٍ واضح وصريح ومباشر، وتثور عليه الشعوب لتحقيق نقائضه أي الديمقراطيات، في حين أن التحاصص الطائفي هو سرطان الديمقراطية، فهو يأخذ شكل خلاياها ويقتلها من الداخل.
التحاصص الطائفي في لبنان والعراق كارثة حقيقة على الديمقراطية ومانع لحدوثها. ولا بد من التذكير أن من لعب طويلًا وبفاعلية على الهويات الطائفية هو الغرب الاستعماري الذي لا يزال ينظر إلينا (حتى في المرحلة ما بعد الكولونيالية) كمجموعات طائفية واثنية وديانات متقاتلة، وهذا الاستشراق السيئ يجعله يستمر بممارسة تمزيقنا عن بعد برعايته لما يُسمى الأقليات.
المواطنة -كما أفهمها هنا وأدعو إليها- هي الوحدة الأولى التي يجب أن يقوم عليها الانتماء والباقي حريات خاصة. في المواطنة، لا نتحدث عن أقليات وأكثريات، ولا عن طوائف وانتماءات دينية، بل عن مواطنين لبلد ما. المواطنة هي قيم اجتماعية وأخلاقية، وهي أيضًا حق وواجب ينظمه الدستور ويصونه. لا شك أن الإعلاء من قيمة المواطنة على قيمة تلك الانتماءات ما قبل الوطنية، وقد تفشت كالوباء وتجذرت لدى السوريين بخاصة الطائفية منها، صار أمرًا صعب التحقيق والمنال، لكن بدون جعل المواطنة هي الوحدة الأولى والهدف النهائي لسورية الجديدة، فإننا سنستمر في دوامة الهويات القاتلة والحروب الأهلية والتدخلات الأجنبية والتمييز الاجتماعي إلخ. هنا أؤكد من جديد أننا نحتاج إلى الخروج من بارديغم السياسة السابق وإلى شيء من دكتاتورية القانون، حتى ينشأ مجتمع مدني قادر على الدفاع عن مؤسسات الديمقراطية والدولة المدنية.
من منظورك، ما واجب المثقف السوري اليوم تجاه القضية السورية؟ وما الفارق الذي يمكن أن يصنعه مقارنة بسواه؟
مرة أخرى عليّ أن أُحدد موقعي هنا، بأنني لا أتحدث من موقع “المثقف الملتزم” ولا من موقع “السوري”، فكل هذه الهويات تنتمي إلى ما أحاول الخروج منه وعليه. على مثل هذا السؤال، هناك إجابات كثيرة تصدر في معظمها عن من يرون في أنفسهم مثقفين ملتزمين، وهذه المواقف أخلاقية تمامًا ونبيلة بالكامل، إذا ما صدرت عن نية صادقة بالتغيير نحو الحريات المدنية والديمقراطية والمساواة الاجتماعية إلخ، لكن مرة أخرى لا يتعلق الأمر بي هنا. من زاوية الرؤية (وهي ضيقة ومحدودة على كل حال ولا تدعي غير ذلك)، التي أَضع نفسي بها، أجد أن من واجبي بالمقابل التيقظ للبنية الذهنية اللاواعية لخطاب التغيير المُعارض “الملتزم”، وهي خطابات تحمل بكل أسف جينات المرحلة الأسدية الأمنية، ولهذا هي تشبه الأسدية في الكثير من الملامح والتصرفات. خطاب المعارضة عمومًا عندنا ينزلق دون وعي إلى الطائفية وعدم الاعتراف بالآخر والتعصب الديني والطائفي والأيديولوجي والمناطقي والشعائري والأُسري. ورؤى المعارضة السورية المُعلنة والخفية بشكلٍ عام، منذ بداية الثورة لليوم، هي في العمق توءم الأسدية، وتضع نصب عينيها قصيرة النظر البحث عن مصادر قوة ونفوذ وثروة على ديدن الأسد وأبنائه الذين جعلوا من سورية شركة خاصة بهم، قبل أن يبيعوا أسهمها لإيران وروسيا، وربما لإسرائيل وأميركا في القريب القادم، ليبقوا في موقع السلطة والتحكم في ثروات البلد ومصيره. كل ما تفكر به المعارضة هو أخذ مكان الأسد وامتيازاته. بهذا المعنى، أجد أن من واجبي أن أبقي العين مفتوحة على مثل هذه الخطابات التي تتغذى من تصورات الاستبداد السياسي، مهما تنكرت بأقنعة الديمقراطية والعلمانية والدولة المدنية، فهي لم تنتج إلى الآن سوى ممارسات نقيضة. ليس عملي هذا في تفكيك المفهوم أو نزع القفاز لرؤية حقيقة اليد التي تتحكم فيه هوسًا برصد المفارقات والمتناقضات، وإنما عمل فكريسياسي (كلمة واحدة) للوصول إلى النبع أو لتتبع المصدر الثقافي والحضاري للاستبداد الذي نعيش فيه ونعيد إنتاجه غلى نحوٍ مستمر، ذلك المصدر الذي نظن أننا نهرب منه، لكننا نحصن جدرانه وندعم أساسه بتوقف مصادرنا عليه. لن تنضح من البئر التي يستقي منها عدوك سوى الماء نفسه. دون الخروج من هذا الكهف، لن ينتج المثقف السوري سوى كوابيس ومسوخ سياسية قريبة بل متماهية مع ما أُنتج سياسيًا في سورية، منذ خمسينيات القرن العشرين على أقل تقدير.
نحتاج إذن إلى تغيير كامل للبارديغم الفكري والثقافي والخروج من سرداب الهويات المتقاتلة، إذا ما أردنا التغيير والخروج من جحيم الاقتتال الأهلي السوري وتأسيس عقد اجتماعي جديد مكتوب على صفحة بيضاء بالكامل، لنضمن التعايش المشترك والتداولي السلمي للسلطة والاعتراف بحق الآخر في الاختلاف. لا شك أن هذا الكلام ليس تاريخيًا ولا يلتزم معايير البحث الأكاديمي، وهو لا يريد أن يكون كذلك أصلًا، وإنما يريد أن يكون كليًا وجذريًا لتغيير البارديغم وليس مجرد بحث جزئي لمعالجة المشكلة الجزئية والإبقاء على الكارثة الكبرى. الثورات هي من يجعل ذلك ممكنًا، ولا أظن أن الفرصة قد ضاعت منّا لإحداث هذه الثورة الحقيقة بتغيير باراديغم السياسة بالكامل.
بعد تعثر ثورات الربيع العربي في أكثر من بلد، بات العالم العربي أكثر فقدانًا للوجهة والمشروع، ومُستباحًا لخارجيين متنوعين، وأقل شأنًا مما كان. ماذا جرى؟ أين يكمن الخطأ؟
ما حصل في العالم العربي هو ثورات انفجارية. لقد تشققت طناجر الضغط من الداخل بحكم كثافة الضغط، ونحن ما زلنا في مرحلة الانفجارات التي تتوالى، ليس في ما يسمى بالعالم العربي وحسب، بل حيث امتد الاضطراب خارجه. كان هناك تواطؤ بين السلطات العربية الحاكمة والعالم، ومن ضمنه “الغرب الديمقراطي”، على قبول بقاء status quo أي الأمور على ما هي عليه: دكتاتوريات وعائلات حاكمة وشعوب خاضعة. الانفجار الشعبي الذي حصل فاجأ الجميع، بالرغم من توقعه، وهنا بدأ السباق المحموم بين الجميع، إما لاستثمار التغيير لأهداف سياسية واقتصادية، وإما لإعادة الأمور إلى سابق عهدها ووضع الشعوب من جديد تحت وصاية القمع والبوط العسكري. لم يُترك للشعوب قيادة ثورتها وإنما سُحقت إرادتها ما بين الأنظمة والقوى الإقليمية التي تريد إعادة الشعوب إلى بيت الطاعة بالإكراه وبين قوى خارجية إقليمية ودولية تدعم التغيير، ليس من أجل تحرير الشعوب بل تنفيذًا لأجنداتها. مع ثورات الربيع العربي، تقدمت إلى واجهة مسرح الاقتتال السياسي على الشرق الأوسط ثلاث مشاريع سياسية متصارعة على النفوذ والسيطرة: المشروع التشييعي الإيراني والمشروع “الديمقراطي”/ الإسلاموي ودعاة “الشرق الأوسط الجديد” بالإضافة إلى عودة روسيا إلى الساحة الدولية كلاعب رئيسي. بغياب أي مشروع قومي عروبي، ظهرت هذه البدائل التي أعاقت الشعوب عن استكمال ثوراتها بنفسها. في تصارعها مع بعضها على السلطة والثروة والنفوذ الجيواستراتيجي، نجحت هذه المشاريع عبر التمويل والتسليح والأسلمة بتوظيف أبناء البلد الواحد في حروب أهلية بالوكالة. هكذا تشتت مجرى التيار القوي، وصار سبخات وحفرًا ومستنقعات متباعدة، يُغرق أحدها الآخر في عملية قتل ذاتي مرعبة. وعلى الرغم من كل ما حصل من جرائم حرب وتشريد وقتل وفظائع، لا يزال الصراع مستمرًا بين هذه المشاريع الإقليمية والتحالفات وصراع المحاور، وهي لم تتفق فيما بينها على تقاسم الطرائد بعد أن استولت على إرادة الشعوب العربية التي عاشت الثورة وقراراتها.
من هنا يأتي الضياع الكلي، ومن هنا يأتي ذلك الإحباط بمآلات الربيع العربي، واليأس من إيجاد مخرج لهذا النفق. وبسبب أهوال آلة القتل الجهنمية التي واجهت بها بعض الأنظمة العربية شعوبَها التي ثارت عليها كما هو الحال في سورية، صار قبول أي مشروع أجنبي أمرًا مقبولًا بل مأمولًا لدى كثيرين، حتى لو كانت إسرائيل نفسها لتخلصهم من جحيم النظام اليومي. ما كان للخارج أن يستطيع أن يحقق مثل هذه الاختراقات ويُخرج السوريين مثلًا من دائرة القرار السوري، نظامًا ومعارضةً، لو أن هذا النظام قبل بالتخلي عن السلطة مبكرًا أو قاد عملية التغيير الديمقراطي، وكم كان ذلك ممكنًا وكم كنا قد وفرنا على أنفسنا دماء وضحايا وبقينا أصحاب سيادة وقرار. مكمن الخطأ إذن في بنية الاستبداد قبل أي شيء آخر. التمسك بالسلطة هو من دول ثورات الربيع العربي وفتح الباب على مصراعيه للقوى الخارجية لأن تدخل وتفتح صندوق باندورا ليخرج منه “داعش” و”النصرة” وأمراء الحرب وتتار العصر الحديث.
شيء أخير أود إضافته هنا، وهو أن كل الثورات حتى الأكثر نجاحًا وتغييرًا من بينها قد مرت كلها بمرحلة اضطراب أثناء وبعد الثورة، ولم تستقر الأمور إلا بعد مرحلة طويلة، لكن الثورات العربية ظهرت تاريخيًا في مرحلة سمحت فيها الليبرالية بظهور تهديدات وتحديات حقيقية للديمقراطية حتى في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية العريقة. لقد سمحت وسائل التواصل الاجتماعي بحرية تعبير غير مسبوقة للجميع. طبعًا، يمكن الاعتراض على أن الدولة الأمنية العربية تمارس رقابة هائلة على مثل تلك الوسائل، وهذا صحيح، ولكن الأمر لم يعد يمكن ضبطه، بل هو من سرّع وتيرة ظهور الثورات وانتقال شرارتها وتوثيق تفاصيلها. وعلى الرغم من أن ذلك الأمر يمكن أن يُعدّ إيجابيًا، فإنه تحوّل إلى نمط من الفوضى غير المنظمة. نميز في الديمقراطيات بين ديمقراطية تمثيلية وأخرى مباشرة، وأنا مع الأولى ضد الثانية. تحتاج الحياة السياسية إلى شيء من التنظيم، وإلا تصدّعت المؤسسات التي تضمن ممارسة الديمقراطية. في الديمقراطيات التمثيلية، يتم تقنين (من القناة) الديمقراطية عبر ممثلين عن الشعب، يقوم هو باختيارهم للحديث باسمه والدفاع عن حقوقه في البرلمانات ومجالس النواب والتشريع إلخ. الآن ومع انفتاح هذا الباب الفردي للجميع على قول كل شيء وأي شيء، تفشت الشعبوية في السياسة، ويكفي أن ننظر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يحكم العالم عبر منصة (تويتر) مثلًا، كما زادت الفوضى واﻟ fake news حيث صار كل شيء قابلًا للتصديق، وكل شيء قابلًا للتكذيب. لقد انفتح التواصل على مصراعيه، ولم يخطر على بال فيلسوف التواصل يورغن هابرماس للحظة أن يتحول التواصل إلى (فيروس) يهدد الديمقراطية، فلا أحد هنا تقريبًا يحترم أخلاقيات النقاش والتواصل، والجميع يتحدث في وقت واحد. ضاعت المعيارية، وباسم الحريات تحوّلت الحرية إلى فوضى غير مؤسسة، وجرف طوفان “كل شيء مباح” كلَّ السدود التي تضبط مجرى العلاقة بين الدولة والمجتمع. كل شيء متاح، كل شيء مباح يعني في النهاية أن الديمقراطية تعيش فيضان فوضاها. ولدت ثورات العالم العربي بفضل ثورات التكنولوجيا، لكنها غرقت فيها أيضًا، ولا شك في أن هناك جزءًا كبيرًا من الفوضى الحاصلة، سببه تمكين الجميع من التعبير عما يريد قوله بسرعة وبنزق وبدون تفكير دون معايير ودون ضوابط ودون مخططات وبرامج ورؤى مشتركة وإرادات تعمل معًا.
اللعبة الديمقراطية والإسلام الساسي:
ما قراءتك لما تشهده فرنسا حاليًا من تهديدات إرهابية؟
ما تشهده فرنسا حاليًا ليس وليد اللحظة، وإنما هو إرث متراكم كان له أن ينفجر في لحظة من اللحظات. لا يمكن اختصار الموضوع بأسطر، لكن للتوتر الحاصل اليوم (وهو ليس بجديد أبدًا) مسببين رئيسيين برأيي: الأول تصلّب العلمانية الفرنسية إزاء الأديان عمومًا، وليست معركتها الأشرس ضد الإسلام والمسلمين كما يحصل اليوم، ولا هي -ولو بطريقة مواربة وغير صريحة- إزاء اليهود في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، ولكنها كانت على الأخص ضد الكاثوليكية، دين الأغلبية في فرنسا. العلمانية في فرنسا لم تكن تاريخيًا ضد الإسلام، فهو لم يكن حاضرًا فيها، عند بداية الصراع المدني الديني مع الثورة الفرنسية التي نجحت في إلغاء الميزات التي كان يتمتع بها الأساقفة وفرضت حرية الاعتقاد والمساواة في الحقوق وإعلان حقوق الإنسان الذي صار جزءًا من دستور 1958. تم إقرار علمانية التعليم في فرنسا منذ عام 1882، وتم إقرار علمانية الدولة عام 1905. مع ذلك الصعود الجامح للدولة المدنية وقيم الحداثة؛ تراجع الدين من المجتمع (ليس فقط في فرنسا وإنما في عموم أوروبا، لكن في فرنسا بشكلٍ مميز) وراح ينسحب من الحياة نحو الأديرة والكنائس التي صارت شبه مهجورة.
السبب الثاني يتعلق بنظري في عدم اندماج فعلي لمسلمي فرنسا مع حرية التعبير والحريات بشكلٍ عام؛ إذ لم يعرف الإسلام والمسلمون في فرنسا مثل هذا الصراع بين الدين وقيم التنوير والحداثة، فالجيل الأول منهم كان يعيش في مستعمرات فرنسية كبلدان المغرب العربي وبعض دول أفريقيا ذات الديانة المسلمة كالسنغال، وقد استُجلبوا للعمل في مناجم وللقيام بالأعمال الصغيرة الشاقة دون العمل الفعلي على تعليمهم ودمجهم. لم يندمج هؤلاء تمامًا بالمجتمع الفرنسي، وظلوا يشعرون بأنهم من درجة ثانية أو ربما ثالثة قياسًا بالفرنسيين. التهميش الاجتماعي والتراتبية الطبقية (التي تخالف كل قيم التنوير وحقوق الإنسان، وتخالف قوانين ودستور الجمهورية الخامسة لفرنسا) ظلت حاضرة وتتفاعل مع الزمن وسيتفجر هذا الغضب مرات ومرات، لعل أهمها أحداث الضواحي عام 2005 التي سيقوم بها خصوصًا أبناء الجيل الثالث من أبناء المهاجرين. عدم الاعتراف والاحتقار الاجتماعي الموجود مع الأسف في فرنسا فجّر الأمور. لكن من غير المنصف تناول الأمور فقط من هذه الزاوية، فقد أدرك مسلمو فرنسا أن حياتهم كمسلمين في فرنسا أنعم بالًا وأكثر كرامة حتى على المستوى الديني، منها لو كانت في بلد مسلم من بلدان العالم الثالث الغارقة بصراعاتها الدينية وانفصامها بين تصور مثالي للدين ووحل الواقع الذي تغرق فيه. لم تكن أسباب الحياة وحدها هي من دفعت مسلمي العالم إلى التطلع إلى الهجرة إلى البلدان الأوروبية العلمانية، بل هناك أسباب تتعلق بالحريات الدينية الممنوحة لهم في تلك البلدان، التي لا يجدون لها نظيرًا في الدول الثيوقراطية الأتوقراطية المسلمة. وقد ظلّ حال الاستقرار هذا قائمًا حتى أحداث 11 سبتمبر/ أيلول تقريبًا بشكلٍ ظاهر، لكن منذ سقوط الاتحاد السوفيتي بشكلٍ أبعد. كان لا بد للولايات المتحدة من خلق عدو خارجي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، لتبرر فيه تدخلاتها في العالم، وكان هذا العدو هو الإرهاب، وتم ربطه بالإسلام، منذ أحداث 11 سبتمبر/ أيلول. ومع تفشي العنف على يد متطرفين إسلاميين ينفذون بين الفترة والأخرى عمليات إرهابية في الغرب، سيتم تحويل الإسلام السياسي إلى غول لإدخاله في اللعبة السياسية الداخلية في الصراعات السياسية بين الأحزاب وفي الانتخابات، لإلهاء الناس عن مشكلات أخرى، وعن ألعاب السياسة القذرة. ومن ناحية أخرى، ستجد دول خارجية في مسلمي أوروبا حصان طروادة، لتدخل منه في لعبة النفوذ والسيطرة والضغط والابتزاز فتقوم -مستفيدة من قوانين أوروبا العلمانية عمومًا- بتمويل جماعات وأفراد وهيئات إسلامية. وباستثناء ألمانيا، لا تقوم دول أوروبا بتمويل أماكن العبادة والمؤسسات والمشاريع الدينية، وهذا يترك الباب مفتوحًا أمام جهات خارجية: أفراد وشركات وحكومات، لتمويل المساجد وتدريس اللغة العربية وإيفاد الأئمة. من هذا الشباك، سيتم إقحام الإسلام في فرنسا في اللعبة السياسية، لكن من الخارج هذه المرة، بعد أن أُقحم فيها داخليًا من قبل الأحزاب المتصارعة. بين طموح بعض الدول والأفراد والأيديولوجيين بأسلمة أوروبا وبين تصلب العلمانية الفرنسية، سيدفع مسلمو فرنسا الثمن الأعلى.
لكن ما يبدأ بلعبة قد يتحول إلى كابوس مرعب. فقد واجه الساسة الفرنسيون حقيقة أن الإسلام السياسي في فرنسا تحول من لعبة إلى خطر حقيقي يهدد قيم الدولة المدنية، لكن معالجة الأمر (الذي ابتدأ بوضوح في عهد جاك شيراك الذي أوكل مهمة معالجة المشكلة إلى وزير داخليته آنذاك نيكولا ساركوزي) كانت تأخذ دومًا شيئًا من الدبلوماسية والحزم معًا، دون الصدام المباشر وتوتير الداخل. ما أخطأ به ماكرون الشاب بنظري هو تسمية الأمور بمسمياتها، دون ذلك اللف والدوران الدبلوماسي والألفاظ المنتقاة التي تتجنب انفجار العنف. لا شك في أن موقفه ينم عن قلة خبرة سياسية، فهو لم يعرف أن ما هو بديهي في فرنسا بدعةٌ في الخارج، وأن خطابه سيتم تحريفه وتشويهه من قبل جهات خارجية لها مصلحة في مضايقته والضغط على فرنسا.
ماكرون الآن بين نارين: فمن جهة هو لا يستطيع التراجع، وبالرغم من أن خطابه لم يتقصد الإساءة لا للإسلام ولا للمسلمين فإنه كان يريد المزاودة على خطاب اليمين المتطرف الذي ينافسه بشدة والانتخابات ليست بعيدة. الآن إن تراجع سيبدو ضعيفًا أمام الداخل الفرنسي المحتقن والمتأثر بخطاب الشعبوية والإقصاء الذي يؤججه اليمين المتطرف، وإن لم يتراجع، فتح البلد على اضطرابات وحوادث مفتوحة لا يعرف أحد أين وكيف ستنتهي. إذن للمشكلة سببان في نظري، يتعلق أحدهما بطريقة تعامل الحكومة الفرنسية بحدة هذه المرة وبشكلٍ مباشر مع معضلة الإسلام السياسي، والثاني يتمثل في مشكلة الرفض الإسلامي الواضح والمتزايد لمسلمي فرنسا لقيم العلمانية والدولة المدنية.
ثمة نقطة أخيرة أودّ الإشارة إليها، وهي قناعتي بوجود شيء من الكاثوليكية المكبوتة في فرنسا، تعبّر عن نفسها بشكلٍ موارب ومحتقن من الأديان الأخرى. لا شك أنها -ككل المكبوتات- لا تظهر بوضوح، وهي تتنكر دومًا، وقد فتحت خطاب المغالاة في العلمانية وقيم المدنية. وأزعم أن في النازية شيئًا من هذه المسيحية المكبوتة لدى هتلر، ولدى بعض المفكرين مثل مارتن هايدجر. اليوم في ذلك الخلط بين الإسلام والمسلمين والإرهابيين والتضيق على المسلمين، كلّما وقع اعتداء أو كان هناك انتخابات مثلًا، تطل هذه المكبوتات الكاثوليكية متقنعة ومتنكرة، لكنها لا تخفي نفسها لمن يطيل النظر ويركز في الكواليس.
عادة ما نتحدث عن تطرف أصولي وتطرف علماني وكل مصطلح ترفعه جهة ما خدمة لأغراض أيديولوجية وسياسية، برأيك ما العلاقة بينهما؟ وهل ترى أن التطرف العلماني يمكن أن يكون جوابًا عن التطرف الأصولي أو حتى العكس؟
العلاقة بين هذين النمطين من التطرف سيامية، فهما شقيقان توأمان يحملان الملامح نفسها. كلاهما إقصائي ومنغلق وخطير، بسبب عمائهما الأيديولوجي وعدم قدرة التواصل مع الآخر ولا حتى قبول وجوده أو الاعتراف بحقه في الوجود. ومع ذلك فهما في العالم العربي ليسا على القدر نفسه من القوة والحضور والتأثير. ففي حين ينحصر التطرف العلماني في فئات محدودة جدًا تكاد تكون غير معروفة وذات تأثير شبه معدوم، (إلا إذا تحدثنا عن تأثيرها العكسي أي دفع الناس نحو التطرف الإسلامي كردة فعل عليها(، فإن التطرف الأصولي الإسلامي تحديدًا حاضر بقوة، مع الأسف، ويكاد يكتسح المشهد الاجتماعي. على خلاف التطرف العلماني عندنا، يظل التطرف الإسلامي مُنظمًا وممولًا وقادرًا على التأثير والحشد ومسح العقول وإغواء الشباب الذين سُدت بوجههم سبل الحياة. بهذا المعنى، نجد أن مقارنة ضعف حضور التطرف العلماني بقوة وكثافة حضور التطرف الإسلامي غيرُ عادلة، مع أنهما شكلان متطابقان من أشكال الإرهاب الفكري. لهذا -وجوابًا على الشق الأخير من سؤالك- لا يمكن أن يكون أحدهما علاجًا للآخر، وإن إقامة أي عقد اجتماعي جديد في عالمنا العربي يجب أن تقوم أساسًا على حق الاعتراف بالآخر وبالاختلاف، على ألا يكون هذا الآخر متطرفًا. وهنا نصل إلى مفارقة حقيقية درجتُ على تسميتها في أبحاث سابقة ﺑ “مفارقة الديمقراطية في العالم العربي”. أثبتت النتائج القريبة لثورات الربيع العربي أن جماعات الإسلام السياسي هي الأكثر حضورًا شعبيًا والأعظم قبولًا وشعبية، لدى القطاعات الواسعة من الشعوب العربية. حتى في بلد ذي تقاليد مجتمع مدني قوي بل علمانية شبه متصلبة، مثل تونس التي شهدت انتصار (حركة النهضة) في أول انتخابات لها بعد الثورة. في مصر، فاز تيار الإخوان المسلمون في نتائج الانتخابات مع محمد مرسي وحزبه (الحرية والعدالة) عام 2012، وقبل الربيع العربي قادت صناديق الاقتراع عام 1991 إلى فوز (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) في الانتخابات البرلمانية الوطنية في الجزائر، واكتسحت (حركة حماس) نتائج الانتخابات التشريعية للسلطة الوطنية الفلسطينية عام 2006 بفوزها على (حركة فتح). هل كانت تلك الانتخابات نزيهة؟ لا شك أنها لم تكن مزورة، وهي تعكس بشكلٍ لا يقبل الشك ميل الشارع العربي اليوم إلى الإسلام السياسي. هل كانت انتخابات ديمقراطية؟ دعني أقول إنها نصف ديمقراطية، أو ديمقراطية منقوصة ومشوهة، فقد تمت بوسائل الديمقراطية لا بروحها. لقد فازت هذه القوى السياسية والأحزاب والحركات الإسلامية باقتراعات شعبية، وهذه إحدى أهم وسائل الانتخاب والتعبير الديمقراطي، لكن روح الديمقراطية التي تقتضي القبول بقواعد اللعبة تظل غائبة عن نمط تفكير هذه القوى في السلطة والعملية السياسية. تظل هذه القوى السياسية للإسلام السياسي مهددة بالعمق لسيرورة وحياة الديمقراطية، فهي تقبل بالانخراط في اللعبة الديمقراطية في البداية لأنها تضمن أن الشارع معها وأن فوزها بصناديق الاقتراع أمرٌ محسوم، لكنها لا تلبث أن تتخلص من سلّم الديمقراطية الذي صعدت عليه، لتغير في السلطة وشكل الدولة، ونظام الحكم الذي تريده إسلاميٌّ لا مدني. وبالرغم من أني أعدّ أن ما حصل في مصر عام 2013 هو انقلاب موصوف على الشرعية، فإن ما كان يسعى إليه مرسي والإخوان في مصر هو تصفية الهياكل (المهلهلة على كل حال) للدولة المدنية هناك، لصالح إنشاء دولة إسلامية غير ديمقراطية. باستثناء الحالة التونسية تقريبًا، تم الانقلاب على كل هذه القوى السياسية للإسلام السياسي التي وصلت إلى الحكم بوسائل الديمقراطية. وحجة الانقلاب على نتائج الديمقراطية الذي دعمته دول “الغرب الديمقراطي” هو أن هذه القوى عدوة للديمقراطية. هي إذن سيرورة تدمير الديمقراطية لذاتها عندنا، وهذا ما أُسميه بمفارقة الديمقراطية العربية.
لكي نخرج من نصف الديمقراطية، ولكي تكون الديمقراطية عندنا ممارسة غير منقوصة، عليها أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها ونتائجها ضد أعتى قوتين عندنا، تمنعان ولادتها أو تقومان بوأدها كلما وُلدت، وهما الإسلام السياسي والدكتاتوريات العربية. تحتاج الديمقراطية الوليدة إلى قوة تحميها إلى أن تصبح قادرة على الدفاع عن نفسها. وهذه القوة التي يمكن أن ترعى ولادة الديمقراطية، لها بتصوري مصدران اثنان في حالة من التنافس التاريخي: الأول هو الدولة، والثاني هو المجتمع المدني. في الحالة التونسية (وهي الاستثناء العربي) نجح المجتمع المدني في ضبط حدود وطموحات (النهضة) الإسلامية وخلق حالة من التوازن (تتصدرها أحيانًا العلمانية المتطرفة، وهنا مصدر الخطر)، أما في بقية أنحاء العالم العربي فلا مجال للوقوف أمام القوى الإسلامية التي تريد دولة إسلامية غير علمانية وغير مدنية، وهنا لا بد من وجود دولة قوية قادرة على ضبط طموحات الإسلام السياسي. لكن مثل هذا النمط من الدولة هو الدولة التي نعرفها والأنظمة الاستبدادية التي نعاني بسببها وثرنا عليها، وهي لا تقل خطرًا على الديمقراطية من الإسلام السياسي. أُميز شخصيًا بين sécularisation التي قد تعني علمنة الوعي الشعبي أي خلق شيء من الوعي الاجتماعي بأهمية العلمانية (ليس فقط للمجتمع المدني وإنما أيضًا وبخاصة للممارسات الدينية) وبين laïcité مفهومة هنا بوصفها علمانية الدولة المقوننة والممأسسة قانونيًا وسياسيًا بالدستور. ولأن النمط الاجتماعي للعلمانية يحتاج إلى تربية مدنية طويلة (قد ترعاها الدولة، وهنا شيء من المفارقة)، فإن ما يمكن التعويل عليه هنا هو علمانية الدولة، على أن تخرج من إهابها الأمني العائلي المصلحي ضيق الأفق وقصير النظر. نحتاج إلى مرحلة سأدعوها هنا ﺑ “دكتاتورية العلمانية”، على أن تكون قصيرة ومؤقتة، تُرسخ قواعد اللعبة الديمقراطية وتؤمن إمكانية دفاع المجتمع والدولة عن الديمقراطية وسيرورتها واستمرارها في وجه الانحرافات الخطيرة كالانقلابات العسكرية والتنظيمات الإسلامية التي تتسلل متنكرة بلبوس الديمقراطية لتؤسس دولة الخلافة. يقدم لنا التاريخ أمثلة على دكتاتورية العلمانية، في كل من تركيا كمال أتاتورك، وتونس الحبيب بورقيبة. لا شك في أن أتاتورك وبورقيبة كانا دكتاتورين، لكنهما أسسا لمجتمع مدني قوي ودولة علمانية قوية دون أن يؤسسا -بسبب من دكتاتوريتهما- لتقاليد ديمقراطية حقيقية. إذن نحتاج إلى نماذج لهما، لكن أفضل منهما، نماذج منفتحة على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ودولة المؤسسات، لا الأفراد والعسكر الذين يجب أن يخلوا كرسي الحكم للمؤسسات المدنية الديمقراطية. إذن لا بد من مرحلة قصيرة من دكتاتورية الديمقراطية لنتمكن من الحديث عن سيرورة الديمقراطية.
وأسمح لنفسي هنا باستطراد أخير في هذا الخصوص، يتعلق بفخّ فكري/ سياسي يقع فيه من سأسمّيهم “جماعة الديمقراطية/ الإسلامية”. حيث يجد هذا التيار، وهو مصيب في ذلك، أن ما يعوق ولادة الديمقراطية في العالم العربي هو الدكتاتوريات العربية ونظم الاستبداد القائمة على هيكلية أمنية عسكرية عمومًا. ويجد هؤلاء (عن مراقبة صحيحة كذلك) أن نتائج الانتخابات تؤدي، في الحالات العربية، إلى فوز الإسلام السياسي. ويعوّل هؤلاء على تمرير الديمقراطية عبر الإسلام السياسي، وهم يريدونه إسلامًا سياسيًا معتدلًا، يقبل بقواعد اللعبة الديمقراطية ثم يتمدن ويتهذب في سيرورتها، ويصبح جزءًا من الديمقراطية العربية المأمولة في المستقبل، كما كانت الكنيسة -مثلًا- جزءًا من تاريخ ولادة وسيرورة الديمقراطية الأميركية. لكن ينسى هؤلاء أن سيرورة الديمقراطية في أميركا كانت مترافقة مع مجتمع مدني ناهض ومؤسسات مدنية ودولاتية علمانية ومدنية تستلهم النموذج الأوروبي، وأن المكون الديني ظل جزءًا محدودًا وهامشيًا، ضمن ذلك التيار الديمقراطي الأميركي. وليست هذي حال الإسلام في العالم العربي. لا شك أن علمانية الولايات المتحدة الأميركية تظلّ أقل تصلبًا من علمانية أوروبا، وبخاصة فرنسا، لكنها لا تقدم نموذجًا تاريخيًا للاحتذاء بالنسبة إلى الإسلام السياسي الحالي الذي يجد نفسه في موضع قوة وقبول شعبي، ويريد السيطرة على الدولة والمجتمع، وليس بوارد الدخول في هوامش اللعبة الديمقراطية، كما فعلت الكنائس في أميركا. يجد هذا التيار العربي في بعض التيارات الفكرية الغربية التي تؤكد ضرورة التصالح بين الدين والدولة المدنية مصدرًا لأوهامهم، وهنا يلعب هابرماس دورَ الملهم لهذا التيار. فهابرماس الشيخ تخلّى عن دفاعه عن مبادئ الحداثة الأوروبية، لصالح ردة سياسية يدعو فيها بإلحاح إلى إخراج الدين من حيّز الإيمان الشخصي والفضاء العام الخاص، وإدخاله إلى الفضاء العام ومؤسسات السياسة، ومن هنا، كان الاحتفاء به وبترجماته وآرائه حول الدين عندنا، ولدى هذا التيار بشكلٍ رئيسي.
وعلى الرغم من أني مقتنع بحسن النيّات الفكرية لهذا التيار، وبأنهم يجدون أن تحالفهم مع قوى الإسلام السياسي شرًا لا بدّ منه، وأنه “تحالف موضوعي”، وأنهم (كما يفكر الإسلام السياسي لكن باتجاه معاكس) مُضطرون إلى الصعود على سلّم الإسلام السياسي ذي القبول الشعبي الكاسح والمدعوم من قبل بعض الدول، فإني أرى أنهم يراهنون بالكامل على حصان خاسر. فالإسلام السياسي هو من يتحكم فيهم، في حين يظنون أنهم هم من يوظفونه، وإنه يريد وضعهم كواجهة لتقديم صورة مدنية وفكرية بحثية محترمة، أو كقناع يخفي مشروع الإسلام السياسي الذي لا يقبل المشاركة.
ولادة الوعي الفلسفي… اكتشاف النار:
ماذا يحدثنا الدكتور خلدون النبواني عن المؤثرات التي ساهمت في تكوين منهجه الفلسفي وتطوره؟ وهل يمكننا أن نتحدث عن آباء روحيين لك في هذا الحقل المعرفي؟
من غير الممكن التحدّث عن منهج فلسفي عندي، ويمكنني القول بنوع من الثقة وبدون كثير من الفخر إنني لستُ من أصحاب المناهج، بل إني كثير الريبة فيهم. ويمكننا الحديث ربّما عن تلك المؤثرات التي ساهمت في تكويني الفلسفي، تلك المؤثرات التي كنتُ في البدايات مهووسًا بها، وانقلبت عليها لاحقًا حتى لا أقول في النهاية. هي “خيانة موصوفة”، إذن، وأنا -على ما يبدو- وفيّ جدًا لمثل هذا النوع من الخيانات الفكرية، أحدثك عن “وفاء للخيانة” أو عن “وفاء الخيانة”.
ولدتُ في منتصف السبعينيات تمامًا من القرن العشرين في (سوريا الأسد)، وتعلمت في مدارس سورية المُهلهلة، ووصلت إلى الجامعة مطلع التسعينيات، وهنا كانت البداية الحقيقة لما يمكن أن يكون ولادة وعي فلسفي. والحديث عن ولادة الوعي في (سوريا الأسد) وإن كان على المستوى الشخصي، شيءٌ يشبه حدوث المعجزة، أو هو عملية تشبه الثورات الكبرى أو اكتشاف النار. قبل الجامعة، كان الأدب هو ما يحركني ويعجبني ويصوغني، لم تكن الرواية تستهويني أكثر من الشعر، لكن في الأدب -وهذا ما لم أدركه إلا متأخرًا- كان لدي ميلٌ خفي نحو الأدب العميق أو الفلسفي، دون أن أعي الأمر كما هو كذلك حينها. دخلتُ الجامعة وقد قرأت هوميروس وما وصل إلينا معربًا من نيكوس كازانتزاكي، على سبيل المثال، وهذه القراءات كانت تشدني دومًا، فأعيد قراءتها كما لو أن هناك شيئًا ضائعًا مني يستدعيني للبحث عنه بين السطور وفي الزوايا المعتمة من النص.
من ناحية أخرى، وهذا قد يبدو مفارقةً وقد يجد فيه البعض ضحالة فلسفية وفقرًا فكريًا مُدقعًا، لكن أشعار محمود درويش -مثلًا- ساهمت في تكويني النفسي والثقافي أكثر مما فعلت أفكار كانط وهيجل، وروايات عبد الرحمن منيف صاغت كثيرًا من قوالبي الذهنية أكثر مما فعل أرسطو وابن رشد لاحقًا، على سبيل المثال، في حين كان للأدب الروسي بخاصة الاشتراكي المؤدلج الذي كان يصل إلينا دور خطير في تصوراتي عن دور الأدب في الحياة.
ما علاقة كل ذلك بالفلسفة؟ دخلت الفلسفة بهذه الذخيرة -الكلمة هنا قريبة من العسكرة، وهذا يتناسب مع نشوئي في “سوريا الأسد”- الثقافية، وكان على الفلسفة أن تتفاهم مع هذه الحصيلة الأدبية بصعوبة، وكلغة أجنبية جافة في البداية احتاجت إلى وقت حتى تتوطن داخلي وتتفاهم مع مكوناتي النفسية وقراءاتي النهمة للأدب. كان على الفيلسوف أن ينظّم عشوائية الشاعر، وظلَّ الشاعر يقاوم دكتاتورية العقل الفلسفي. لا بد لي من التذكير هنا أنني من أسرة أدبية، لكنها متواضعة ماديًا، ولم يكن للفتى الذي كنتُه قبل بلوغ العشرين عامًا إذن أن يقرأ بلغة غير العربية، ولا أن أطّلع على سوى ما هو متاحٌ حولي من كتب في المراكز الثقافية، أو ما يُهرّب لي ولأختي من الأدب الروسي عن طريق أحد أخوالي.
الدخول إلى قسم الفلسفة في “جامعة دمشق” كان يشبه الزواج من امرأة أخرى دون تطليق الزوجة الأولى، وكأي ضرتين كان على الفلسفة والأدب أن يتصارعا داخلي طويلًا، إلا إن وجدا لغة مشتركة، وتلازمًا عضويًا. الدخول إلى قسم الفلسفة في دمشق كان أيضًا خروجًا من الأيديولوجيا الفجة العسكرية التي يشربنا إياها نظام الأسد بنظامه التعليمي الأمني، ودخولًا في أيديولوجيا أخرى هي الماركسية، لكنها أيديولوجية قائمة على التفلسف والعقل، وكان هذا يكفي لتأخذ أول نفحة حرية فكرية على بؤسها. دخلت الجامعة والاتحاد السوفيتي كان قد بدأ يتفكك، لكن انهيار النموذج السياسي “الماركسي”، إن صحت التسمية، قد جعل معظم أساتذتنا الكبار من الماركسيين (وجلهم كانوا ماركسيين) أكثر تمسكًا بالماركسية. كما لو أن سقوط الاتحاد السوفيتي جعلهم أكثر تشبثًا بذلك العالم الذي بنَوا عليه آمالهم وقيمهم وتصوراتهم، ثم راح يتصدع فجأة فوق رؤوسهم. لهذا لا تستغرب أن يكتب صادق جلال العظم، مثلًا، كتابه الأقوى، والأكثر أيديولوجية «دفاعًا عن المادية والتاريخ»، في تلك الحقبة المتداعية. آنذاك كانت المحاضرات والندوات التي تقوم في الكلية تصرّ على أن فشل التجربة ليس فشلًا في الفكر والنظرية، إلى آخر ما هنالك من هذا الكلام الأيديولوجي، لكن الجو المشبع بالماركسية كان هو المسيطر، وكان من الصعب على شاب غرّ ريفي مثلي آنذاك الإفلاتُ من قفص الماركسية. والماركسية في قسم الفلسفة في “جامعة دمشق” كانت دليلًا على الإفلاس الفكري حقيقة، وعلى الفقر الفلسفي الذي كنا وما زلنا نعيشه. إذن؛ دخلتُ الفلسفة من باب الأيديولوجيا، أو يمكن القول بشكلٍ آخر كانت الأيديولوجيا الماركسية هي ذلك الطريق الطويل والمتعرج الذي أطال وأخّر وصولي إلى الفلسفة. وعند الحديث عن الماركسية، يمكن لنا طبعًا الحديث عن منهج، بل عن “المنهج” (بأل التعريف) كما كان يصرّ طيب تيزيني أن يطلق على المادية التاريخية والديالكتيكية، بينما كانت بقية وسائل المعرفة الفلسفية الأخرى مجرد أدوات ثانوية بنظره. ووفق مفردات قاموس الماركسية الضيق جدًا، على اتساعه الكبير، يمكن لنا الحديث عن تطور الفكر وتطور المجتمع وتقدمه، ففكرة الزمن الخطي السائر دائمًا إلى الأمام، أو من شكل من أشكال نمط الإنتاج إلى شكلٍ أرقى يتجاوزه في عملية ديالكتيكية تمّ ابتسارها، على طريقة أليكساندر كوجيف بأحسن الحالات، أو على طريقة جوزيف ستالين في بسترة الماركسية. وعلى الرغم من كل تلك القشرة الأيديولوجية للماركسية، بوصفها فلسفة أو بوصفها الفلسفة بالأحرى، كانت البدايات الصعبة لأبناء جيلي وزملائي في قسم الفلسفة. وعلى الرغم من نقدي الحالي لتلك الوضعية الأيديولوجية التي كانت عليها حال القسم عندنا في دمشق في مطلع التسعينيات، وانتقادي لبعض الأساتذة القديرين على تضييع طاقاتهم الكبيرة في الأيديولوجيا السهلة بدلًا من عناء التأمل الفلسفي العميق، وإنْ في الماركسية، كما فعل لوي ألتوسير أو جورج لوكاتش أو جان بول سارتر أو مدرسة فرانكفورت.. إلخ، فإن بعضًا من أساتذتي في “جامعة دمشق” كانوا آبائي الروحيين، ولهم أعظم الفضل والأثر -بعجره وبجره- عليّ حتى الآن. حين يتحدث المرء عن أبيه الروحي ينحو غالبًا لذكر الأسماء الكبيرة شبه المقدسة، لكنه يغفل أن بعض أساتذته المباشرين قد أثروا فيه أكثر من هذه الأسماء المهمة بكثير، وينسى آثارًا قد يظنها هامشية، لكنها في الحقيقة حاسمة مثل الأم (المعلم الأول وقبل أرسطو بكثير)، والأب (تجسد الإلهي في البشري، بكل ما تحمله الآلهة من غموض ورهبة وقدسية)، والحي وأصدقاء الطفولة وقصص الأطفال والمدرسة.. إلخ. يشبه هذا الأثر الهامشي والحاسم تفسيرَ إريك فروم للأحلام، في كتابه «الحكايات والأساطير والأحلام»، إن لم تخُنّي الذاكرة، حيث يؤكد عن حق أن ما يحتل مسرح الحلم هو أحداث بسيطة هامشية مرّت من دون أن ننتبه إليها، في حين أن ما كان قوي الحضور في الواقع يختفي أو بالكاد يكون كومبارسًا في الحُلم. ومرة أخرى أسأل: ما علاقة كل ذلك بالفلسفة؟ الفلسفة بالمعنى المفروض تاريخيًا ومدرسيًا علينا؟ حسنٌ، إن أردتُ إجابتك عن الذي أثر بي في الفلسفة مفهومة بوصفها كذلك من الفلاسفة، فلا بد لي من الاعتراف بأني قرأت كثيرًا في الفلسفة وبعض الفلاسفة هُم مَن أثر فيّ تأثيرًا كبيرًا. هذا البعض هم أولئك الفلاسفة الذين يُشعلون عقلي ويثيرون مخيلتي ويجعلوني مندهشًا من قوة أفكارهم وعظمتها. أحببتُ إذن مخيلة أفلاطون (أكثر من عقلانية أرسطو)، وتأثرت بأسلوب القديس أوغسطين وذاتيته الشفافة (أكثر من تحليلية رينيه ديكارت) وأدهشني فريدريك نيتشه حدّ فقدان التوازن، وأعاد لي مارتن هايدجر وجاك دريدا وجان بودريار ما أطفأه فيّ إيمانويل كانط ويورغن هابرماس. لا شك في أني أحترم الفلاسفة الكبار الذين تأثرت بهم بدرجة أقلّ، ويترتب عقلي حين أقرأ لفيلسوف كبير مثل أرسطو أو كانط أو حتى هابرماس، لكني لا أجد نفسي إلا لدى فلاسفة آخرين، يحرروني من الفكر الصندوقي المغلق، ويعيدون لي الوجود بتولًا عذريًا غامضًا من جديد يستحق الحياة والتأمل وإعادة التكوين.
وعلى الرغم من كل ما أنتقدُ به كارل ماركس الذي حجب عنا الفلسفة طويلًا، فإن أثره عميق ومهم وقوي، وليس غريبًا أن يكتب فيلسوف بذاتوية جاك دريدا «أطياف ماركس»، فماركس المفكر الثائر تحضر أطيافه، كما الاستغاثة بالآلهة، كلّما وقع الظلم واختلت العدالة الاجتماعية وساد القهر والاستغلال. ماركس مُفككًا ومصفى من الأيديولوجيا يمكن أن يكون الأب الروحي كذلك لليسار الجديد الذي ألهج به.
إلى أي مدى وضعتك كتاباتك الجريئة في مواجهة مع النظام الأمني ببلدك؟
أنا، بكل صراحة، لم أكن شجاعًا كثيرًا قبل الثورة في سورية، ولذلك لم أتعرّض قبلها إلا لبعض المساءلات والتحقيقات التي كانت تتم “لفلفتها” كل مرة، على ندرتها. مرة واحدة، استجوبني الأمن، قبل الثورة بسنوات، حين قدّمت محاضرة بدعوة من مجموعة مثقفين في الحزب الشيوعي في السويداء (لم أكن يومًا شيوعيًا ولا ماركسيًا حزبيًا) كانت بعنوان «الدولة القومية قداسة المصطلح وتقادم الظاهرة»، وكانت نقدًا لأدبيات حزب البعث. عدا ذلك لم يتم توقيفي أو مساءلتي أبدًا. طبعًا، أصبحتُ مطلوبًا مباشرة من قبل النظام ما إن بدأت الثورة في تونس. كنتُ متحمّسًا جدًا للتغيير العربي، وأترقب باحتراق انطلاق الثورة في سورية، وكنت أتقافز على القنوات التلفزيونية بحماس، بل كنت أُحرض السوريين على الخروج بثورة سلمية لإسقاط النظام؛ فأصبحت مطلوبًا في سورية، وتعرضت لبعض المضايقات في باريس. منذ انطلاق الثورة في تونس لا أستطيع العودة إلى سورية، بسبب من معارضتي لنظام الأسد.
لستُ بطلًا إذن، ولا أدعي أني كنتُ شجاعًا، فأنا تحدثتُ وانتقدت وفضحت النظام من باريس. لم أتلق صفعة ولم أعرف الحرمان ولا السجن الذي عرفه الناس في الداخل، وإنما اكتفيت بالكتابة والتعليق الإعلامي من الخارج، ولم أنخرط في هيئات الثورة إلا مدة شهرين أو أكثر قليلًا، بقيت فيها في (المجلس الوطني السوري) قبل أن أعلن استقالتي منه على العلن، بعد خيبة أملي الكبيرة فيه، ولا زلت أرفض إلى الآن أي دعوة توجه لي على شكل تنظيم أو حزب أو حتى جماعة سياسية.
وتعرية الأكسدة الأسدية:
بكونك مثقفًا تنويريًا سوريًا تشغلك القضايا العامة في الكتابة؛ ما الذي يشغلك اليوم على وجه الخصوص؟
تقديمك لي كمثقف تنويري سوري يفرض علي ثلاثة قيود تكبّلني: مثقف وتنويري وسوري، في حين أن الانفكاك منها أو محاولة الانعتاق الدائمة (على استحالتها) هو ما يشبهني أكثر. لا أريد أن أكون سوريًا إذن، لكني لا أستطيع رغم كل محاولات الانعتاق العبثية سوى أن أكون هذا السوري المغترب والملعون على نحو من الأنحاء. سورية هنا هي اللعنة التي تلاحقني ولا فكاك لي منها، شيء يشبه القدر بالمعنى الإغريقي الأوديبي، مهما حاولت الفرار منه سيكون في النهاية المصير والمستقبل. سورية هي صخرة سيزيف التي أحاول إيصالها إلى أعلى الجبل لا لإثبات قوتي وإنما لأرميها من علٍ فتتشظى ملايين النثرات وانفك منها، لكنها تعود كل مرة وتسقط فوقي وعلى أضلاعي وتكتم نفسي. أتذكر هنا موقف دريدا من هويته اليهودية، حيث يرى -بالمعنى- أن اليهودي الحقيقي هو من يخون مبادئ اليهودية. أنا في كلّ الهويات اللعينة التي وجدت نفسي مسجونًا فيها أخونُها، لكني بخيانتها أظلّ ابنها البار وفي هذا كل المفارقة.
لا شك في أن كلامي هنا لا يشبه لغة الأستاذ الجامعي (وهي سجن هوياتي آخر أسعى للتحرر منه) ولا لغة ما صار أسطورة “المثقف الملتزم”، بالمعنى الغرامشي أو السارتري، إلخ، بقدر ما يُشبه لغة بعض الفلاسفة الذين يشغلهم سؤال الوجود (سارتر بالمناسبة تمزّق بين الالتزام والانعتاق منه، وكم أفهمه وأشبه تمزقه هنا). وبما أنني من أولئك الذين لا تعرف أناهم أن تتطبع مع العالم، فإن حلًا أخيرًا يظل ممكنًا وهو أن يتطبع العالم معنا، وهذا يتطلب إرادة تغيير ومقاومة حقيقة لكل مظاهر التشوه الحاصل. من هنا هاجسي بحاجة العالم إلى خلق يسار جديد، يسار يتحرر من صدأ اليسار الماضي وجموده العقائدي وانحرافاته التي أنشأت وساندت دكتاتوريات وأمراء حرب وعسكرتِ المجتمع وقضت على تحرره. اليسار المأمول هو مقاومة دون أحزاب، وهذا لا يعني أن تكون فوضوية أو غير منظمة ومشتتة الجهود، وإنما أن تحرص ألا يتحول اليسار بتحوله إلى الحزب والسلطة إلى مجموعة خنازير قذرة وفاسدة، كما في «مزرعة الحيوان» لجورج أورويل. اليسار الجديد هو في نظري وبشكلٍ موازٍ لمقاومته لليمين الشعبوي والمتعصب وتوحش الرأسمالية يجب أن يكون أيضًا وبشكلٍ مواز رفض لدوغمائيات اليسار الحديث التي أنتجت ودعمت الأنظمة الشمولية، وصادرت حريات الناس وسيادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها. أيضًا اليسار يحتاج اليوم إلى باردايغم جديد.
بالعودة إلى مسألة التنوير، فهي عندي اليوم جهد نظري لتخليص الوعي مما صدأ وتكلّس من مصطلحات التنوير نفسها. التنوير كما أريد أن أفهمه هو فكّ القداسة والكونية عمّا اعتبر بوصفه كذلك، أي مبادئ كونية وعامة قابلة للتعميم في الزمان والمكان. بمعنى آخر: لا تنحصر مهمة تفكيك مفهوم التنوير ومبادئه على تلك الجهود النظرية الجبارة التي اضطلع بها مجموعة كبيرة من الفلاسفة والمفكرين والنقاد من تيودور أدورنو وماكس هوركهايمر، وصولًا إلى إدوارد سعيد، مرورًا بـ ليفي ستراوس وميشيل فوكو وجاك دريدا إلخ، والتي فضحت عن ذلك التشوه الكبير الذي ألحقته السياسة بقيم التنوير، حين استعمر الغرب الليبرالي التنويري أجزاء مهمة من العالم باسم تنوير تلك الشعوب وتحديثها وتمدينها منتهكًا بممارساته الاستعمارية الهمجية أبسط قيم التنوير وحقوق الإنسان والمدنية.
شخصيًا، لا أجد أن هذه المراجعة للتنوير كافية اليوم، فنحن بحاجة أيضًا إلى تفكيك مفهوم التنوير ومبادئه فكريًا وفلسفيًا، أي في الحيّز النظري الخالص للكشف عن تلك القيود الخفية (قد تكون ظلامية بالمناسبة) التي تحدّ من حريتنا ورؤيتنا وإنسانيتنا باسم الحرية ومُثل التنوير ومبادئ حقوق الإنسان. نعرف جيدًا مثلًا ذلك الجدل الدائر حول كونية حقوق الإنسان وتلك المركزية الغربية التي تريد فرضه كقيمة كونية تنطبق على الجميع في الزمان والمكان، لكنها بسبب ذلك قد تنتهك حقوق الإنسان لدى ثقافات من مرجعية ليست غربية.. إلخ.
أحرص إذن على “كحت” كل ذلك الصدأ الذي تراكم فوق مُثل التنوير وحوّله إلى مجرد شعارات فارغة، جُثة بلا روح نتعثر بها في مسيرتنا نحو “التنوير”.
من الظلامية إذن -برأيي- أن نردد كالببغاوات عبارات الحرية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة والتعاقد الاجتماعي.. إلخ، كما لو كانت مجرد تعويذة من هذه القيم نفسها، فنكررها لطردها كما فعلنا لعقود في سورية مثلًا في شعارات حزب البعث في الوحدة والحرية والاشتراكية، فأنتجنا نقائضها الأسوأ بامتياز.
أعكف منذ فترة على تفكيك مصطلحات السياسة، أي مقدّساتها وأصنامها، مثل مفهوم الوطن والوطنية والدولة والقومية والعروبة وفلسطين إلخ (وسيصدر عملي هذا في كتاب قريبًا). بهذا المعنى “سوريا” هي كذلك “مصطلح” سياسي تراكم عليه الصدأ، وصار لا بد من تعرية كل تلك الأكسدة الأسدية التي تراكمت عليها وعلينا. لا بد إذن من تفكيك الأسدية التي تلبست جسد سورية كالحروق من الدرجة الأولى، التي تشوه الجلد وتلتصق به، والتي لا زالت تحمل توقيع المعارضة والنظام معًا. هكذا لا بد من الخروج من قداسة سورية وامتلاك الشجاعة على رفضها كوطن مقدس من أجل إعادة خلقها من جديد، من دون قداسة مَرضية ولا تابوهات المدرسة الأسدية القومية ولا حتى العروبية.
ماذا تعني لك لحظة الكتابة؟ وما الذي تطمح إليه من وراء كتاباتك الفلسفية؟
لحظة الكتابة؟ لا يوجد زمن حين تسيطر علي الفكرة وتحولني إلى مجرد راقن للنص الذي تمليه علي. تظل لحظة الكتابة معلقة هي خارج الزمن بالنسبة إلى كاتبها. لا يعود الزمن هنا كرونوميتري أي قابلًا للقياس عند الكاتب في لحظة الإبداع. لا شك أن الزمن الخارجي يسيل دائمًا، لكن زمن الإبداع صفري متوقف أو ضوئي، وبالتالي لحظة الإبداع هي من دون زمن، والزمن ليس في النهاية سوى وهم نفسي كبير نحن عالقون داخله. وعلى أي حال، ومع الأسف، لحظات الكتابة كثيرة وومضات الإبداع فيها قليلة. أعرف حالات أتمنى لو أستطيع فيها لحاق الأفكار واعتقالها في كلمات، وأعرف أوقات أخرى في الكتابة لا أستطيع فيها كتابة فكرة واحدة أو عبارة جيدة. في الحالة الأخيرة، الزمن بليد أبدي بطيء حاضرٌ كمحقق في غرفة الاستجواب. وكثيرًا ما أفسد أفكارًا جيدة سابقة حين أقوم بإعادة كتابتها ما إن أجبر نفسي على الكتابة.بين الإبداع خفيّ الأصل والتبلد الذهني، تمنحنا الورقة البيضاء فرصة جديدة دائمًا لإعادة المحاولة، ربّما للفشل من جديد، أو لإفساد إبداع حضر سابقًا وغاب، لكنها أيضًا فرصة جديدة للخلق من عدم، لإعادة التكوين: في البدء كان البياض. الورقة البيضاء فرصة متكررة لولادة جديدة، لمحاولة ثانية وثالثة ولا نهائية، ومن هنا يأتي الخوف من البياض: أو ما سأدعوه هنا “رُهاب البياض” أي الرعب من إمكانية تكرار الفشل. الورقة البيضاء حياة جديدة من الصفر، أو من السطر، لا فرق بكل ما تحمله البدايات من آمال النجاح الفريد وكوابيس الفشل المتكرر…
أما ما الذي أطمح إليه من وراء الكتابة؟ فالجواب قد يكون صادمًا مرة أخرى، لكنه صادق على الأقل، وهو أنني اليوم أُغلّب الصدق مع الذات في الكتابة، على إكراه نفسي على أن أكون مُثقفًا مُلتزمًا أو ملتزمًا بمعايير الكتابة البحثية أو برأي الناس فيما أقول. تحررتُ منذ مدة من أسطورة المثقف الملتزم بتفكيك قدسيتها، ووجدت أن أكبر التزام يمكن أن أحترمه هو صدقي مع نفسي، مع هواجسي، وطموحاتي وترجمة روحي وأفكاري إلى كلمات. أنا مقتنع تمامًا اليوم بأن الصدق مع الذات والإنصات لوشوشات الأنا من أعمق وأصعب أنواع الالتزام، وترجمة هذه اللغة الأليفة جدًا، والعصية على النقل، من أصعب وأشق المهام. ولأن ترجمة أفكاري إلى لغة تستعصي عليّ أحيانًا، فإن مواضيع وأهداف الكتابة تتنوع عندي. فأنا أكتب أحيانًا مدفوعًا بوهم تغيير العالم على طريقة ماركس، وأكتب أحيانًا وفق المعايير الأكاديمية التي لا تختلف كثيرًا عن تعاليم الكنيسة القروسطية، وأضطر لغايات عملية أيضًا إلى أن أكتب المقال التأملي الجاف، ومع ذلك تخونني لغتي الذاتية دائمًا، فتبرز من بين شقوق نصوصي.
إن أسباب الكتابة، يا صديقي، كأسباب الموت، كثيرةٌ جدًا “من بينها وجع الحياة”، بعضها يكون حاضرًا في الوعي وبعضها لا. منذ بضعة سنوات توقفت عن الكتابة بدافع الحاجة المادية (وهذا سبب توقفي عن الترجمة أيضًا)، لكن هناك أسبابًا أخرى للكتابة، مثل تحقيق الذات، ووهم الخلود، ووهم إعادة تفصيل العالم على مقاسنا. أكتب أحيانًا بنوازع أيديولوجية أو دوغمائية عنيدة أو خفية، وأكتب مرات لخلخة ثوابت العالم التي صارت قيودًا على الفكر والتغيير.. إلخ. ودعني أكون صريحًا معك أيضًا، نحتاج إلى شجاعة اعترافات شخص مثل رولان بارت، حين تحدث عن الأسباب التي تدفعه للكتابة، بأن من بينها الشعور بلذة الكتابة التي لا تقل عن الشعور باللذة الجنسية، وانتزاع الاعتراف وحصد المعجبين والمريدين والمحبين، لكننا نكتب أيضًا لإرضاء من نحبّ، وإن كانوا مجهولين لنا بالكامل، ونكتب أحيانًا نكايةً بمن يحسدنا، ونكتب كذلك ربّما لأن الكتابة هي الشيء الوحيد الذي نجيده.
يرى مختصون أن الأيديولوجيا تصبح عيبًا إذا أُلحقت بالفلسفة. ما رأيك؟
على الرغم من نقدي للأيديولوجيا أعلاه، فإنها جزءٌ لا يتجزأ من الفلسفة، وشرطٌ من شروط الوعي البشري. شيء يشبه وهم الحقيقة وإرادة القوة من أجل التغيير والسيطرة والفعل في العالم. بدون أيديولوجيا لا توجد مشاريع وأحزاب ونظريات سياسية ومعايير اجتماعية ولا دولة ولا مجتمع. الأيديولوجيا هي وهم الحقيقة وصنم الفكرة، ولهذا هي ابنة الفلسفة العاقّة بل هي القاتلة لوالدتها، ما إن تولد منها، وعلى الرغم من كل ذلك، تظل الأيديولوجيا ابنة الفلسفة وسليلتها وتجليها في الواقع وتعينها في التاريخ.
الأيديولوجيا هي إرادة الفلسفة في التشخص والتمأسس وإيجاد معادلاتها الواقعية والتاريخية. ليست الأيديولوجيا أبدًا واقع الفلسفة، إنما هي طريقها إلى التحقق في الواقع. لكن مهما كانت الأفكار الفلسفية نبيلة، فإنها ما إن تتحول إلى أيديولوجيا تنتهي – ولو بعد حين ولو بعد نجاح مهمة الأيديولوجيا في تغيير العالم وتحسين شروطه- إلى نقيضها ونقيض تلك اليوتوبيا الفلسفية التي بشّرت بها. انظرْ إلى حال الدول الاشتراكية التي استلهمت الماركسية، وانظر إلى تاريخ الاستعمار وجرائمه باسم التنوير وتحرير الشعوب من الجهل ودمقرطتها وتمدينها.
في كتاباتك، هل تحرص على تقديم إجابات أم تُشرع باب التساؤلات والبحث والاجتهاد؟
لو احتفظت بتمييزي بين الفلسفة والأيديولوجيا والعلاقة العائلية بينهما؛ لقلت إن الإجابة تفتح الباب على الأيديولوجيا بينما يظل التساؤل شأن الفلسفة الأول. إن أي سؤال يفترض ويستدعي إجابة أو إجابات عدة. لكن من جهة أخرى مهما حاولت الادعاء بأنك بخطابك أو نصك الذي تشرح فيه سؤالك أو إشكاليتك أو فرضيتك تتهرب من الإجابة أو تترك الباب مفتوحًا على أجوبة لا نهائية، وإنك بذلك ولذلك لا تقدم جوابًا نهائيًا ولا حتى جوابًا واحدًا، فإن طرحك وهروبك من الإجابة هو شكلٌ من أشكال الإجابة وتوجيه نحو إجابةٍ ما. بهذا المعنى، العبثية نفسها هي إجابة ما، والعدمية كذلك. هي إجابات نزقة ومتملصة أو جبانة، لكنها تظل إجابات على مشكلة ما. الهرب دائمًا إجابة ومواجهة رأسية للمشكلة بمحاولة إلغائها وحذفها. حينما تغلق عينيك عن مشهد مخيف ما أو ضربة مفاجئة، أنت تواجهها هكذا. ردة الفعل هي إجابة مباشرة. كتبتُ في السابق (دون عمق) عن أن الفلسفة تسير على قدمين نظرية وعملية، وتتوازن بفضلهما، لكن دعني أعترف بأني فيلسوف أعرج لديه ساق أطول من الأخرى. أفضّل التأمل على الأيديولوجيا، والتساؤل على الإجابة، دون أن يعني هذا أني لا أحاول تقديم أجوبة ولا أنتهي إلى نوع من الأيديولوجيا أو أتحرك ضمنها واعيًا أو غير واعٍ، لكني أسعى أكثر لخلخة الثابت وتحطيم الدوغمائيات والقناعات التي تكلست وصارت معوّقات تجاوزها الزمن والمكان.
يقال: “وراء كل كتابة جيدة ثمة مأساة كبرى”، وإن “الإبداع عمومًا يختمر داخل بوتقة المحنة“، هل تؤيد هاتين المقولتين؟ وأيّ المحن التي تعرضت لها كانت دافعًا للإبداع؟
لعل هذا النوع من الكتابات التي تولد كردة فعل على المحنة وكمقاومة لها تظهر أكثر في الأدب والشعر مما هي عليه في الكتابة الفلسفية. لا أنفي أن هناك نصوصًا فلسفية مهمة وأصيلة كتبتها المحن، إذ لا يمكن فهم موقف نيتشه من المرأة دون التأمل في علاقته بسالومي وبأخته إليزابيث، ويمكن لنا وضع يدنا على مواضع الألم عند سورين كيركيجارد، بسبب من إخفاق ارتباطه بريجين أولسن، لكن الفلسفة عمومًا -كما يراد لنا فهمها- هي تأمل موضوعي بارد. شخصيًا أدافع عن نمط من الكتابة الفلسفية الذاتية، وهو أمرٌ يُنظر له باستخفاف واحتقار لدى معظم المشتغلين بالفلسفة خاصة المدرسيين (أصحاب المنهج) منهم. لنتذكر مثلًا أن يوسف كرم في «تاريخ الفلسفة الحديثة» يرفض اعتبار نيتشه فيلسوفًا، ويرى أنه “أديب مطبوع حُشر في زمرة الفلاسفة، لأنه فكّر وكتب في الإنسان ومصيره والأخلاق وقيمها، وفكّر تفكير الأديب وكتب كتابة الأديب”. وإلى الآن يرفض أساتذة الفلسفة الأكاديميون المصابون بعقدة الأستاذ اعتبار سارتر مثلًا فيلسوفًا جادًا، ويعدّونه أديبًا “متعربشًا” ومتطفلًا على الفلسفة، بينما يضيع دريدا بين الفلسفة والأدب، فلا أيديولوجيو الفلسفة يعتبرونه فيلسوفًا لأسلوبه الأدبي وانشغاله بالأدب، ولا أيديولوجيو الأدب يعتبرونه أديبًا لأنه يتفلسف بعمق في تنظيراته الأدبفلسفية. طبعًا يكفي العودة إلى تاريخ الفلسفة لتأكيد حضور هذا التيار الأدبفلسفي، منذ أفلاطون مرورًا بالقديس أوغسطين وابن سينا وابن عربي وروسو، وصولًا إلى سارتر ودريدا، إلخ. إذن كتاباتي من هذا الصنف المغضوب عليه؛ فلا أنا أكتب فلسفة رصينة في نظر الفلسفيين، ولا أدبًا حُرًا في نظر أرباب الأدب. وأعتقد أن لتجربة الحب ومحنة الاغتراب الأبدي والخوف الطفولي الذي لم يفارقني يومًا آثارًا تظهر مواربة في أسلوبي الكتابي حتى الأكثر فلسفية من بينها.
يتحدث نقاد غربيون عما يسمى “أصالة الفكرة”. هل استطاع الكاتب العربي أن ينتج أفكارًا أصيلة به أم أنه لم ينتج إلا مكررًا؟ ومن قبل، كيف تقرأ أصالة الفكرة؟
اسمح لي أن أجيبك بسرعة هنا عن هذا السؤال الذي تكرر في مقابلاتي الأخيرة. باختصار: الأفكار الأصيلة ليست حكرًا على أحد أو عرق أو جهة. حتى في التقليد هناك هامش للإبداع، وفي الترجمة هناك هامش للإبداع والتفوق على مؤلف العمل “الأصلي” المُترجم. هناك إبداع عربي دون أدنى شك، لكنه يشبه تكويننا النفسي، فهو غالبًا كسول، ومتردد في ثقته بنفسه. هناك إبداع عربي وأصالة عربية حتى في إعادة إنتاج أفكار الآخر. لكن كما يحصل دائمًا، على اختلاف الزمان والمكان وعلى اختلاف الحضارات، يظل المبدعون قلّة والكُتّاب كُثُر، حتى المبدع لا يكون كل ما ينتجه إبداعًا، من سقراط وصولًا إلى دريدا، ومن هوميروس إلى محمود درويش. الأصالة الفكرية العربية موجودة واقعيًا، أما لماذا لا نراها؟ فهذا لأننا لا نريد الاعتراف بها. عقدة النقص التي تستحوذ علينا كالشخصية المُستلَبَة تجعلنا نعمى عن رؤية الإبداع العربي، لعقدة الخصاء التي نشعر بها واستلابنا للآخر ووهمنا أن الإبداع لا يأتِ إلا من الغرب المفتوق ونحن، في حال فرض إبداع عربي نفسه علينا، نجتهد في البحث عن مصدره الغربي، مقتنعين بأن المبدع هنا لا بد أن يكون مختلسًا أو مزورًا أو مقلدًا للمبدع الغربي الأبيض الحديث.
أما في ما يتعلق بأصالة الفكرة، فقد اجتهد الفلاسفة والنقاد في محاولة تحديد “الأصيل” مقابل “التقليد”، منذ أفلاطون في محاورة «السفسطائي» أو في الكتاب العاشر من محاورة «الجمهورية» على سبيل المثال، وصولًا إلى دريدا مرورًا بنيتشه وبودلير، بحسب معرفتي الضعيفة في هذا الموضوع. هناك تأكيد مثلًا عند بودلير سيأخذه عنه فوكو ودريدا في تعريف الحديث بوصفه الذي يذكّر بأصالة قديمة تخطر بثياب العصر الجديد. يحيل دريدا الأصالة إلى تجلي الماضي الذي لا أصل له في الحاضر على شكل فكرة أو عمل.
بعيدًا عن هذه التعريفات، ومن دون الابتعاد عن هذا الميل الصوفي إلى تعريف الأصالة؛ أجد أن الأصيل هو قدرة الذات على التجلي عبر الفكرة أو العمل الفني. هنا تتجلى الفكرة وتتشخصن ولو كانت مجرد خطاب أو نص على ورق. هناك شيء من المُطلَق في أي فكرة أصيلة. الأصيل بنظري هو فتح العين فجأة على شيء كان موجودًا دائمًا أمام أعيننا، لكننا لم نكن نراه. اصطدام بحقيقة تفتح بصيرتنا. بهذا المعنى حتى لو كان الأصيل (الذي يحيل إلى أصلٍ ما، أي إلى الماضي) هو استعادة لأصالة ماضٍ مضى وانقضى بإحيائه على نحو جديد قابل للحياة أمدًا ما، فإنه يحمل في طياته قشعريرة الدهشة، وكأنه دائمًا وأبدًا حدثٌ يحدث لأول مرة؛ حتى لو تكرر آلاف المرات في السابق، وحتى لو عايشناه قبلًا فإنه يبدو في كل مرة جديدًا أبدًا. بهذا المعنى؛ ليس الأصيل مرتبطًا فقط بالماضي (الأصالة) ولا بالجديد (الحاضر) فحسب، بل كذلك بمفاجأته بوصفه “حدثًا” مباغتًا، وهذه المباغتة تأتي بالرغم من ترقبنا لها أو ربّما بسبب هذا الترقب والانتظار الذي يشتت الانتباه حين يتكثف. في الأصالة ننتظر قدوم الماضي من المستقبل.
أخيرًا، ما الذي تعكف على كتابته أو ترجمته في الوقت الحالي؟
بالنسبة إلى الترجمة، أعتقد أنها كانت محطة قصيرة عابرة، أما بالنسبة إلى الكتابة، فأنا أستعدّ لبداية فصل جديد من حياتي ككاتب وفيلسوف. ولهذا أجدني أعمل اليوم بجهد، لأنهي المرحلة الأولى بنشر ما تمثّله من نصوص أكاديمية، كنتُ قد أنجزتها منذ مدة ولم يتسنَ لي نشرها بعدُ، لأبدأ بعدها مرحلة جديدة في الكتابة. إذن، سأغلق ولو جزئيًا بابَ الكتابة الأكاديمية أو المدرسيّة بالمعنى الأصح، لأبدأ بعدها ما أعكف عليه بهدوء، وهو صوغ مفرداتي ومفاهيمي وأفكاري التي لن تُشكل أبدًا نظرية أو نسقًا أو منهجًا، بل فلسفة ذاتية تطمح إلى أن تقدم تصورات جديدة للعديد من الإشكالات والتساؤلات، وتفكر بشكلٍ مختلف لفتح الباب على أسئلة جديدة وأجوبة لا مفرّ منها، مهما هربنا من محاولة تقديمها. على المدى القريب والمتوسط أيضًا، أعمل على جمع الحوارات حول الفلسفة والسياسة التي أُجريت معي في السنوات الأخيرة في كتاب، وأعتزم استكمال مشروع كتاب نشرتُ منه مجموعة نصوص متفرقة، بعنوان «في تفكيك بعض مصطلحات السياسة». أما العناوين الواضحة لما سيأتي بعدها، فأفضل أن أبقيه طيّ الكتمان حتى يكتمل، إن اكتمل.
* صحافي سوري – فلسطيني
المصدر: حرمون

التعليقات مغلقة.