
شمس الدين الكيلاني *
في موازاة الصراع السياسي – العسكري الدامي والمرير على أرض فلسطين ومن أجلها، خلال أكثر من مئة عام، ما بين الشعب الفلسطيني ومعه العرب، ومنظمة الغزو الكولونيالية الصهيونيّة وخلفها بريطانيا العظمى والغرب الاستعماري، كان ثمّة صراع آخر يحدث بين روايتين في قراءة تاريخ هذا الصراع السياسي؛ الرواية الصهيونية التي حولت الظالم إلى مظلوم، والرواية العربيّة التي حاولت بصعوبة، الحفاظ على ذاكرة ومظلومية فلسطين، ووقفت شاهدة وشهيدة على تاريخ المذبحة الفلسطينية التي ارتُكبت في عز نهار القرن العشرين، بتواطؤ من الدول العظمى وتخاذل محلي لا يُنكر.
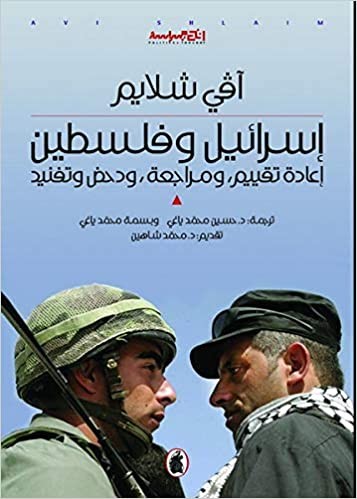 وقد حاول عدد من المثقفين الإسرائيليين إظهار حقيقة هذا التاريخ، في ثمانينات القرن الماضي، فكان من أبرزهم آفي شلايم، مؤلف كتاب “إسرائيل وفلسطين”، والذي ينتمي إلى مجموعة من المؤرخين يطلق عليهم اسم “المؤرخين الجدد”، ولم يقتصر اهتمامه بهذا التاريخ على هذا الكتاب فحسب، بل قدّم العديد من الكتب والدراسات، فساهم مع مثقفين عرب وإسرائيليين في الكتاب الجماعي “حرب فلسطين: إعادة كتابة تاريخ 1948″، و”الحرب والسلام في الشرق الأوسط”، والكتاب الآخر والمهم الذي تُرجم مؤخرًا للعربية، وعنوانه “الجدار الحديدي، إسرائيل والعالم العربي”، والذي عبَّر عنوانه عن موضوعه وفكرته، حيث أراد فيه شلايم التأكيد على أن سياسة العزل والتهجير والأبواب المغلقة، هي نهج أصيل في السياسة الصهيونية منذ مؤسسها هرتسل، فالممارسات الصهيونية التي تحولت إلى سياسة رسمية لإسرائيل، اعتمدت على الإقصاء والتجاهل لأصحاب الأرض الأصليين، فهي لم تر سكانًا وبشرًا في فلسطين، وهو ما تجلى في شعارها الشهير “أرض بلا شعب”، وهذا ما نتج عنه، كما يذهب شلايم إلى عدم الاكتراث بالفظائع التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين ونسيانها في الوقت نفسه، حيث كان هرتسل قد أغدق في الوعود لكل الزعماء الذين قابلهم، وكأنّ فلسطين ملك أبيه، في تجاهل يثير الحنق لشعب فلسطين.
وقد حاول عدد من المثقفين الإسرائيليين إظهار حقيقة هذا التاريخ، في ثمانينات القرن الماضي، فكان من أبرزهم آفي شلايم، مؤلف كتاب “إسرائيل وفلسطين”، والذي ينتمي إلى مجموعة من المؤرخين يطلق عليهم اسم “المؤرخين الجدد”، ولم يقتصر اهتمامه بهذا التاريخ على هذا الكتاب فحسب، بل قدّم العديد من الكتب والدراسات، فساهم مع مثقفين عرب وإسرائيليين في الكتاب الجماعي “حرب فلسطين: إعادة كتابة تاريخ 1948″، و”الحرب والسلام في الشرق الأوسط”، والكتاب الآخر والمهم الذي تُرجم مؤخرًا للعربية، وعنوانه “الجدار الحديدي، إسرائيل والعالم العربي”، والذي عبَّر عنوانه عن موضوعه وفكرته، حيث أراد فيه شلايم التأكيد على أن سياسة العزل والتهجير والأبواب المغلقة، هي نهج أصيل في السياسة الصهيونية منذ مؤسسها هرتسل، فالممارسات الصهيونية التي تحولت إلى سياسة رسمية لإسرائيل، اعتمدت على الإقصاء والتجاهل لأصحاب الأرض الأصليين، فهي لم تر سكانًا وبشرًا في فلسطين، وهو ما تجلى في شعارها الشهير “أرض بلا شعب”، وهذا ما نتج عنه، كما يذهب شلايم إلى عدم الاكتراث بالفظائع التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين ونسيانها في الوقت نفسه، حيث كان هرتسل قد أغدق في الوعود لكل الزعماء الذين قابلهم، وكأنّ فلسطين ملك أبيه، في تجاهل يثير الحنق لشعب فلسطين.
 ولا ينسى شلايم سلسلة التحايلات والأكاذيب التي مارستها الصهيونيّة على القريب والبعيد؛ ليصل إلى تقرير أن الصهيونية منذ ولادتها، حافظت على مبدأين في سلوكها: إنكار وجود شعب فلسطين، وبحثها المحموم عن دولة عظمى تستند عليها. ووصف كتابه هذا قائلًا: “في هذا الكتاب، ازعم أنّ تاريخ دولة إسرائيل، هو عبارة عن تبرير لإستراتيجيّة الحائط الحديدي”[1] .
ولا ينسى شلايم سلسلة التحايلات والأكاذيب التي مارستها الصهيونيّة على القريب والبعيد؛ ليصل إلى تقرير أن الصهيونية منذ ولادتها، حافظت على مبدأين في سلوكها: إنكار وجود شعب فلسطين، وبحثها المحموم عن دولة عظمى تستند عليها. ووصف كتابه هذا قائلًا: “في هذا الكتاب، ازعم أنّ تاريخ دولة إسرائيل، هو عبارة عن تبرير لإستراتيجيّة الحائط الحديدي”[1] .
حاول شلايم في كتابه “إسرائيل وفلسطين: إعادة تقييم”، تكوين صورة حقيقية لديناميكيات تاريخ هذا الصراع المأساوية، كما بحث بجدية في إمكانيات حله، إذ يقول: إنني أنتمي إلى جماعة صغيرة من الباحثين الذين يُطلق عليهم في بعض الأحيان “المؤرخون الإسرائيليون التصحيحيون” وأحيانًا أخرى “المؤرخون الجدد”[2].
حاول شلايم في جميع أعماله، تقديم رؤية جديدة للصراع بين العرب وإسرائيل في الفترة الواقعة بين عام 1948 وحتى حرب إسرائيل على غزة عام 2008، باستثناء الفصل الخاص بوعد بلفور عام 1917. وقد قسَّم كتابه إلى ثلاثة محاور، وهي إقامة دولة إسرائيل في مايو1948، وحرب الأيام الستة في يونيو 1967 وتمخضاتها النهائية في اتفاقية أوسلو في 23 سبتمبر 1993، ثم عرض في فصوله الأخيرة وجهات النظر الاستشرافية المُثارة حول مستقبل الصراع الإسرائيلي العربي، وقد أثارت كل محطة من هذه المحطات الثلاث جدلًا واسعًا.
- حرب 1948… “ثمن نشوء إسرائيل”:
 يعتبر المؤلف، الصراع العربي – الإسرائيلي، من حيث نشأته وجوهره، صراعًا بين حركتين قوميتين: الحركة القومية الفلسطينية والحركة القومية اليهودية أو الصهيونية، كان هناك شعبان ومجتمعان عرقيان مختلفان، وأرض واحدة، ومن هنا جاء الصراع[3]. وحاولت كلّ من الروايتين المتعارضتين الحديث حول الصراع في ما بينهما على فلسطين، إذ دارت الرواية الصهيونية حول حق اليهود في إنشاء دولة يهودية مستقلة على ’أرض أجدادهم’ في فلسطين، والعيش هناك في سلام ووئام مع جيرانهم. لذا… فإن رفض العرب حق اليهود في الوجود المستقل في فلسطين هو السبب الأساسي للصراع. فالصراع لا يتعلق بالأرض، بل بحق اليهود الخاص في وجودهم ككيان له سيادة على أرض إسرائيل. في حين يرى شلايم، أن الحركة الصهيونية ليست حركة تحرير قومية لليهود، ولكنها نقطة ارتكاز للاستعمار الغربي، فهي حركة عدوانية توسّعية تقوم على طرد السكان الأصليين من أرضهم. ووفقًا لهذه الرؤية، فإن فلسطين هي إرث للفلسطينيين، وأن طرد وتشتيت السكان الأصليين بواسطة دولة إسرائيل هو السبب الأساسي للصراع. كما يرى أنه من المحتم، كما هو الحال مع كل الروايات القومية للتاريخ، أن تكون كلتا الروايتين مشوهة وانتقائية ومبررة للذات، ولكن يكمن الفرق في أن الصهاينة، كانوا أكثر فعالية من خصومهم في تحقق النجاح للجانب الخاص بهم في القصة، “فكانت الصهيونية إحدى أعظم قصص نجاح العلاقات العامة في القرن العشرين، أما القومية الفلسطينية، فكانت واحدة من أكبر قصص الفشل… كان لدى الفلسطينيين قضية قوية ولكن كان لديهم محامون فاشلون”[4].
يعتبر المؤلف، الصراع العربي – الإسرائيلي، من حيث نشأته وجوهره، صراعًا بين حركتين قوميتين: الحركة القومية الفلسطينية والحركة القومية اليهودية أو الصهيونية، كان هناك شعبان ومجتمعان عرقيان مختلفان، وأرض واحدة، ومن هنا جاء الصراع[3]. وحاولت كلّ من الروايتين المتعارضتين الحديث حول الصراع في ما بينهما على فلسطين، إذ دارت الرواية الصهيونية حول حق اليهود في إنشاء دولة يهودية مستقلة على ’أرض أجدادهم’ في فلسطين، والعيش هناك في سلام ووئام مع جيرانهم. لذا… فإن رفض العرب حق اليهود في الوجود المستقل في فلسطين هو السبب الأساسي للصراع. فالصراع لا يتعلق بالأرض، بل بحق اليهود الخاص في وجودهم ككيان له سيادة على أرض إسرائيل. في حين يرى شلايم، أن الحركة الصهيونية ليست حركة تحرير قومية لليهود، ولكنها نقطة ارتكاز للاستعمار الغربي، فهي حركة عدوانية توسّعية تقوم على طرد السكان الأصليين من أرضهم. ووفقًا لهذه الرؤية، فإن فلسطين هي إرث للفلسطينيين، وأن طرد وتشتيت السكان الأصليين بواسطة دولة إسرائيل هو السبب الأساسي للصراع. كما يرى أنه من المحتم، كما هو الحال مع كل الروايات القومية للتاريخ، أن تكون كلتا الروايتين مشوهة وانتقائية ومبررة للذات، ولكن يكمن الفرق في أن الصهاينة، كانوا أكثر فعالية من خصومهم في تحقق النجاح للجانب الخاص بهم في القصة، “فكانت الصهيونية إحدى أعظم قصص نجاح العلاقات العامة في القرن العشرين، أما القومية الفلسطينية، فكانت واحدة من أكبر قصص الفشل… كان لدى الفلسطينيين قضية قوية ولكن كان لديهم محامون فاشلون”[4].
ويرى المؤرخ الفلسطيني، نور مصالحة، أن هذا الخروج الجماعي لم يكن نتيجة عشوائية للحرب، ولكنه كان أمرًا محتمًا من أجل ميلاد إسرائيل، وقد عبر حاييم وايزمان، رئيس إسرائيل آنذاك، عن سعادته الغامرة برحيل العرب باعتباره “تطهيرًا رائعًا للأرض وتيسيرًا معجزًا لمهمة إسرائيل”. ويرى مصالحة أن الأمر ليس به معجزات ولا يحزنون، ولكنه مجرد نتيجة طبيعية لما يزيد عن نصف قرن من الجهد المتواصل والقوة الغاشمة[5]. وقد تعامل الطرفان مع الحرب بطريقين مختلفين وتصوّرات متباينة؛ “الإسرائيليون أطلقوا عليها: حرب الاستقلال، بينما العرب نعتوها بالنكبة”[6].
سلط شلايم الضوء على المفارقة بين ادّعاء الصهيونية القائل إنّ “فلسطين أرض بلا شعب”، وبين واقع أن الفلسطينيين هم سكان فلسطين منذ مئات السنين، هذه المفارقة تقف وراء هذا الصراع المديد، “فلو كان هذا الشعار صحيحًا لما كان هناك صراع، ولكن لسوء الحظ، كان هناك مجتمع عربي يعيش على هذه الأرض منذ قرون، وأدى رفضه للمهاجرين اليهود القادمين من أوروبا، إلى تفجّر الصراع الذي بلغ ذروته عام 1948 من خلال إنشاء دولة إسرائيل وتشريد وتشتيت 830 ألف فلسطيني”[7]. فقدم العرب والصهاينة الرواية الخاصة بكلّ منهما حول أسباب نزوح الفلسطينيين، حيث ادّعت الرواية الإسرائيلية الرسمية أنهم خرجوا بمحض إرادتهم، وظلت هذه الرواية سائدة لدى الطرف الإسرائيلي تُخفي الحقيقة حتى مجيء ما يُعرف بالمؤرخين الإسرائيليين الجدد، فكان أوسع هجوم على الرواية الرسمية عام 1988 من خلال كتاب سمحة فلابان “مولد إسرائيل، حقائق وأساطير”، كما شهدت تلك السنة أيضًا، صدور كتاب بيني مورس “مولد مشكلة اللاجئين 1947-1959″، والذي يصف فرار الفلسطينيين على هيئة موجات متلاحقة، تحت ضغط “الحرب النفسية والتهديد والطرد القسري، ولكنه لم يكشف عن أي دليل على وجود خطة يهودية شاملة تم فرضها من أعلى”[8]، فيما يؤكد نور مصالحة، أن النزوح الجماعي كانت وراءه خطة محكمة، كما ذهب اليهودي الليبرالي الروسي آشر غنسبرج إلى نقد السلوك العدواني والعنصرية السياسية للمستوطنين، الذين كانوا “يتعاملون مع العرب بعدوانية ووحشية، وانتهكوا حرمة حدودهم ويعتدون عليهم بلا سبب ويتفاخرون بذلك”[9]. ويكشف شلايم الجذور البعيدة لنزعة الاستبعاد والعنف، فيشير إلى أن وايزمان، وهو من المعتدلين من الصهاينة، طالب منذ عام 1919، “بأن تكون فلسطين يهودية مثلما هي إنكلترا إنجليزية”[10]، وفيما بعد، وعلى خلفية الاضطرابات الجارية في فلسطين، اقترح على استحياء، فكرة ترحيل العرب في مناقشات مع المسؤولين البريطانيين.
وقد كان ديفيد بن غوريون، رئيس الوكالة اليهودية، “أحد المعتنقين الأوائل لفكرة الترحيل ’الترانسفير’، باعتبارها أفضل وسيلة للتعامل مع الأقلية العربية”[11]. وينوّه شلايم إلى أبحاث إيلان بابيه التي انتهت بالتوافق مع نتاج أبحاث وليد الخالدي، والتي خلصت إلى أنّ النزوح الفلسطيني وراءه خطة مدبرة “ترمي إلى طرد أكثر عدد من الفلسطينيين”[12]. ويؤكد أنه في لوزان، في نيسان/ أبريل 1949، وبواسطة لجنة المصالحة الفلسطينية، “كان العرب مستعدين للتفاوض على أساس قرار الأمم المتحدة للتقسيم، فيما أصر الإسرائيليون على أن تقوم المفاوضات على الوضع الراهن”[13].
وأدّت هزيمة الجيوش العربية، في المرحلة الثانية للحرب – حسب المؤلف – على يد دولة إسرائيل الوليدة، إلى تقرير مصير فلسطين العربية، ونتيجة للحرب، فقد استولت إسرائيل على المزيد من الأراضي والتخوم أكثر بكثير مما أعطاها راسمو خرائط الأمم المتحدة، وتمّ محو اسم فلسطين من على الخريطة، وتحوّل ما يزيد عن سبعمائة ألف فلسطيني إلى لاجئين، كما بدأ المجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة، بالتعامل مع المشكلة الفلسطينية ليس باعتبارها مشكلة سياسية تحتاج إلى حل سياسي، ولكن كمشكلة لاجئين يطالبون بالعودة والتعويض”[14]،موجهًا اللوم للفلسطينيين لأنهم رفضوا قرار التقسيم، بينما أثنى على الصهاينة من الناحية السياسية، لأنهم قبلوا بالقرار واستثمروه، حيث أدى قبول الصهاينة لقرار التقسيم عام 1947، إلى وضعهم في إطار الشرعية الدولية، كما وفّر ميثاقًا لشرعية الدولة اليهودية، والذي ساعدهم في الحصول على دولة عام 1948، تمامًا كما أدت عدم المرونة الدبلوماسية للفلسطينيين، إلى وقوع أكبر كارثة على رؤوسهم عبر تاريخهم[15]. متناسيا الفرق بين مساومة صاحب المنزل عن مساومة سارق المنزل.
وقد رأى الكاتب أن غولدا مئير وبسبب مخاوفها التي تغذيّها المذابح والصدمة اليهودية الجماعية بفعل الهولوكست، كانت تنظر إلى العالم باعتباره أبيض أو أسود لا… مكان فيه للرمادي، وكان موقفها بسيطًا للغاية: إما نحن وإما هم، ورفضت تمامًا قبول المنطق الذي يقول بأن العرب يدفعهم الإحساس بالظلم وأنهم يشعرون بالمهانة، أو أن لديهم رواية مختلفة بشأن الصراع في فلسطين، فقد كانت تشعر بالاستياء حينما كان يشير إليها بن غوريون من وراء ظهرها، باسم الرجل الوحيد في مجلس الوزراء[16]. ولا يخفي شلايم رغبة الدول العربية في فتح مباحثات سلام مع إسرائيل على أن تكون سرية، ويبدو أن حسني الزعيم، ما كان ليترددّ في إجراء لقاءات علنية مع بن غوريون[17].
- هزيمة حزيران/ يونيو 1967:
يعتقد المؤلف أن حرب حزيران/ يونيو 1967، كانت “نقطة تحول كبرى في تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي، فأطلقت موجة أخرى من اللاجئين الفلسطينيين، الذين أصبح بعضهم لاجئين للمرة الثانية، ولكنها، وفي الوقت نفسه، قدمت دفعة قوية لمنظمة التحرير الفلسطينية في كفاحها ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومع انقشاع غبار الحرب، كانت إسرائيل قد استولت على شبه جزيرة سيناء من مصر، ومرتفعات الجولان من سورية والضفة الغربية من الأردن، وأصبح لدى الدول العربية من الآن فصاعدًا علاقة مباشرة في الصراع مع إسرائيل”[18].
كان وقع الهزيمة زلزاليًا على الشعوب والنخب العربية، إذ يعطي مثالًا على ذلك، خليل حاوي الذي كان غارقًا في حلم الوحدة العربية، إلى درجة لم يحتمل وقع مأساة عار الهزيمة فتجندل منتحرًا؛ فيعلق شلايم قائلًا “ولم يكن الموقف الفردي أو الجماعي، بعيدًا عن أفكاره بأي حال من الأحوال، وأدى فشل الكلمة المكتوبة إلى إقناع خليل حاوي، بأن معركة جيله من العرب قد انتهت بالهزيمة”[19].
وصار لأصحاب الطموح التوسعي وضم الأراضي، اليد العليا في السياسة الإسرائلية، وهذا ما أثار نقاشًا دوليًّا حول الأغراض التوسعية الإسرائيلية [20]. وكانت رئيسة الحكومة لاحقًا غولدا مئير، عبارة عن “تجميع بين الجهل والغرور بالقدر نفسه”، وكانت أشهر العبارات التي قالتها عام 1969، أنه لا وجود للشعب الفلسطيني، وقد رد البروفيسور يشعياهو ليبوفيتش عليها قائلًا إن هذه العجوز الشمطاء القبيحة ليست هي من تقرر ما إذا كان هناك شعب فلسطيني أم لا.
أما أحد أسوأ الأمثلة الدالة على تخريف مئير، فهو زعمها أن “الإسرائيليين قد يغفرون للعرب يومًا ما، قتلهم أبناء إسرائيل، ولكنهم لن يغفروا لهم أبدًا إجبار الإسرائيليين على قتل أبناء العرب”[21] ؛ فالحقيقة أن العرب قد اعترفوا بإسرائيل، حينما وقّعوا اتفاقيات الهدنة تحت مظلة الأمم المتحدة في جزيرة رودوس عام 1949، كما جرى عقد عدد لا حصر له من الاجتماعيات – بعضها سري وبعضها علني – بينهم وبين إسرائيل منذ ذلك التاريخ، ولكن إسرائيل واصلت الادعاء بأن العرب لم يعترفوا بها، والإصرار على إجراء مفاوضات مباشرة، ويبدو أن بعض الأشخاص لا شيء يرضيهم.[22]
واعتقد شلايم أن بناء المستوطنات على الأرض العربية عقب حرب 1967، “أدى بشكل محتّم إلى تفاقم الصراع وازدياد حدته، مما نقله من مستوى ما بين الدول إلى المستوى الداخلي بين المجتمعين، وكان ذلك يعني مصادرة الأراضي العربية بشكل عام، وأصبح الصراع الذي كان ينحصر بين جيش إسرائيل ومنظمات حرب العصابات [أي منظمات المقاومة الفلسطينية التي برزت بعد هزيمة 1967 – الكيلاني]، أصبح يضم المدنيين من الجانبين، وتحوّل جيش الدفاع الإسرائيلي من جيش نظامي من الدرجة الأولى إلى جيش احتلال وأداة قمع استعمارية، وأصبحت إسرائيل نفسها آخر قوة استعمارية على وجه الأرض”[23].
- حرب 1973 والطريق إلى أوسلو وخيارات المستقبل:
كان الخيار الرئيسي لليمين الإسرائيلي لحل مشكلة الكثافة الديمغرافية للعرب الفلسطينيين، هو اتباع سياسة الإقصاء – الترانسفير،”فكان هناك عدد من السياسيين داخل الليكود، مثل آرييل شارون، وكذلك في الأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى ممن يفضلون الطرد الواسع النطاق للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية، باعتبارها فرصة سانحة جاءت إليهم على طبق من ذهب”[24]، وقد رفض الليكود منظمة التحرير الفلسطينية رفضًا دائمًا مطلقًا، وبالقدر نفسه، رفض أيضًا أي حق فلسطيني في تقرير المصير على أي جزء من التراب الفلسطيني، وأصبح الرفض الإسرائيلي يتلخص فيما أطلق عليه الملك حسين لاءات الليكود الأربعة ألا وهي: لا تبادل للأرض مقابل السلام، ولا تفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية، ولا دولة فلسطينية مستقلة، ولا مؤتمرًا دوليًّا لمناقشة المشكلة العربية – الإسرائيلية”[25]. ويضيف أنه “كان شارون يزدري التسوية الدبلوماسية ويمارس ضغوطه من أجل مصادرة المزيد من الأراضي العربية، لبناء المزيد من المستوطنات اليهودية على الأراضي المحتلة وتوسيع المستوطنات القائمة، التي كانت بالنسبة له مظهرًا من مظاهر التوسع الإقليمي، ووسيلة لمنع قيام الدولة الفلسطينية”[26]. فكان هو الصورة العنيفة المعبرة عن اليمين الإسرائيلي، فهو “رجل الحرب القح، وكان ينظر إلى الفلسطينيين ليس باعتبارهم شريكًا على طريق السلام، بل باعتبارهم عدوًا لدودًا لإسرائيل، وتعود جذور تفكيره بشأن الفلسطينيين إلى زئيف جابوتنسكي، الأب الروحي لليمين الإسرائيلي”[27]. أمّا حزب العمل، ” فيقبل مبدأ التقسيم – مقولة الأرض مقابل السلام – كأساس للتسوية، ولكنه كان يفضل عادة الأردن على الفلسطينيين كشريك”[28].
لهذا قامت انتفاضة الشعب الفلسطيني عام 1987 والتي “كان هدفها الأسمى هو الحصول على حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل… لقد كانت حرب استقلال فلسطينية، وكانت إحدى سمات الانتفاضة على نحو غير مسبوق في التاريخ الفلسطيني، أنها أول نموذج حي للعمل الشعبي يشمل كل طبقات وجماعات المجتمع بلا استثناء”، أما كيف كان الموقف الإسرائيلي إزائها، فيقول شلايم “بدأ بعض قادة إسرائيل في الاعتراف بأن القوة العسكرية لها حدود لا تستطيع تجاوزها، وأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لما هو في الاٍساس مشكلة سياسية… إن الجيش يمكنه أن يهزم جيشًا، ولكنه لا يستطيع أن يهزم شعبًا”[29].
ويلفت شلايم النظر إلى أن الزعماء الفلسطينيين المحليين، أدركوا بأنّه “يجب أن تكون هناك مبادرة سلام فلسطينية، فقد كانوا يخشون أن تنتهي الانتفاضة دون تحقيق أية نتائج سياسية، فبدأوا بممارسة الضغوط على منظمة التحرير في تونس”، في وقت كان التيار الرئيسي في المنظمة يميل نحو الاعتدال، فقام ياسر عرفات بزمام المبادرة، فانعقد مؤتمر المنظمة في الجزائر في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1988، “ونجح عرفات في الحصول على الأغلبية لإصدار القرار التاريخي الذي ينص على الاعتراف بشرعية إسرائيل وقبول قرارات الأمم المتحدة الصادرة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، وتبنى مبدأ الدولتين، أما المطالبة بكل فلسطين، المدون في الميثاق الوطني الفلسطيني، فقد نُحيت جانبًا، وصدر إعلان الاستقلال عبر إنشاء دولة صغيرة في الضفة الغربية وغزة، تكون عاصمتها القدس الشرقية”[30].
كان قد أصبح مناحيم بيغن رئيسًا للحكومة، وكان برنامجه الانتخابي لحزب الليكود عام 1977، يتضمن “حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل هو حق خالد… ولا يجوز التخلي عن يهودا والسامرة لحكم أجنبي، وما بين البحر ونهر الأردن يجب أن يخضع للسيادة اليهودية”[31]. تخلَّى بيغن عن سيناء لأنه كان يعتبرها خارج أرض إسرائيل، وكان “يؤمن بقوة بأن الحق التاريخي لليهود في أرض إسرائيل يُبطل المزاعم الأخرى”[32]، وقد خلفه إسحاق شامير بعد استقالته عام 1983 إثر حرب لبنان، وأثناء مؤتمر مدريد لم يقبل الليكود الاجتماع بمنظمة التحرير الفلسطينية، إلّا ضمن وفد الأردن، وتحت ضغط أميركي واضح، وذلك بعد حرب الخليج الثانية لإخراج الجيش العراقي الغازي من الكويت، “فإن مبادرة سلام منظمة التحرير الفلسطينية والحوار مع الحكومة الأميركية الذي مهد الطريق لها، قد أظهرا إسرائيل على نحو أوضح من قبل، بمظهر الطرف المتسلط والمعتدي على الدبلوماسية المعتدلة لمنظمة التحرير الفلسطينية[33].
وقد تميز مؤتمر مدريد – حسب شلايم – عن المؤتمرات العربية – الإسرائيلية السابقة، بأن الفلسطينيين قد جرى تمثيلهم للمرة الأولى على قدم المساواة مع إسرائيل، وكان ذلك في حد ذاته يمثل مكسبًا عظيمًا يتمثل في الحصول على الاعتراف الدولي، وكان على الفلسطينيين أن يدفعوا ثمنًا باهظًا، فلم يتم رفع العلم الفلسطيني أو ارتداء الكوفية[34]، وقد ألقى الخطاب رئيس الوفد الفلسطيني، الدكتور حيدر عبد الشافي، الذي قال إنه “نود مخاطبة الشعب الإسرائيلي، الذي عانينا وإياه دهرًا من الألم، نحن على استعداد لأن نعيش جنبًا الى جنب، نقتسم الأرض والوعد بالمستقبل، غير أن التقاسم يستدعي أن يكون الشريكان على استعداد للاقتسام كأنداد. لقد رأيناكم تستعيدون بأسى عميق، مأساة ماضيكم، فننظر ’الآن’ برعب إلى التشويه الذي صير الضحية جلادًا، ليس من أجل هذا ترعرعت آمالكم وأحلامكم وأولادكم”. فيعلق شلايم على خطاب الدكتور عبد الشافي في مدريد، بأنّه “أفضل تعبير ممكن عن القضية الفلسطينية من حيث البلاغة والاعتدال، يلقيها متحدث رسمي فلسطيني منذ اندلاع الصراع في نهاية القرن التاسع عشر… وكان هناك إحساس واضح بأن ثمّة تاريخ يُصنع، بينما كان يقرأ الدكتور القادم من غزة بفصاحة بيانه، وسوف ينظر مؤرخو المستقبل إلى يوم الحادي والثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر 1991، باعتباره علامة فارقة على طريق السعي نحو التوفيق بين المطالب الوطنية الفلسطينية والإسرائيلية”[35]. ولاحظ شلايم، أن نصف أعضاء الوفد الفلسطيني كانوا أطباء وأساتذة جامعات، بينما ترأس الوفد الإسرائيلي شامير المتهم بالإرهاب وقتل الوسيط الدولي فولك برنادوت في القدس في عام 1948[36].
ومع تولي حكومة حزب العمل للسلطة برئاسة يتسحاق رابين في حزيران/ يونيو 1992، عاد فريق السلام الأميركي للعمل، وقد “مال الزعيمان بيل كلنتون ورابين إلى تفضيل إستراتيجية “سورية أولًا”، إيمانًا منهما بأن عقد اتفاق مع سورية يمكن أن يغير المشهد الاستراتيجي للمنطقة، بحيث يستحيل عقد اتفاق مع الفلسطينيين. وكان رابين مستعدًا للتفكير في الانسحاب الكامل من مرتفعات الجولان مقابل السلام والأمن الكاملين، وعُرف هذا العرض باسم “الجيب”، حيث أنه وضع في جيب وزير الخارجية الأميركية وارن كريستوفر، الذي قام بزيارات مكوكية بين تل أبيب ودمشق جعلت الجانبين على شفا إبرام اتفاقية السلام، لكن البنود النهائية التي عرضها الأسد كانت بعيدة عن توقعات رابين، مما دفعه إلى تصعيد المحادثات السرية مع السلطة الفلسطينية، والتي أثمرت عن اتفاقية أوسلو، وكانت الصفقة تنطوي على إقامة دولة مقابل تحقيق الأمن، وكان ذلك يمثل تحولًا تاريخيًا، بحسب شلايم[37].
وفي عام 1993، جرى التوقيع على اتفاقية أوسلو، وبمناسبة الاحتفال بتوقيع الاتفاقية بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، أعلن رابين “أقول لكم أيها الفلسطينيون، لقد كُتب علينا أن نعيش معًا على البقعة ذاتها من الأرض، في البلد ذاتها”، ويعلق شلايم قائلًا إنه “كان من المستحيل أن ينطق شامير بهذه الكلمات”[38].
ينظر شلايم إلى حل الدولتين الذي قبل به رابين بأمل، كما اعتبر أوسلو المحطة الأولى لتصحيح الأخطاء التاريخية بين الشعبين، “فمن خلال الاعتراف الرسمي بالشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد، يكون قد خطا الخطوة الأولى نحو تصحيح خطأ مأساوي يحمُل حزبُه حزب العمل وزره منذ انتصار 1967. ومن خلال البدء بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، لم يكن رابين يقود إسرائيل نحو الانتحار كما زعم بعض مناوئيه في جناح اليمين، وإنما أرسى بذلك أساسًا آمنًا للتعايش السلمي بين إسرائيل والفلسطينيين”[39]. فيرى أن اليمين كان عقبة كأداء، “فقد واجهت محاولة رابين للقيام بانسحاب محدود وتدريجي وتحت السيطرة في الضفة الغربية، استهجانًا هستيريًّا من قب اليمين الإسرائيلي، وعندما تم اغتيال رابين في تشرين الثاني/ نوفمبر 1995، على يد متطرف”[40]، كانت هذه إشارة إلى عمق الانقسام الإسرائيلي، فيعود شلايم إلى ميرون بنفينستي، مؤلف كتاب “أعداء حميميون: اليهود والعرب في أرض مشتركة”، ليستعير منه تشبيهه للعلاقة العربية اليهودية بـ”صراع بين تجمعين بشريين يكافحان من أجل الحصول على الموارد الطبيعية والبشرية، ويتنافسان من أجل احتكار السيطرة على الأصول الرمزية… هو صراع سياسي قومي وعرقي على السيادة، وهو نموذج لمجتمعين منقسمين يستمد طاقته من التوزيع غير العادل للموارد، وهي حرب ليست لها نهاية، إنّهما يرقصان معًا رقصة الموت”[41]. ويعتقد “أن السلطات الإسرائيلية لا تستطيع التمييز بين “سيادة القانون” كمفهوم يجسِّد المبادئ الليبرالية والديمقراطية الدولية للحكم، والحكم عن طريق “استغلال القانون”، والذي يمثل نظامًا أحاديًا وقمعيًا يُستخدم بواسطة طائفة ما لفرض مشيئتها على الأخرى”[42].
لم تستمر عملية أوسلو طويلًا من بعده، فقد “كان هناك شيء ما غير أمين في الموقف الإسرائيلي، كانت أقوال إسرائيل تتحدث عن السلام، ولكن أعمالها كانت تكشف عن نواياها الخفية، ألا وهي التوسع على حساب الأراضي الفلسطينية… وفي ظل هذا الظروف، كان الانفجار مسألة وقت، وقد حدث في 28 أيلول/ سبتمبر 2000، حينما قام شارون بزيارته الاستفزازية المتعمدة إلى الأمكن المقدسة في القدس”[43]، فانفجرت “الانتفاضة الثانية”، فيعلق المؤلف إنه “ربما يكون قد جرى استفزاز الفلسطينيين على نحو يفوق قدرتهم على الاحتمال بسبب الوحشية الإسرائيلية، ومع ذلك، فإن اللجوء إلى استخدام الأسلحة النارية كان خطأ قاتلًا. فالعامل الجوهري الذي يكمن وراء نجاح الانتفاضة الأولى هو أنها ذات طبيعة غير عنيفة”[44]. ولا ينسى تحميل الولايات المتحدة جزءًا من المسؤولية، فقد “كان التأكيد الأميركي على أمن إسرائيل على حساب حقوق الفلسطينيين، أحد أسباب فشل عملية السلام”[45]، كما يرى “أن الولايات المتحدة وحدها القادرة على كسر جمود السياسة الإسرائيلية، وإذا لم يحدث ذلك، فلا يمكن لأحد آخر أن يفعله”[46].
وقد نظر شلايم إلى أوسلو بإيجابية، ونافذة أمل للحل، وحمَّل السلطات الإسرائيلية مسؤولية الفشل، مخالفًا بذلك بيني موريس، الذي ارتدّ عن مواقفه القديمة حول مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وعبر شلايم عن ذلك بقوله، “أنا مثل بيني، كنت متفائلاً على نحو حذر بعد توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر عام 1993، ولكن تفسيرنا للأحداث التاريخية اللاحقة كان مختلفًا للغاية. فيرى بيني أن السبب الرئيسي وراء انهيار هذه التسوية التاريخية هو الأكاذيب الفلسطينية، أما بالنسبة لي، فأرى أن السبب يرجع إلى سياسية التوسع التي تتبعها إسرائيل. وقد ثبت مدى تهافت اعتراضات إسرائيل على النوايا السلميّة للفلسطينيين، من خلال السياسة التي تنتهجها عبر مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات اليهودية على تلك الأراضي. ومن خلال مواصلتها بناء المستوطنات، تراجعت إسرائيل من جانبها، على نحو جوهري، عن الاتفاقية التي تم إبرامها في أوسلو”[47].
وجهات نظر أخرى:
لم يقتصر شلايم على العرض التاريخي المُرسل، فقد ضمَّن كتابه محطات صغيرة؛ مقابلته للملك حسين المستفيضة، خصوصًا في ما يتعلق بلقاءاته السرية مع زعماء إسرائيل، مثل غولد مئير، وشمعون بيرس، ويتسحاق رابين وموشيه ديان. وكذلك أزمة الخليج – صدام، الحروب، السادات. وفتح صفحة للتحولات في رؤية إدوارد سعيد للحل، وصفحة لبيني موريس وانقلابه الفكري، ونورمان فنكلشتاين ومعارضيه، والحرب على غزة.
- وجهة نظر شلايم:
يبسط شلايم موقفه، من دون تجميل، من قضية الصراع برمته، فيقول “إنني أكتب كشخص خدم الجيش في الإسرائيلي بمنتهى الإخلاص في منتصف الستينيات، ولم يشكّ في شرعية دولة إسرائيل داخل حدود ما قبل 1967، وما أرفضه بشدة هو المشروع الصهيوني الاستعماري وراء الخط الأخضر؛ فاحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في أعقاب حرب حزيران/ يونيو 1967، لم يفعل الكثير من أجل ما يتصل بالأمن، وكل ما تفعله إسرائيل هو بغرض التوسع الإقليمي فقط، وكان الهدف من ذلك هو إقامة إسرائيل الكبرى من خلال السيطرة الدائمة على الأراضي الفلسطينية، وكانت النتيجة واحدًا من أكثر أنواع الاحتلال العسكري طولًا ووحشية في العصر الحديث”[48].
ويصف شلايم حرب إسرائيل على غزة بقوله “إن بربرية إسرائيل قد أخرست نقاد حماس وأضفت الشرعية على حركة المقاومة الراديكالية في نظر الكثير من المتشككين الفلسطينيين والمسلمين، وأدت هذه الحرب دون غيرها من الحروب العربية الإسرائيلية السابقة، إلى نزع الشرعية عن النظم العربية الموالية للغرب مثل مصر والسعودية والأردن”[49]. ويستنتج من عرضه لجرائم الجيش الإسرائيلي إلى نتيجة مفادها، أنه “من الصعب مقاومة النتيجة التي تقول بأنها ’أي إسرائيل’ تحولت إلى دولة مارقة تحكمها ’عصبة من القادة معدومي الضمير’، إنها تفي تمامًا بالمؤهلات الثلاثة الواردة في تعريف الإرهاب، إن الهدف الحقيقي لإسرائيل ليس التعايش السلمي مع جيرانها الفلسطينيين، وإنما الهيمنة العسكرية”[50].
- وجهة نظر إدوارد سعيد:
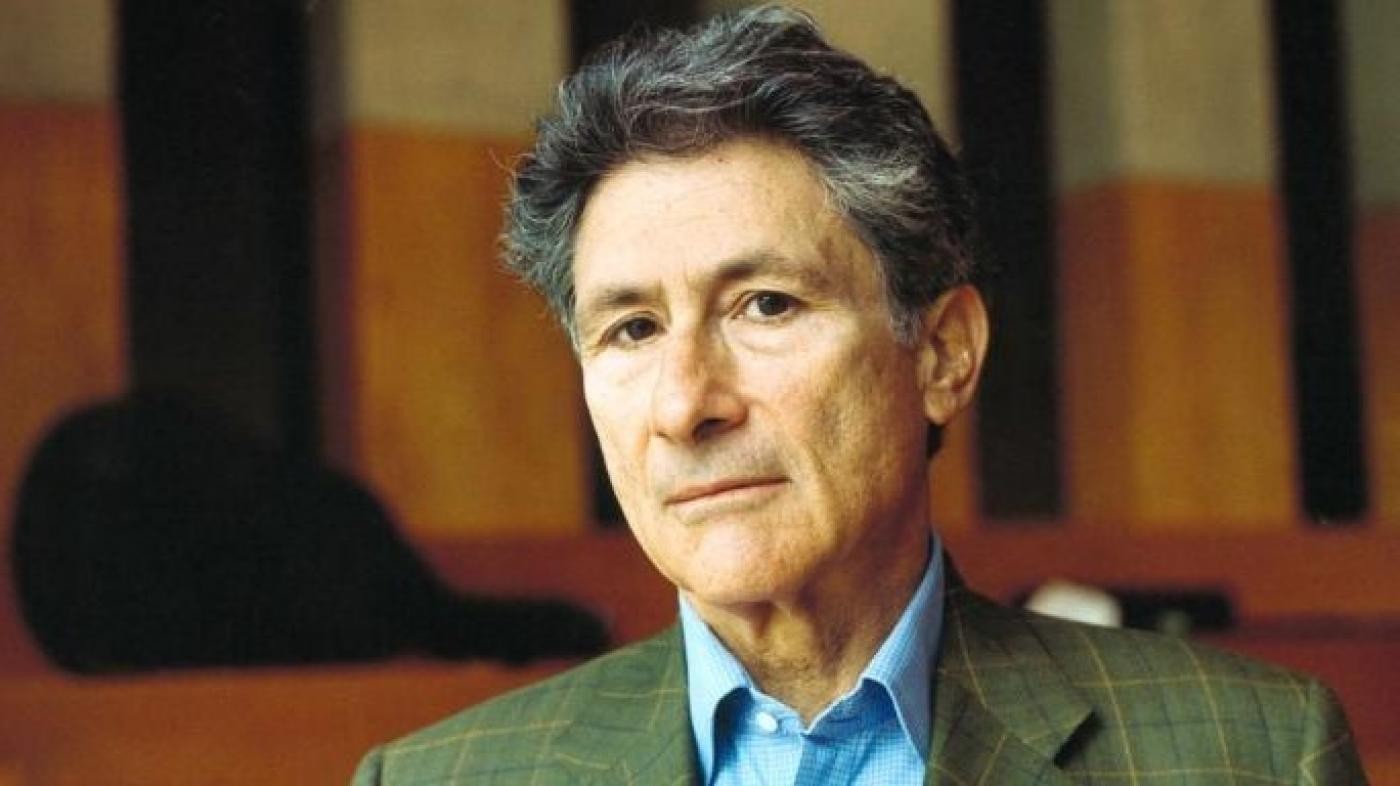 نظر شلايم باحترام شديد لإخلاص إدوارد سعيد وجرأته ولثقافته الواسعة، وأظهر إعجابه بوصف سعيد لليهود والعرب في فلسطين؛ “وصف سعيد الفلسطينيين في عبارة خالدة بأنهم ضحايا الضحايا”، وأكد أنه ينبغي على الفلسطينيين تفهُّم أثر الهولوكست على نفسية اليهود، وخصوصًا الهاجس الأمني إن أرادوا تفهم الموقف الإسرائيلي إزاءهم، ومن جهة أخرى، ينبغي على الإسرائيليين الاعتراف بإن إقامة دولتهم في عام 1948 كان ينطوي على ظلم هائل للفلسطينيين، ولم يكن ما أراده سعيد هو محو الماضي، ولكن التوصل لفهم أوسع لجذور الصراع، وكان سعيد يجمع بين الإنسانية العظيمة والإحساس العميق بالكرامة، وكان التعاون بين القبيلتين المتقاتلتين في فلسطين هو هدفه المطلق، ولكن ليس على حساب كرامة شعبه، وكان هذا التأكيد على ضرورة الاحترام المتبادل جزءًا من تراثه”[51].
نظر شلايم باحترام شديد لإخلاص إدوارد سعيد وجرأته ولثقافته الواسعة، وأظهر إعجابه بوصف سعيد لليهود والعرب في فلسطين؛ “وصف سعيد الفلسطينيين في عبارة خالدة بأنهم ضحايا الضحايا”، وأكد أنه ينبغي على الفلسطينيين تفهُّم أثر الهولوكست على نفسية اليهود، وخصوصًا الهاجس الأمني إن أرادوا تفهم الموقف الإسرائيلي إزاءهم، ومن جهة أخرى، ينبغي على الإسرائيليين الاعتراف بإن إقامة دولتهم في عام 1948 كان ينطوي على ظلم هائل للفلسطينيين، ولم يكن ما أراده سعيد هو محو الماضي، ولكن التوصل لفهم أوسع لجذور الصراع، وكان سعيد يجمع بين الإنسانية العظيمة والإحساس العميق بالكرامة، وكان التعاون بين القبيلتين المتقاتلتين في فلسطين هو هدفه المطلق، ولكن ليس على حساب كرامة شعبه، وكان هذا التأكيد على ضرورة الاحترام المتبادل جزءًا من تراثه”[51].
في محاولة للفهم، يتعقب شلايم تحولات أفكار سعيد واستشرافه لمستقبل فلسطين/ إسرائيل، فقد رأى كيف تجنب المتشددين من أبناء جلدته، “الذين أصروا على الحق الخالص للفلسطينيين، على كامل أرض فلسطين التاريخية، وقد أخذ نقد سعيد، المناهض للاستعمار الإسرائيلي، في الاعتبار اضطهاد اليهود في أوروبا والتأثير القوي للأفكار الصهيونية على الضمير الأوروبي، وكان يدرك دائمًا أن الهولوكوست تعني أنه لا يمكن الحكم على إسرائيل وفقًا للمعايير ذاتها التي يحكم بها على الدول الأخرى، لكنه لم يستطع إدراك السبب وراء وجوب حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الطبيعية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد اليهود، وهم منها براء، وبالتالي ربط تعاطفه مع معاناة اليهود، بمطالبة إسرائيل بالاعتراف بالإثم الذي اقترفته في حق الفلسطينيين. وفي مناظرة عامة مع سلمان رشدي في أواخر عام 1980، من خلال عبارته التي أصبحت ذائعة الصيت، وصف سعيد الفلسطينيين بأنهم “ضحايا الضحايا”[52].
وعرض شلايم ما كتبه سعيد في كتابه “قضية فلسطين”، حيث تطرق سعيد إلى هذا الظلم الشديد الذي حاق بالفلسطينيين، ولكن “على الرغم من نقده اللاذع للقومية الإسرائيلية، ينبغي قراءة كتاب ’قضية فلسطين’ باعتباره دعوة للتصالح، وعلى الرغم من أن دعوات سعيد للتصالح والتعايش السلمي قد أكسبته عداء الراديكاليين العرب وبعض المتشددين على الجانب الإسرائيلي، إلا أنه لم يتخلّ أبدًا عن اعتقاده بأن الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية كانت أهم من أي شيء آخر، بل كان يرى المسألة أكبر من عملية سلام”، وأنه لم تكن القضية بين الإسرائيليين والفلسطينيين قضية سلام أبدًا، ولكنها قضية إمكانية استعادة الفلسطينيين لممتلكاتهم، وقوميتهم وهويتهم التي سُلبت منهم من قِبل الدولة اليهودية الجديدة، “علاوة على ذلك، فإن السلام بشروط إسرائيل، يعني بالنسبة للفلسطينيين الموافقة على النتيجة التي تمخضت عنها حرب 1948″[53].
وقد وصف سعيد مهمته المحددة على نحو قاطع بأنّها “ببساطة وضع قضية الوجود الفلسطيني على الساحة في عالم يميل إلى إنكارها. إنها الإصرار، مرارًا وتكرارًا، يتمكنوا من وضع هدف واضح لهم”. وكتب أنه يجب على العالم أن يرى “الفكرة الفلسطينية تتمثل في التعايش، واحترام الآخر، والاعتراف المتبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين”. وهذه الجملة تلخص جوهر فكر إدوارد سعيد. وهو الموضوع الأكثر اتساقًا في كتاباته الغزيرة عن الموضوع، بدءًا من كتاب قضية فلسطين وحتى المقال الأخير[54].
ولم تكن تأملات سعيد بشأن مسارات السلام ثابتة، كما أنّها لم تكن متسقة دائمًا. فكانت أفكاره الخاصة بالتسوية تتطور على نحو مستمر، وكان يأخذ في حسبانه الواقع المتغير على الأرض، “ويمكن الإشارة إلى أربع مراحل رئيسية في فكر وكتابات سعيد عن هذا الموضوع”.
في البداية، فضل سعيد فكرة الدولة الواحدة على كامل أرض فلسطين التاريخية، على دولة ثنائية القومية لكل من اليهود والعرب. ثم انتقل إلى القبول بحل الدولتين، فقد “حدث حدثان كبيران في الثمانينيات، دفعًا سعيد إلى إعادة النظر في موقفه والانتقال من حل الدولة الواحدة إلى حل الدولتين. الحدث الأول، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، حينما اضطرت منظمة التحرير الفلسطينية إلى نقل مقرها من بيروت إلى تونس. وتقلصت بذلك مكانتها وأصبحت المنظمة ضعيفة ومنعزلة، حتى أنها كانت بالكاد قادرة على توفير قيادة سياسية فعالة، والحدث الثاني في كانون الأول/ ديسمبر عام 1987، عندما اندلعت الانتفاضة الأولى في غزة وانتشرت”[55]. وعندما تم توقيع اتفاقية أوسلو في عام 1993، عارض سعيد بشدة حل الدولتين الذين ورد ضمنًا في هذا الاتفاق”[56]. وأخيرًا، في نهاية حياته، عاد إلى حل الدولة الواحدة. وكان تفكيره قد تحول تمامًا في كتابه “قضية فلسطين”، حيث شرح مبررات حل الدولة الواحدة بوضوح وقناعة عميقة.
اعتبر سعيد الفكرة ذات أهمية فائقة للأسباب التالية: “أنها قبلت ما لم تكن أجيال من العرب والفلسطينيين قادرة على قبوله، ألا وهو وجود مجتمع يهودي في فلسطين، حصل على دولته عن طريق الحرب، كما أنها ذهبت إلى أبعد من ذلك، فقد اقترحت الرؤية الفلسطينية حلاً لا يزال، في رأيي، يعبر عن المصير الوحيد الممكن والمقبول لمنطقة الشرق الأوسط المتعددة الطوائف، ألا وهو مفهوم الدولة القائمة على الحقوق العلمانية للإنسان، وليس على أساس حقوق الأقليات الدينية، أو الوحدة الجيوسياسية المثالية. فقد تم تجاوز دولة الغيتو، ودولة الأمن القومي، وحكومة الأقلية، لصالح دولة ديمقراطية علمانية، تتعايش فيها كافة الطوائف من أجل مصلحة الجميع”[57]، وشن هجومًا ضاريًا، مع توقيع اتفاقية أوسلو، على الاتفاق، وانصبت بعض انتقاداته على أسلوب عرفات الاستبدادي، وأدرك أن الاتفاق لم يكن نتاج مفاوضات بين طرفين متكافئين، فقد فرضت إسرائيل إرادتها على منظمة التحرير الفلسطينية، ولم يكن هناك ذكر لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم أو سيادتهم أو وضع حد لتوسيع المستوطنات اليهودية، وفي السنوات التي تلت إبرام اتفاقية أوسلو، تحول سعيد تدريجيًا إلى موقفه الأول، وهو أن الحل الوحيد العادل والقابل للاستمرار للصراع بين العرب واليهود، هو دولة علمانية ثنائية القومية على كامل أرض فلسطين، من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، والدولة الواحدة سوف تعالج المشاكل الجذرية للصراع، والمشاكل الناجمة عن حرب 1948، وعلى وجه الخصوص حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، فقد ارتأى أن الدولة الديمقراطية ثنائية القومية هي البديل الحقيقي الوحيد لذلك المأزق الدموي لانتفاضة الأقصى[58].
يقدم شلايم مع بعض زملائه من المؤرخين الجدد، أفضل النماذج لمقاربة الفرص الضائعة، وتوصلوا إلى أن القادة الإسرائيليين مذنبون لفقدان العديد من الفرص لإنهاء الصراع، وهذا يظهر في دراسة شلايم عن حسني الزعيم في سورية، كما هي الحال أيضًا في دراستين أخريين: “صدام عبر الأردن” و”الجدار الحديدي”، فينتقد شلايم وغيره من المؤرخين الجدد، قادة إسرائيل لعدم بذلهم المزيد من الجهد لتحويل اتفاقاتهم للهدنة المؤقتة الموقعة عام 1949 إلى معاهدة سلام أكثر امتدادًا واستمرارًا”[59]، أو اقتناص فرص استعداد قادة عرب لتحقيق السلام مع إسرائيل، ويضرب شلايم مثلًا على ذلك بحسني الزعيم، قائد الانقلاب على الحكومة الديمقراطية المنتخبة في سورية عام 1949، الذي أبدى استعداده لإعادة توطين 300 ألف لاجئ فلسطيني في سورية[60]، كما قام باتصالات واسعة بإسرائيل لهذا الغرض، فيرى شلايم أنّه “إذا كانت عروضه قد قوبلت بالازدراء، ولم تخضع مقترحاته البنّاءة لاختبار جدي، وتحطمت فرصته التاريخية على صخرة انعدام الرؤية والهوس بالتفاصيل، فلا يجب إلقاء اللوم على الزعيم ولكن على الجانب الإسرائيلي”[61].
هوامش:
[1] شلايم، إسرائيل وفلسطين، ص 386
[2] المصدر نفسه، ص 23
[3] المصدر نفسه، ص71. يخطئ شلايم عندما يساوي بين الحركة القومية الفلسطينية وما يسميه حركة قومية يهودية، والحال لا قومية يهودية ولا شعب إسرائيلي. كان اليهود حينئذ مجموعة من شعوب مختلفة، لم يحدث اندماج بينهم، ما كان يجمعهم هو العداء للسكان الأصليين والطمع في الأرض.
[4] المصدر نفسه، ص 72
[5] المصدر نفسه، ص 72
[6] المصدر نفسه، ص 75
[7] المصدر نفسه، ص 107
[8] المصدر نفسه، ص 108
[9] المصدر نفسه، ص 110
[10] المصدر نفسه، ص 110
[11] المصدر نفسه، ص 111
[12] المصدر نفسه، ص 115
[13] المصدر نفسه، ص 116
[14] المصدر نفسه، ص 76
[15] المصدر نفسه، ص 88
[16] المصدر نفسه، 195
[17] المصدر نفسه، ص 13
[18] المصدر نفسه، ص 77
[19] المصدر نفسه، ص 137-139
[20] المصدر نفسه، ص 78
[21] المصدر نفسه، ص 197
[22] المصدر نفسه، ص 240
[23] المصدر نفسه، ص 79
[24] المصدر نفسه، ص 218
[25] المصدر نفسه، ص 219-220
[26] المصدر نفسه، ص 400
[27] المصدر نفسه، ص 393
[28] المصدر نفسه، ص 350
[29] المصدر نفسه، ص 83-84
[30] المصدر نفسه، ص 85
[31] المصدر نفسه، ص 336
[32] المصدر نفسه، ص 338
[33] المصدر نفسه، ص 231
[34] المصدر نفسه، ص 333
[35] المصدر نفسه، ص 235-237
[36] المصدر نفسه، ص 238
[37] المصدر نفسه، ص 374
[38] المصدر نفسه، ص 268-269
[39] المصدر نفسه، ص 269
[40] المصدر نفسه، ص 317
[41] المصدر نفسه، ص 320
[42] المصدر نفسه، ص 323
[43] المصدر نفسه، ص 83
[44] المصدر نفسه، ص 84
[45] المصدر نفسه، ص 383
[46] المصدر نفسه، ص 393
[47] المصدر نفسه، ص 490
[48] المصدر نفسه، ص 423-424
[49] المصدر نفسه، ص 436
[50] المصدر نفسه، ص 436
[51] المصدر نفسه، ص 484
[52] المصدر نفسه، ص 468
[53] المصدر نفسه، ص 470
[54] المصدر نفسه، ص 469-470
[55] المصدر نفسه، ص 472
[56] المصدر نفسه، ص 471
[57] المصدر نفسه، ص 472
[58] المصدر نفسه، ص 475
[59] كابلان، ص 405
[60] المصدر نفسه، ص 119
[61] شلايم، ص 133
——————————–
* باحث سوري في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
المصدر: عرب 48

التعليقات مغلقة.