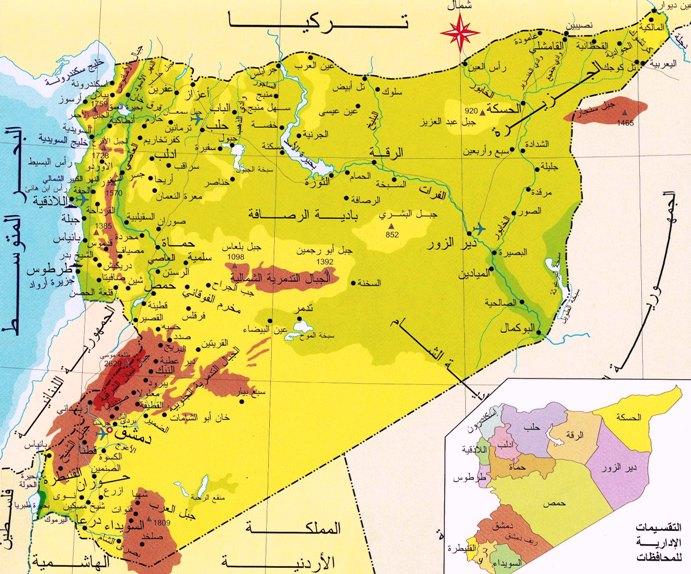
د. عبدالله تركماني
ثالثًا – الديكتاتورية العسكرية وولادة الجمهورية الثانية
جاء انقلاب 8 آذار/مارس 1963 تعبيرًا عن ردِّ فعل القوى القومية على نظام حكم الانفصال، حيث اشتركت فيه أطراف عسكرية بعثية وناصرية وقومية مستقلة، شكلت “مجلس قيادة الثورة” الذي أذاع البيان الأول: “منذ فجر التاريخ وسورية تلعب دورها الإيجابي في النضال تحت راية العروبة والوحدة العربية، ولم تعترف سورية العربية وشعبها على الإطلاق بحدود البلاد ولا تعرف غير حدود الوطن العربي الكبير. وحتى السلام الوطني لسورية لا يحوي كلمة (سورية) وإنما يمجّد العروبة والنضال البطولي للعرب جميعًا”. وبعد إدانة الرجعية التي اتخذت من أخطاء الوحدة مع مصر ذريعة لتقوم بـ “كارثة الانفصال” مضى البيان معلنًا أنّ الجيش كان يحذّر دائما من تلك الأخطاء، وأنّ ضباطه وقادته سعوا مرارًا “لرفع صوت الشعب السوري، وفي صباح اليوم قامت القيادة بحركة ثورية واستولت على الحكم”.
وبعد الانقلاب العسكري الذي جاء بحزب البعث إلى السلطة تحوّلت سلطة الدولة إلى مالك عام لوسائل الإنتاج، أي إلى القوة الأساسية القادرة على إعادة النظر في بنية المجتمع السوري، وإلى متحكّم أساسي بتوزيع الدخل الوطني، وبالتالي تحوّل الدولة إلى القوة الممسكة بسائر الفئات الاجتماعية وبقسم كبير من الثروات والعوائد، مع ما يستتبعه ذلك من تبدّل في طبيعتها ودورها، ومن تغيّر في ثقل مختلف مكوّنات المجتمع. بحيث تمّت إقامة نظام جديد، لا هو بالرأسمالي على الطريقة الغربية ولا هو بالاشتراكي على الطريقة الشرقية، نظام يقوم على رأسمالية دولة تابعة، يتوسّل آليات سياسية تضبط سيرورة الإنتاج الاجتماعي وتوزيع فوائض الدخل، يأخذ بآليات تنظيمية هدفها التغطية على واقعه وحقيقته كنظام رأسمالي تابع، يرتبط بالدولة ذاتها وليس بطبقة بورجوازية تمسك بزمام الإنتاج من خلال ملكيتها لوسائله (23).
لقد كانت الأطروحة القومية، في السلطة، تضع نفسها مقابل التنمية ومقابل عصرنة البلاد وبنائها وطنيًا. ولذلك فإنها لم تفشل فقط في إنجاز التنمية، وإنما عرقلت قيامها، واتهمت الشروع بها قطريًا بأنه “إقليمية ومصالح قطرية ضيقة”.
لكنّ صراع الأجنحة داخل “مجلس قيادة الثورة” و”اللجنة العسكرية” أدت إلى انقلاب 23 شباط 1966، الذي تميز بخطاب “يساري” متطرف، قاده اللواء صلاح جديد، والدكتور نور الدين الأتاسي، والدكتور إبراهيم ماخوس، واللواء حافظ الأسد … الخ. وقد تعرض النظام الجديد أيضًا إلى صراعات داخلية، كان من أبرزها محاولة الانقلاب التي قادها الضابط سليم حاطوم في خريف العام نفسه.
وهكذا فإنّ الجيش السوري دخل الحرب العربية – الإسرائيلية في العام 1967 وهو منهك القوى، نتيجة التصفيات والصراعات التي طالته خلال المرحلة كلها (1948- 1967). فمع اندلاع حرب حزيران/يونيو 1967 “كان ما لا يقل عن 700 ضابط وأكثر من ثلث سلك الضباط بكامله قد طُرد، واستُبدل باحتياطيين كانوا، إلى حد بعيد، معلمي مدرسة ريفيين، أو بطلاب ضباط غير مدربين تدريبًا كافيًا، وغالبًا من أصل ريفي” (24).
وفي الواقع، منذ الانفصال عن الجمهورية العربية المتحدة، لعبت الولاءات الطائفية والإقليمية والعشائرية دورًا هامًا في الصراع على السلطة في سورية. وبالتالي، يمكن استنتاج أنّ “قوة الضباط العسكريين والسياسيين المدنيين على المستوى الوطني قد اعتمدت بشكل كبير على النفوذ الذي استطاعوا فرضه على المستويات الإقليمية والطائفية و/أو العشائرية. وكثيرًا ما تم التعبير عن الصراع على السلطة بين أشخاص من مناطق مختلفة و/أو طوائف دينية على شكل نزاع بين مناطق و/أو صراع بين طوائف، كما تم التعبير عن الصراع على السلطة بين الأشخاص من نفس المنطقة و/أو الطائفة الدينية على شكل نزاع إقليمي داخلي و/أو نزاع طائفي داخلي”.
وبعد استيلاء البعث على السلطة في 1963، استمر الصراع “التقليدي” بين النخب السياسية المتنافسة ذات الخلفيات الاجتماعية الاقتصادية المتقاربة، وكان الفارق الجوهري بينه وبين الفترة السابقة لعام 1963 هو “الاختلاف الكبير بين الخلفيات الاجتماعية الاقتصادية والطائفية والإقليمية للنخب السياسية الجديدة وبين خلفيات السياسيين السابقين، إذ أصبحت السلطة السياسية أساسًا في أيدي أفراد من أهل الريف ومن الطبقة البرجوازية الصغيرة ومن أبناء الأقليات الدينية”. وهذا فتح الطريق أمام تغيّرات سياسية اجتماعية اقتصادية عنيفة أصبحت تولي اهتمامًا رئيسيًا لمصالح أهل الريف وأفراد الأقليات الدينية الذين عانوا من التفرقة فيما مضى”(25).
1- انقلاب حافظ الأسد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970
منذ انقلاب حافظ الأسد امتزج تاريخ حزب البعث ونظامه بسيرته، بوصفه “قائد المسيرة”، وسوف تعبر مؤتمرات الحزب وقياداته عن مشاعر الحبور بـ “القيادة التاريخية الاستثنائية”. مع العلم أنه يمكن تمييز أربعة مستويات في هرم سلطة الأسد (26): أولها، أساسي ويتعلق بالمسائل الحاسمة بالنسبة إلى نظامه – كالأمن والشؤون الخارجية– تتركز الخيوط المهمة كلها في يديه، لا ينازعه فيها أحد. وثانيها، رؤساء شبكات الاستخبارات والأمن المتعددة، التي تعمل باستقلال بعضها عن بعض، وتتمتع بحرية واسعة، وهي تشكل عيون الأسد وأذنيه. وهناك قادة التشكيلات المسلحة النخبوية الحامية للنظام (الحرس الجمهوري، والقوات الخاصة، والفرقة الثالثة المدرعة، وسرايا الدفاع قبل عام 1984)، وهي مسؤولة أمام الأسد مباشرة. وثالثها، قيادة حزب البعث، التي تعمل كهيئة استشارية للأسد، تراقب –عبر الآلة الحزبية– تنفيذ سياساته. ورابعها، الوزراء وكبار موظفي الدولة والمحافظين وقادة المنظمات الشعبية.
ويمكن الاستدلال بمؤشرات واقعية عديدة على “عسكرة المجتمع”، فقد نقلت سلطة الأسد شباب الأرياف إلى المدن وحولتهم إلى “جيش عقائدي”، وبدأت عملية “ترييف” للمدن بشكل مضطرد، وتجلى ذلك في نظام الحكم، وفي جهاز الدولة العسكري والمدني. واعتُبرت الشعبوية القاعدة الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية لنظام الحكم، وتجلى ذلك من خلال اتسام الخطاب الشعبوي بالديماغوجيا والذرائعية في آن واحد، وتسويقها في نكهة شعبوية خاصة تختلط فيها مصلحة الأمة مع مصلحة قائد الانقلاب، والحلقة الضيقة التي حوله.
وفي إطار إحكام النظام السياسي قبضته على مفاصل المجتمع والدولة، راح يتمترس وراء الأيديولوجيا، متبنيًا قضايا كبرى ظاهريًا، متناسيًا أنّ شرعية أي نظام سياسي تبدأ من قدرته على إطلاق قاطرة التنمية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وإيجاد مستوى مقبول من العدالة الاجتماعية والقضائية، وفتح المجال أمام حرية الرأي والتعبير والإعلام، لكن ما افتقده النظام السياسي في حقيقة الأمر هو تلك الشرعية الداخلية نفسها.
ومنذ ذلك الحين “بدأ هذا القطر -المفتاح الآخر في الشرق الأدنى، بقيادة رئيسه الجديد، دخول لعبة التحوّل الخفي من أجل تجديد اللقاء بالغرب، وبالتالي إيجاد حل سريع للصراع العربي- الإسرائيلي الذي جمّدته مقررات مؤتمر قمة الخرطوم عام 1967(27).
كما منعت أيديولوجية النظام وممارسته تشكُّل هوية وطنية سورية في حدود الدولة السورية، وذلك عبر الممارسات التالية (28):
- عدم تحول المواطنة السورية إلى أي كيان حقوقي من أي نوع.
- التعامل مع المواطنين عبر الهويات الجهوية والعشائرية، وحتى الطائفية من جهة، والتأكيد على الهوية العربية، بوصفها أيديولوجية دولة من جهة أخرى.
وإذا عدنا إلى الدراسات التي تناولت الشباب السوري، قبل الثورة، نجد أنها قليلة جدًا، وتفيدنا بحقيقة ضعف مدارك الشباب السوري السياسية، وضعف رغبته، وخبرته، في التعاطي مع مسائل الشأن العام بالمجمل، ويعود ذلك إلى أسباب عدة، تعود إلى تآكل روح السياسة في المجتمع؛ نتيجة احتقار السلطة المجتمع، وقمعها له.
لقد مثّلت سلطة حافظ الأسد تراجعًا عن المكاسب العقلانية والتنويرية النسبية التي ورثتها سورية من مرحلة نهضتها الحديثة، فكان ضجيج الشعارات وضوضاء الإعلام الشعبوي إيذانًا بمرحلة جديدة في سورية، تميزت بهيمنة النظام الأمني – العسكري الريفي ذي الخطاب الانفعالي اللاعقلاني، حيث حسمت الشعبوية معركتها ضد الوعي المدني وتقاليده في تمثّل التعددية، والحوار، والانفتاح على الوعي الكوني الحديث.
وكان تسييس المؤسسة العسكرية بمثابة النار التي التهمت قوى المجتمع المدني والقيادات الفكرية والسياسية. حيث ألغيت السياسة، بآلياتها المعروفة، مما فرض على زعامات الأحزاب البحث عن آليات جديدة للسلطة، فوجدتها في البنى والروابط التقليدية المفوّتة ما قبل الوطنية (العشائرية، والطائفية، والجهوية…)، التي قدّمت نماذج صارخة لأنظمة حكم توتاليتارية.
وفي هذا النمط قامت سلطة الدولة باستغلال مزدوج للمجتمع من حيث:
(أ) – كونها أكبر مستخدم وصاحب عمل، تحدد الأجور والأسعار وتقررها الاحتكارات الحكومية.
(ب) – وكونها وسيطًا بين أفراد مجتمعها والشركات المتعددة الجنسيات والسوق الرأسمالية العالمية.
(ج) – وكون موظفيها الكبار (المدعومين من الأجهزة الأمنية والحزبية) يملكون سيطرة حقيقية على وسائل الإنتاج، وبالتالي إمكانية الاستيلاء على فائض وقت العمل “القيمة الزائدة”، بما يراكم – مع الزمن – رأسمالها الخاص.
ومنذ أواخر السبعينيات تراكمت العديد من المؤشرات الخطيرة في تطور الاقتصاد السوري، من أهمها:
(1) – التدهور النسبي في القطاع الزراعي والارتفاع الكبير في نصيب الصناعات الاستخراجية وقطاع الخدمات.
(2) – تخلخل التوازن بين القطاعات والفئات الاجتماعية، وتوسّع الفجوة بين الأرياف والمدن.
(3) – انخفاض موقع الصناعة التحويلية في هيكل الإنتاج الوطني.
(4) – تركيز الاهتمام بالتنمية المادية وإغفال أهمية التنمية البشرية.
(5) – مهّد النفط لمفهوم الدولة الريعية، حيث تمكنت السلطة من أن” ترشو” قطاعات من المجتمع، بهدف توسيع قاعدة حكمها وسلطتها.
(6) – سوء استعمال السلطة في المراتب العليا.
ولكن “يجب ألا نحدد الأسباب الأكثر عمقًا لعدم الاستقرار الذي ألمَّ بالنظام السوري في الخلفية الطائفية للنخبة الحاكمة فقط، وإنما في مزيج من عوامل مختلفة مثل الفساد والصعوبات الاقتصادية والأساليب القمعية وغير الديمقراطية وغياب الانضباط الحزبي والممارسات الطائفية التي طفت إلى السطح، خاصة في الفترة التي تلت التدخل العسكري السوري في الحرب الأهلية اللبنانية”. ونتيجة لذلك، “أصبح من الممكن توجيه السخط الشعبي والتوترات الاجتماعية الاقتصادية وإثارتها عبر قنوات طائفية، مثلما بدا واضحًا في الاضطرابات المدنية العنيفة والدموية بطول البلاد وعرضها في ربيع 1980”. لقد بدت الحملات الإعلامية للنظام التي تلت ذلك وحملة النظام لاستئصال الإخوان المسلمين “فظة وحادة للغاية، حتى أنها أثارت عداوة الشق الأعظم من الشعب بدلًا من أن تثير تعاطفهم”(29).
لقد كان عقد الثمانينات عقدًا متفرّدًا، بالنسبة إلى سورية، قياسًا إلى الفترات السابقة. فقد أدت الحرب العراقية- الإيرانية ونتائجها إلى تضاؤل دور العراق والسعودية، بينما كانت مصر قد استُبعدت رسميًا من العالم العربي. ولم يكن طموح سورية في ممارسة هيمنة على “سورية الكبرى” ممكنًا إلا بفضل ذلك السياق الخاص.
وعلى الصعيد الاقتصادي، عانى الاقتصاد السوري من أزمة عميقة في منتصف عقد الثمانينيات، بسبب انخفاض المساعدة العربية لسورية، تحت حجة انخفاض سعر النفط وأعباء الحرب العراقية- الإيرانية المالية على البلدان العربية النفطية. وإزاء ذلك، خاصة على ضوء سياسة التسلّح المفرط على حساب الاستثمارات الاقتصادية الحيوية، تم تشجيع القطاع الاقتصادي الخاص، وبدأت بورجوازية جديدة بالظهور من أوساط “بورجوازية الدولة” التي ولّدتها التأميمات و”قطاع الدولة” الاقتصادي، ومالت هذه البورجوازية الجديدة إلى إيجاد اقتصاد سوق يصب في مصلحتها، إذ بدلًا من طلب منافع مفترضة يقدمها الاقتصاد القائم على المنافسة تصرفت كعنصر طفيلي على الاقتصاد الحقيقي.
لقد كان استيلاء الجيش والمؤسسات الأمنية على السلطة ذا نتائج مباشرة على بنى وأدوار الطبقات الاجتماعية المختلفة، حين استهدف تحويلها إلى “طبقات أدواتية” ذات طابع سياسي غالب، ترتبط بأجهزة الدولة الجديدة، وباقتصادها، وبنمط إنتاجها ذي الطابع السياسي الغالب لدوره، تبلورت سلطة الدولة بوصفها محصّلة سلطة الأجهزة من جهة، وحدث انتقال على مستوى القوى المكوّنة للدولة من جهة أخرى. لقد زادت سلطة الأجهزة، لأنّ الانتماء إلى هذا الجهاز أو ذاك كان يعني في الواقع الانتماء إلى هذه الشريحة الطبقية أو إلى هذه الطبقة أو تلك. كما أنّ الانتماء إلى الأجهزة المختلفة كان يعني الانتماء إلى احتمالات تقدّم وصعود شخصي مختلفة (30).
وليس سرًا أنّ إقامة الرأسمالية على مستوى الدولة دون المجتمع قد مرَّ بسيرورة توطيد متواصل لجهازها القائد، لمؤسستها العسكرية، التي أخذت على عاتقها -منذ البداية- مهمة القيام بدور الطبقة الرأسمالية الغائبة، وفعّلت أجهزتها في هذا الاتجاه، ورسملت دولة غدت دولتها وحدها بصورة متزايدة، وحملت صفاتها بصورة متعاظمة. ذلك كان يعني مركزة الدولة وحصرها بها، وإمساكها المتعاظم بمركز القرار الحقيقي، وتعديل الشكل القانوني والدستوري للسلطة، كي يناسب حاجاتها في الإدارة والحكم، وتحويل نفسها إلى قناة يصعد عبرها الكادر الجديد في طبقة الدولة، تركّز بين يديها الموارد التي ستقوم بإعادة توزيعها على ضوء اعتباراتها السياسية الخاصة ونظرتها إلى آفاق التطور السياسي والاجتماعي لسورية. وكما حدث في أجهزة الإدارة المدنية انتقال باتجاه أجهزة الأمن، كذلك حصل في المؤسسة العسكرية انتقال مماثل جعلها روح الجيش وجهازه العصبي والقيادي الفعلي.
لقد كان مردود هذه السياسات الجديدة، التدرجية، سلبيًا بشكل عام. إذ إنّ سلطة الدولة لم تحقق أي هدف تنموي رئيسي، بل بدت سياساتها متاهات تجريبية في أحسن الأحوال، أو تخريبًا مقصودًا في جسد ما أُنجز في مرحلة نهوض المشروع الوطني. كما أنّ هذه السياسات قد هيأت الظروف لبروز ظاهرة “الإسلام السياسي” في سورية، في الفترة من 1979 – 1982، إذ كان ممثلوه قد اعترضوا على صياغة الدستور السوري الجديد في العام 1973، بسبب عدم إشارته إلى أي انتماء ديني خاص لرئيس الدولة، كما اعتبر أنّ التدخل السوري في لبنان بمثابة “التعبير عن إرادة الوصول إلى تحالف سياسي أقلياتي”، وقد تركت هذه الظاهرة آثارها على الحياة السياسية السورية.
وكانت الأحداث التي شهدتها سورية في العام 1979 (هجوم إرهابي مسلح على مدرسة المدفعية بحلب ومقتل العديد من طلاب الضباط في تموز/يوليو 1979) نقطة انعطاف كبيرة في مسار الأزمة القائمة، وقد تجلى ذلك بالعديد من الظواهر:
(أ) – استمرار مظاهر القمع والإرهاب، من خلال القمع الجماعي وزرع الرعب والإرهاب في بعض المدن. فأي حادث عنف، ولو كان صغيرًا، في مدينة أو منطقة، كفيل بمحاصرتها أو قسم منها، حيث يتحول المواطنون فجأة إلى رهائن في سجن كبير، مع كل الاحتمالات من إذلال مهين للكرامة الشخصية، حتى الاعتقال والتعذيب، بما في ذلك التصفية الجسدية الجماعية.
(ب) – استمرار عسكرة المجتمع، من خلال تنظيم وتدريب الفتيان والفتيات وتعبئتهم وشحنهم بروح الحقد والتمايز عن الشعب وضده، وترسيخ التمايز السياسي والطائفي والعشائري، فهو لم يتوانَ عن دفع العشائر بعضها ضد البعض في المنطقة الشمالية الشرقية (الجزيرة)، وتسهيل امتلاك السلاح واستعماله.
كما تمت شرعنة الاستبداد من خلال ضبط الحركة السياسية في أطر معينة مرسومة مسبقًا، بما يوجه النشاط السياسي للأحزاب الأخرى في تيار موازٍ لتيار حزب النظام (الجبهة الوطنية التقدمية). وضبط الحركة النقابية، العمالية والفلاحية والمهنية، بتقوية إشراف الأجهزة عليها، وإسباغ مظهر عسكري أمني على بنيتها العامة.
وإذا كانت عملية إلحاق المجتمع بالدولة وتطوير وسائل وأساليب تغييب وتزوير إرادة المواطنين والتمييز فيما بينهم أمام القانون، وإلغاء الحريات، قد تواترت وتضخمت باعتبارها مظهرًا أيديولوجيًا لصيقًا بالبرنامج العام للسلطة، فقد توازت معها في مراحل لاحقة عمليات القمع المنظم العاري الذي يكمل ثنائية آلة الدولة ويكشف جوهرها الأيديولوجي- القمعي الموضوعي.
وكانت الأهداف التي ترمي إليها سياسات وممارسات السلطة (31):
(1) – وضع السلطة في كل حيّز من المجال الاجتماعي، وخلق نقاط إضافية تأخذ صفة نقاط الارتكاز التي تنتشر بآلية سرطانية إلى المهنة والعائلة والنقابة والسكن.
(2) – تنويع أنماط القهر ومدها في اتجاه عمودي لتأخذ شكل القاعدة التي يكرّسها القانون بالتضافر مع بدائل العنف ونظام السيطرة العامة.
(3) – إحداث نقلة إلزامية في فكرة الحزب، أو التنظيم الحزبي بصورة عامة، بحيث يعيد التنظيم إنتاج العلاقات السلطوية في صفوفه، وفي البنى القاعدية.
لقد دخل النظام طوره الفاشي منذ سنة 1979، حيث توّجَه في شباط/فبراير 1982 إلى تدمير مدينة حماة والفتك بأكثر من عشرين ألفًا من مواطنيها، وتشريد عشرات الآلاف منهم. وهكذا فقد برهنت أزمة الثمانينات على هشاشة المؤسسات التي أقامتها سلطة الدولة السورية، والتي كانت مصدر افتخار نظام الحكم في بداية السبعينيات.
إنّ الدولة السورية التي انتزعها الأسد بالقوة الانقلابية لم تعد دولة السوريين المؤسّسة لتنظيم شؤونهم العامة، ورعاية مصالحهم، وضمان أمنهم الفردي والجماعي، وأصبحت، خلال أشهر معدودة، دولة الأسد القائمة لتنظيم شؤون ملكه، وتثبيت أركانه، ورعاية مصالح عصبيته، وضمان توسع نفوذ أصحابها وأمنهم. كانت هذه السلطة التي نشأت على أساس العصبية وسيلةً لتبديل طبيعة الدولة نفسها، وأسلوب عملها وأهدافها وغايتها. وكي تستطيع أن تتعزز وتستمر، ما كان أمامها إلا التوسع في إنتاج العنف لردع خصومها ومنافسيها، وأولهم الشعب نفسه الذي فقد دولته، من جهة، والتفنن في التغطية على حقيقة أهدافها وغاياتها، والمصالح التي تخفيها، بتطوير أشكال غير مسبوقة من الخداع والغش والتحايل على الرأي العام المحلي والعالمي، والتستر على الحقيقة، وما يترتب عن ذلك من تحويل الانتهازية والوصولية والازدواجية والرياء والكذب والتلوّن بكل الألوان إلى الفضيلة والوسيلة الوحيدة للتعايش والاستمرار والنجاح في الحياة العامة والخاصة، من جهة ثانية (32).
لقد تعرض العقد الاجتماعي، جراء انتقال السلطة وتمركزها بيد عائلة الأسد، لتحولات عميقة. فانتقل حكم البعث تدريجيًا من تحالف بين قاعدته الشعبية المكونة من فقراء الريف في سورية وشرائح من الطبقة المتوسطة المدنية، ليغير جلده تدريجيًا فيما بعد ويتحول العقد الاجتماعي إلى تحالف بين زمرة عسكرية نواتها عائلة الأسد ومجموعات من التجار الطفيليين، تمركزت خاصة في دمشق وحلب وبعض المناطق الأخرى. وبالإضافة إلى العنف، تمكن النظام من إعادة إنتاج وتوطيد سلطته من خلال تجديد عقده الاجتماعي ومن خلال استمرار قدرته في الحصول على ريع مادي كبير ثمنًا لدوره الوظيفي كـ “بلطجي” في إقليم مأزوم تجري فيها تصفية عواقب مشاريع سايكس- بيكو ووعد بلفور وعواقب الحرب الباردة.
لقد أتاح له ذلك تأمين ريع كبير وفّرته الريوع والمساعدات على مدى أربعين عامًا، وسمح له بتغطية نسبية لفشله التنموي المدقع وأتاح له موازنة التناقضات الاجتماعية وضبط الأمن الاجتماعي. لقد سمح هذا الوضع للنظام ببناء منظومة فساد عميقة الجذور في المجتمع وكانت لها وظيفة اجتماعية جوهرية سمحت بإعادة إنتاج منظومة الولاء وتوسيع قاعدة الرشوة الاجتماعية بما يؤمن ضبط وقمع تناقضات الحقل الاجتماعي.
إنّ الدولة الأســـدية لم تستولِ على الدولة، أو نظام الحكم فقط، على ما تفعل النظم الديكتاتورية عادة، بل استولت أيضًا على الفضاء العام المجتمعي، أو بالأصح همّشته أو محته، إلى حــد كبير، حتى لم يعد يظهر منه إلا ما تريده وتبيحه، أو ما يخدم شرعيتها واستمرار وجودها. فالدولة الأسدية ليس فقط أعاقت تطور الدولة إلى دولة مؤسسات وقانون، بل أطاحت، أيضًا، إمكان تحولها إلى دولة مواطنين أفراد، أحرار ومتساوين ومستقلين، وبالتالي قطعت إمكان تكوّن الجماعات السورية، باختلاف مكوناتها الدينية والمذهبية والأثنية والعشائرية، على شكل مجتمع.
المشكلة في هذا الوضع الشاذ أنه أبقى السوريين في حيّز الهويات القبلية المغلقة، الأثنية والطائفية والمذهبية والعشائرية، ولم يسمح لها، في الوقت ذاته، بالتبلور والتعبير عن ذاتها، أي أنها أُبقيت مجالًا لتلاعبات وتوظيفات السلطة، وضمن ذلك وضعها في مواجهة بعضها.
لقد تأتى عن إخراج السوريين من دائرة المواطنة، بالمعنى الحقوقي والسياسي، وحرمانهم من التكوّن كشعب، أو كمجتمع، حرمانهم من حقوقهم الفردية، وتاليًا حرمانهم من السياسة، فهذه سورية الأسد، وهؤلاء عليهم أن يعيشوا على هذا الأساس، وباعتبار أنّ العيش في هذه “السورية” بمثابة منّة من النظام، ينبغي أن يكونوا شاكرين لها، وأن يكونوا طوع إملاءاتها ومتطلباتها، وفي مقدمة ذلك نسيان أنهم مواطنون وأنّ لهم حقوقًا.
كانت الغلبة داخل الجهاز الحكومي المتضخم للدولة من نصيب الجهاز العسكري (الجيش والأمن)، مما سبب انعدام التوازن داخل الدولة نفسها، بين جهازها العسكري وجهازها البيروقراطي، وبين الدولة والمجتمع من جهة أخرى. أصبح الاستيلاء على الجهاز العسكري المدخل الأبسط والأكيد للسيطرة على السلطة في الدولة، وتحول الجهاز العسكري (ضباط الجيش والأمن) إلى ما يشبه طبقة مستقلة بذاتها، حريصة على امتيازاتها ومصالحها، وفي كثير من الحالات قامت عصبيات طائفية أو قبلية أو عائلية بالسيطرة على الجيش ولاحقًا الدولة، واستخدمت قوتها القهرية في صراعاتها ضد الجماعات الأخرى في مجتمعها. وما أن تسيطر أية جماعة على الدولة فإنها لا تنوى أن تتخلى عنها كمصدر للريع، كما أنها لا تولي اهتمامًا حقيقيًا بحماية وكلائها ومصالحهم وتنمية وتوسيع الرأسمال المحلي وإنتاجية مجتمعها طالما أنها لا تلعب أي دور في صيانة بقاء هذه الدولة في صراعها وتنافسها مع أعدائها الداخليين أو الخارجيين. الكفاءة البيروقراطية والاهتمام برأس المال وإنتاجيته ليست أمورًا ذات أهمية للدولة طالما أنّ هذه الأخيرة قادرة على إعادة إنتاج سلطتها ومصالحها ومصالح حلفائها. وبمعزل عن هذه الأمور كثيرًا ما كان حافظ الأسد يتحدث عن الشعب وإرادة الشعب وسلطة الشعب ودولة الشعب، وأنه مع الديموقراطية، وجعل من حزبه الحزب القائد للدولة والمجتمع، ودمج الدولة بالحزب، بحيث صار المجتمع ضحية الدولة، والدولة ضحية الحزب، والحزب ضحية الطائفة، والطائفة ضحية الأمن والجيش، والأمن خاضع للعائلة. وبالانتقال إلى توصيفات تناولت شخصية حافظ الأسد وسياساته، يصفه بطاطو بأنه صاحب “بلاغة ديمقراطية”، لا تتجسد في فعل، يرى في الناس العاديين “كائنات اقتصادية” لم تخلق للسياسية (33).
لقد نجح النظــام التسلــطي في السيــطرة عــلى مؤسسات المجتمع الأهلي ومؤسـسات المجتــمع المدني، عبر مختــلف وسائل الترغيب والترهيب، وإلحاقها قسريًا بأجـهزة الدولة التســلطية. كما نجح أحيانًا في تهدئة العصبيات القبــلية والطائفية الموروثة إبان مرحلة الاستقرار، ثم استفاد من تناقضاتها الكثيرة في زمن الأزمات الحادة.
لقد تأسس النظام الأسدي السلطوي على قاعدة القوانين الناظمة التالية للممارسة وللأداء السلطوي (34):
أولًا، أحادية السلطة واختزال مؤسسات الحكم برمتها بشخص وقرارات ورغبات الرئيس الحاكم. ثانيًا، اشتراط الولاء المطلق والطاعة العمياء لكل أوامر الرأس الحاكم الأوحد ورغباته ورؤاه، مثلما على الجنود الطاعة العمياء والتنفيذ الحرفي لأوامر القائد. ثالثًا، ضمان ولاء الأتباع بإشراكهم بالفوائد والمكاسب، بصفتها مغانم معارك ومكاسب هيمنة النظام، بحيث يصبح مقياس الولاء مدى رضوخ الأتباع للحصة المعطاة لهم من المغانم. رابعًا، التعامل مع الشارع العام بمنطق حالة “نفير عام” بما تتطلبه من تطبيق حالة “حكم عرفي” و”إدارة عسكرية أمنية”، حتى ولو لم يتم تطبيق هذا بشكل علني ورسمي عام، بل تم اتباعه بشكل سري وملتبس، وتم التفكير وفقه خلف الأبواب المغلقة.
ومن زاوية أخرى، فإنّ الظروف المواتية التي يمكن في ظلها كبح الطائفية، ومن ثم القضاء عليها، لم تتحقق خلال وجود حزب البعث في السلطة، فسورية “لا تزال في منتصف التسعينيات تبدو بشكل متناقض ومأساوي أبعد ما تكون منذ استقلالها عن التصور البعثي المثالي لمجتمع علماني” (35).
إنّ ما بدأته مراحل تكوُّن الدولة السورية الحديثة من إعلاء شأن الوطنية السورية على حساب الروابط ما قبل الوطنية عملت العائلة الأسدية على تقويضه وتدميره (36).
إنّ السير العام للشؤون الاجتماعية والسياسية والثقافية بين الاستقلال عام 1946 وانقلاب 1970 كان باتجاه توسع الحقل السياسي الوطني، ومشاركة أوسع لسوريين مختلفي المنابت في الحياة العامة، وعلمنة أوسع للتفكير والحياة العامة أيضًا، ووزن متراجع للطائفية في الدولة.
وفي تشخيص النظام السوري الأسدي، يخطئ من يعتقد أنه نظام طائفي خاص بطائفة ما، فهو ليس نظام الطائفة العلوية، أو نظام حكم الطائفة العلوية، لأنه ببساطة لم يكن في خدمتها، ويمكن اكتشاف ذلك من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التي تظهر أحوال السوريين من أبناء هذه الطائفة. بل على العكس، كانت الطائفة العلوية، ولا تزال، في الأسر، وكان السوريون “العلويون”، ولا يزالون، محتجزين رهائن بيد نظام الحكم.
لقد تمايزت منذ وقت باكر من حكم حافظ الأسد، دولتان في سورية: دولة ظاهرة، عامة ولا طائفية، لكن لا سلطة حقيقية لها. ودولة باطنة، خاصة وطائفية، وحائزة على سلطة القرار فيما يخص المصائر البشرية والعلاقات بين السكان وتحريك الموارد العامة، فضلًا عن العلاقات الإقليمية والدولية. تتكون الدولة الظاهرة من الحكومة والإدارة والجيش العام والتعليم والمؤسسات العامة و”مجلس الشعب” والقضاء والمحاكم، إنها عالم الموظفين التنفيذيين الذين لا سلطة لهم، ولا حرية. فيما تتكون الدولة الباطنة من الرئيس (والأسرة الأسدية) ومن الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية ذات الوظيفة الأمنية، ومن أثرياء السلطة الكبار. محروسة بالخوف، الدولة الباطنة ليست مرئية من قبل عموم السوريين، ولا نفاذ لهم إلى آليات القرار فيها. أركان الدولة الباطنة الأمنيون يصفون أنفسهم بأنهم أبناء النظام، أو النظام ذاته، فيما كبار الدولة الظاهرة مجرد موظفين. الفرق بين الكبير والصغير في الدولة الظاهرة أصغر من الفرق بين كبير في الدولة الباطنة وكبير في الدولة الظاهرة. أو، بعبارة أخرى، ليس هناك إلا صغار في الدولة الظاهرة. الكبار موجودون في الدولة الباطنة (37).
وعلى الرغم من خلفيته غير العسكرية، مارس بشار الأسد الحكم بمنطق عسكريتاري/تسلطي، طبق فيه تلك القواعد الأربع، بمنتهى التشدد والأصولية، إلى درجة أنه أنتج حكمًا عسكريتاريًا فاق، ببشاعته وفساده وفجوره، نظام أبيه العسكري بامتياز، والذي حكم كعسكري، وطبق نظامًا عسكرياً في حكمه.
وفي كل ذلك تتبدى الدولة الأسدية، إن في رؤاها عن ذاتها أو في تصرفاتها وسياساتها، بمثابة دولة احتلال، أو أقله بمثابة سلطة خارجية، إزاء شعبها، أو ما يفترض أنه شعبها، ولعل هذا ما يفسر انعدام حساسيتها، ليس السياسية أو القانونية فحسب، وإنما حتى الأخلاقية، إزاء قتلها مواطنيها، بالبراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية وبالكيماوي، أو في المعتقلات تحت التعذيب، وكذا محاصرتهم إلى حد الجوع، وتشريد الملايين منهم.
الهوامش:
(23) – صادق محمود، نهاية الأمان ..، المرجع السابق.
(24) – حنا بطاطو: فلاحو سورية، أبناء وجهائهم الريفيين الأقل شأنا وسياساتهم، ترجمة: عبدالله فاضل و رائد النقشبندي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – ط 2 2015.
(25) – د. نيقولاوس فان دام: الصراع على السلطة في سوريا (الطائفية والإقليمية والعشائرية في السياسة) – الطبعة الإلكترونية الأولى المعتمدة باللغة العربية – كانون الأول/ديسمبر 2006.
(26) – حنا بطاطو: فلاحو سورية … المرجع السابق.
(27) – باتريك سيل، الصراع على سورية …، المرجع السابق.
(28) – مضر الدبس، دور البنية الاجتماعية …، المرجع السابق.
(29) – د. نيقولاوس فان دام: الصراع على السلطة في سوريا ..، المرجع السابق.
(30) – د. عبدالله تركماني، الأحزاب الشيوعية في المشرق العربي والمسألة القومية من العشرينات حتى حرب الخليج الثانية، منشورات الآن ط 1– بيروت 2002.
(31) – د. عبدالله تركماني، الأحزاب الشيوعية في المشرق العربي ….، المرجع السابق.
(32) – د. برهان غليون، عن الدولة البربرية (كتاب لميشيل سورا في الثمانينيات) – صحيفة ” العربي الجديد ” – لندن 13 تشرين الثاني 2016.
(33) – حنا بطاطو، فلاحو سورية …، المرجع السابق.
(34) – نجيب جورج عوض، في معنى حكم العسكر، صحيفة ” العربي الجديد ” – لندن 25 تموز/يوليو 2016.
(35) – د. نيقولاوس فان دام، الصراع على السلطة في سوريا …، المرجع السابق.
(36) – ياسين الحاج صالح، الدولة الظاهرة والدولة الباطنة في سورية – الموقع الإلكتروني ” الحوار المتمدن ” – 13 آب/أغسطس 2012.
(37) – ياسين الحاج صالح، حافظ الأسد والدولة الأسدية، صحيفة ” القدس العربي ” – لندن 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
(*) – فصل من كتابي المنشور في كانون الأول/ديسمبر 2020 ” أنماط من بناء الدولة القومية في التاريخ الحديث “.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: سوريا المستقبل

التعليقات مغلقة.