
إن المرء يستنتج بعد قراءة كتاب «توماس بيكيتّي» المؤثر “رأس المال في القرن الحادي والعشرين” إن العالم لم يعش هذه الحالة من انعدام المساواة منذ أيام البارونات والملوك اللصوص . فهل أراد “توماس بيكيتي” بكتابه “راس المال في القرن الواحد و العشرين” أن يخطف أضواء منارة راس المال التي شيدها كارل ماركس؟
إليكم قراءة موقع الحوار المتمدن لكتاب ‘بيكيتي’:
كيف ينشأ تراكم رأس المال وكيف يتم توزيعه؟ وماهي القوى المحرّكة الحاسمة في ذلك؟
تشكل قضايا تطور اللامساواة وتمركز الرخاء في أيدٍ قليلة وفرص النمو الاقتصادي، عبر الزمن، جوهر الاقتصاد السياسي. وتكاد لا توجد أجوبة مُرْضِية على هذه التساؤلات، بسبب عدم توافر معطيات مُسْنَدة ونظرية مُقنِعة حتى الآن.
يحلل «توماس بيكيتّي» (Thomas Piketty) في “رأس المال في القرن الواحد والعشرين” معطياتٍ معبِّرةً من عشرين بلداً تعود حتى إلى القرن الثامن عشر، وذلك من أجل الكشف عن التطورات الاقتصادية والاجتماعية الهامة بالاستناد إليها. وتضع النتائجُ التي توصل إليها النقاشَ على أسُسٍ جديدة وتحدد في نفس الوقت جدول العمل المتعلق بالتفكير المستقبلي في الرخاء واللامساواة.
يبيّن لنا ‘بيكيتّي’ أن النمو الاقتصادي في العصر الحديث وانتشار المعرفة قد مكّنانا من تفادي حدوث اللامساواة بالشكل التناحري الذي تنبّأ به كارل ماركس. إلا أننا، من جهة أخرى، لم نغيِّر بنى رأس المال واللامساواة بشكل عميق كما بدا عليه الأمر في عقود الرخاء التي تلت الحرب العالمية الثانية. فالقوّة الدافعة لللامساواة – وخصوصاً توجّه أرباح رأس المال إلى أن تفوق معدل النمو الاقتصادي – تهدد اليوم بإحداث لامساواة شديدة التطرف قد تزعزع في نهاية المطاف الأمن الاجتماعي وقيَمنا الديموقراطية. إلا أن التوجهات الاقتصادية ليست أحكاماً إلهية. والعمل السياسي قد صحَّح في الماضي لامساواتٍ عديدةً خطيرة، وهو قادر على فعل ذلك لاحقاً.-
(ولد “توماس بيكيتي” في 7 أيار/ مايو 1971 في ضاحية كليشي الباريسية، حصل على الدكتوراة في الاقتصاد، مدير الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية، أستاذ في مدرسة باريس للاقتصاد، خريج المدرسة العليا للأساتذة، اشتهر في مجال دراسة اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية وفق منهج بحثي تاريخي. ألف عدة كتب في الاقتصاد كان آخرها “رأس المال في القرن الواحد والعشرين” في عام 2013 فزاع صيته وترجم إلى العديد من اللغات وأعيدت طباعته مرات عديدة، وكانت الطبعة الخامسة عشرة له باللغة الألمانية في عام 2015، وهي التي نستقي منها المعلومات الواردة أدناه)
يُسمح بالفوارق الاجتماعية إذا كانت في خدمة الصالح العام فقط.
المادة 1 من إعلان حقوق الإنسان والمواطنة (للثورة الفرنسية عام 1789)
سنعرض فيما يلي ملخصاً مكثفاً لأهم الأفكار الواردة في كتاب (رأس المال في القرن الواحد والعشرين) من تأليف الاقتصادي الفرنسي الشهير “توماس بيكيتي”:
يعتبر توزيع الثروة في هذه الأيام من أهم المسائل التي تحظى بنقاش واسع. لكن ماذا نعرف فعلاً عن تطور هذا التوزيع عبر الزمن؟ وهل تؤدي ديناميّة تراكم رؤوس الأموال الخاصة بالضرورة إلى تمركز شديد ودائم للثروة والسلطة في أيدي عدد قليل من الناس، كما أعتقد كارل ماركس في القرن التاسع عشر؟ أم أن القوى الموازِنة للنمو الاقتصادي والتنافس والتقدم التقني ستؤدي تلقائياً إلى تقليص اللامساواة وإلى استقرارٍ منسجم في جميع مراحل التطور المتقدمة، كما اعتقد سيمون كوزنِتس (Simon Kuznets) في القرن العشرين؟ ماذا نعرف بالفعل عن كيفية تطور توزيع الدخول والثروة (الأصول) منذ القرن الثامن عشر؟، وما هي الدروس التي يمكن استقاؤها منها للقرن الواحد والعشرين؟
ليكن واضحاً من البداية أن الأجوبة على هذه التساؤلات لن تكون شافية ووافية، على الرغم من أنها تستند إلى المعطيات التاريخية الأكثر شمولاً من أية دراسة سابقة، وإنما هي تريد إثارة النقاش والجدال في هذا المجال. اعتمدَتْ دراسات مسألة توزيع الثروة واللامساواة، طيلة أزمنة مديدة، على القليل من المعطيات المثْبَتة نسبياً وعلى الكثير من التأملات النظرية. وقبل عرض المصادر التي أستند إليها في هذه الدراسة، يُفضل التطرق باختصار إلى تاريخ تطور الأفكار المتعلقة بهذه المسألة، من مالتوس إلى يونغ، ومن ريكاردو إلى ماركس، ومن كوزنِتس إلى بيكيتّي.
مالتوس ويونغ والثورة الفرنسية:
عندما نشأ الاقتصاد السياسي الكلاسيكي في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر في بريطانيا وفرنسا، انصب الاهتمام على موضوع التوزيع هذا، إذ كان واضحاً للجميع أن تغيّرات جذرية بدأت تحصل، كازدياد عدد السكان إلى أرقام غير مسبوقة وهجرة الريف والثورة الصناعية. فكيف ستؤثر هذه التغيّرات على توزيع الثروة وبنية المجتمعات والتوازن السياسي بين الدول الأوربية؟
كان الخوري ‘مالتوس’ (Malthus)، الذي نشر أطروحته عن قانون السكان في عام 1798، مقتنعاً قناعة راسخة بأن كثافة السكان هي أم المصائب والتهديد الأكبر. كانت مصادره شحيحة، لكنه حاول استنباط النتائج منها إلى أقصى حد. وكان متأثراً جداً بالتقرير الذي وضعه ابن بلده المهندس الزراعي البريطاني ‘يونغ’ (Young) بعد زيارة قام بها في الريف الفرنسي في 1787/1788، أي عشية قيام الثورة الفرنسية عام 1789. كانت مملكة فرنسا آنذاك البلد الأكثر عدداً للسكان في أوربا، إذ بلغ عدد سكانها في عام 1700 حوالي عشرين مليوناً، في حين كان عدد سكان المملكة المتحدة بالكاد أكثر من ثمانية ملايين نسمة (منهم خمسة ملايين في إنكلترا). وازداد عدد سكان فرنسا خلال كامل القرن الثامن عشر، أي من نهاية حكم لويس الرابع عشر وحتى نهاية حكم لويس السادس عشر، بشكل مستمر وبطيء، فأصبح في عام 1780 حوالي ثلاثين مليوناً, وقد أدى هذا التطور السكاني، الذي لم يكن معهوداً في القرون السابقة، إلى ركود الأجور في قطاع الزراعة وإلى ارتفاع ريع الأرض، مما أسهم، بين أمور عديدة أخرى، في استعداء طبقة النبلاء وعدم احترام النظام السياسي السائد آنذاك، فأدى بالتالي إلى انفجار الوضع في عام الثورة 1789.
كان ‘يونغ’ مستاءً جداً من الوضع البائس للفلاحين الفرنسيين، وكان يعتقد أن النظام البريطاني ذي الغرفتين (مجلس العموم ومجلس اللوردات مع حق النقض لهذا المجلس) هو الوحيد الذي يمكنه أن يضمن مجتمعاً متجانساً ومسالماً. وقد شعر بالخوف عندما اجتمعت طبقة النبلاء مع ممثلي الشعب الفرنسي في برلمان واحد في عام 1789، واعتقد أن فرنسا مهدَّدة بالزوال لهذا السبب، كما أنه لم يخفِ خوفه من أن تقفز شرارة مثل هذه الثورة إلى المملكة المتحدة.
كانت استنتاجات مالتوس التي توصل إليها في دراسته التي نشرها في عام 1798 أكثر تشاؤماً من استنتاجات ‘يونغ’ وكان أكثرَ استياءً منه من الأخبار السياسية التي كانت ترد من فرنسا. وللتأكّد من أن مثل هذا “الشطط” السياسي لن يطال المملكة المتحدة، ذات يوم، فقد نادى بإلغاء جميع المساعدات التي كانت تقدَّم للفقراء في حينه، وبمراقبة نسبة تكاثرهم مراقبة شديدة. وإلا، فإن الكثافة السكانية والفوضى والبؤس سيعم العالم أجمع، وسيؤدي ذلك إلى زواله. ومن الواضح أنه لا يمكن فهم نبوآت ‘مالتوس’ السوداوية هذه إلا إذا أخذنا بنظر الاعتبار ذلك الخوف الكبير الذي كان يسري في أوساط جزء كبير من النخبة الأوربية في تسعينيات القرن الثامن عشر.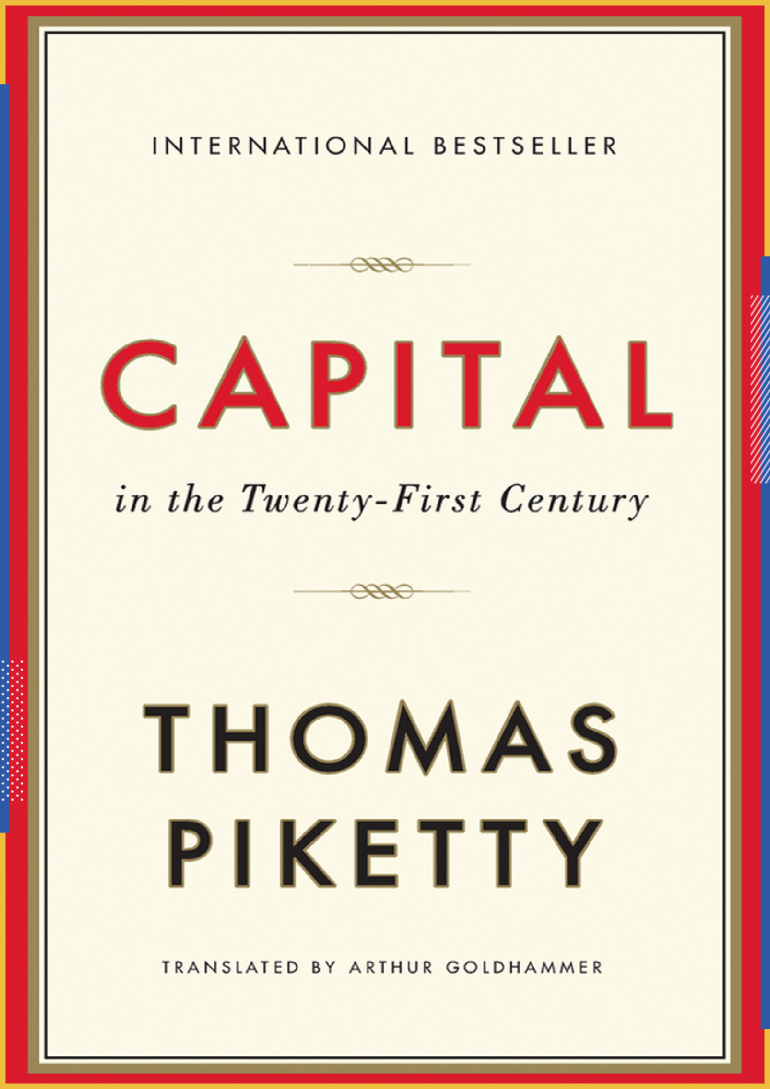
ريكاردو ومبدأ الندرة:
عندما ننظر إلى الوراء يصبح من السهل جداً أن نهزأ من النظرة السوداوية التي سيطرت على عقول الكثيرين في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، إلا أنه يجب أن نعترف أيضاً بأن التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي حصلت آنذاك كانت كبيرة جداً، ولحدٍّ ما صادمة. فكانت وجهات نظر أغلب مراقبي تلك الفترة الزمنية قاتمة، إن لم تكن تُنْبئ بـ”نهاية العالم”، فيما يتعلق بالتطور البعيد المدى لتوزيع الثروة والبنية الاجتماعية. ولم يسلم من ذلك بشكل خاص كلٌّ من “دافيد ريكاردو” وكارل ماركس اللذين كانا بدون أدنى شك الأكثر تأثيراً في عالم الاقتصاد في القرن التاسع عشر واللذين انطلقا من أن مجموعة صغيرة في المجتمع- مالكي الأراضي عند ‘ريكاردو’ والرأسماليين الصناعيين عند ماركس- ستستأثر بالضرورة وبشكل دائم بجزء متزايد من الإنتاج والدخل. (كانت هناك أيضاً مدرسة ليبرالية أشاعت بعض التفاؤل، منها آدم سميث الذي لم يعالج مسألة نشوء هوّة ممكنة وبعيدة المدى في مجال توزيع الثروة، بل طرح فكرة “اليد الخفية” التي تنظم اقتصاد السوق تلقائياً، ومنهم أيضاً “جان باتيست” (1767-1832) الذي اعتقد أيضاً أن الانسجام هو من طبيعة الأمور).
اهتم ‘ريكاردو’ الذي أصدر كتابه عن “أسس الاقتصاد السياسي وفرض الضرائب” في عام 1817، بشكل خاص بالتطور بعيد المدى لأسعار الأراضي وريعها. ولم يكن بحوزته، كـ’مالتوس’، أية مصادر إحصائية تستحق هذا الإسم. إلا أنه عرف رأسماليّة زمانه بشكل جيد، فتخطّت أفكاره النموذج “المالتوسي” الذي تأثر به في البداية، ليعالج بعد ذلك التناقض الذي يمكن اختصاره بالآتي: إذا كان عدد السكان والإنتاج سيزدادان باضطراد، فستصبح الأرض، بالمقارنة مع المصادر الأخرى، غير كافية، مما سيؤدي بالتالي، وانطلاقاً من مبدأ العرض والطلب، إلى ارتفاع مستمر في ثمن الأراضي وأجرة الأرض التي ستُدفع لمالكي الأراضي الذين سيحصلون إذاً على جزء يزداد باضطراد من الدخل القومي ، في حين سيحصل الشعب على جزء يتناقص باستمرار من الدخل القومي. وهذا ما سيحطّم التوازن الاجتماعي. كان الحل المنطقي والسياسي المُرْضي الوحيد بالنسبة لريكاردو يتمثّل في فرض ضريبة تصاعدية على ريع الأرض.
سنرى أن نبوءته القاتمة هذه لم تتحقق. فصحيح أن ريع الأراضي قد بقي فترة طويلة مرتفعاً، إلا أن قيمة الأراضي المزروعة بالمقارنة مع باقي أشكال الثروة قد انخفضت أخيراً بالمقدار الذي انخفضت فيه مساهمة قطاع الزراعة في الدخل القومي. إذ لم يستطع ريكاردو الذي كتب أطروحته في سنوات 1810 أن يتصوّر مقدار التقدم التقني والنمو الاقتصادي اللذين سيتحققان في كامل القرن التاسع عشر. وكان غير قادر، حالُه في ذلك كحال مالتوس ويونغ، أن يتصوّر أن البشر سيتحررون، يوماً ما، من شح المواد الغذائية، ومن عناء العمل الحقلي في الزراعة.
ومع ذلك تبقى نظريته المتعلقة بسعر الأرض هامّة. فمبدأ الندرة الذي انطلق منه يمكن أن يؤدي إلى بقاء بعض الأسعار خلال عقود عديدة مرتفعاً جداً ، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زعزعة مجتمعات بكاملها. ومن الخطأ إهمال قيمة هذا المبدأ عند تحليل توزيع الثروة في القرن الحادي والعشرين على المستوى العالمي، حيث ما علينا سوى استبدال سعر الأرض الزراعية في أطروحة ريكاردو بسعر العقارات في المدن الكبيرة أو بسعر البترول. ولو أسقطنا المنحى الملاحَظ خلال سنوات 1970 – 2010 على الفترة الزمنية من 2010 حتى 2050 أو حتى 2100 لنتج عن ذلك خلل جسيم في التوازن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين الدول وضمن الدول ذاتها، وقد يذكّرنا هذا الخلل برؤية ‘ريكاردو’ التناحرية.
يعتبر قانون العرض والطلب الآلية الاقتصادية البسيطة التي تضمن من حيث المبدأ الحفاظ على هذا التوازن. فإذا أصبحت بضاعة ما نادرة، وأصبح سعرها مرتفعاً جداً، فلا شك في أن الطلب عليها سينخفض، مما سيؤدي إلى إزالة التوتر الحاصل. وعندما ترتفع أسعار العقارات أو البترول، على سبيل المثال، فيكفي عندئذ الانتقال إلى الريف بدلاً من المدينة أو استخدام الدراجة بدلاً من السيارة (أو الإثنين معاً). وكالعادة، فلن يحصل الأسوأ دائماً. إلا أنه يجب أن يكون واضحاً أن قانون العرض والطلب لا ينفي إمكانية نشوء هوّة عميقة ودائمة في توزيع الثروات، وهذه هي أهم رسالة لمبدأ الندرة الذي اعتمده ريكاردو.
ماركس ومبدأ التراكم اللامحدود:
عندما أصدر ماركس كتابه “رأس المال” في عام 1867، أي بعد نصف قرن من صدور “أسس” ريكاردو، كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية قد تغيرت تغيراً جذرياً. فلم يعد يتعلق الأمر بمدى إمكانية الزراعة إطعام الأعداد المتزايدة من البشر، أو بمدى ارتفاع أسعار الأراضي إلى أرقام فلكية، وإنما بفهم القوى المحرِّكة للرأسمالية الصناعية التي كانت تتطوَّر آنذاك.
كانت أوضاع العمال البائسة هي السمة الظاهرة لذلك العصر، حيث كانوا يعيشون في أحياء مكتظة، رغم أو ربما بسبب النمو الاقتصادي وهجرة الريف الكثيفة. كانت أيام العمل طويلة والأجور منخفضة. فأصبحت فاقة الحياة في المدينة أشد وطأة من فقر الحياة في الريف أيام النظام القديم (Ancien Régime)، بما لا يقارن. وللدلالة على بؤس الحالة في تلك الفترة من الزمن نذكر قانون منع تشغيل الأطفال دون سن الثامنة في المصانع في فرنسا الصادر عام 1841 ومنع تشغيل الأطفال دون سن العاشرة في المناجم في بريطانيا الصادر عام 1842. وفي هذا السياق لا بد أيضاً من ذكر كتاب إنجلز عن “حالة الطبقة العاملة في إنكلترا” الذي أصدره في عام 1845.
تدل جميع المعطيات المتوافرة لدينا على أن القيمة الشرائية للأجور قد ارتفعت بشكل ملموس في النصف الثاني – أو بالأحرى في الثلث الأخير – من القرن التاسع عشر، في حين استقرت أجور العمال المنخفضة جداً خلال كامل النصف الأول منه وبما يوازي الأجور في القرن الثامن عشر، وأحياناً حتى دونها، على الرغم من النمو الاقتصادي الكبير الذي تحقق في القرن التاسع عشر في كل من بريطانيا وفرنسا، مما أدى إلى ازدياد حصة رأس المال في الدخل القومي- أرباح من المصانع وريع الأراضي وأجرة البيوت في المدن-، وذلك وفق المعطيات المتاحة لدينا، وإن كانت غير كاملة. وقد تراجعت هذه الحصة في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر بشكل طفيف، فتبعتها الأجور جزئياً.
كان نمو رأس المال والأرباح من الشركات الصناعية في أربعينيات القرن التاسع عشر واضحاً جداً للعيان بالمقارنة مع دخول العمال، حتى وإن لم تتوافر الإحصائيات الوطنية التي تثبت ذلك. وقد تطورت الحركات الاشتراكية والشيوعية في هذا المناخ. وكان السؤال المحوري المطروح آنذاك بكل بساطة هو: ما هي الفائدة من الصناعة، ومن كل هذا التجديد التقني، من كل هذا العمل، ومن هجرة الريف إلى المدينة، إذا كانت أوضاع العمال بعد نصف قرن من التقدم الصناعي بهذا السوء، وإذا كنا نضطر إلى سن القوانين لمنع عمل الأطفال دون سن العاشرة في المصانع ؟! كان فشل النظام السياسي والاقتصادي القائم جلياً جداً. وكان السؤال الهام منصباً على سبر آفاق تطور مثل هذا النظام في المدى البعيد.
كرَّس كارل ماركس جلَّ جهده للإجابة عن هذا السؤال، وغيره. فكان أن أصدر البيان الشيوعي، ذلك النص المؤثِّر، في شباط 1848 والذي يبدأ بالكلمات الشهيرة التالية: “شبحٌ ينتاب أوربا- شبح الشيوعية”، وينتهي بالنبوءة الشهيرة: “إنَّ تطوّر الصناعة الكبيرة يزلزل تحت أقدام البرجوازية الأساسَ الذي تُنتج عليه وتتملَّك المنتجات. إن انهيار البرجوازية وانتصار البروليتاريا أمران حتميّان”.
ألّف ماركس في العقدين التاليين دراسته الشاملة، أي كتاب رأس المال، من أجل تبرير هذا الاستنتاج وتحليل الرأسمالية وانهيارها بشكل علمي، حيث حرص، كـ’ريكاردو’، على تحليل التناقضات المنطقية الداخلية التي يتصف بها النظام الرأسمالي، نائياً بنفسه عن الاقتصاديين البرجوازيين (الذين يرون في السوق نظاماً ينظّم نفسه بنفسه، من قبيل “اليد الخفية” وفق آدم سميث) وعن الاشتراكيين الطوباويين الذين قال فيهم بأنهم اكتفوا بانتقاد وضع العمال البائس، من دون تحليل العمليات التي تؤدي إلى هذا الوضع تحليلاً علمياً. وإذا اعتبر ريكاردو الأرض على أنها رأس المال المتحكِّم، فقد انطلق ماركس من رأس المال الصناعي (آلات وتجهيزات وغيرها من أدوات الإنتاج) على أنه رأس المال الأهم والذي يمكن مراكمته بشكل لامحدود، بحيث يمكن أن نُطلق على أهم استنتاجاته بالفعل اسم “مبدأ التراكم اللامحدود”، أي توجّه رأس المال الحتمي إلى التراكم والتمركز في أيدٍ قليلة، من دون أي حد طبيعي، مما سيؤدي، وفق رؤية ماركس التناحرية، إلى أحد أمرين: فإما أن تميل الأرباح إلى الانخفاض، فيُخنق محرك التراكم، مما يؤدي بالتالي إلى تنافس الرأسماليين فيما بينهم عليها إلى حد الموت، وإما أن تزداد حصة رأس المال في الدخل القومي بشكل لامحدود، مما سيؤدي بعد زمن قصير أو طويل إلى اتحاد العمال والثورة. وفي جميع هذه الحالات يتعذر إقامة توازن سياسي أو اقتصادي-اجتماعي مستقر.
لم تتحقق تلك النبوءة القاتمة، كما لم تتحقق نبوءة ريكاردو من قبله. فقد ارتفعت الأجور أخيراً اعتباراً من الثلث الأخير للقرن التاسع عشر، وكذلك القيمة الشرائية، بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تغيّر الظروف تغيّراً جذرياً، حتى وإن بقيت اللامساواة كبيرة جداً، بل إنها ازدادت في بعض المجالات حتى الحرب العالمية الأولى. وحدثت الثورة الشيوعية. لكن في الدولة الأكثر تخلفاً في أوربا (روسيا) والتي كانت الثورة الصناعية فيها في بداياتها، بينما خطت الدول الأوربية الأكثر تطوراً، لحسن حظ مواطنيها، على طرق أخرى من الاشتراكية الديموقراطية. لقد أهمل ماركس، كسابقيه من المؤلفين، إمكانية التقدم التقني الدائم والزيادة المستمرة للإنتاجية. لكننا أصبحنا اليوم نعرف أن هذه العوامل تمكننا- لحد ما- من التأثير في عملية تراكم رأس المال الخاص وتركيزه باتجاه الاستقرار. من المؤكد أن ماركس كان يفتقر إلى المعطيات الإحصائية اللازمة لتشذيب نبوآته. يضاف إلى ذلك أنه كتب استنتاجاته في عام 1848، أي قبل الانكباب على دراساته التي يمكنها تبريرها. لقد كتب ماركس في مناخ حامٍ سياسياً مما أوصله إلى استنتاجات متعجّلة يصعب الخروج منها- ولهذا فإنه من الضروري جداً أن نقرن النقاش التاريخي بمعطيات تاريخية كاملة. (يجب القول بأن ماركس كان مطلعاً على المعطيات المتاحة من أيام ‘مالتوس’ و’ريكاردو’، إلا أنه كان يتعامل معها بسطحية لم تمكّنه من إقامة علاقة واضحة بينها وبين دراساته النظرية). كما أن ماركس لم يطرح على نفسه السؤال عن كيفية التنظيم السياسي والاقتصادي لمجتمعٍ أُلغيت فيه مُلكية رأس المال الخاص بشكل كامل، وهذه مسألة في غاية التعقيد بيَّـنتها لنا الارتجالات الشمولية والمؤسفة التي طُبّقت في الدول التي مشت على طريق الشيوعية.
مع كل ذلك، سنرى أن التحليل الماركسي، رغم حدوده، لا يزال ساري المفعول في العديد من النقاط. إذ انطلق ماركس بدايةً من السؤال الحقيقي والهام (عن تركيز الثروة اللامعقول إبان الثورة الصناعية) وحاول الإجابة عنه بالوسائل المتاحة له. ولا يزال مبدأ التراكم اللامحدود الذي اعتمده آنذاك ينطوي عن فهم عميق عند تحليل قضايا القرن الواحد والعشرين، كما كان أيضاً في القرن التاسع عشر، ويدعو، بطريقة ما، إلى القلق أكثر من مبدأ الندرة الذي اعتمده ريكاردو. وخصوصاً، إذا كان معدل نمو السكان ونمو الإنتاجية ضعيفان نسبياً، فإن الثروات (الأصول) المتراكمة في الماضي تكتسب بالضرورة أهمية استثنائية غير متناسبة وتؤثر في زعزعة استقرار المجتمعات المعنية. وبكلمات أخرى: يشكل النمو الضعيف وزناً معاكساً ضعيفاً لمبدأ التراكم اللامحدود الماركسي، وهذا ما يؤدي إلى وضع غير تناحري، كالذي تنبأ به ماركس، وإنما إلى وضع يدعو إلى القلق. فالتراكم قد يصل في نقطة ما إلى الثبات، إلا أن المستوى الذي يصل إليه قد يكون عالياً جداً ويزعزع الاستقرار. وسنرى أن ازدياد الثروات الخاصة المتحقق في جميع الدول الغنية منذ السبعينيات (1970)- وخصوصاً في أوربا واليابان- بالمقارنة مع الدخل القومي السنوي قد نجم مباشرةً عن هذا المنطق.
من ماركس إلى كوزنِتس: من التناحر إلى الأسطورة
يمكن القول، عند مقارنة تحليل ريكاردو وماركس في القرن التاسع عشر بتحليل سيمون كوزنِتس (Kuznets) في القرن العشرين، بأن علم الاقتصاد، الذي كان يميل بطبيعته في الماضي إلى الاستنتاجات التناحرية والمبالغ فيها بدون شك، قد بات يميل، بشكل لا يقل عنه في المبالغة، إلى الأسطورة، أو على الأقل إلى ” النهاية السعيدة ” (Happy end). فوفق نظرية كوزنِتس تتناقص اللامساواة في المراحل المتقدمة من تطور الرأسمالية من تلقاء نفسها وتستقر بعد ذلك على مستوىً مقبول، مهما كانت خصائص السياسة المتّبعة في البلد المعني. من الواضح أن هذه النظرية، التي نُشرت في عام 1955، كانت تتناسب مع السنوات “الثلاثين السِمان” (Trente Glorieuses)، فما علينا سوى الانتظار حتى يعمّ الخير على الجميع. “والنمو الاقتصادي فيضانٌ يرفع معه جميع القوارب”. يمكن مشاهدة مثل هذا التفاؤل أيضاً عند ‘سولو’ ( Robert Solow) الذي عبّر عنه في مقاله المنشور عام 1955 والمعنون “طريق النمو الاقتصادي المتوازن” حيث يقول فيه بأن الإنتاج والدخول والأرباح والأجور والرواتب ورأس المال وبورصة الأوراق المالية وأسعار العقارات …إلخ سترتفع في نفس الوقت وستستفيد من هذا النمو جميع الشرائح الاجتماعية بنفس المقدار من دون ظهور أية فروقات كبيرة. وتعتبر هذه النظرية النقيض التام والكامل لما ذهب إليه كلٌ من ريكاردو وماركس عن اللامساواة وما توصّل إليه التحليل التناحري في القرن التاسع عشر.
إن أهم ما تتميّز به نظرية كوزنِتس هو أنها أول نظرية اعتمدت في هذا المجال على دراسة إحصائية مستفيضة عن توزيع الدخول في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الزمنية 1913- 1948، والتي نشرها في كتابه الصادر عام 1953 بعنوان “حصص المجموعات ذات الدخل العالي من الدخل والادخار“. وكان ذلك إسهاماً كبيراً اعتمد في طياته على مصدرين لم يكونا متاحين لكُتاب القرن التاسع عشر: أولهما بيانات ضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل الذي سُنّ في الولايات المتحدة في عام 1913، وثانيهما تقديرات الدخل القومي في الولايات المتحدة التي كان قد أعدها ونشرها كوزنِتس قبل عدة سنوات. وهكذا وُضع حجر الأساس لتقدير اللامساواة بالأرقام في أي مجتمع عن طريق اعتماد نفس المنهجية.
تعود محاولات تقدير الدخل القومي في كل من بريطانيا وفرنسا إلى نهايات القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر، إلا أن هذه المعطيات كانت دائماً مجتزأة. أما في القرن العشرين، وخصوصاً في الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين، فقد تم إعطاء هذا الأمر حق قدره، وذلك نتيجة إلحاح العديد من الاقتصاديين في أمريكا وأوربا عليه، نظراً لأهمية تقدير الدخل الإجمالي في البلد المعني. أما بالنسبة لضريبة الدخل التصاعدية، فقد سُنت القوانين بشأنها قبيل الحرب العالمية الأولى (1913 في أمريكا و1914 في فرنسا و1909 في بريطانيا و1922 في الهند و1932 في الأرجنتين). ومن المعروف أن الكثيرين لا يعرفون دخلهم بدقة، إلا عندما يضطرون إلى ملء البيان الضريبي المتعلق به. فهذه الضريبة ليست فقط الطريقة لبيان مساهمة المواطنين في تمويل تنفيذ المشاريع ذات النفع العام، وجَعْل هذا العبء على المواطن مقبولاً، بل إنها تمكّن أيضاً من خلق فروع جديدة في الاقتصاد والشؤون المالية وكذلك من إشاعة جوٍّ من الشفافية.
استطاع ‘كوزنِتس’ بالاستناد إلى السلاسل السنوية لهذه المعطيات حساب تطوّر حصة العشرة بالمائة أو الواحد بالمائة الأكثر غنىً من الدخل القومي الأمريكي السنوي. فماذا وجد ؟ لقد وجد أن اللامساواة قد تناقصت في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال الفترة الزمنية 1913-1948. ففي السنوات من 1910 وحتى 1920 كانت حصة العشرة بالمائة الأكثر غنىً حوالي 45%-50% من الدخل القومي، وانخفضت هذه الحصة في نهاية الأربعينيات أكثر من عشر نقاط مئوية إلى 30%-35%. وهذا انخفاض كبير، وهو يعادل حوالي 50% من دخل أفقر شريحة من الأمريكيين. وقد أثار تفسير هذا الانخفاض الكثير من الجدال في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية في أروقة الجامعات والمنظمات الدولية المختصة.
لقد تحدث ‘مالتوس’ و’ريكاردو’ و’ماركس’، وغيرهم، قبل عقود كثيرة، عن اللامساواة، لكن من دون أن يكون بحوزتهم أي مصدر موثوق في هذا المجال، ومن دون أن يقدموا لنا طريقة حساب تمكّننا من مقارنة فترات زمنية مختلفة، وبالتالي تقييم الفرضيات المعتمدة. أما الآن، وبفضل ‘كوزنِتس’، فقد أصبح لدينا قاعدة معلومات موضوعية عن المصادر المعتمدة (دخل الأفراد، والدخل القومي)، وطريقة حساب تمكننا من إعادة حساب معطيات أية فترة زمنية. ويضاف إلى كل ذلك أن ‘كوزنِتس’ قد بشّرنا بأن اللامساواة تتناقص!
منحني كوزنِتس البياني: خبر جيد في الحرب الباردة
كان ‘كوزنِتس’ يعرف تماماً سبب انخفاض دخل الأكثر غنىً في أمريكا خلال فترة 1913-1948، ومنها الكساد الاقتصادي الكبير في عشرينيات القرن العشرين والحرب العالمية الثانية. وهو ما ليس له علاقة بعملية اقتصادية ذاتية. وقد فصّل ‘كوزنِتس’ ذلك في كتابه الصادر عام 1953. إلا أنه قدم لزملائه خلال المؤتمر الذي ترأسه في ديترويت عندما كان رئيس رابطة الاقتصاديين الأمريكيين في عام 1954 شرحاً أكثر تفاؤلاً لاستنتاجاته الواردة في هذا الكتاب، مما أدى إلى “ولادة” ما أصبح يُطلق عليه “منحني كوزنِتس”.
يقول هذا المنحني البياني بأن اللامساواة تأخذ شكل الناقوس، أو حرف الـ U المقلوب. في كل مكان، أي أنها تزداد في البداية في سياق عملية التصنيع والتطور الاقتصادي، ثم تتناقص تلقائياً، مما يعني أن المنطق الداخلي لعملية التطور الاقتصادي لا يتأثر بأي إجراء أو تدخّل سياسي، أو بأي صدمات خارجية، بل يؤدي دائماً وفي كل مكان إلى نفس النتيجة، حتى في الدول النامية التي لا تزال تكافح ضد الفقر والاستعمار. وهكذا تتحول الوقائع التي عرضها كوزنِتس في كتابه فجأةً إلى سلاح سياسي. إذ قال لزملائه المؤتمرين بكل وضوح بأن نبوآته المتفائلة إنما تتوخّى الحفاظ على الدول النامية في مجال نفوذ “العالم الحر”. وبذلك أصبحت نظرية ‘كوزنِتس’، إلى حد بعيد، نتاجَ الحرب الباردة.
مع كل ذلك يجب القول بأن العمل الذي أنجزه ‘كوزنِتس’، أي تقدير الدخل القومي الأمريكي السنوي وإعداد سلاسل إحصائية سنوية عن اللامساواة لأول مرة، إنما هو عمل جبار. ويتضح لقارئ كتبه، وخصوصاً مقالاته، بأنه كان باحثاً من الطراز الأول. وهذا لا يغيّر في الأمر شيئاً من أن نظريته التي تعتمد على المنحني البياني آنف الذكر قد وُضعت لأسباب يحق لنا أن نشك فيها. إذ أن تناقص اللامساواة الكبير في فترة 1914-1945 في جميع الدول الصناعية يعود بشكل جوهري إلى الحربين العالميتين وما نتج عنهما من فوالق سياسية واقتصادية ضربت أول ما ضربت أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة.
تركيز التحليل الاقتصادي على مسألة التوزيع من جديد:
ازدادت اللامساواة من جديد في الدول الغنية منذ سبعينيات القرن العشرين (1970) بشكل كبير، وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصل تركيز الدخل في الفترة الواقعة بين عامي 2000 – 2010 من جديد إلى نفس المستوى القياسي الذي كان عليه في فترة 1910 وحتى 1920، أو قد تجاوزه قليلاً. لذا، من الهام أن نعرف لماذا وكيف تناقصت اللامساواة قبل ذلك. لقد أدى النمو الاقتصادي في بعض الدول النامية، وخصوصاً في الصين، إلى تقليص اللامساواة على الصعيد العالمي، دون أدنى شك. لكننا الآن، في بداية القرن الواحد والعشرين، في وضع يشبه وضعنا في القرن التاسع عشر. نحن الآن شهود تغيرات كبيرة تجعلنا غير قادرين على استقراء ما ستؤول إليه الأمور بعد عدة عقود، وخصوصاً ماله علاقة بتوزيع الثروة بين الدول وضمن الدول ذاتها. ومما لاشك فيه هو أن اقتصاديي القرن التاسع عشر قد جعلوا مسألة التوزيع هذه في بؤرة اهتمامهم. وإذا لم تكن إجاباتهم عليها مُرْضيةً دائماً، فسيبقى إنجازهم الكبير هو أنهم قد طرحوا هذا السؤال، على الأقل، وعالجوه بطريقتهم. أما نحن، فليس لدينا أي سبب يدعونا للاعتقاد بأن النمو الاقتصادي يخلق التوازن من تلقاء نفسه. لقد آن الأوان أن نطرح مسألة اللامساواة من جديد والإجابة عن الأسئلة التي بقيت من دون جواب في القرن التاسع عشر. وإذا أهمل الاقتصاديون معالجة هذه المسألة مدة طويلة، فمردّ ذلك جزئياً إلى الاستنتاجات المتفائلة التي توصل إليها كوزنِتس، وغيره، وإلى اعتماد الاقتصاديين في دراساتهم، بشكل مبالغ فيه جداً، على معادلات رياضية بسيطة لا تمثل الواقع، كما هو، في حين تبقى المعطيات التاريخية المصدر الأهم لدراسة التطور التاريخي لتوزيع الثروة.
المصادر المعتمَدة في هذا الكتاب:
تعتمد هذه الدراسة على نوعيْن من المصادر التي يمكن بواسطتهما دراسة التطور التاريخي لتوزيع الثروة، أولهما الدخل وتوزيعه غير المتساوي، وثانيهما الثروة (الأصول) وتوزيعها وعلاقتها بالدخل، حيث انصبّ الجزء الأكبر من الجهد المبذول في هذه الدراسة على تمديد وتوسيع طريقة العمل الرائدة التي اعتمدها ‘كوزنِتس’ مكانياً وزمانياً. وقد مكّننا ذلك من فهم استنتاجات ‘كوزنِتس’ بشكل أفضل، وفي نفس الوقت، الشك جذرياً في العلاقة المتفائلة التي أنشأها بين تطور الاقتصاد وتوزيع الثروة. لقد تم تطبيق طريقة ‘كوزنِتس’ على فرنسا، أول الأمر، ومن ثم على عشرين دولة من مختلف القارات، وذلك بمساعدة العديد من الزملاء الاقتصاديين في كل مكان، حيث قدّرنا دخل العشرة بالمائة أو الواحد بالمائة الأكثر غنىً من بيانات ضريبة الدخل في هذه الدول، واستقينا الدخل القومي ووسطي الدخل فيها عن طريق الحسابات الاقتصادية الإجمالية فيها. ولم يكن ذلك سهلاً دائماً، ويجري تحديث هذه المعطيات باستمرار. وهذا ما أدى إلى نشوء بنك المعلومات العالمي للدخول العالية (WTID= World Top Income Database) .
أما بالنسبة إلى المصدر الثاني، أي الثروة، فلا شك في أنها تلعب دوراً كبيراً في الحصول على الدخل. فالثروة (الأصول) تخلق الدخل أيضاً. ولنتذكَّرْ أن الدخل يتألف دائماً من مركّبتين: الدخل الناجم عن عمل (الأجور والرواتب والمكافآت. والعلاوات ..إلخ)، والدخل الناجم عن ثروة (آجار البيوت وأرباح الأسهم والفوائد المصرفية وأرباح الشركات وعوائد رأس المال ..إلخ).
وكما تمكّننا بيانات ضريبة الدخل من الوقوف على تطور اللامساواة في الدخول، فإن بيانات ضريبة الإرث (التركات) تمكننا من دراسة تطور اللامساواة في الثروة في العديد من الدول، وإن كنا لا نحصل في هذا المجال إلا على معطيات قليلة عن الإرث والادخار بالمقارنة مع المعطيات المتعلقة بالدخل. وقد توصلنا إلى أن اللامساواة ليست دائماً شيئاً سيئاً، وخصوصاً إذا كانت مبررة وهناك ما يكفي من الأسباب التي تستدعيها. (يُسمح بالفوارق الاجتماعية إذا كانت في خدمة الصالح العام فقط، المادة 1 من لائحة حقوق الإنسان والمواطنة، الثورة الفرنسية 1789)
يمكن دراسة تطور القيمة الإجمالية للدخل القومي عن طريق حصر المعطيات ذات العلاقة بالثروة (الأرض كرأسمال والعقارات والرأسمال الصناعي ورأس المال النقدي…إلخ) وتقدير علاقتها بالدخل القومي السنوي، وذلك في البلد المعني، أو على الصعيد العالمي. وقد استطعنا متابعة ذلك في فرنسا وبريطانيا، مثلاً، حتى بدايات القرن الثامن عشر. وهذا ما مكّننا من ترتيب الثورة الصناعية في سياق تاريخ رأس المال عموماً. وفي هذا السياق لا بد من ذكر الخدمات الكبيرة التي تقدمها لنا حواسيب هذه الأيام في ترتيب ومعالجة هذا الكم الهائل من المعلومات، الأمر الذي لم يكن متاحاً للاقتصاديين السابقين، إضافة إلى أن البعد الزمني الذي نتمتع به الآن قد سمح لنا رؤيةَ أحداث الماضي الاقتصادية برويّة أكبر مما فعل معاصروها آنذاك.
أهم النتائج التي تم التوصّل إليها في هذا الكتاب:
يقول الاستنتاج الأول بأنه علينا أن نتحاشى الحديث عن أي حتمية اقتصادية في هذا المجال. فتاريخ توزيع الثروة هو دائماً وأولاً وأخيراً تاريخ سياسي لا يسمح بإرجاعه إلى عمليات اقتصادية بحتة. ولم يكن تناقص اللامساواة الملاحَظ في الدول الغنية في النصف الأول من القرن العشرين (1900-1960) إلا، وبصورة خاصة، نتيجةَ الحروب والاستراتيجيات السياسية المتّبعة في أعقاب تلك الصدمات. إلا أن انتهاج سياسات مالية وضريبية مغايرة في العقود الأخيرة قد ساهم إلى حد كبير في ازدياد اللامساواة منذ السبعينيات (1970). ويتعلق تاريخ اللامساواة بتصورات الناشطين في المجتمع والسياسيين والاقتصاديين عن العدالة وعدم العدالة وبتوازن القوى فيما بينهم وبالقرارات المتخذة بالاستناد إلى ذلك. فاللامساواة هي ما يفعله كلُّ هؤلاء منها.
ينص الاستنتاج الثاني الذي يشكّل جوهر هذا الكتاب على أن هناك، في سياق القوى المحرِّكة لتوزيع الثروة، آلياتٍ قويةً تجنح إما باتجاه تقليص اللامساواة (Konvergence) وإما باتجاه تكبيرها (أو انفلاتها) (Divergence)، كما ينص على عدم وجود عملية طبيعية تعمل ذاتياً باستمرار على الحد من التوجه باتجاه عدم الاستقرار واللامساواة.
لنبدأ بالعوامل التي تشجّع على ضبط توزيع الثروة وتقليص اللامساواة. إن أهم القوى الفاعلة في هذا المجال هو نشر العلم والمعرفة وزيادة الاستثمارات في التعليم والتدريب والتأهيل. وقد يلعب العرض والطلب وانتقال رأس المال والعمل في هذا الاتجاه أيضاً، ولكن بقوة أقل وبشكل متناقض غالباً. إذ يبقى نشر العلم والتركيز على التأهيل والتدريب العامل المركزي في زيادة الإنتاجية وتقليص اللامساواة، وذلك في كل دولة على حدة، و بين الدول على الصعيد العالمي أيضاً. وهذا ما نراه حالياً في سعي عددٍ لابأس به من الدول النامية وتلك التي تقف على عتبة التطور، وفي مقدّمتهم الصين، إلى اللحاق بالدول الغنية. فعندما تقتبس هذه الدول الأقل تطوراً طرق الإنتاج المطبقة في الدول الغنية وتصل إلى مستوى التأهيل فيها، فإنها تتخلص من تخلّف إنتاجيتها وتزيد في نفس الوقت من دخلها. ويمكن لعملية خفض اللامساواة التقنية هذه أن تحصل أيضاً عن طريق سياسة الانفتاح التجاري، إلا أن ذلك يتعلق بشكل جوهري بنشر العلم، وهو المُلْك العام ذو القيمة العليا، وليس بإحدى آليات عمل السوق.
من منطلق نظري بحت، هناك عوامل أخرى تعمل باتجاه تحقيق عدالة أكبر. فمن الممكن أن نفترض أن تقنيات الإنتاج عبر التاريخ قد رفعت من قيمة عمل الإنسان والتأهيل، فزادت حصة دخل العمل بوضوح (وتناقصت حصة رأس المال بما يتوافق مع ذلك)، وهي فرضية يمكن أن نطلق عليها اسم “ارتقاء رأس المال البشري”. وبكلمات أخرى: يؤدي التطور باتجاه العقلانية التقنية ذاتياً إلى انتصار رأس المال البشري على رأس المال النقدي والعقاري، وإلى انتصار كبار رجال الأعمال القياديين المخلصين على أصحاب الأسهم ذوي الكروش، والكفاءة على الحَسَب والنَسَب. وبذلك تكتسب اللامساواة عبر التاريخ وبشكل طبيعي طابعاً يستحق التقدير لا يسعى إلى الثبات (حتى وإن كانت بارزة بقوة). فالعقلانية الاقتصادية ترفد لحد ما ذاتياً العقلانية الديموقراطية.
الافتراض المتفائل الآخر المنتشر في مجتمعاتنا الحديثة هو أن ارتفاع متوسط عمر الإنسان يؤدي ذاتياً إلى حلول “صراع الأجيال” محل “صراع الطبقات” (وصراع الأجيال صراعٌ يمزق وحدة الشعب بشكل أقل بكثير، لأن كل واحد منا شابٌ مرةً وعجوزٌ مرةً أخرى). وهكذا لا يتوقف تراكم الثروة وتوزيعها في هذه الأيام على صراعٍ لا رحمة فيه بين الأسر الوارثة وأسر أولئك الذين لا يملكون سوى قوة عملهم، وإنما على منطق التوفير طيلة الحياة: فكل واحد منا يراكم (يدّخر) بعض الثروة احتياطاً للشيخوخة. وبذلك فإن تقدم الطب وتحسين ظروف الحياة قد غيَّرا طبيعة رأس المال كليّاً.
سنرى بكل أسف أن هذين الافتراضين (ارتقاء رأس المال البشري وحلول صراع الأجيال محل صراع الطبقات) هما من ضرب الخيال. لحد بعيد. ويمكن القول بدقة أكبر: لقد حصلت هذه التغيرات المعقولة- من منطلق منطقي بحت- حقيقةً بشكل جزئي، ولكن بمستوى أقل بكثير مما نتصوَّره أحياناً. فليس من المؤكَّد أن حصة العمل من الدخل القومي قد زادت على المدى الطويل بشكل ملحوظ: ويبدو أنه لا يمكن الاستغناء عن رأس المال (غير البشري) في القرن الواحد والعشرين، كما كان عليه الأمر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ولا يمكن استبعاد أن قيمته ستزداد باضطراد. كما أن اللامساوة في الثروة هي اليوم كما كانت في الماضي، بشكل رئيس، لامساواة ضمن كل جيل. وسنرى أن للتركات في بداية القرن الواحد والعشرين قيمة مقاربة جداً لما كانت عليه أيام الأب غوريو (بلزاك) . ويبقى نشر العلم والتركيز على التأهيل القوةَ المحرِّكة الحاسمة لتسوية ظروف الحياة على المدى البعيد.
ومع ذلك، يمكن لهذه القوة الساعية إلى التسوية، ورغم أهميتها في تقليص اللامساواة بين الدول، أن تعادلها وتزيحها قوىً كبيرةٌ ومضادةٌ تؤدي إلى تكبير اللامساواة. فانعدام الاستثمارات المناسبة في التعليم والتأهيل يُسهم في عدم مشاركة مجموعات كاملة من المجتمع في النمو الاقتصادي أو في أن تحل مجموعات جديدة محلهم، بالشكل الذي نراه في سياق تطور بعض الدول النامية (عمال صينيون يحلون محل عمال أمريكيين أو فرنسيين). وبكلمات أخرى: تعمل القوة التي تسعى إلى تقليص اللامساواة- أي نشر العلم- جزئياً بشكل طبيعي وذاتي، إلا أنها تتعلق إلى حد بعيد بالسياسة المتبعة في مجالي التعليم والتأهيل وإمكانية الحصول على التأهيل اللازم ومدى توافر المؤسسات اللازمة في هذا المجال.
سنركّز اهتمامنا في هذا الملخَّص على القوى والعوامل التي تؤدي إلى تكبير اللامساواة والتي تدعو إلى المزيد من القلق في عالمٍ استثمرَ ما يكفي في مجالات التعليم والتأهيل. وتوافرت فيه، على ما يبدو، جميع مقوّمات نشوء اقتصاد سوق منتج – وفق مفهوم الاقتصاديين. ومن هذه العوامل أولاً انفصال رواتب كبار الموظفين (رجال الأعمال) عن المداخيل العادية بمقادير كبيرة، وإن كان ذلك حتى اليوم محصوراً في بعض المجالات الضيقة. ومنها ثانياً مجموعة من العوامل الناجمة عن تراكم وتمركز الثروة (الأصول) في عالمٍ يسود فيه نمو اقتصادي ضعيف، من جهة، وعائدات رأس مال عالية، من جهة أخرى. وسنرى أن لهذا العامل تأثيراً أكبر بكثير من العامل الأول في تكبير اللامساواة وأنه يمثّل بدون شك التهديد الأكبر لتطور توزيع الثروة في المدى البعيد.
لنتطرّق الآن إلى جوهر القضية. فالشكلان البيانيان 1 و 2 يمثلان تطوريْن أساسييْن سنحاول فهمهما وإيضاح معنى العوامل الكامنة وراءهما والمؤدية إلى تكبير اللامساواة. فلهذين التطورين شكل حرف U، أي أنهما يتناقصان في البداية ثم يتزايدان بعد ذلك، مما يجعلنا نعتقد أنهما يستندان إلى نفس الوقائع. إلا أن الأمر ليس كذلك. فهما ينطويان عن ظواهر متباينة تماماً تستند إلى آليات سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، إضافةً إلى أن التطور وفق الشكل الأول يمثّل وضع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، بينما يمثل التطور وفق الشكل الثاني واقع الحال في أوربا واليابان بشكل رئيس. ولا نستبعد أن يظهر هذان التطوران بما فيهما من عوامل تكبيرٍ لللامساواة خلال القرن الواحد والعشرين في هذه البلدان معاً – وسنرى أن ذلك قد حصل جزئياً بالفعل. ولو حصل ذلك على مستوى العالم بأكمله، فإن ذلك سيؤدي إلى نشوء لامساواة لم نعرفها من قبل، كما سيؤدي بصورة خاصة إلى نشوء بنية جديدة للامساواة. إلا أن هذين التطورين المدهشين يستندان حتى الآن وبشكل جوهري إلى ظواهر مختلفة.
يُظهر التطور المبيَّن في الشكل 1 المسار الذي اتخذته حصة الـ 10% الأكثر غنىً في هرم المداخيل من إجمالي الدخل الوطني الأمريكي خلال الفترة الزمنية من 1910 وحتى 2010. ويتعلق الأمر هنا بتمديد السلاسل التي اعتمدها كوزنِتس (Kuznets) في خمسينيات القرن العشرين. حيث نرى هنا ما لاحظه كوزنِتس من تراجع كبير في اللامساواة بين عام 1913 وعام 1948 وحيث انخفض نصيب الـ 10% الأكثر غنىً حوالي خمس عشرة نقطة مئوية، إذ بلغ في سنوات 1910 وحتى 1920 45-50% من الدخل القومي وانخفض في نهاية الأربعينيات إلى 30-35%، ثم استقرت اللامساواة بين الخمسينيات والسبعينيات على هذا المستوى تقريباً إلى أن بدأ منذ السبعينيات تطور سريع ومضاد بالظهور حيث بلغت حصة الـ 10% الأكثر غنىً في السنوات 2000 وحتى 2010 من جديد حوالي 45-50% من الدخل القومي. إن مقدار هذا التغير ملفت للنظر ويطرح السؤال عن المدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا التوجّه في المستقبل.
سنرى أن هذا التطور المدهش يعود في جوهره إلى الزيادة التي لا مثيل لها في مداخيل العمل المرتفعة جداً والتي تعكس قبل كل شيء انفصال أجور القياديين في الشركات الكبيرة عن المداخيل الأخرى. ويمكن أن يُفسَّر هذا التطور بازدياد مفاجئ لمستوى تأهيل وإنتاجية العناصر القيادية بالمقارنة مع جموع العمال الآخرين، إلا أن التفسير الآخر الذي يبدو لي أنه أكثر قبولاً وأكثر اتساقاً مع الوقائع المحقَّقة هو أن هذه العناصر القيادية هي التي حددت أجورها بنفسها ولنفسها إلى حد كبير- حيث بالغوا في ذلك بلا خجل- وأن زيادة دخلهم هذه لم تتوافق إطلاقاً مع زيادةٍ ملحوظة في إنتاجيّتهم الشخصية، التي يصعب تحديدها أصلاً في الشركات الكبيرة عموماً. يحصل هذا التطور بشكل رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية وبقدرٍ أقل في المملكة المتحدة، وبما ينسجم مع التاريخ الخاص للقوانين المالية والاجتماعية المعمول بها خلال القرن الأخير في هذين البلدين. أما في البلاد الغنية الأخرى (اليابان وألمانيا وفرنسا ودول أخرى في القارة الأوربية)، فقد كان هذا التوجّه أضعف، لكنه يسير في نفس الاتجاه. وستكون مجازفة لو اعتقدنا أن هذه الظواهر ستأخذ نفس البعد في كل مكان من دون تمحيص مسبق، وهذا ليس بالأمر اليسير نظراً إلى قلّة المعلومات اللازمة لذلك.
الشكل 1 من الكتاب: حصة الـ 10% الأكثر غنىً من الدخل القومي الأمريكي خلال مائة عام
الشكل 2 من الكتاب: تطور رؤوس الأموال الخاصة كنسبة مئوية من الدخل القومي في فرنسا وألمانيا وبريطانيا
(القوة الأساسية التي تشجّع على زيادة اللامساواة: r > g):
يُظهر التطور المبيَّن في الشكل 2 آلية هذه الزيادة، وهي أبسط وأكثر شفافية لحد ما، ولها دون أدنى شك قيمة أكبر فيما يتعلّق بتوزيع الثروة على المدى البعيد. إذ يبيّن هذا الشكل تطور القيمة الإجمالية للثروة الخاصة (عقارات خالية من الديون، أموال، وأملاك في شركات …إلخ) في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا من عام 1870 وحتى عام 2010 وعلاقتها بإجمالي الدخل القومي السنوي، حيث نرى قبل كل شيء ازدهار الثروات في نهاية القرن التاسع عشر وفي الفترة التي تسمى في أوربا بالعصر الجميل (Belle Epoque): فقيمة الثروة تعادل حوالي الدخل القومي لست أو سبع سنوات، وهو أمر مهم. ويلي ذلك تناقص كبير بسبب الحروب في سنوات 1914 وحتى 1948 حيث تنخفض نسبة رأس المال إلى الدخل إلى حوالي مثليْ أو ثلاثة أمثال الدخل القومي السنوي. واعتباراً من سنوات الخمسينيات تبدأ الزيادة المستمرة إلى أن تصل الثروات الخاصة في بدايات القرن الواحد والعشرين من جديد إلى المستوى العالي الذي كانت عليه قبل الحرب العالمية الأولى: ففي سنوات الـ 2000 وحتى الـ 2010 وصلت نسبة رأس المال إلى الدخل من جديد مستوى الخمسة أضعاف إلى الستة أضعاف إجمالي الدخل القومي السنوي في المملكة المتحدة وفرنسا. (كانت أصغر قيمة في ألمانيا حيث كان مستوى البداية أصغر، إلا أن المنحى العام هنا أيضاً واضح تماماً).
يتطابق هذا المنحني البياني ذو شكل الحرف U الواضح جداً مع تغيّر هام جداً، إذ أننا نجد بصورة خاصة أن زيادة الثروة الكبيرة الملاحظة في العقود الأخيرة بالنسبة إلى الدخل القومي قد نجمت عن نمو اقتصادي بطيء نسبياً. ففي المجتمعات ذات النمو الضعيف تكتسب الثروات الموروثة أهمية قصوى غير متناسبة، حيث يكفي ادخار مبلغ صغير جديد لزيادة رأس المال بشكل جوهري ومستمر.
وعلاوة على ذلك، إذا كانت عائدات رأس المال أكبر بكثير من معدل النمو الاقتصادي باستمرار (وهذا لا يحصل ذاتياً وإنما باحتمال أكبر عندما يكون معدل النمو ضعيفاً)،فإن خطراً كبيراً يتهددنا في أن يصبح توزيع الثروة أكثر تبايناً.
ستلعب هذه اللامساواة الأساسية التي نعبّر عنها بالمتراجحة التالية:( r > g ) في هذا الكتاب دوراً كبيراً، – حيث r هي عائد رأس المال (أي وسطي ربح رأس المال السنوي متضمناً الأرباح والفوائد وأرباح الأسهم والآجار وأية مداخيل رأس مال أخرى، كنسبة مئوية من رأس المال الموظَّف)، و g معدل النمو الاقتصادي (أي النمو السنوي للمداخيل والإنتاج)-. وتختصر هذه المتراجحة، لحد ما، الحجة التي ينادي بها (مؤلف الكتاب).
فعندما يكون عائد رأس المال أكبر من معدل الإنتاج بشكل واضح- وسنرى أن ذلك كان هو واقع الحال عبر التاريخ، أو على الأقل حتى القرن التاسع عشر، وأنه سيكون كذلك أيضاً على الأغلب في القرن الواحد والعشرين- فإن ذلك يعني ذاتياً أن الثروة الموروثة ستزداد بسرعة أكبر من الإنتاج والمداخيل. وما على الوَرَثة سوى ادّخار جزء بسيط من عائدات رأسمالهم حتى ينمو رأسمالهم بشكل أسرع من إجمالي الاقتصاد. ولا يمكننا تفادي أن تلعب الثروة المتوارثة دوراً أهم بكثير من الثروة الناجمة عن العمل طيلة الحياة، في مثل هذه الظروف، وأن يصل تمركز رأس المال إلى مستويات لم تعد تنسجم إطلاقاً مع مبدأ تقدير الإنسان حَسْب ما يؤديه من عمل، ووفق أسس العدالة الاجتماعية، وهي المبادئ التي تشكل أساس مجتمعاتنا الديموقراطية الحديثة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض الآليات الأخرى أن تقوّي من شكيمة هذه القوة المشجِّعة على ازدياد (انفلات) اللامساواة كأن تزداد مبالغ التوفير باضطراد مع ازدياد مستويات الثروة. وأكثر من ذلك، عندما يصبح وسطي عائد رأس المال أكبر، كلما كان رأس المال الابتدائي أكبر (سنرى أن ذلك هو واقع الحال دائماً على ما يبدو). ويمكن للطابع الطارئ والعشوائي لعائدات رأس المال وأشكال زيادة الثروة الناجمة عنه أن يكون مناسباً للتشكيك في المَثل الأعلى لمجتمعنا القائم على تقدير الإنسان وفق ما يؤديه من عمل. ويمكن لجميع هذه المؤثّرات أن تصبح أقوى بواسطة الآلية التي عبّر عنها ريكاردو في “مبدأ الندرة”: حيث يمكن للارتفاع الكبير في أسعار العقارات أو البترول أن تعزّز تلك القوة التي تشجع على ازدياد اللامساواة بنيوياً.
وباختصار: تشتمل عملية تراكم الثروة وتوزيعها على قوىً كبيرةٍ تعمل على زيادة اللامساواة، أو أنها تؤثر بشكل كبير في هذا الاتجاه على الأقل. وهناك أيضاً قوى تعمل باتجاه تقليص اللامساواة وتنجح في ذلك في بعض البلدان وفي بعض الأزمان. إلا أن القوى المضادة قادرة دائماً على أن تفرض نفسها من جديد، كما يبدو أنه واقع الحال في بداية القرن الواحد والعشرين، وما يقرّب ذلك إلى الأذهان هو التراجع المحتمل لكلٍّ من النمو السكاني والنمو الاقتصادي في العقود القادمة (في دول غربي أوربا).
لا تتنبأ الاستنتاجات التي توصلتُ إليها بـ”نهاية العالم”، كما فعلت الاستنتاجات التي نجمت عن مبدأ التراكم اللامحدود وازدياد اللامساواة الدائم الذي اعتمده ماركس (إذ تستند نظريته إلى الافتراض الضمني بانعدام نمو الإنتاجية لمدةٍ طويلة). أما ازدياد اللامساواة الوارد في هذه الدراسة، فهو غير دائم، وهو إمكانية مستقبلية واحدة من بين عدّة إمكانات. ومع ذلك فإن استنتاجاتي لا تدعو إلى السرور. فمن الهام جداً أن نعرف أنه ليس للمتراجحة الأساسية ( r > g)، التي تُعَدّ في هذه الدراسة مسؤولةً بشكل رئيس عن اللامساواة، أية علاقة بالسوق غير الكامل. إذ بالعكس، كلما كان سوق رؤوس الأموال أكثر كمالاً، وفق مفهوم الاقتصاديين، كلما فرضت اللامساواة نفسها بشكل أقوى. إلا أنه يمكننا أيضاً أن نتصور اجتراح سياسات ومؤسسات ملائمة للتصدي لهذا المنطق الصارم، كأن نفرض ضريبة تصاعدية على رؤوس الأموال على مستوى العالم، وإن ترافق اعتمادها مع مشكلات تنسيق دولية كبيرة. إلا أننا نخشى، بكل أسف، أن تبقى هذه الإجراءات عملياً متواضعة جداً وذات فاعلية قليلة، وأنها قد تأخذ طابع الانعزال الوطني، من دون تنسيق مع الآخرين.
الضريبة التصاعدية المقترحة على رؤوس الأموال:
يقودنا التفكير ملياً بما ورد أعلاه إلى استقاء الدرس العام الذي يقول بأن القوى المحركة لاقتصاد السوق المعتمِد على المُلْكية الخاصة، والمتروك لحاله، تطور قوى تسعى إلى خفض اللامساواة عن طريق نشر المعرفة والاهتمام بالتدريب والتأهيل، من جهة، لكنها تطور أيضاً قوى تسعى إلى زيادة اللامساواة لدرجة أنها تهدد مجتمعاتنا الديموقراطية وتلك العدالة الاجتماعية التي تعتبر إحدى مقوّماتها، من جهة أخرى.
تكمن أكبر قوة قادرة على زعزعة استقرار بلدٍ ما في أن تكون عائدية رأس المال الخاص فيه (r) لمدة طويلة أكبر من معدل نمو الدخل والإنتاج (g).
تؤدي المتراجحة ( r > g) إلى جعل الثروات الموروثة من الماضي رأسمالاً، وذلك بسرعة أكبر بكثير من نمو الأجور والإنتاج. وهي تعبّر بذلك عن التناقض الجوهري الذي يلازم الرأسمالية دائماً وأبداً. وكلما كان ذلك أوضح للعيان، كلما استطاع الرأسمالي ممارسة سلطة أكبر على أولئك الذين لا يملكون سوى قوة عملهم. فعندما يتواجد رأس المال، فإنه يعيد إنتاج نفسه بنفسه، وبسرعة أكبر من نمو الإنتاج. وهكذا يفترس الماضي المستقبل.
تعتبر عواقب ديناميّة توزيع الثروة بعيدة المدى أمراً مرعباً، وخصوصاً إذا ترافقت هذه العملية بزيادة عائدية رأس المال، كلما كان رأس المال الابتدائي أكبر، وكلما ازدادت الهوة بين الثروات على الصعيد العالمي.
لا يوجد حل بسيط للتغلّب على هذه المعضلة. إذ يمكن تشجيع النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الاستثمارات في التعليم ونشر المعرفة وفي التقنيات الصديقة للبيئة، إلا أن معدل النمو لن يصل بذلك إلى حدود 4%-5% بالسنة، ولم يكن هذا ممكناً إلا في الدول الأوربية بعد الحرب العالمية الثانية، والآن في الدول النامية التي تسعى إلى اللحاق بالدول الغنية كالصين، ولكن ليس في الدول التي وصلت إلى حدها التقني العالمي، بعد أن صنّعت كل ما يمكن تصنيعه. وهذا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن معدل النمو الاقتصادي في العالم لن يزيد، يوماً ما، عن 1%-1.5% بالسنة.
وإذا كان معدل عائدية رأس المال 4%-5%، فهذا يعني أن المتراجحة ( r > g ) ستكون على الأغلب القاعدة في القرن الواحد والعشرين، كما كانت عليه أيضاً خلال كامل التاريخ وحتى الحرب العالمية الأولى. ولم يغيّر من ذلك سوى حروب القرن العشرين التي قلّصت عائدية رأس المال بشكل كبير، فخلقت وهم التغلّب على الرأسمالية وعلى ذلك التناقض البنيوي الذي يكتنفها.
من الممكن فرض ضريبة عالية على عائدية رأس المال بحيث تصبح هذه العائدية أصغر من معدل النمو الاقتصادي، إلا أننا إذا فعلنا ذلك، فسنكون قد خنقنا محرك النمو ومعدل النمو في نفس الوقت.
لذلك نرى أن الحل الأفضل يكمن في فرض ضريبة تصاعدية سنوية على رؤوس الأموال، تتفادى دوران لولب اللامساواة نحو الأعلى إلى ما لانهاية، ولا تضر بقوى التنافس، وتحفِّز على التراكم من جديد، كأن تبلغ مثلاً 0.1%-0.5% سنوياً على ثروة مقدارها أقل من مليون وحدة نقدية، و 1% على ثروة بين مليون واحد و5 ملايين، و2% على ثروة مقدارها بين 5 ملايين و10 ملايين، و5% – 10% على ثروة من عدة مئات من الملايين أو المليارات. فمثل هذه الضريبة ستحدّ من نمو اللامساواة اللامحدود الذي نشاهده في هذه الأيام على الصعيد العالمي دون أي ضابط، والذي لن يكون قابلاً للاحتمال في المدى البعيد، وإنما سيؤدي إلى إقلاق حتى أولئك المتحمسين إلى فكرة أن السوق الحر ينظم نفسه بنفسه تلقائياً. وقد علمتنا التجربة التاريخية أنْ ليس لمثل هذه اللامساواة أي علاقة بروح العمل والإقدام على المجازفة، بل إنها تؤدي في نهاية المطاف إلى خنق النمو وبالتالي إلى الإضرار بالصالح العام.
تكمن صعوبة فرض مثل هذه الضريبة التصاعدية السنوية في أنها تحتاج إلى مستوىً عالٍ من التعاون الدولي والتكامل السياسي الإقليمي الذي لن تكون بعض الدول القومية مستعدة له خشية فقدان بعض الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال على الصعيد الوطني. وعلى الرغم من كل ذلك يبدو لي أنه لايوجد وسيلة أخرى لضبط الرأسمالية وتشذيبها سوى أن نقيس كل شيء بمقياس الديموقراطية والنفع العام، وخصوصاً في دول الاتحاد الأوربي التي ستبدو أصغر وأصغر على خارطة الاقتصاد العالمي في المستقبل. فالتكامل السياسي الإقليمي في إطار الديموقراطية هو الذي سيفتح وحده آفاق لجم الرأسمالية المعولمة في هذا القرن.
كلمة أخيرة:
كلمة أخيرة عن علاقة الاقتصاد بالعلوم الاجتماعية، فليس هناك من مكان أفضل للاقتصاد من أن يكون واحداً من هذه العلوم. لذلك لا أفضّلُ استخدام تعبير “علم الاقتصاد” لأنه ينطوي عن تعالٍ وتعجرف غير مبررين، وخصوصاً عندما يجنح الاقتصاديون في دراساتهم إلى الاستقلالية وإلى استخدام المعادلات الرياضية المجردة التي لا تعني في المحصلة شيئاً كثيراً، نظراً لأنها تُبعدهم عن الواقع وتطوره التاريخي، فالتاريخ هو منبع معلوماتنا ومعطياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي لا غنىً عنها عندما نجتهد في استقاء الدروس من أجل المستقبل. لذلك فإنني أفضّل استخدام تعبير “الاقتصاد السياسي”، رغم قدمه، وذلك لأنه يذكّرنا بالمجتمع ودور الدولة وقراراتها السياسية التي تؤثر في الاقتصاد بشكل مباشر، وكذلك بدور المواطن وتفاعله مع هذه القرارات. إذ لا يجوز أن يكون هناك حفنة من السياسيين والاقتصاديين الذين يتخذون القرارات، وفي نفس الوقت جمهورٌ عريض من المتفرجين أو حتى الناقدين. يجب على الاقتصاديين أن يتعلموا من نتائج أبحاث العلوم الاجتماعية والسياسية والتاريخية، كما على المختصين بهذه العلوم ألا يتركوا الاقتصاد للاقتصاديين لوحدهم.
المصدر: الحوار المتمدن

التعليقات مغلقة.