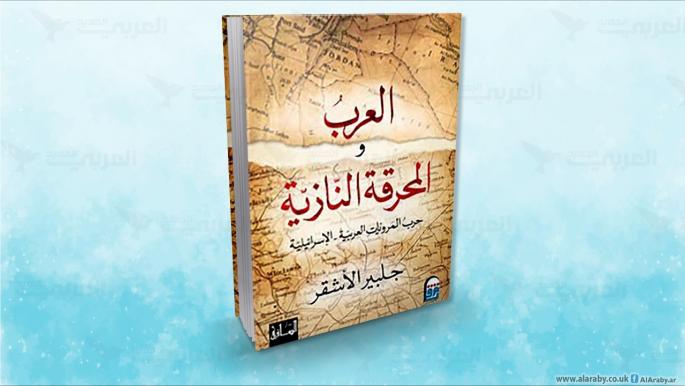
جلبير الأشقر *
يُدرك كل تلميذ أكمل المدرسة باللغة العربية أن منطق العصبية القبَلية الذي ساد في العصر الجاهلي يتلخّص بمبدأ “انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً” (وهي المقولة التي قلبها رأساً على عقب حديثٌ نبوي شهير ليمنحها معنى سامياً). وللأسف، فإن المنطق الجاهلي المتخلّف ما زال واسع الانتشار في منطقتنا، يتلازم مع بقاء أساسه الاجتماعي، أي العلاقات القبَلية، ويتنازع مع مبدأ نصرة الحقّ ضد الظالم، حتى لو كان الظالم أخاك (الذي ينبغي عليك في هذه الحالة أن تمنعه من الظلم، بحسب الحديث النبوي). وتشكّل مسألة أمين الحسيني مثالاً ساطعاً على ذلك، إذ ما زلنا نجد، بين حين وآخر، مَن ينتصر لهذا الرجل، بالرغم من أنه قدّم للصهيونية خدمة عظيمة بالتحاقه بألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية في عام 1941، وعمله في خدمة النظامين الكريهين، متنقّلاً بين برلين وروما حتى نهاية الحرب العالمية.
من المعلوم أن المندوب السامي البريطاني في فلسطين، هربرت صموئيل، وهو صهيوني بامتياز وأحد الضالعين في إصدار “وعد بلفور” المشؤوم، هو الذي عيّن أمين الحسيني، بل فرضه، في منصب “المفتي الأكبر” لفلسطين في عام 1921، عندما كان الحسيني شابّاً بلا مؤهلاتٍ علميةٍ لمثل هذا المنصب الرفيع، وقد بلغ لتوّه سنّ السادسة والعشرين! وطوال المدة التي سبقت “الثورة الكبرى” في عام 1936، ترأس الحسيني “المجلس الإسلامي الأعلى” الذي أنشأته سلطات الانتداب البريطاني، وأشرفت عليه وموّلته. وكان يُفيد سلطات الانتداب بسعيه إلى توجيه النقمة الشعبية ضد اليهود حصراً، وكأن الانتداب براءٌ من هجرتهم الاستيطانية. في هذه الفترة، كان الحكم السعودي يشجّع الحسيني على التعاون مع الاستعمار البريطاني، إذ كان الرجل قد عقد علاقة وطيدة مع السعوديين.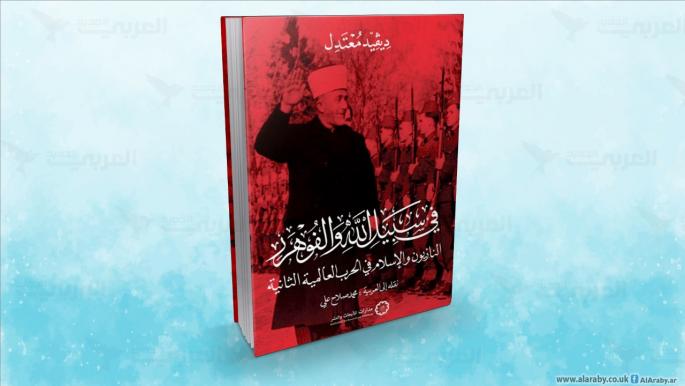
وكان من الطبيعي خلال هذه المرحلة أن تُخاصمه القوى الوطنية والعروبية الفلسطينية، سيما حزب الاستقلال الذي هاجم الحسيني لتعاونه مع الاستعمار ولممارسته المحسوبية في إدارة المؤسسات. هذا وقد بدأ الحسيني، على غرار أصدقائه السعوديين، ينسج علاقاتٍ مع ألمانيا إثر استيلاء النازيين على السلطة فيها في عام 1933، بالرغم من علمه الأكيد أن السلطات النازية تعاونت منذ قيامها مع الحركة الصهيونية على تنظيم تهجير اليهود الألمان إلى فلسطين، وهو تعاونٌ استمرّ حتى عام 1941 (حتى أن المخابرات الألمانية ساعدت الحركة الصهيونية على تنظيم نقل سرّي لليهود الألمان إلى فلسطين بعدما فرضت بريطانيا قيوداً على الهجرة اليهودية في عام 1939).
وقد ساءت علاقة الحسيني بالبريطانيين بعد أن بدأت صلته بالألمان، ثم أخذت تتدهور مع انفجار “الثورة الكبرى” في فلسطين، عندما شكّلت الأحزاب الوطنية الفلسطينية “اللجنة العربية العليا”، وأوكلت رئاستها إلى الحسيني. وبعد أن لعب دوراً مركزياً في إجهاض الإضراب العام في سنة 1936، بما أثار سخط القوى الوطنية، انحطّت علاقته بالبريطانيين على خلفية تجدّد الانتفاضة الشعبية ضدّهم في عام 1937 بعد نشر تقرير أعدّته لجنة تحقيق موفدة من لندن، دعا إلى تقسيم فلسطين، فحلّت سلطات الانتداب “اللجنة العربية العليا”، واعتقلت جملة من أعضائها، أما الحسيني فتمكّن من الفرار، وغادر فلسطين إلى لبنان ومن ثم العراق، حتى بلغ أوروبا.
وقد تحوّل هناك إلى بوقٍ للدعايتين، الفاشية والنازية، باتجاه العرب والمسلمين على موجات إذاعتي روما وبرلين، وسعى جهده ليساعد الألمان على تجنيد عربٍ ومسلمين للقتال تحت إمرتهم. بيد أن مجهوده ومجهود النازيين لم يفلحا سوى في تجنيد مسلمين من غير العرب. أما العرب بوجه عام، والفلسطينيون بوجه خاص، فيكاد لا يُذكر من لبّى منهم دعوة الحسيني، بينما حارب عددٌ منهم أكبر بما لا يُقاس في صفوف الحلفاء في حربهم ضد النازيين ومن لفّ لفّهم. وقد تبنّى الحسيني بالكامل الخطاب العنصري النازي المعادي لليهود، إلى حدّ أنه، في رسالة نشرها هو نفسه في مذكّراته، دعا الحكومة المجرية حليفة النازيين ليس إلى منع اليهود من الهجرة إلى فلسطين وحسب (وهي دعوة مشروعة)، بل إلى إرسالهم عوض ذلك إلى بولندا حيث كانت معسكرات الاعتقال النازية.
هذا وقد فرّ الحسيني من أوروبا مع نهاية الحرب، ولجأ إلى مصر، إلى أن اضطرّ إلى مغادرتها في عام 1959 بعد دخوله في نزاع مع حكم جمال عبد الناصر، فأنهى حياته في لبنان حيث توفي في عام 1974. وقد استمرّ في رفض الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثّلة الشعب الفلسطيني، حتى بعد أن استولت منظمات الكفاح المسلّح على مقاليدها إثر حرب 1967، لا بل دخل أحد أقرب أعوانه الحكومة الأردنية وبقي عضواً فيها عندما شنّت المملكة الهاشمية هجومها الدامي على المقاومة الفلسطينية في عام 1970.
وقد بات الحسيني رمز الهزائم والسياسات المغلوطة، تكمن إساءته العظمى للنضال الفلسطيني في تحوّله إلى خدمة النازيين والفاشيين، موفّراً للدعاية الصهيونية حجّةً استخدمتها بكثافة، وما زالت تستخدمها في وصمها الفلسطينيين بأنهم كانوا أجمعين من أنصار النازية. وهي كذبة كبرى، تناقضها دراسات عديدة أشارت إلى أن غالبية الرأي العام والنخبة السياسية الوطنية في فلسطين لم تؤيد النازيين وحلفاءهم خلال الحرب العالمية، بالرغم من معارضتها الانتداب. ولو كان شعب فلسطين مؤيداً للنازيين للبّى دعوة الحسيني وحمل السلاح ضد البريطانيين خلال الحرب نصرةً للألمان، بينما الحقيقة أن دعوات الحسيني من برلين وروما بقيت من دون مفعول.
هذه الأمور مشروحة في كتابي “العرب والمحرقة النازية: حرب المرويات العربية-الإسرائيلية” (ترجمة بشير السباعي، دار الساقي، بيروت. والمركز القومي للترجمة، القاهرة، 2010) الذي يتناول بالتفصيل والتوثيق، بين أمور أخرى عديدة، مسيرة الحسيني الملخّصة أعلاه، حيث إن غاية الكتاب هي دحض الدعاية الصهيونية ومرويتها لتاريخ النزاع العربي – الصهيوني. والحال أن التصدّي لتلك الدعاية، كما يدرك المتنوّرون الفلسطينيون والعرب، يقتضي التصدّي لمحاولتها تلبيس الجانب العربي ثوب النازية. ومن المؤسف أن بعض العرب يقعون في فخّ الصهيونية، فيؤكّدون دعايتها الكاذبة سواء بإنكارهم حقيقة إبادة النازية اليهود (والمفارقة أن الحسيني لا ينكرها، بل يؤكدها في مذكّراته) أو بالانتصار للحسيني بما يؤكد الادّعاء الصهيوني بأنه يمثّل الفلسطينيين، بل العرب والمسلمين.
إلى هذه الفئة الأخيرة، ينتمي صقر أبو فخر الذي كتب مقالاً طويلاً نُشر في “العربي الجديد” (28/2/2022)، تحت عنوان “الافتراء على الحاج أمين الحسيني في ميزان الوقائع”. والمقال مخصّص، بالدرجة الأولى، لمراجعة كتاب للمؤرّخ البريطاني من أصل إيراني، ديفيد معتدل، صدر في العام الماضي في القاهرة بترجمة عربية. وقد انتهز أبو فخر هذه المناسبة لإيراد جملة تعليقات نابية على كتابي، منصّباً نفسه محامياً عن الحسيني، ومتخطّياً ذلك إلى ممارسة ما أراد أن يردّه عن الحسيني، ألا وهو الافتراء. وسوف أكتفي هنا بتعليق سريع على تعليقات أبو فخر، والحقيقة أنه لولا كانت هذه مناسبةً لتوضيح الأمور بما يخص الحسيني نفسه، لما اكترثت لمذمّة أبو فخر لي.
يبدأ أبو فخر هجومه عليّ بالقول إنه “ليس صحيحاً على الإطلاق أن المفتي هو أحد أكبر منظّمي الهزائم لشعبه” كما بيّنتُ في كتابي، بل يردّ قائلاً إن المسؤولين عن الهزيمة هم الأوروبيون، والبريطانيون بالأخصّ. كان بإمكانه بهذا المنطق ذاته أن يضيف الصهاينة، وهو منطقٌ معهودٌ يفسّر الهزيمة بقوة الأعداء ليبرّئ القيادات أو الحكومات من مسؤوليتها في الهزيمة، فيرى أبو فخر أن الحسيني لم يُخطئ في رفضه “الكتاب الأبيض” الذي وافق عليه البرلمان البريطاني في عام 1939، والذي تخلّى عن فكرة تقسيم فلسطين وتبنّى فكرة دولة مستقلة واحدة يشارك اليهود في حكمها بحسب نسبتهم من السكّان، مع تقييد فوري للهجرة اليهودية.
أما حجة أبو فخر فهي أن سائر أعضاء “اللجنة العربية العليا”، الممثلة الرسمية للفلسطينيين، أيّدوا “الكتاب الأبيض” كما شرحتُ في كتابي، فيضيف: “ماذا كانت نتيجة الموافقة؟ لا شيء. ولم تنفّذ بريطانيا بنود كتابها ذاك. وهو يتغافل عن أن الرجال المذكورين تكلّموا بصفاتهم الشخصية، محاولين إقناع الحسيني، وقد انصاعوا إلى الموقف الذي فرضه عليهم وأعلنه باسم “اللجنة العربية العليا” بسلطويةٍ انفراديةٍ باتت معهودة، إذ مارسها لاحقاً غيره من زعماء الحركة الوطنية الفلسطينية. هكذا ضيّعت الحركة، بسبب الحسيني، الفرصة التي شكّلها “الكتاب الأبيض” لاستمالة البريطانيين إلى الموقف الفلسطيني في وجه الصهاينة، علماً أن هؤلاء الأخيرين رفضوا الكتاب رفضاً مُطلقاً، وتحوّل جناحهم اليميني المتطرّف (الذي يعود أصل حزب الليكود إليه) إلى ممارسة عمليات إرهابية ضد سلطات الانتداب.
وببساطة، وقع أبو فخر في فخّ توكيد الدعاية الصهيونية بتصويره الحسيني وكأنه كان ممثلاً للحركة الوطنية الفلسطينية لا نزاع حوله، في حين كان رجلاً خلافياً إلى أقصى حدّ، دانه سائر رجالات الحركة الوطنية الفلسطينية الذين عاصروه، أمثال أكرم زعيتر وأحمد الشقيري. بل يذهب أبو فخر إلى أبعد في توكيد الدعاية الصهيونية بتصوير الفلسطينيين وكأنهم “مالوا” إلى المحور النازي، وهو ما فنّدته دراسات عديدة. فيكتب: “أما الميل الفلسطيني إلى دول المحور، خلافًا لأطروحات ديفيد معتدل وجلبير الأشقر، فقد نشأ جرّاء سياسة بريطانيا في رعاية الحركة الصهيونية وتسهيلها الهجرة اليهودية. وبهذا المعنى، كان التعاطف الفلسطيني مع ألمانيا من طرائق التعبير عن العداء للبريطانيين. ومعظم أعلام الحركة القومية العربية في تلك الحقبة رأوا أن من شأن هزيمة الحلفاء في الحرب أن يخلّص العرب من الاستعمارين، البريطاني والفرنسي، ويوقف الهجرة اليهودية، ويمنع قيام دولة يهودية في فلسطين”. لم ينتبه أبو فخر إلى أن معتدل تجاهل كتابي، مكتفياً بذكره في هامشٍ طويلٍ بين مراجع أخرى عديدة. ولو قرأ أبو فخر كتابي أو فهمه لأدرك أنني دحضت الزعم الصهيوني بوجود “ميل فلسطيني إلى دول المحور”، والحال أن ما ينسبه هو إلى “معظم أعلام الحركة القومية العربية” من مراهنة على فوز النازيين إنما يتناقض مع الحقيقة التاريخية التي بيّنتها في كتابي.
ثم يخلط أبو فخر بين بعض الأوصاف التي استخدمتها في حديثي عن الحسيني استناداً إلى حجج واضحة واستخدامي تعبير “أحد شياطين العصر” الذي ينسبه إليّ بقصر نظر عجيب، إذ كيف يمكن لمن يعرف كتاباتي أن يعتقد، ولو للحظة واحدة، أنني من الذين يستخدمون تعبير “الشيطان” في وصف أي إنسان كان. والحقيقة أنه لو أحسن القراءة ولم يعزل العبارة عن سياقها، لأدرك أنني أشرت بها إلى “شيطنة” الحسيني من الدعاية الصهيونية. والعبارة في سياقها تأتي في مستهلّ قسم من أقسام الكتاب، قائلة: “لا شك في أن محمد أمين الحسيني هو أحد أبرز الأسماء المدرجة على لائحة شياطين العصر”. ولا يحتاج المرء إلى كثيرٍ من الفطنة ليفهم المقصود.
وفي تناولي الشيطنة الصهيونية للحسيني ودحضي أبرز مزاعمها، ولا سيما تصويرها له كمُشارك مباشر في هندسة إبادة اليهود، وهو الافتراء بعينه، أوردت زعمَين منتشرَين في الأدبيات الصهيونية، لأؤكّد أن لا أساس لهما من الصحة، كما يذكر أبو فخر نفسه. لكنّه يسأل مع ذلك: “لماذا إذاً يسرد جلبير الأشقر مزاعم وخرافات عن الحاج أمين الحسيني (مع إشارته الخجولة إلى أنها مزاعم لم تثبت صحتها؟).” ويبدو أن أبو فخر لم يفطن إلى الإجابة البديهية عن سؤاله التي هي أن كتابي مخصّصٌ لاستعراض عناصر المروية الصهيونية كافة ودحضها، فيتابع بالغاً حضيض أساليب النقاش ليعلّق: “يمكن تقليد هذه الطريقة البائسة بالقول إن جلبير الأشقر التقى أريئيل شارون قبيل مجزرة صبرا وشاتيلا، ثم التقى باروخ غولدشتاين قبيل تنفيذه مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل، غير أن هذه الأخبار لم تثبت صحتها”. وأترك للقراء تقدير هذه الطريقة بالغة الابتذال، فهي لا تستحقّ المزيد من التعليق.
ثمّ يواصل أبو فخر قائلاً: “والعجيب أن الأشقر يظهر في كتابه المذكور ليّنًا مع الصهيونية وإسرائيل، وقاسيًا جدًا مع الحاج أمين الحسيني وفوزي القاوقجي ورشيد عالي الكيلاني.” هنا تكتمل لدى أبو فخر نفسه ممارسة الافتراء الذي نصّب نفسه مفنّداً له، والحال أن كتابي تعرّض إلى هجومات صهيونية مسعورة أخذت عليه عداءه الصهيونية وتصويره دولتها على حقيقتها دولة قائمة على العنصرية والاستعمار الاستيطاني واقتلاع شعب فلسطين من أرضه. أما رشيد عالي الكيلاني وفوزي القاوقجي، فلو أحسن أبو فخر القراءة، لانتبه إلى أنني دافعت عنهما خلافاً لما فهِمَ، أو ظنّ من دون أن يقرأ.
العصبية الجاهلية، إذ تشكّل إحدى مصائب قومنا، هي بالطبع مما تفيد منه الصهيونية، وتُضعف حجّتنا أمام الرأي العام العالمي. وقد تقلّصت في صفوف المثقفين الفلسطينيين والعرب منذ الستينيات والسبعينيات، لكنّها لم تختفِ، لا سيما أنها بقيت منتشرةً في المجتمع الأوسع، فنراها بالتالي تطلّ علينا بين الحين والآخر بزيّ ثقافي، ولا بدّ من التصدّي لها في سبيل معركتنا الكبرى.
* كاتب وأكاديمي لبناني
المصدر: العربي الجديد

التعليقات مغلقة.