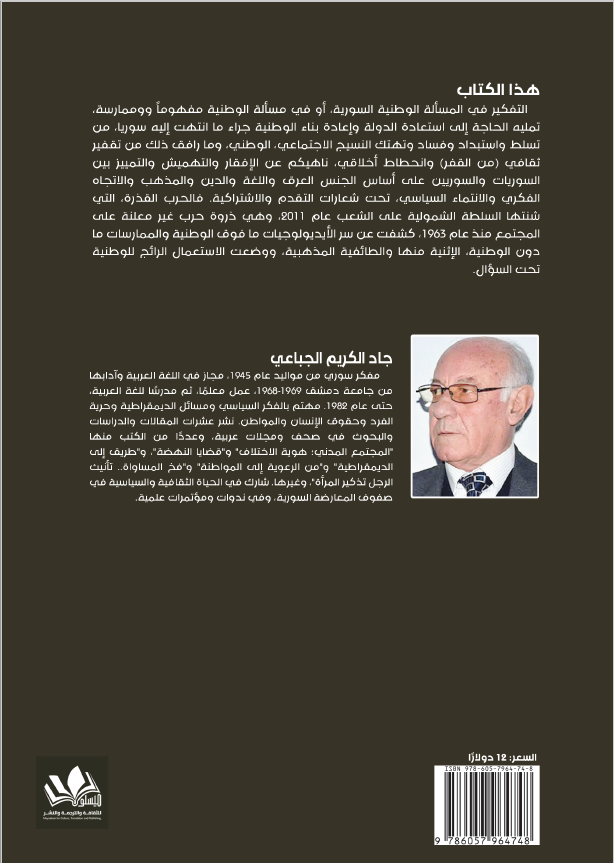
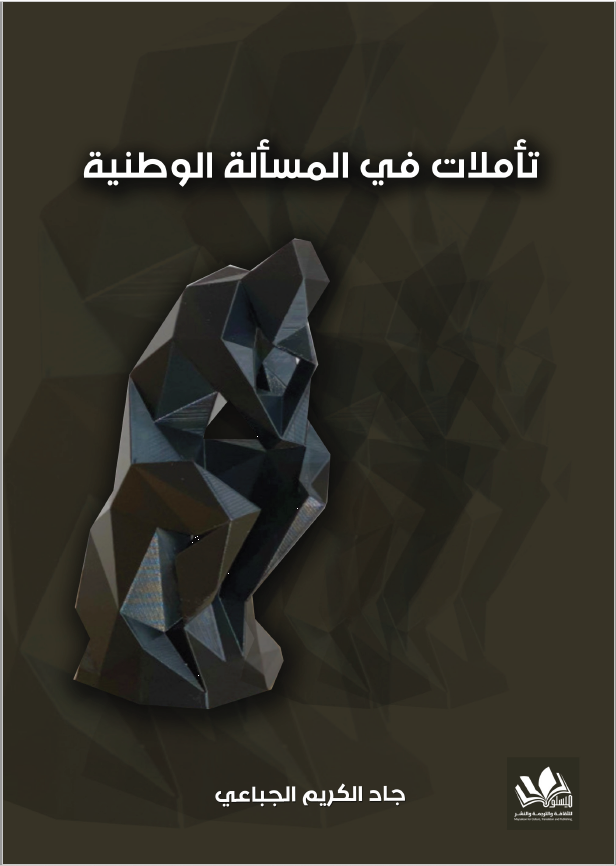
( الحرية أولاً ) ينشر كتاب «تأملات في المسألة الوطنية» كاملاً “على حلقات” للكاتب الأستاذ: ’’جاد الكريم الجباعي‘‘.. الحلقة الثانية عشرة والأخيرة: الاندماج الاجتماعي في الفكر العربي المعاصر
الاندماج الاجتماعي في الفكر العربي المعاصر:
الاندماج الاجتماعي هو الاسم الآخر للمواطنة المتساوية والتشارك الحر في إنتاج الوطن وإنتاج العالم، والصفة المرادفة للتماسك الاجتماعي لمجتمع جيد التنظيم، ولعلّه علامة على جودة التنظيم الاجتماعي وكونه فضاء من الحرية. شحوب هذا المفهوم في الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة، ولا سيما في الثقافة السورية، ينم على شحوب الفكرة الوطنية والتباسها بالفكرة الإثنية، في إهابها الديني- المذهبي، أو التباسها بالفكرة الدينية في إهابها الإثني، العربي، بحكم علاقة الارتباط «التاريخية» المفترضة بين العروبة والإسلام، إسلام المتكلم/ـة، وفقًا لتاريخ تصوري، مكتوب بلغة الأهواء. المفكرون الباحثون والكتاب العرب لم يتناولوا قضية الاندماج الاجتماعي إلا لمامًا، ومن تناولها منهم عالجها في إطار «المجتمع العربي» الأوسع أو الأكبر، ومن منظور الوحدة العربية، أو في إطار «مشروع النهضة العربية»، أو «التحول الديمقراطي»، كياسين الحافظ وعزمي بشارة وحليم بركات وهشام شرابي وغسان سلامة ومحمد عابد الجابري وعبد الله العروي وبرهان غليون وإسماعيل صبري عبد الله وغيرهم، على اختلاف رؤاهم.
امتاز ياسين الحافظ بإيلاء هذه القضية أهمية تستحقها في ما سماه مشروع «الثورة القومية الديمقراطية ذات الأفق الاشتراكي». وقد عبر الياس مرقص عن ذلك بقوله: «كان فكر ياسين الحافظ محاولة جادة لقراءة العالم، الواقع، الوطن والشعب، التاريخ والبشرية. علمانيته كانت هذا أولً: الاعتراف بالعالم الزمني اعترافًا أوليًا ونهائيًا، فهمه وفهم ضروراته شرطًا لتغييره. هذا ما يؤسس العلمانية بالمعنى (الآخر)، المعلوم، فصل «الدين» و«الدنيا»، علمنة المجتمع العربي والدولة، عتق الإنسان كإنسان والمواطن كمواطن، تجاوز فكرة الأقلية والأكثرية، تجاوز الطوائف إلى المجتمع والفرد»(159).
لعل تعريف ياسين الحافظ للتجزئة القومية بأنها «حصيلة وضع التأخر التاريخي للأمة العربية والأوضاع الإمبريالية التي نشأت عنه»(160)، يحدد معنى «الاندماج القومي» وحدوده في ترسيمته الفكرية. فإن «نقص الاندماج القومي» أو «التكسر الاجتماعي الصلبي»، عنده من أبرز تظاهرات التأخر التاريخي للشعب العربي، ومن ثم، فإن الاندماج القومي شرط لازم للوحدة العربية والتقدم العربي. فالعوامل الجاذبة للوحدة العربية هي ذاتها العوامل الجاذبة للاندماج القومي، والعوامل النابذة للوحدة العربية هي العوامل النابذة للاندماج، ولا سيما «الأيديولوجيات الضمنية أو الصريحة للأقليات الدينية والقومية »(161). ترسيمة الحافظ ديمقراطية علمانية ذات محتوى اشتراكي، تُحَلُّ وفقها مسألة الأقليات القومية حلاً ديمقراطيًا، حسب شروط كل بلد، بدءًا من توفير شروط اندماجها وصولاً إلى «منحها نوعًا من حكم ذاتي أو ما هو أكثر من حكم ذاتي». أما مسألة الأقليات الدينية والمذهبية فتُحَلُّ حلً علمانيًا بامتلاك الأكثرية الإسلامية وعيًا علمانيًا وامتلاك الأقليات الدينية (المسيحية خاصة) وعيًا قوميًا(162). ولكن الحافظ، لم يتحرر كليًا من رواسب الرومانسية القومية والاشتراكية، التي رافقته من بواكير شبابه، على الرغم من وصف القومية المشرقية بالعنصرية، وكان يعني قومية حزب البعث، ويعارضها بقومية ناصرية، نسبة لجمال عبد الناصر.
ويمكن أن نلتمس موقف محمد عابد الجابري من خلال قراءته لابن خلدون في كتابه «العصبية والدولة»، إذ يقرر أن الدين كان شرطًا ضروريًا، ولكنه ليس كافيًا، لقيام الدولة، لأن «الدعوى (هكذا) الدينية لا تتم من غير العصبية»، وأن العصبية، عصبية قريش أولاً وعصبية العرب جميعًا كانت شرطًا ضروريًا لنجاح الدعوة الإسلامية وقيام دولة العرب»، وأن جميع الحركات الإصلاحية التي لم تعتمد على إحدى العصبيات باءت بالفشل»(163). ويخلص إلى أن الأيديولوجيا (الدين) والعصبية وشؤون المعاش عوامل أساسية في تشكل العمران. ولكنه لا يقول لنا هل شؤون المعاش هي التي تشكل الأيديولوجيا والعصبية، في نطاق العمران، أم الأيديولوجيا (الدين) والعصبية هما اللتان تشكلان شؤون المعاش، الدنيوية؟ الإسلام لم ينتصر ولم ينتشر بغير عصبية قريش، وعصبية قريش لم تنتصر وتؤسس إمبراطورية مترامية الأطراف بغير الإسلام، فالعروبة والإسلام عنده متضايفان مفهوميًا وتاريخيًا والاندماج القومي، كما يمكن أن نفترض هو نتاج تضايفهما وتضافرهما. أي إن مشروع الاندماج الاجتماعي أو مشروع الوحدة العربية هو مشروع قومي- إسلامي سني. ولذلك ربما اعتبر الجابري العلمانية إشكالية زائفة.
من موقع آخر، وزاوية نظر أخرى، يذهب مصطفى حجازي إلى أن مجتمعات الهدر لا تطمح إلى تداول السلطة من أجل التجديد والتجاوز، بل تطمح إلى العدل وإصلاح الحال الذي يهدف إلى تأزيل سلطة السلطان على الرعية، وبالتالي تأزيل الوضع القطيعي (التبعي) للرعية(164). «المستبد يحتل العالم الذاتي لرعيته»، لا بصفتها مصدر تهديد وموضوع رهبة فقط، بل بصفتها مصدر إعجاب وافتتان وموضوع تعلق. وهو ما يعزز تشكيل السلوكات والأذهان والأفئدة، ويعزز هيمنة السطوة، ومعها تتعزز بالطبع حالة هدر كيان الناس ووعيهم وإرادتهم واستقلالهم. في هذا الجانب تقوم العقيدة الدينية والموروث الثقافي (التراث) في تعزيز سلطة المستبد وجعلها أمرًا طبيعيًا.
الاستبداد هو الحصيلة المنطقية للعصبية التي تنتج التعصب والعنف والأصولية التي تنتج التطرف وتسوغ الاحتكار، فما من استبداد لا يقوم على هاتين الركيزتين. وما كان للعصبية والأصولية أن تكونا ركيزتي الاستبداد لولا أن الأولى تولد علاقات الأمر والطاعة، التسلط والخضوع، مما يسند الاستبداد وينشره في شبكة العلاقات الاجتماعية، ولولا أن الأصولية تضفي على العصبية طابع القداسة والجوهرانية والثبات وبناء المعرفة على القطعية ومنع الاختلاف.
في سياق مختلف نسبيًا تناول عزمي بشارة هذه المسألة بموضعتها في سيرورة تشكل المجتمع المدني(165) والتحول إلى الديمقراطية، فلاحظ أن «حالة الارتداد عن الحداثة إلى مؤسسات المجتمع التقليدية، خارج الدولة، لا تنتج أنظمة حكم، بل مراحل انتقالية نحو تفسُّخ الدولة والتحول إلى جماعات عضوية محزَّبة. فالطائفية والعشائرية حالة انفصالية تفتت نظام الدولة، وتدخل في إطار الصراعات والتوازنات الإقليمية والدولية(166). ورأى أن الهويات الوطنية المحلية لم تتمكن من التغلب على الطائفية أو العشائرية كهويات سياسية، لأنها غالبًا أقل شرعية منها، أو لأنها بنيت أصلاً على التوازن الطائفي المحلي، أو على سيطرة طائفة منذ العهد الاستعماري(167). ولكنه لاحظ أن هناك فرقًا بين تخلف المجتمع عن الوصول إلى معايير المواطنة والدولة والوطن والمجتمع ومراوحته التاريخية في الطائفة والعشيرة والقبيلة والحارة والبلدة، وبيَّن تبدد عقيدة الدولة الوطنية والأمة والمواطنة، كأنها وهم في نظر أوساط وفئات واسعة من الناس، وغالبًا ما يتبع انهيار الوهم ارتداد إلى البنى ما قبل الحداثية»، إذ تصبح هذه العودة أيديولوجية. «الطائفية هنا لم تعد مجرد انتماء طبيعي، بل أصبحت انتماء سياسيًا واعيًا لذاته كأيديولوجيا وكأداة تصفية حساب مع انتماءات وهويات أخرى»(168).
وكان هشام شرابي قد وضع مسالة الاندماج الاجتماعي في إطار عملية انتقال شامل من نظام الأبوية (المحافِظة والمستَحدَثة على السواء) أو من النظام البطركي الحديث(169)، إلى نظام الحداثة، على صعيد الدولة كما على صعيد الفكر، وعلى صعيد الاقتصاد كما على صعيد المجتمع والحضارة ككل»(170). لأن «نظام الرعاية الذي يفترض الخضوع والتبعية لا يخضع المجتمع لإرادة مشتركة، بل لإرادة فردية، لا تحدها سوى حدود مادية (القوة) أو روادع أخلاقية (الدين). ولا يكون القانون في خدمة المجتمع، بل في خدمة الوضع القائم، والعقوبة لا تستهدف الإصلاح، بل توكيد قدسية القانون والحفاظ على النظام. وبما أن المعارضة متعذرة قانونيًا فالتآمر والتمرد يصبحان الشكلين الوحيدين للعمل السياسي. وبما أن النقاش العلني الحر ممنوع فإن العنف يصبح وسيلة الإقناع الحديثة(171).
وكتب حليم بركات فصلً خاصًا، في كتابه «المجتمع العربي المعاصر»، بعنوان «مصير الاندماج الاجتماعي والسياسي» لا تنفصل فيه مسألة الاندماج الاجتماعي عن مسألة الوحدة العربية، ولاحظ أن ثمة انتماء عربيًا عامًا وانتماءات خاصة: وطنية محلية ودينية وطائفية ومعيشية وقبلية وإثنية وغيرها(172)، فخلص إلى أن الوحدة العربية ليست حتمية، بحكم هذه التناقضات، خلافًا لرؤية منير شفيق، (وخلافًا لرؤية ياسين الحافظ). ورأى أن «المجتمع العربي مصاب بحالة الاغتراب، فلا يسيطر على موارده ومصيره ويتداعى من الداخل حتى يكاد يفقد محوره وصميمه، فلا يملك إرادة وهدفًا وخطة، وتسيطر عليه مؤسساته بدل أن يسيطر عليها فتستعمله لمصالحها الخاصة أكثر مما تخدم مصالحه وتثبت مناعته وتقدمه، وحتى يستعيد المجتمع سيطرته على موارده ومؤسساته ويتكون له صميم ومحور وغاية سيستمر الانهيار العربي بسرعة أقصى فأقصى »(173). الخروج من حالة الاغتراب ووضع حد للانهيار والسير نحو الاندماج الاجتماعي والسياسي تستوجب: القضاء على التبعية والتخلف وإلغاء الطبقية وإنجاز الوحدة العربية والتخلص من الاغتراب وتحقيق الحرية والعدالة(174).
ويرى علي حرب أن الاستبداد الثقافي هو الذي يتيح الاستبداد السياسي والسلوكي. فالاستبداد الفكري هو أن يقع المرء أسير أفكاره، أو حبيس أصوله وثوابته، وأن يتعامل مع المرجعية الفكرية كسلطة مطلقة لا تخضع للجدل والمساءلة، أو يتصرف إزاءها بمنطق التسليم والطاعة. يكمن أساس الاستبداد في فقدان المرء حريته الفكرية إزاء شخص أو نص أو حدث يجري التعامل معه كأصل ثابت أو مرجع مطلق أو رمز مقدس».
تكتمل حلقة الاستبداد والطغيان المرتكز على علاقة الأمر والطاعة والسيطرة والخضوع بما يسميه مصطفى حجازي التعلق الرضوخي، الذي يتخذ شكل إعجاب بالمستبد أو الطاغية، وهو إعجاب يتغذى من الموروث الثقافي والديني وآليات التجميل والتفخيم، بل إن هذه الآليات لا تفعل فعلها إلا بسبب تحرك آلية التعلق الرضوخي، الذي يتجاوز الخضوع والتبعية المحضة كي يفتح باب الإعجاب ويثير سلوكات الحصول على العفو والرضى. هنا تتحرك آلية التماهي بالمستبد أو الطاغية التي تتيح قلب المعادلة تمامًا. فمن جرح نرجسي وجلد ذات وتحقيرها بسبب العجز والخسارة يبرز الإعجاب بل الافتتان بشخص الطاغية المتعالي. كل واحد يتخلص من بؤس كيانه ونقائصه ويداوي جرحه النرجسي بأن يأخذ قبسًا من عظمة المستبد أو الطاغية، يعطيه قيمة بديلة ومجالً للاعتزاز بالكيان البديل. إنه يتحول هواميًا إلى طاغية أو مستبد صغير يمارس بطشه على من هم دونه في حالة من الشعور بالتعالي مقارنة بتدني قيمتهم.
يقدم برهان غليون في هذا الشأن خطابًا مسكونًا بهاجس التضاد بين الأكثرية والنخبة، ونزعة شعبوية مصدرها عصبية مضمرة، إذ يقرر أن «البنى التقليدية التي نحمِّلها كل مسؤوليات التخلف والتأخر والركود هي التي أصبحت وما زالت درع المقاومة للجماعة السياسية القومية.. وإن ما حال دون التحلل الكامل لهذه الجماعة هو بالضبط كل ما ورثناه من الماضي والذي نفد الآن ونفدت معه مقاومتنا: الاعتقاد الديني والإيمان الذي يولد الثقة والحماس والاندفاع لدى الشعب، الاقتصاد الطبيعي الذي لا تهزه الكوارث، والتضامن العائلي والعشائري الذي لا تحطمه ألاعيب السياسة ويتجاوزها باستمرار، ومع ذلك فإننا مدانون بالحداثة ».(175) فما زال التعايش بين العلم والدين في نظره، هو المبدأ الوحيد الذي يسمح للثقافة العربية أن تستمر في وجودها وأن تتجدد في الوقت ذاته. وهو الذي يسمح لها بأن تعطي للمجتمع الشعور بهويته واستقراره النفسي حتى يستوعب الحضارة ويجذرها في تربته نفسها ومن أفق المفاهيم والقيم الأساسية لثقافته »(176). يبدو للدكتور برهان غليون أن نموذج الثورة الإيرانية يمكن أن يحل التضاد بين النخبة والأكثرية، وبين الدولة والأمة، إذ يقرر أنه «بعد سنوات الاغتراب الطويلة يبدو كما لو أن النخبة المثقفة العربية التقت نفسها في لهب الأحداث الإيرانية، وكان تبنيها السريع لها وسيلة، بلا ريب، للتعبير عن مشاغلها الذاتية، وعن رفضها للوضع العربي الراهن. وهكذا جاءت الثورة الإيرانية في الوقت المناسب، لتعيد إلى الوجدان العربي المثلوم فرحه الزائل وإلى الشعور العميق بالخيبة أملً متجددًا في القدرة على استملاك العالم من جديد. فالتقت في هذه المناسبة التاريخية العروبة روحها الإسلامي الضائع، كما التقى الإسلام موطنه العربي الجافي، الإسلام الذي عمَّد نفسه في أعظم ثورة شهدها النصف الثاني من القرن العشرين، مطالب اليوم أن يحقق الحلم الذي عجرت عن تحقيقه الأيديولوجيات الماضية، القومية والماركسية»(177). قد نحتاج إلى منجّم لنعرف ما هي علاقة الوجدان العربي بالثورة الإيرانية، وما الذي يعنيه الوجدان العربي، وكيف التقت العروبةُ روحَها الإسلامي الضائع، في الثورة الإسلامية الإيرانية، وكيف التقى الإسلام موطنه العربي الجافي، في هذه الثورة الإيرانية ذاتها.
هذه عينات من معالجات مختلفة للاندماج الاجتماعي، وشروط إمكانه ومعوقاته، انتخبناها انتخابًا مُغرضًا من كتابات عاملين في علم الاجتماع والاجتماع السياسي وعلم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع الثقافي؛ كلها تتناول الموضوع انطلاقًا من افتراض «مجتمع عربي» و«أمة عربية». ويبدو لنا أن المجتمع والأمة قد اشتقا اشتقاقًا من الفضاء الثقافي المشترك بين العرب المسلمين وغير المسلمين، وبين المسلمين من العرب وغير العرب، وأن اللغة والتاريخ هما الدالتان الأساسيتان على ذلك، ما يعني أن اللغة والتاريخ لا يزالان خارج إطار المفكَّر فيه، فليسا موضوعًا للمراجعة والنقد. فأن تكون اللغة، بوصفها نسقًا معرفيًا، بل أنساقًا، خارج إطار المفكر فيه يعني انقطاعها عن الحياة، وأن يكون التاريخ كذلك يعني أنه تاريخ لاتاريخي، إذا استعملنا عبارة ميشيل فوكو، أي إنه تأويلات ذاتية لوقائع وأحداث، بعضها مشكوك في صحتها، يمتزج في تأويلها العقلاني والأسطوري والغيبي.
ولما كان المجتمع هو التجسيد العياني للأمة، أو التعبير السوسيولوجي عنها، سنضرب مثالاً واحدًا على ما ندعيه، هو معنى الأمة لدى بعض المنظرين القوميين، ونزعم أن هذا المعنى منسرب في العينات التي انتخبناها، على نحو أو آخر، صراحة أو ضمنًا: الأمة، عند زكي الأرسوزي (1900- 1968)، مشتقة من الأم، ما يحيل على فكرة الأصل، التي تنكشف لأفراد الأمة بالحدس، فإن «الاختلاف بين فرد وفرد من أبناء الأمة إنما هو اختلاف في درجة الوضوح في الأمور المتعلقة بالأصول؛ فما هو حدس مبهم عند الجمهور يتحول إلى بصيرة نيرة عند القادة. وذلك ما يحمل على الاعتقاد أيضًا بأن ما يتجسد من شبه بين الأفراد المنحدرين من ذات الأصول وبين ما يظهر من انسجام في المؤسسات العامة يرجع إلى آية الأمة المتحققة عبقريةً في الطبيعة، يرجع إلى تجربة الأجداد المثلى في أصول الحياة، وليس التاريخ إلا سجل هذا التحقيق كمصير حصل من انتصارات الحياة على القدر». (وليس ذلك فحسب، بل) «تبدو الأمة البدائية في الكون حاملة سيماءها بصورة مجملة، فتنفتح عنها بتجاوب تجلياتها بين (قطبيها): قطب ترسم به في بنية أبنائها معرفة متبلورة، وفي الكون عالمًا تنعكس عنه الطبيعة محددة إمكانية إدراكهم، وقطب آخر ترتقي إليه النفوس من خلال هذه التجليات المستشفة في تساميها بنور ذاتها» … «تلك هي الأمة العربية عبقرية أبدعت أداة بيانها فأفصحت بهذا الإبداع عن حقيقتها. إن الحدس في الكلمة العربية من صرح الثقافة بمثابة البذرة من الشجرة. ذلك ما دعانا إلى القول: بأن أمتنا ليست حصيلة ظروف تاريخية، بل إنها معنى يبدع تجلياته ويوجهها نحو المزيد من الحرية. وذلك ما دعانا إلى الاعتقاد بأن مثل ظهور الأمم البدئ على مسرح التاريخ كمثل ظهور الأنواع الحياتية على مسرح الطبيعة »(178). لاحظوًا جيدًا: الأمة العربية والقومية العربية تنبثقان من اللغة والتاريخ بحدس العبقرية الكامنة فيهما. فـ«الفكر في حد ذاته قوة تاريخية، قوة تاريخية لا تقدر. فمجرد وضع القضية العربية القومية في صيغة فكرة شاملة كان أول مساهمة في تركيز الحركة الثورية العربية على أسس صلبة..» بتعبير ميشيل عفلق. (1911- 1989)(179) الفكرة القومية فكرة مطلقة وحية، بتعبير عبد الله عبد الدايم، والإطلاق والحياة فيها هما طابعها الجوهري لا مجرد نعتين من جملة نعوت يمكن أن تطلق على القومية العربية. «إنها فكرة حية لأنها فكرة قومية قبل كل شيء تريد أن تبعث أمة فلا تنسى الروابط التاريخية الحية التي تربط بين أفرادها، وفكرة مطلقة لأنها تريد أن تجعل من الحياة القومية حياة حية لا ضيق فيها ولا فقر تستمد قوتها من قوة العقل وحقائقه»(180). يبدو ذلك كله مفهومًا إذا عرفنا أن القومية «قدر محبب» بتعبير ميشيل عفلق، «فمتى انتبه الإنسان إلى قدره يخرج من حالة الحياة السطحية، ويدخل في جريان الحياة الحارة القوية، فإذا رافق عنده هذا الانتباه إلى القدر القبول به اتخذت حياته اتجاهًا واتسمت بالرجولة »(181). القومية عند ميشيل عفلق «ليست نظرية ولكنها مبعث النظريات، ولا هي وليدة الفكر بل مرضعته، وليست مستعبدة للفن بل نبعه وروحه… كل تفسير للقومية العربية لا ينبعث من صميمها انبعاث الغرسة من الأرض والسنبلة من القمحة يكون تفسيرًا ضالاً جامدًا ميتًا… لا يحتاج العرب إلى تعلم شيء جديد ليصبحوا قوميين، بل إلى إهمال كثير مما تعلموه حتى تعود إليهم صلتهم المباشرة بطبعهم الصافي الأصيل، القومية ليست علمًا بل هي تذكر، تذكر حي… ما عسى أن تكون دهشتهم عندما تظهر فيهم نقية كاملة بسيطة بساطة المعجزات.. »(182). القومية عند ميشيل عفلق حب قبل كل شيء. وكان يخشى أن تسف إلى المعرفة الذهنية والبحث الكلامي، فتفقد بذلك قوة العصب وحرارة العاطفة… (فإن) الإيمان يجب أن يسبق كل معرفة ويهزأ بأي تعريف، بل إنه هو الذي يبعث على المعرفة ويضيء طريقها»(183).
ساطع الحصري (1880- 1968) الذي فند «وحدة الأصل» أو العرق مؤكدًا أن «جميع الأبحاث العلمية المستمدة من حقائق التاريخ ومن مكتشفات علم الإنسان ومكتسبات علم الأقوام لا تترك مجالً للشك في أنه لا يوجد على وجه البسيطة أمة تنحدر من أصل واحد فعلً، ولا توجد على الأرض أمة خالصة الدم تمامًا »(184). انتهى إلى القول: «إن المهم في القرابة والنسب ليس رابطة الدم في حد ذاتها، بل هو الاعتقاد بها والنشوء عليها، وهذا هو الواقع بالنسبة إلى الأفراد والجماعات على حد سواء: إن الاعتقاد بوحدة الأصل والشعور بالقرابة يعمل عملاً هامًا في تكوين الأمم، سواء كان ذلك موافقًا للحقيقة أم مخالفًا لها، لأن القرابة بين أفراد الأمم تكون قرابة نفسانية معنوية أكثر مما تكون جسمانية ومادية(185)» وإن العوامل التي تؤدي إلى تكوين هذه القرابة المعنوية هي اللغة والتاريخ. «اللغة هي روح الأمة وحياتها… والتاريخ هو شعور الأمة وذاكرتها »(186). يتبين مما سبق أن وحدة الأصل ورابطة الدم وهم من الأوهام، ولكن لا بأس أن تقوم الأمة على الاعتقاد بهذا الوهم والإيمان به. وقد فات الحصري أن تفنيد رابطة الدم يؤدي إلى تفنيد رابطة اللغة والتاريخ، إذ تتماهى اللغة والثقافة والتاريخ؛ فإن اللغة قد تكون لغة جماعة عرقية بعينها، (لغة قريش، مثلاً) أما الثقافة فلا يمكن أن تكون كذلك، ففي ثقافة العرب من العناصر الفارسية واليونانية، على سبيل المثال، أكثر مما في لغتهم من كلمات فارسية ويونانية، وليس في فقه لغتهم ونحوها وصرفها أي أثر للغة الفارسية أو اليونانية، في حين يتجلى أثر الثقافة اليونانية، ولا سيما منطق أرسطو، واضحًا فيها.
افترض الحصري أن «وحدة اللغة توجد نوعًا من وحدة في التفكير وفي الشعور»، وأن «وحدة التاريخ تولد تقاربًا في العواطف والنزعات »، وهو افتراض غير واقعي، تدحضه اتجاهات التفكير المختلفة والمتخالفة في «الثقافة العربية الإسلامية»، وتدحضه الملل والنحل، كما تدحضه الذكريات التاريخية المتناقضة والعواطف والنزعات المتناقضة، التي تخترق التاريخ «العربي الإسلامي»، منذ مقتل عثمان بن عفان على الأقل. هذا الافتراض أسس لأوهام «العقل العربي» و«العقل الإسلامي» و«العقل البياني» و«العقل البرهاني» و«العقل المستقيل» ولما تشاء من العقول الخاصة. وهذا لا ينفي بالطبع أن اللغة واسطة التفاهم بين الأفراد»، ولا ينفي أنها «آلة التفكير» و«واسطة لنقل الأفكار والمكتسبات من الآباء إلى الأبناء»، بتعبير الحصري، بل هي شكل الفكر ومظهره المادي، ولكنها لا تجعل من المتكلمين بها أمة، ولا توجد بينهم نوعًا من «وحدة التفكير والشعور».
للموضوع أو مجال البحث سلطة على الذات تفوق سلطة الذات عليه. تنقلب هذه الحال رأسًا على عقب حين يكون الموضوع مُتَخَيَّلً، أو محددًا تحديدًا ذاتيًا، بشكله ومضمونه، فيغدو عجينة لينة أو صلصالً تشكله الذات على هواها، وتحدد وظيفته بتزكية الهدف وتسويغه. الانطلاق من الهدف وإرادة تحقيقه أو العزم على تحقيقه، فقط، لا يؤديان إلى معرفة الواقع الذي يراد تحسينه أو تغييره، بل إلى تأويل أيديولوجي لما هو الواقع، ولا يؤديان من ثم إلى تحقيق الهدف ذاته. وهذا ما يحيل في كل مرة على التوتر بين ممكنات الواقع وتطلعات الأفراد والجماعات، والأحزاب السياسية خاصة، ويساعد في تفسير الإحباطات والهزائم.
نقد المركزية المركبة وتفكيكها:
أخيرًا، إن المواطنة، في أفق العدالة الاجتماعية، والوطنية، في أفق الإنسانية والسلام الشامل والدائم، تقتضيان نقد المركزية البطركية بصيغتها المركبة: الجنسية (الذكورية) والإثنية (العرقية) والقومية (ما قبل المدنية، أو ما قبل الديمقراطية، ولا فرق) والثقافية (وهم التفوق الثقافي والأخلاقي) والدينية (وهم الديانة الكونية، ووهم الملة الناجية)، والسياسية والإدارية. كما أن التوزيع العادل للثروة وعوامل الإنتاج يظل ناقصًا ومثلومًا ما لم يقترن بتوزيع عادل للسلطة والموارد المعرفية والثقافية والخيرات الاجتماعية، ولا سيما الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص وتساوي الشروط، وتكافؤ المعاني والقيم… كما يقتضيان ربط الإدارة المدنية بالتنمية الإنسانية الشاملة والعادلة والمنصفة، بصفتها مصدرًا من مصادر شرعية السلطة.
النظام الاجتماعي- الاقتصادي والسياسي، الذي ينشده نقد المركزية/ المركزيات، أو المركزية المركبة، والذي يلبي مطالب الروح الإنساني بالمساواة والحرية وتكافؤ المعاني والقيم.. هو النظام الفيدرالي، الذي يهرب الخطاب السياسي السوري من تسميته باسمه إلى «النظام اللامركزي»، وهذا نظام قائم، يضع المجالس المحلية المنتخبة انتخابًا زائفًا، وفق معايير أيديولوجية، تحت وصاية السلطة المركزية، ويجعل من هذه المجالس أدوات ووسائل للسلطة المركزية، وأدوات ووسائل لإدارة الفساد وشراء الذمم بالامتيازات.
يمكن النظر إلى النظام الفيدرالي من زاويتين متناقضتين: الأولى هي النظر إليه من زاوية أن المواطنين والمواطنات يخضعون ويخضعن لسلطتين: واحدة محلية والثانية فيدرالية، والسلطة هي السلطة، قيد على الحرية، ويمكن أن تتجاوز على الحقوق الطبيعية، بما فيها حق الحياة، وعلى الحقوق المدنية والسياسية، كما هي الحال في سوريا حتى اليوم. والثانية هي النظر إلى الفيدرالية من زاوية أن المواطنات والمواطنين يحظون بحماية سلطتين، واحدة محلية والثانية فيدرالية. الفيصل في هذه المسألة، والذي يرجح المعنى الثاني، هو النظام السياسي، الذي يستمد شرعيته من الشعب، والذي تعينه سيرورة الاندماج الاجتماعي، وتحدد وتائر نموه وتطوره، ووظيفة الدولة أو وظائفها، ومبادئ إنتاج السلطة وآليات اشتغالها وأساليب عملها. في نظام ديمقراطي فيدرالي قولً وفعلً يحظى المواطنون والمواطنات بحماية سلطتين تتضافران وتتعاونان على قيام الدولة بواجباتها، والمجتمع المدني يعزز هذه الحماية، بما يوفره من شبكات الأمان والحماية الاجتماعية.
من المؤكد أن شكل النظام السياسي، المركزي أو الفيدرالي، البرلماني أو الرئاسي، أو المختلط، مسألة وطنية عامة، والمسائل الوطنية كافة نظيمة مترابطة، أي خلل أو اضطراب في ترابطها يؤدي إلى اضطراب الجسم الاجتماعي كله، لذلك يفترض أن يكون الخيار الفيدرالي تعبيرًا عن إرادة وطنية عامة، يترجمها الدستور، واستفتاء الشعب فيه. الحكومات المنتخبة في النظم الديمقراطية الحديثة تستفتي مواطناتها ومواطنيها في أي مسألة وطنية عامة، مهما بدت بسيطة أو ثانوية.(187)
المراجع:
– أبو حيان التوحيدي، المقابسات، تحقيق حسن السندوبي، جار سعاد الصباح، الكويت، ط 1992
– إدغار موران في كتابه «مقدمات للخروج من القرن العشرين»، وزارة الثقافة، دمشق.
– أرسطو، في السياسة، نقله من الأصل اليوناني إلى العربية وقدم له وعلق عليه الأب أوغسطينوس بربارة البولسي، (اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، بيروت، الطبعة الثانية، 1980).
– إرنست بلوخ، «فلسفة عصر النهضة»، ترجمة وتقديم إلياس مرقص، دار الحقيقة، بيروت، 1980 .
– ألان إيتش جودمان ويولاندا تي موزس وجوزيف إل جونز، الأعراق البشرية، هل نحن على هذا القدر من الاختلاف، ترجمة شيماء طه الريدي وهبة عبد المولى أحمد، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة.
– ألان تورين، إنتاج المجتمع، ترجمة الياس بديوي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، .1976
– ألان تورين، نقد الحداثة، ترجمة صياح جهيم، وزارة الثقافة، دمشق، 1998 .
– ألكسيس دو توكفيل، الديمقراطية في أميركا ترجمه وقدم له أمين مرسي قنديل، دار كتابي، القاهرة، 1962 .
– إلياس مرقص، مقدمات من أجل التنوير، جمعها وحررها جاد الكريم الجباعي، (منشورات مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، 2017).
– أمارتيا صن، فكرة العدالة، ترجمة مازن جندلي، الدار العربية للعلوم، ناشرون، بيروت، 2010 .
– أميرة حلمي مطر، جمهورية أفلاطون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مهرجان القراءة للجميع، 1994 .
– أندريه لالاند، الموسوعة الفلسفية، تعريب خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت – باريس، الطبعة الثانية، 2001 .
– إيان كريب، النظرية الاجتماعية، من بارسونز إلى هابرماس، ترجمة د. محمد حسين غلوم، مراجعة د. محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والعلوم والآداب، الكويت، العدد 244 ، أبريل 1999 .
– إيمانويل كانط، نقد ملكة الحكم، ترجمة غانم هنا، المنظمة العربية للترجمة، القاهرة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2005 .
– برهان غليون، الوعي الذاتي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية .1992
– برهان غليون، مجتمع النخبة، معهد الإنماء العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1986 .
– جاد الكريم الجباعي، «من الرعوية إلى المواطنة » دار أطلس، دمشق وبيروت، .2013
– جاد الكريم الجباعي، «فخ المساواة، تأنيث الرجل، تذكير المرأة »، (مؤسسة مؤمنون
بلا حدود، الرباط، 2018 ).
– جاد الكريم الجباعي، المجتمع المدني هوية الاختلاف، الطبعة الثانية، دار النايا، دمشق، 2010 .
– جاد الكريم الجباعي، طريق إلى الديمقراطية، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، 2010 .
– جاد الكريم الجباعي، وردة في صليب الحاضر، نحو عقد اجتماعي جديد وعروبة ديمقراطية، من منشورات رابطة العقلانيين العرب، دار الفرات للنشر والتوزيع، بيروت، دار بترا للنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى، 2008 .
– جان جاك روسو، خطاب في أصل التفاوت وفي أسسه بين البشر، ترجمة بولس غانم، تدقيق وتعليق وتقديم عبد العزيز لبيب، إعداد المنظمة العربية للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2009 .
– جان جاك روسو، في العقد الاجتماعي، أو مبادئ القانون السياسي، ترجمة عبد العزيز لبيب، المنظمة العربية للنشر، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2011.
– جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1982 .
– جون استيوارت ميل، المنفعة، ترجمة شاهرلي حرار، المؤسسة العربية للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2012 .
– جون رولز، العدالة كإنصاف، إعادة صياغة، ترجمة حيدر حاج إسماعيل، المنظمة العربية للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2009 .
– جون رولز، نظرية في العدالة، ترجمة ليلى الطويل، الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 2011 .
– جيمس جينز، الفيزياء والفلسفة، ترجمة جعفر رجب، (دار المعارف)، بيروت، بلا تاريخ نشر.
– حسين مقلد، القيم والمبادئ في نظريات العلاقات الدولية، وزارة الثقافة، دمشق، 2018.
– حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر، بحث استطلاعي اجتماعي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة السادسة، 1998 .
– حنة أرندت أسس التوتاليتارية، ترجمة أنطوان أبو زيد، دار الساقي، بيروت، الطبعة الأولى، 1993 .
– ديفيد جونستون، مختصر تاريخ العدالة، ترجمة مصطفى ناصر، سلسلة عالم المعرفة، العدد 387 ، أبريل 2012 .
– زكريا إبراهيم، مشكلة الحرية، (مكتبة مصر، القاهرة، بلا تاريخ).
– ستيفن هوكينغ، تاريخ موجز للزمان، سلسلة جدران المعرفة، 2006 .
– عبد الله العروي، مفهوم العقل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، وبيروت، لبنان، الطبعة الثالثة 2001 .
– عبد الله حمودي في «الشيخ والمريد»، ترجمة عبد المجيد جحفة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط 4، 2010 .
– عزمي بشارة، المجتمع المدني، دراسة نقدية (مع إشارة للمجتمع المدني العربي)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 1998 .
– عزمي بشارة، في المسألة العربية، مقدمة لبيان ديمقراطي عربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، 2010 .
– عمانويل كانط، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة عبد الغفار مكاوي، منشورات الجمل، كولونيا، ألمانيا، 2002 .
– عمانويل كانط، نحو السلام الدائم، محاولة فلسفية، ترجمة الدكتور نبيل الخوري، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، 1985 .
– غاستون باشلار، جدلية الزمن، ترجمة خليل أحمد خليل، (المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1992).
– غسان سلامة، نحو عقد اجتماعي جديد، بحث في الشرعية الدستورية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طبعة ثانية منقحة، 2011 .
– فيرجينيا هيلد، أخلاق العناية، ترجمة ميشيل حنا متياس، (سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد 365 ، أكتوبر، 2008).
– كارل ماركس وفريدريك إنغلز، في «البيان الشيوعي»، ترجمة العفيف الأخضر، (منشورات الجمل، مكتبة الفكر الجديد، بلا تاريخ).
– كارل ماركس، المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام 1844 ، ترجمة الياس مرقص، (دار الطليعة، بيروت، 1963).
– كارل ماركس، المسألة اليهودية، ترجمة الياس مرقص، دار الطليعة، بيروت، 1963 .
– كمال عبد اللطيف، في تشريح أصول الاستبداد، دار الطليعة، بيروت، 1999 .
– لودفيغ فويرباخ، أصل الدين، ترجمة أحمد عبد الحليم عطية، (المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1991).
– ماركس وإنغلز، حول الدين، ترجمة ياسين الحافظ، (دار الطليعة، بيروت، ط 2، 1981).
– محمد عابد الجابري، العصبية والدولة، ملامح نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة السادسة، 1994 .
– محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 4، 2000 .
– محمد كامل الخطيب محررًا، «القومية والوحدة، المقالات »، وزارة الثقافة، 1994
– مرسيا إلياد، المقدس والمدنس، ترجمة عبد الهادي عباس، دار دمشق، دمشق، 1988
– مرسيا إلياد، تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية، ترجمة عبد الهادي عباس، (دار دمشق، دمشق، 1987).
– مشير باسيل عون محررًا، مجموعة من المؤلفين، الفكر الفلسفي المعاصر في لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2017 .
– مصدق حسن، يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، النظرية النقدية التواصلية، (المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء وبيروت، 2005).
– مصطفى حجازي، الإنسان المهدور، دراسة تحليلية نفسية اجتماعية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب وبيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2015 .
– مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي، مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، وبيروت، لبنان، الطبعة التاسعة، 2005
– مونتسكيو، روح الشرائع، ترجمة عادل زعيتر، اللجنة الدولية لترجمة الروائع، (دار المعارف بمصر، القاهرة، 1953).
– ميرسيا إلياد، مظاهر الأسطورة، ترجمة نهاد خياطة، دار كنعان للنشر، دمشق، 1991
– ميشيل فوكو، يجب الدفاع عن المجتمع المدني، دروس ألقيت في الكوليج دي فرانس لسنة 1976 ، ترجمة وتقديم وتعليق د. الزواوي بغورة، دار الطليعة، بيروت، 2003 .
– نوبوأكي نوتوهارا، العرب، وجهة نظر يابانية، (منشورات الجمل، لندن، 2003).
– هشام شرابي، البنية البطركية، بحث في المجتمع العربي المعاصر، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى، 1987 .
– هشام شرابي، في النقد الحضاري للمجتمع العربي في نهاية القرن العشرين، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، د.ت.
– هيغل، أصول فلسفة الحق، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1996
– ياسين الحافظ، الأعمال الكاملة، مركز دراسات الوحدة العربية، 2005 .
– يمنى طريف الخولي، الزمان في الفلسفة والعلم، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1999).
– يورغن هابرماس، الأخلاق والتواصل، أبو النور حمدي أبو النور حسن، دار التنوير، بيروت، 2012، ص 216 .
……………………
هوامش:
(159). راجع، ياسين الحافظ، في المسألة القومية الديمقراطية، الأعمال الكاملة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 2005 ، ص 7 (5 / 963).
(160). ياسين الحافظ، المصدر السابق، ص 16 (5 / 971).
(161). ياسين الحافظ، المصدر السابق، ص 38 (5 / 994).
(162). راجع، ياسين الحافظ، المصدر السابق، بحث الطائفية وأزمة لبنان الدائمة، ص 125 (5 / 1081) وما بعدها.
(163). محمد عابد الجابري، العصبية والدولة، معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة السادسة، 1994 ، ص 256 .
(164). راجع مصطفى حجازي، الإنسان المهدور، المصدر السابق، ص 106 .
(165). راجع أيضًا، عزمي بشارة، المجتمع المدني، دراسة نقدية (مع إشارة للمجتمع المدني العربي)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 1998.
(166). عزمي بشارة، في المسألة العربية، مقدمة لبيان ديمقراطي عربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، 2010 ، ص 68 .
(167). عزمي بشارة، المصدر السابق، ص 164 .
(168). عزمي بشارة المصدر السابق، ص 243 – 244 .
(169). هشام شرابي، البنية البطركية، بحث في المجتمع العربي المعاصر، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى، 1987 . فقد حدد شرابي خصائص النظام البطركي باستمرار التركيب القبلي والشقاق والتنازع أو فصل الذات عن الآخرين وتقسيم الجسم الاجتماعي إلى أزواج متنافية (قريب/ غريب. إسلام/ كفر) وأخاق بسيطة واختزالية (الواجبات والالتزامات محددة بدقة ووضوح داخل التنظيم القبلي، أما خارجه فهي غر محدودة وغر واضحة، وانغراس الولاء القبلي في الحاجات الأساسية للأفراد وتماهي الفرد والقبيلة). راجع تفصيل ذلك في الصفحات 39 – 41 .
(170). هشام شرابي، في النقد الحضاري للمجتمع العربي في نهاية القرن العشرين، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص 11 .
(171). هشام شرابي، البنية البطركية، بحث في المجتمع العربي المعاصر، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى، 1987، (مصدر سابق) ص 55 .
(172). راجع، حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة السادسة، 1998، ص 111، وما بعدها.
(173). حليم بركات، المصدر السابق، ص 447 – 448 .
(174). حليم بركات، المصدر السابق، ص 457 – 460 .
(175). برهان غليون، مجتمع النخبة، معهد الإنماء العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1986، ص 294 – 295 .
(176). برهان غليون، الوعي الذاتي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية 1992، ص 76 .
(177). برهان غليون، المصدر السابق، ص 79 .
(178). زكي الأرسوزي، الأمة في الحدس العربي، من «القومية والوحدة، المقالات »، تحرير وتقديم محمد كامل الخطيب، وزارة الثقافة، 1994 ، ص 576 .
(179). ميشيل عفلق، معالم القومية التقدمية، عن المصدر السابق، الجزء الثاني، ص 685 .
(180). عبد الله عبد الدايم، فكرتنا حية، عن المصدر نفسه، الجزء الثاني، ص 555 .
(181). ميشيل عفلق، القومية قدر محبب، عن المصدر السابق، الجزء الأول، ص 316 .
(182). المصدر السابق، ص 323 .
(183). المصدر السابق، ص 313 .
(184). المصدر السابق، ص 57 .
(185). المصدر السابق، ص 60 .
(186). المصدر السابق، ص 63 .
(187). أغلقت الحكومة المحلية لولاية برلين، عاصمة ألمانيا، أحد المطارات، ومن المعروف أن المطار وحرَمَه يحتلان مساحة واسعة من الأرض، وأن هذه المساحة ملك عام؛ لذلك لم تتصرف الحكومة المحلية المنتخبة بهذه الأرض من تلقاء ذاتها، بل استفتت المواطنين والمواطنات في كيفية التصرف فيها، فكان رأي الأكثرية أن تظل مساحة مفتوحة، وجزءًا من رئة المدينة، فامتثلت الحكومة لإرادة العامة.
======================
محتويات:
– مقدمة وفرضيات أولية…………………………………………………….. 9
– الأسس والقواعد الموضوعية للوطنية……………………………………… 35
– عالمنا هو ما نضعه فيه من ذواتنا………………………………………… 41
– الانعتاق السياسي………………………………………………………… 71
– الانتماء الجذري والتحديدات الذاتية ……………………………………… 76
– الانتماء الأصيل والانتماء الزائف………………………………………… 92
– التواصل في أفق التـذاوت……………………………………………….. 95
– المواطنة… تملك العالم بالمعرفة- العمل……………………………….. 111
– المواطنة / اللامواطنة، نصاب النفي أو السلب…………………………… 119
– المواطنة مبادرة وشعور بالمسؤولية…………………………………….. 126
– الوطن نتاج المواطنة والوطنية نتاج المساواة في المواطنة……………….. 128
– المواطنة والصراع الطبقي…………………………………………….. 132
– المواطنة مؤانسة………………………………………………………. 134
– خطاب المواطنة……………………………………………………….. 135
– المواطنة وعضوية الدولة……………………………………………… 137
– المواطنة مشاركة حرة ومبدعة………………………………………… 143
– من العيش المشترك إلى التشارك الحر…………………………………. 148
– الوطن هو شكل وجودنا الاجتماعي……………………………………. 149
أ- المكان- الزمان………………………………………………….. 149
ب – الوطن في اللغة………………………………………………. 160
ج – الوطن نسيج الوجود الاجتماعي………………………………… 169
– الوطن والمقدس…………………………………………………….. 177
– الوطن نظيمة إيكولوجية مركزها الإنسان……………………………. 181
– الوطنية بنية علائقية………………………………………………… 187
– الوطنية بين الدولة القومية والدولة الديمقراطية………………………. 192
– المجتمع المدني هو الرافعة التاريخية للمواطنة………………………. 203
– الفضاء العمومي والتدرب على المواطنة…………………………… 211
– المنفعة والمنفعة العامة……………………………………………. 217
– في الأخلاق الوطنية ومبادئ العدالة……………………………….. 220
– اللاعدالة أو التفاوت الاجتماعي…………………………………… 230
– العدالة القانونية………………………………………………….. 233
– العدالة الإجرائية…………………………………………………. 235
– العدالة الانتقالية…………………………………………………. 237
– أخلاقيات اللعب…………………………………………………. 239
– قوة السلب الأخلاقية وثقافة الحرب………………………………. 241
– الفردية.. الوطنية والكونية……………………………………… 245
– نصاب الحقيقة………………………………………………… 249
– العدالة والعقد الاجتماعي……………………………………… 251
– رأس المال الاجتماعي……………………………………….. 260
– الاستبداد والحرب يبددان قوة المجتمع…………………………. 266
– مقومات رأس المال الاجتماعي……………………………….. 270
– الفردية والاجتماع الإنساني………………………………….. 284
– التمدن شرط إمكان المواطنة المتساوية……………………….. 286
– جدل الحرية والقانون………………………………………. 290
– في نقد «الروح القومية» أو الوطنية ……………………… 305
– الاندماج الاجتماعي في الفكر العربي المعاصر……………… 316
– نقد المركزية المركبة وتفكيكها……………………………… 328
– المراجع………………………………………………….. 331
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتهى..
«جاد الكريم الجباعي»: مفكر سوري، مجاز في علوم اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق، مهتم بالفلسفة المدنية وقضايا الديمقراطية والمجتمع المدني والدولة الوطنية وحقوق الإنسان والمواطن، له عشرات المقالات والأبحاث والدراسات والكتب.

التعليقات مغلقة.