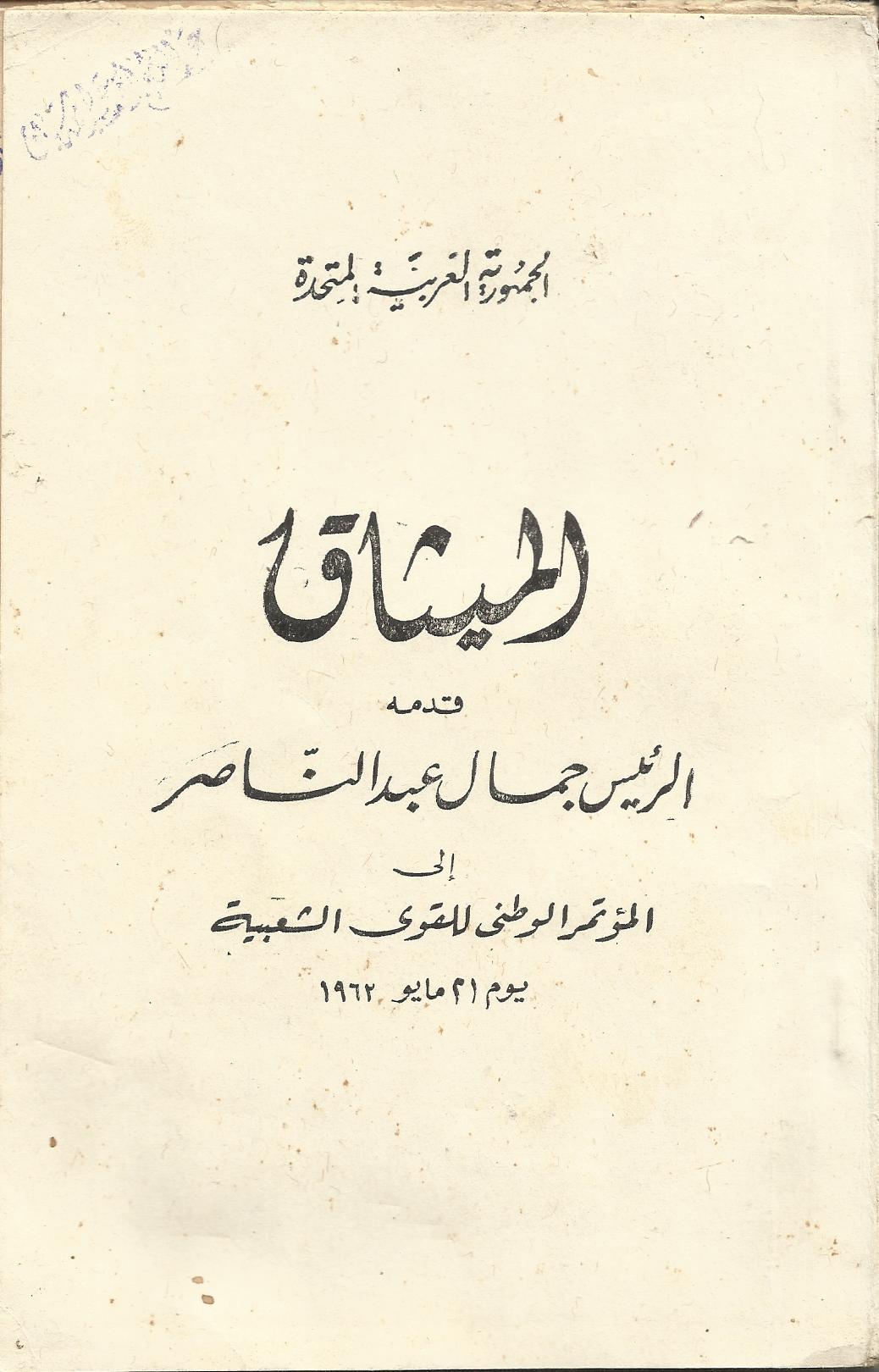
البــاب السـادس
في حتمية الحل الاشتراكي
إن الحرية الاجتماعية طريقها الاشتراكية. إن الحرية الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق إلا بفرصة مكافئة أمام كل مواطن في نصيب عادل من الثروة الوطنية.
إن ذلك لا يقتصر على مجرد إعادة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين، وإنما هو يتطلب أولاً وقبل كل شيء توسيع قاعدة هذه الثروة الوطنية؛ بحيث تستطيع الوفاء بالحقوق المشروعة لجماهير الشعب العاملة.
إن ذلك معناه أن الاشتراكية بدعامتيها من الكفاية والعدل هي طريق الحرية الاجتماعية.
إن الحل الاشتراكي لمشكلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وصولاً ثورياً إلى التقدم؛ لم يكن افتراضاً قائماً على الانتقاء الاختياري؛ وإنما كان الحل الاشتراكي حتمية تاريخية فرضها الواقع، وفرضتها الآمال العريضة للجماهير؛ كما فرضتها الطبيعة المتغيرة للعالم في النصف الثاني من القرن العشرين.
إن التجارب الرأسمالية في التقدم تلازمت تلازماً كاملاً مع الاستعمار؛ فلقد وصلت بلدان العالم الرأسمالي إلى مرحلة الانطلاق الاقتصادي على أساس الاستثمارات التي حصلت عليها من مستعمراتها.
وكانت ثروة الهند التي نزح الاستعمار البريطاني النصيب الأكبر منها؛ هي بداية تكوين المدخرات البريطانية التي استُعملت في تطوير الزراعة والصناعة في بريطانيا.
وإذا كانت بريطانيا قد وصلت إلى مرحلة الانطلاق اعتماداً على صناعة النسيج في لانكشير؛ فإن تحويل مصر إلى حقل كبير لزراعة القطن كان شرياناً ينقل الدم إلى قلب الاقتصاد البريطاني؛ على حساب جوع الفلاح المصري.
إن عصور القرصنة الاستعمارية التي جرى فيها نهب ثروات الشعوب لصالح غيرها – بلا وازع من القانون أو الأخلاق – قد مضى عهدها، وينبغي القضاء على ما تبقى من ذكريات لها مازالت فيها بقية من الحياة خصوصاً في إفريقيا.
كذلك فإن هناك تجارب أخرى للتقدم حققت أهدافها على حساب زيادة شقاء الشعب العامل واستغلاله؛ إما لصالح رأس المال، أو تحت ضغط تطبيقات مذهبية مضت إلى حد التضحية الكاملة بأجيال حية؛ في سبيل أجيال لم تطرق بعد أبواب الحياة.
إن طبيعة العصر لم تعد تسمح بشيء من ذلك. إن التقدم عن طريق النهب أو التقدم عن طريق السخرة لم يعد أمراً محتملاً في ظل القيم الإنسانية الجديدة.
إن هذه القيم الإنسانية أسقطت الاستعمار، كما أن هذه القيم أسقطت السخرة.. ولم تكتف هذه القيم الإنسانية بإسقاط هذين المنهجين؛ وإنما كانت إيجابية في تعبيرها عن روح العصر ومثله العليا حين فتحت بالعلم مناهج أخرى للعمل من أجل التقدم.
إن الاشتراكية العلمية هي الصيغة الملائمة لإيجاد المنهج الصحيح للتقدم. إن أي منهاج آخر لا يستطيع بالقطع أن يحقق التقدم المنشود، والذين ينادون بترك الحرية لرأس المال، ويتصورن أن ذلك طريق إلى التقدم؛ يقعون في خطأ فادح.
إن رأس المال في تطوره الطبيعي، في البلاد التي أرغمت على التخلف؛ لم يعد قادراً على أن يقود الانطلاق الاقتصادي، في زمن نمت فيه الاحتكارات الرأسمالية الكبرى في البلدان المتقدمة؛ اعتماداً على استغلال موارد الثروة في المستعمرات.
إن نمو الاحتكارات العالمية الضخم لم يترك إلا سبيلين للرأسمالية المحلية في البلاد المتطلعة إلى التقدم:
أولهما: أنها لم تعد تقدر على المنافسة إلا من وراء أسوار الحمايات الجمركية العالمية، التي تدفعها الجماهير.
والثاني: أن الأمل الوحيد لها في النمو هو أن تربط نفسها بحركة الاحتكارات العالمية، وتقتفى أثرها، وتتحول إلى ذيل لها، وتجر أوطانها وراءها إلى هذه الهاوية الخطيرة.
ومن ناحية أخرى فإن اتساع مسافة التخلف في العالم بين السابقين وبين الذين يحاولون اللحاق بهم لم تعد تسمح بأن يترك منهاج التقدم للجهود الفردية العفوية التي لا يحركها غير دافع الربح الأناني.
إن هذه الجهود بالتأكيد لم تعد قادرة على مواجهة التحدي. إن مواجهة التحدي لا يمكن أن تتم إلا بثلاثة شروط:
1- تجميع المدخرات الوطنية.
2- وضع كل خبرات العلم الحديث في خدمة استثمار هذه المدخرات.
3- وضع تخطيط شامل لعملية الإنتاج.
ومن الناحية الأخرى المقابلة لجانب زيادة الإنتاج؛ وهى ناحية عدالة التوزيع، فإن الأمر يقتضى وضع برامج شاملة للعمل الاجتماعي، تعود بخيرات العمل الاقتصادي ونتائجه على الجموع الشعبية العاملة، وتصنع لها مجتمع الرفاهية الذى تتطلع إليه وتكافح لكى يقترب يومه.
إن العمل من أجل زيادة قاعدة الثورة الوطنية؛ لا يمكن أن يترك لعفوية رأس المال الخاص المستغل ونزعاته الجامحة.
كذلك فإن إعادة توزيع فائض العمل الوطني على أساس من العدل، لا يمكن أن يتم بالتطوع القائم على حسن النية مهما صدقت.
إن ذلك يضع نتيجة محققة أمام إرادة الثورة الوطنية؛ لا يمكن بغير الوصول إليها أن تحقق أهدافها؛ وهذه النتيجة هي ضرورة سيطرة الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها طبقاً لخطة محددة.
إن هذا الحل الاشتراكي هو المخرج الوحيد إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وهو طريق الديمقراطية في كل أشكالها السياسية والاجتماعية. إن سيطرة الشعب على كل أدوات الإنتاج لا تستلزم تأميم كل وسائل الإنتاج، ولا تلغى الملكية الخاصة، ولا تمس حق الإرث الشرعي المترتب عليها، وإنما يمكن الوصول إليها بطريقين:
أولهما: خلق قطاع عام وقادر؛ يقود التقدم في جميع المجالات، ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
ثانيهما: وجود قطاع خاص يشارك في التنمية في إطار الخطة الشاملة، لها من غير استغلال؛ على أن تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعين، مسيطرة عليهما معاً.
إن ذلك الحل الاشتراكي هو الطريق الوحيد الذى يمكن أن تتلاقى عليه جميع العناصر في عملية الإنتاج؛ على قواعد علمية وإنسانية تقدر على مد المجتمع بجميع الطاقات التي تمكنه من أن يصنع حياته من جديد وفق خطة مرسومة مدروسة وشاملة.
إن التخطيط الاشتراكي الكفء هو الطريقة الوحيدة التي تضمن استخدام جميع الموارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية؛ بطريقة عملية وعلمية وإنسانية؛ لكى تحقق الخير لجموع الشعب، وتوفر لهم حياة الرفاهية.
إنه الضمان لحسن استغلال الثروات الموجودة والكامنة والمحتملة؛ ثم هو في الوقت ذاته ضمان توزيع الخدمات الأساسية باستمرار، ورفع مستوى ما يقدم منها بالفعل، ومد هذه الخدمات إلى المناطق التي افترسها الإهمال والعجز؛ نتيجة لطول الحرمان الذى فرضته أنانية الطبقات المتحكمة المستعلية على الشعب المناضل.
والتخطيط من هذا كله ينبغي أن يكون عملية خلق علمي منظم؛ يجيب على جميع التحديات التي تواجه مجتمعنا؛ فهو ليس مجرد عملية حساب الممكن، ولكنه عملية تحقيق الأمل؛ ومن ثم فإن التخطيط في مجتمعنا مطالب بأن يجد حلاً للمعادلة الصعبة؛ التي يكمن في حلها نجاح العمل الوطني مادياً وإنسانياً.. هذه المعادلة هي: كيف يمكن أن نزيد الإنتاج وفى نفس الوقت نزيد الاستهلاك في السلع والخدمات؟ هذا مع استمرار التزايد في المدخرات من أجل الاستثمارات الجديدة. هذه المعادلة الصعبة ذات الشعب الثلاث الحيوية تتطلب إيجاد تنظيم ذي كفاية عالية وقدرة؛ يستطيع تعبئة القوى المنتجة، ورفع كفايتها مادياً وفكرياً، وربطها بعملية الإنتاج.
إن هذا التنظيم مطالب بأن يدرك أن غاية الإنتاج هي توسيع نطاق الخدمات، وأن الخدمات بدورها قوة دافعة لعجلات الإنتاج، وأن الصلة بين الإنتاج والخدمات وسرعتها، وسهولة جريانها، تصنع دورة دموية صحيحة لحياة الشعب، ولحياة كل إنسان فرد فيه.
إن هذا التنظيم لابد له أن يعتمد على مركزية في التخطيط، وعلى لا مركزية في التنفيذ تكفل وضع برامج الخطة في يد كل جموع الشعب وأفراده.
إن الجزء الأكبر من الخطة نتيجة لذلك كله يجب أن يقع على القطاع العام الذى يملكه الشعب بمجموعه. إن ذلك ليس ضماناً لحسن سير عملية الإنتاج في طريقها المحدد من أجل الكفاية؛ وإنما هو في ذات الوقت تحقيق للعدل باعتبار أن هذا القطاع العام ملك للشعب بمجموعه.
إن النضال الوطني لجماهير الشعب هو الذى صنع نواة القطاع العام؛ بتصميمه على استرداد المصالح الاحتكارية الأجنبية، وتأميمها، وإعادتها إلى مكانها الطبيعي والشرعي؛ وهو الملكية العامة للشعب كله.
كذلك فإن هذا النضال الوطني – حتى في إبان معركته العسكرية المسلحة ضد الاستعمار – أضاف لهذا القطاع العام كل الأموال البريطانية والفرنسية في مصر، وهى الأموال التي سلبت من الشعب تحت ظروف الامتيازات الأجنبية، وفى العهود التي استبيحت فيها حرمة الثروة الوطنية لتكون نهباً للمغامرين الأجانب.
كذلك فإن هذا النضال الوطني في سعيه إلى الحرية الاجتماعية، وفى اقتحامه لكل مراكز الاستغلال الطبقي؛ هو الذى ضم إلى هذا القطاع العام الجزء الأكبر من أدوات الإنتاج؛ وذلك بقوانين يوليو سنة 1961، وثوريتها العميقة المعبرة عن إرادة التغيير الشامل في مصر.
إن هذه الخطوات الجبارة التي مكنت للقطاع العام من أداء دوره الطليعي في قيادة التقدم، ورسمت خطوطاً واضحة المعالم؛ كما أرست حدوداً أملاها الواقع الوطني، وفرضتها الدراسة الدقيقة لظروفه وإمكانياته وأهدافه، إن هذه الخطوط والحدود يمكن إجمالها فيما يلى:
أولاً: في مجال الإنتاج عموماً:
يجب أن تكون الهياكل الرئيسية لعملية الإنتاج؛ كالسكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات، وطاقات القوى المحركة، والسدود، ووسائل النقل البحري والبري والجوي، وغيرها من المرافق العامة؛ في نطاق الملكية العامة للشعب.
ثانياً: في مجال الصناعة:
يجب أن تكون الصناعات الثقيلة والمتوسطة والصناعات التعدينية في غالبيتها داخلة في إطار الملكية العامة للشعب، وإذا كان من الممكن أن يسمح بالملكية الخاصة في هذا المجال فإن هذه الملكية الخاصة يجب أن تكون تحت سيطرة القطاع العام المملوك للشعب وفى ظله، يجب أن تظل الصناعات الخفيفة بمنأى دائماً عن الاحتكار، وإذا كانت الملكية الخاصة مفتوحة في مجالها فإن القطاع العام يجب أن يحتفظ بدور فيها يمكنه من التوجيه لصالح الشعب.
ثالثاً: في مجال التجارة:
يجب أن تكون التجارة الخارجية تحت الإشراف الكامل للشعب، وفي هذا المجال فإن تجارة الاستيراد يجب أن تكون كلها في إطار القطاع العام، وإن كان من واجب رأس المال الخاص أن يشارك في تجارة الصادرات، وفى هذا المجال فإن القطاع العام لابد أن تكون له الغالبية في تجارة هذه الصادرات؛ منعاً لاحتمالات التلاعب. وإذا جاز تحديد نسب في هذا النطاق فإن القطاع العام لابد له أن يتحمل عبء ثلاثة أرباع الصادرات؛ مشجعاً للقطاع الخاص على تحمل مسئولية الجزء الباقي منها.
يجب أن يكون للقطاع العام دور في التجارة الداخلية، ولا بد للقطاع العام على مدى السنوات الثمانية القادمة – وهى المدة المتبقية من الخطة الأولى للتنمية الشاملة من أجل مضاعفة الدخل في عشر سنوات – أن يتحمل مسئولية ربع التجارة الداخلية على الأقل؛ منعاً للاحتكار، ليفسح مجالاً واسعاً في ميدان التجارة الداخلية للنشاط الخاص والتعاوني؛ على أن يكون مفهوماً بالطبع أن التجارة الداخلية خدمة وتوزيع مقابل ربح معقول لا يصل إلى حد الاستغلال تحت أي ظرف من الظروف.
رابعاً: في مجال المال:
يجب أن تكون المصارف في إطار الملكية العامة؛ فإن المال وظيفته وطنية لا تترك للمضاربة أو المغامرة، كذلك فإن شركات التأمين لابد أن تكون في نفس إطار الملكية العامة صيانة لجزء كبير من المدخرات الوطنية، وضماناً لحسن توجيهها والحفاظ عليها.
خامساً: في المجال العقاري:
يجب أن تكون هناك تفرقة واضحة بين نوعين من الملكية الخاصة؛ ملكية مستغلة، أو تفتح الباب للاستغلال وملكية غير مستغلة تؤدى دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما تؤديه في خدمة أصحابها، وفى مجال ملكية الأرض الزراعية فإن قوانين الإصلاح الزراعي قد انتهت بوضع حد أعلى لملكية الفرد لا يتجاوز مائة فدان؛ على أن روح القانون تفرض أن يكون هذا الحد شاملاً للأسرة كلها؛ أي للأب والأم وأولادهما القصر؛ حتى لا تتجمع ملكيات في نطاق الحد الأعلى تسمح بنوع من الإقطاع.
على أن ذلك يمكن أن يتم الوصول إليه خلال مرحلة السنوات الثمانية القادمة، وعلى أن تقوم الأسر التي تنطبق عليها حكمة القانون وروحه ببيع الأراضي الزائدة عن هذا الحد بثمن نقدى إلى الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي أو للغير؛ كذلك ففي مجال ملكية المباني تكفلت قوانين الضرائب التصاعدية على المباني، وقوانين تخفيض الإيجارات، والقوانين المحددة لقواعد ربطها؛ بوضع الملكية العقارية في مكان يبتعد بها عن أوضاع الاستغلال.. على أن متابعة الرقابة أمر ضروري، وإن كانت الزيادة في الإسكان العام والتعاوني سوف تساهم بطريقة عملية في مكافحة أي محاولة للاستغلال في هذا المجال.
إن قوانين يوليو سنة 1961 بالعمل الاشتراكي العظيم الذى حققته؛ تعد بمثابة أكبر انتصار توصلت إليه قوة الدفع الثوري في المجال الاقتصادي. إن هذه القوانين تعد امتداداً لمقدمات سبقتها، كانت جسراً عبرته عملية التحول نحو الاشتراكية بنجاح منقطع النظير.
إن هذه المرحلة الثورية الحاسمة ما كان يمكن إتمامها بالكفاية التي تمت بها وبالجو السلمى الذى تحققت فيه؛ لولا قوة إيمان الشعب، ولولا وعيه، ولولا استجماعه لكل قواه في مواجهة حاسمة مع الرجعية، استطاع فيها أن يقتحم عليها جميع مواقعها المنيعة، ويؤكد سيادته على مقدرات الثروة في بلاده.
إن قوانين يوليو المجيدة، والطريقة الحاسمة التي تمت بها، والجهود الموفقة الشجاعة التي بذلها مئات الألوف من أبناء الشعب – العاملين في المؤسسات التي انتقلت ملكيتها إلى الشعب بهذه القوانين – في الفترة الحرجة التي أعقبت عملية التحويل الواسعة المدى، قد مكنت من حفظ الكفاية الإنتاجية لهذه المؤسسات ودعمها.
إن ذلك كله إذ يؤكد تصميم الشعب على امتلاك مقدراته؛ يثبت في الوقت نفسه مقدرة الشعب على توجيهها، واستعداده بالعناصر المخلصة من أبنائه لتحمل أصعب المسئوليات وأكثرها دقة. ومن المؤكد أن الإجراءات التي أعقبت قوانين يوليو الاشتراكية قد حققت بنجاح عملية تصفية كانت محتمة وضرورية، لقد تمت بعد أن بدت محاولة الانقضاض الرجعى على الثورة الاجتماعية عملية حاسمة لإزالة رواسب عهود الإقطاع والرجعية والتحكم. إن هذه العملية قطعت الطريق على كل محاولات التسلل والدوران من حول أهداف الشعب، ولحساب المصالح الخاصة للفئات التي حكمت وتحكمت من المراكز الطبقية الممتازة، ولقد أكدت هذه الإجراءات – الإجراءات يعنى الحراسة – أن الشعب قد عقد عزمه من غير تردد على رفض كل وضع استغلالي؛ سواء كان طبقية موروثة، أو كان طفيلية انتهازية.. على أنه من الواجب ألا يستقر في أذهاننا أن الرجعية قد تم الخلاص منها إلى الأبد؛ إن الرجعية مازالت تملك من المؤثرات المادية والفكرية ما قد يغريها بالتصدي للتيار الثوري الجارف؛ خصوصاً في اعتمادها على الفلول الرجعية في العالم العربي، المسنودة من جانب قوى الاستعمار. إن اليقظة الثورية كفيلة -! تحت كل الظروف – بسحق كل تسلل رجعى مهما كانت أساليبه، ومهما كانت القوى المساعدة له، وإنه لمن الأمور البالغة الأهمية أن تتخلص نظرتنا إلى التأميم من كل الشوائب التي حاولت المصالح الخاصة أن تلصقها به.
إن التأميم ليس إلا انتقال أداة من أدوات الإنتاج من مجال الملكية الخاصة إلى مجال الملكية العامة للشعب، وليس ذلك ضربة للمبادرة الفردية كما ينادى أعداء الاشتراكية؛ وإنما هو توسيع لإطار المنفعة، وضمان لها في الحالات التي تقتضيها مصلحة التحول الاشتراكي الذى يتم لصالح الشعب؛ كذلك فإن التأميم لا يؤدى إلى خفض الإنتاج، بل إن التجربة أثبتت قدرة القطاع العام على الوفاء بأكبر المسئوليات، وبأعظم قدر من الكفاية؛ سواء في تحقيق أهداف الإنتاج أو في رفع مستواه النوعي، وحتى إذا وقعت خلال عملية التحول الكبيرة بعض الأخطاء فلابد لنا أن ندرك أن الأيدي الجديدة التي انتقلت إليها المسئولية في حاجة إلى المران على تحمل مسئولياتها، ولقد كان محتماً على أي حال أن تنتقل المصالح الكبرى الوطنية إلى الأيدي الوطنية، حتى وإن اضطررنا إلى مواجهة صعوبات مؤقتة، وليس التأميم – كما تنادى بعض العناصر الانتهازية – عقوبة تحل برأس المال الخاص حين ينحرف، ولا ينبغي بالتالي ممارسته في غير أحوال العقوبة. إن نقل أداة من أدوات الإنتاج من مجال الملكية الفردية إلى مجال الملكية العامة أكبر من معنى العقوبة وأهم؛ على أن الأهمية الكبرى المعلقة على دور القطاع العام لا يمكن أن تلغي وجود القطاع الخاص.
إن القطاع الخاص له دوره الفعال في خطة التنمية من أجل التقدم، ولابد له من الحماية التي تكفل له أداء دوره، والقطاع الخاص الآن مطالب بأن يجدد نفسه، وبأن يشق لعمله طريقاً من الجهد الخلاق، لا يعتمد – كما كان في الماضي- على الاستغلال الطفيلي. إن الأزمة التي وقع فيها رأس المال الخاص قبل الثورة تنبع من واقع الأمر من كونه كان وارثاً لعهد المغامرين الأجانب؛ الذين ساعدوا على نزح ثروة مصر إلى خارجها في القرن التاسع عشر. لقد تعود رأس المال الخاص أن يعيش وراء أسوار الحماية العالية التي كانت توفر له من قوت الشعب؛ كذلك تعود السيطرة على الحكم بغية التمكين له من مواصلة الاستغلال، ولقد كان عبئاً لا فائدة منه أن يدفع الشعب تكاليف الحماية؛ ليزيد أرباح حفنة من الرأسماليين، ليسوا – في معظم الأحوال – غير واجهات محلية لمصالح أجنبية، تريد مواصلة الاستغلال من وراء الستار؛ كذلك فإن الشعب لم يكن بوسعه أن يقف مكتوف اليدين إلى الأبد أمام مناورات توجيه الحكم لصالح القلة المتحكمة في الثروة، ولضمان احتفاظها بمراكزها الممتازة على حساب مصالح الجماهير.
إن التقدم بالطريق الاشتراكي هو تعميق للقوائم التي تستند إليها الديمقراطية السليمة، وهى ديمقراطية كل الشعب.
إن صنع التقدم بالطريق الرأسمالي حتى وإن تصورنا إمكان حدوثه في مثل الظروف العالمية القائمة الآن، لا يمكن من الناحية السياسية إلا أن يؤكد الحكم للطبقة المالكة للمصالح والمحتكرة لها. إن عائد العمل في مثل هذا التصور يعود كله إلى قلة من الناس، يفيض المال لديها لدرجة أن تبدده في ألوان من الترف الاستهلاكي يتحدى حرمان المجموع. إن ذلك معناه زيادة حدة الصراع الطبقي، والقضاء على كل أمل في التطور الديمقراطي، لكن الطريق الاشتراكي بما يتيحه من فرص لحل الصراع الطبقي سلمياً، وبما يتيحه من إمكانية تذويب الفوارق بين الطبقات؛ يوزع عائد العمل على كل الشعب طبقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
إن الطريق الاشتراكي بذلك يفتح الباب للتطور الحتمي سياسياً؛ من حكم ديكتاتورية الإقطاع المتحالف مع رأس المال إلى حكم الديمقراطية الممثلة لحقوق الشعب العامل وآماله. إن تحرير الإنسان سياسياً لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء كل قيد للاستغلال يحد حريته. إن الاشتراكية مع الديمقراطية هما جناحا الحرية، وبهما معاً تستطيع أن تحلق إلى الآفاق العالية التي تتطلع إليها جماهير الشعب.
يتبع؛ الباب السابع (الانتاج والمجتمع)…

التعليقات مغلقة.