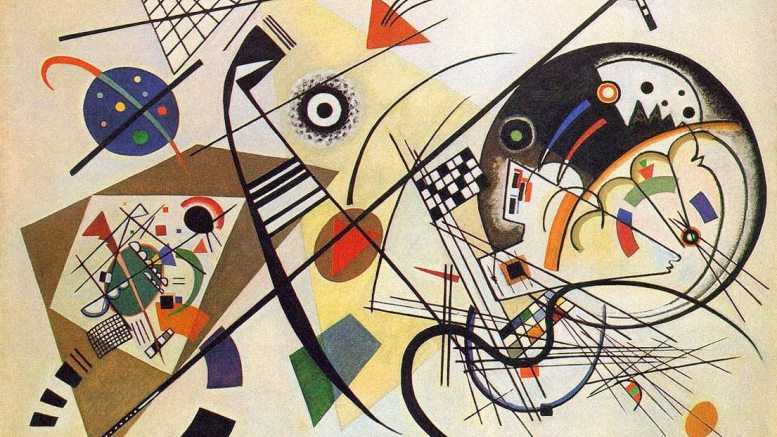
د. عبد الله تركماني
بداية يجدر بنا أن نؤكد أنّ عصر الحداثة لم ينغلق في نمط نهائي، بل هو في تطور متواصل، بهدف التعاطي المجدي مع التحديات التي تواجهها المجتمعات البشرية، عبر عقلانيته النقدية. ولكنّ مشروع الحداثة، الذي بدأ منذ عصر التنوير الأوروبي في القرن الثامن عشر، قد أوصلنا إلى مرحلة جديدة من تاريخ الإنسانية هي مرحلة ما بعد الحداثة. فقد نعى الفيلسوف الفرنسي جان فرانسوا ليوتار عصر الحداثة، حيث رأى أنّ أهم معالم المرحلة الراهنة للمعرفة الإنسانية، هو سقوط النظريات الكبرى وعجزها عن قراءة العالم. وفي المقابل، فإنّ الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس، وريث مدرسة فرانكفورت النقدية، نشر مقالة هامة تحت عنوان ” مشروع الحداثة لم يكتمل بعد “.
وهكذا، تظل الحدود ما بين الحداثة وما بعد الحداثة متداخلة متشابكة، وهذا ما دعا بعض المفكرين إلى القول: إنّ ما بعد الحداثة ليست نهاية الحداثة، بل كامنة في حالتها الوليدة، وهي حالة مستمرة.
وفي الواقع يتميز الخطاب الثقافي، في ظل ما تشهده المجتمعات المعاصرة من تحديات وتحوّلات في هذا الزمن المتغيّر، بأنه خطاب إشكالي: فمن جهة، هناك الانهيارات السياسية والأيديولوجية التي أصابت العديد من الأفكار والنظم والمشاريع. ومن جهة ثانية، هناك الطفرات المعرفية التي شهدتها الفلسفة وعلوم الإنسان، والتي أسفرت عن انبثاق قراءات جديدة للحداثة وشعاراتها حول العقل والحرية والتقدم. ومن جهة ثالثة، هناك الثورات العلمية والتقنية والمعلوماتية التي ندخل معها في طور حضاري جديد. ولعلَّ أحد أهم ملامح أزمة الخطاب الثقافي المعاصر تكمن في محاولة التعرف على عناصر ومكوّنات ثقافة العولمة/ثقافة ما بعد الحداثة وأدواتها الوظيفية، وكذلك ما تنطوي عليه من قضايا: الثقافة الوطنية، والهوية الحضارية، والخصوصية القومية، وتعدد الثقافات، والعنصرية، والأقليات، والهجرة. وإزاء كل ذلك، يبدو أنه من الضروري أن يعمل المرء على إعادة صياغة وترتيب أفكاره، بما يمكّنه من فهم وتشخيص هذه التحوّلات العميقة بداية.
ولعل منبع تجدد الإشكال الثقافي اليوم راجع إلى تصادم حقيقتين بارزتين: أولاهما، الالتزام الجماعي بمقتضيات الكونية الناتجة عن مسار تَوَحُّد البشرية واقتران مصائر أبنائها، من خلال الثورة الاتصالية والاندراج في الاقتصاد العالمي. وثانيتهما، الإقرار النظري والمعياري بحق الثقافات في الاختلاف والتمايز وتماثلها من حيث القيمة والمشروعية. والواقع أنّ مكمن الإشكال عائد إلى صعوبة صياغة تأليفية لهاتين الحقيقتين.
ومما يزيد الأمر تعقيداً أنّ الثقافة الكونية، التي وجدت في ثورة الاتصالات مرتكزاً وفرصة للانتشار الهائل، تتوقف عند بعض الرموز والإشارات التي يمكن فهمها والتعرف عليها في كل مكان، مهما تعددت الثقافات المحلية وتنوعت.
أصول مصطلح ما بعد الحداثة:
ظهر لأول مرة في اللغة الإنكليزية لدى ناقد أمريكي هو تشارلز جيكينس حوالي عام 1975، وقد طبقه على فن العمارة أولاً قبل أن ينتقل إلى الفلسفة والميادين الأخرى لاحقاً. ولكنّ المصطلح لم يأخذ كل أبعاده الفلسفية إلا عندما أصدر المفكر الفرنسي جان فرانسوا ليوتار كتابه المعروف ” شرط ما بعد الحداثـة ” عام 1979. وفي رأي هذا الفيلسوف أنّ الأيديولوجيات الكبرى التي سيطرت علينا طيلة القرنين الماضيين كالليبرالية، والاشتراكية، والماركسية، لم تستطع أن تحقق للبشر السعادة على هذه الأرض. ولذلك فهو يدعوهـــــا بـ ” الحكايات الطوباوية ” أو ” الأساطير الكبرى “، وبالتالي ينبغي التخلي عنها ومحاولة البحث عن أيديولوجيا بديلة، وهي ما بعد الحداثة.
إنّ مفكري ما بعد الحداثة يرون أنّ النظريات الشمولية الكبرى والأيديولوجيات والتعميمات، التي أنتجتها الحداثة، أخفقت في الإجابة عن كثير من الأزمات خاصة في ادعائها بالتجانس والوضوح والتماسك والعلمية، لذا فهم يرفضون التعميم الشامل مقابل شرح الخصوصيات بسياقاتها ومستوياتها، ويرفضون التجانس الوهمي مقابل التنوع الواقعي، ويرفضون وضوح الفكرة مقابل التضحية بدقتها، ويرفضون الأجوبة القطعية مقابل الاحتمالات المتعددة للحالة، ويرفضون الأجوبة الكاملة مقابل الأجوبة الجزئية والنسبية.
وباعتبار أنّ حركة ما بعد الحداثة تشكل أحد مظاهر ثقافة العولمة فإننا نتناول أهم مبادئها، التي لها آثار عميقة على مناهج البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وخاصة ما يتعلق منها بتعدد الثقافات:
(1) – سعي حركة ما بعد الحداثة لتحطيم السلطة الفكرية للأنساق الفكرية الكبرى المغلقة، التي عادة ما تأخذ شكل الأيديولوجيات، على أساس أنها في زعمها تقدم تفسيراً كلياً للظواهر، وأنها ألغت حقيقة التنوّع الإنساني، وانطلقت من حتمية وهمية لا أساس لها.
(2) – لحركة ما بعد الحداثة أفكار محددة وجديدة حول التاريخ كعلم مستقل، أو كمدخل لكثير من العلوم الاجتماعية، تريد الحركة أن تنزله من موقعه وتقلل من أهميته ومن كثرة الاعتماد عليه. والتقليل من أهمية التاريخ يُرَدُّ إلى فكرة أساسية مفادها أنّ الحاضر الذي نعيشه ينبغي أن يكون هو محور اهتمامنا، وليس التاريخ مهماً إلا بقدر ما يلقي الضوء على الأحوال المعاصرة.
(3) – هناك لحركة ما بعد الحداثة أفكار عن دور النظرية، وعن نفي ما يطلقون عليه ” إرهاب الحقيقة “. والفكرة الجوهرية هنا أنّ الحقيقة يكاد يكون من المستحيل الوصول إليها، فهي إما أن تكون لا معنى لها أو أن تكون تعسفية. ومن هنا ترفض الحركة أي زعم باحتكار ما يسمى الحقيقة، لأنّ في ذلك ” إرهاباً فكريـاً ” غير مقبول.
وهكذا، يشهد العالم مرحلة إعادة نظر جذرية في قضية الثقافة، بل إعادة اعتبار لها من زاوية استراتيجيات المستقبل، خاصة وأنّ التطورات الجارية تبشّر بمستقبل جديد على مستوى الإنجاز المادي والتقدم التكنولوجي، ومراكز البث الإلكتروني، وبرامج التنفيذ في مجالات الإدارة والعمل الوظيفي.
ما هو التنوع الثقافي:
بداية يُقصد بعبارة ” التنوع الثقافي ” تعدد تعبيرات الجماعة والمجتمعات عن ثقافاتها، وأشكال انتقال هذه الثقافات، بالمضامين الحاملة لها، أي المعاني الرمزية والأبعاد الفنية والقيم الثقافية المستمدة من الهويات الثقافية أو المعبرة عنها.
وتعتمد أطروحة التنوع الثقافي جملة مبادئ أهمها: تساوي جميع الثقافات في الكرامة وفي جدارة الاحترام، ومبدأ الانتفاع المنصف، ومبدأ الانفتاح والتوازن. ويعتني التنوع الثقافي بمبدأ الاعتماد المتبادل الذي يعني التعاون بين الأطراف الفاعلة في الوحدة الثرية بتنوعها، والقادرة على أن تتيح لعناصرها حرية التباين دون القضاء على أساس الوحدة.
وفي الواقع، تواجه كثير من الجماعات الأصلية، وبخاصة في عالم الجنوب، خطورة احتمال اندثارها واختفائها من الوجود، ككيانات عرقية لها هوياتها وثقافاتها وتقاليدها، أمام زحف تيارات العولمة الهوجاء. وتعتبر هذه الجماعات الأصلية مجرد أقليات تعيش في شبه عزلة، بحيث أصبحت تؤلف ما هو أقرب إلى المحميات البشرية المتخلفة المهمشة التي لا يكاد يسمع لها رأي ولا تشارك مشاركة فعلية في اتخاذ القرارات التي يتعين عليها الالتزام بها، كما يساهم في هذا التهميش التقدم التكنولوجي الذي يتطلب توافر إمكانيات مادية وفكرية غير متاحة لتلك الجماعات في أغلب الأحيان.
إنّ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان حين أقرت التنوع الثقافي استندت إلى المبادئ التالية: المساواة بين الثقافات، ورفض التمييز بين الأمم والشعوب، وعدم الاعتراف بفكرة التفوق أو الهيمنة الثقافية. وقد أكدت منظمة اليونسكو حق كل شعب في الحفاظ على هويته الثقافية، وتبنّى إعلان مكسيكو عام 1982 هذا الحق مؤكدا احترام الهوية الثقافية، وعدم السعي إلى فرض هوية ثقافية بالإكراه على أي شعب.
ويصعب على المرء أن يصدّق أنّ لغة واحدة من اللغات الأم التي تمتلكها شعوب العالم تختفي كل سنتين. وليس من باب المصادفة أنّ الكثير من الوثائق التي صدرت في إطار منظمة اليونسكو تتضمن إشارات مهمة إلى اللغات، ومنها الإعلان العالمي للتنوع الثقافي وخطة عمله في العام 2001، والاتفاق الخاص بصون التراث الثقافي غير المادي في العام 2003، والتوصية في شأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم الانتفاع بالمجال الإلكتروني في العام 2003، واتفاق حماية أشكال التعبير الثقافي وتعزيز تنوعه في العام 2005.
أما الاتفاقية العالمية حول التنوع الثقافي التي صدرت عن الدورة 33 لمؤتمر اليونسكو في العام 2005، فقد حظيت بإجماع عالمي شامل شذّت عنه الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل. ومن المعروف أنّ الاتفاقية المذكورة قد أتت تجسيداً مؤسسياً وتشريعياً للإعلان العالمي حول التنوع الثقافي بعيد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وتعني هذه العبارة إضفاء الخصوصية على المنتوجات الثقافية، باعتبارها ليست مجرد سلع عادية للتداول، بل هي أنماط وجودية وأشكال تعبير عن الهويات المختلفة، وبالتالي يجب حمايتها بصفتها تراثاً إنسانياً مشتركاً، في مقابل نزوع الهيمنة الثقافية واللغوية.
وبعيداً عن المبالغات والتوصيفات والتهويمات الأيديولوجية، فإنّ مظاهر العولمة كلها تشير إلى أنّ الإنسانية تتجه نحو ثقافة عالمية ومشتركة، فلم تعد منظمة اليونسكو تتردد في الحديث عن أخلاقيات عالمية جديدة. ففي تقريرها عـن ” التنوّع البشري الخلاق ” دعوة واضحة إلى عولمة تتسم بوحدة وتنوّع الثقافة الإنسانية معاً. وقد أصبح الشعور بوحدة هذا الكوكب حقيقة وليس مجرد أمنيات، سواء أكان ذلك من خلال سرعة التعرف عما يجري في العالم، أو الإحساس بمشكلات قد تتجاوز حدود الدول مثل: الإرهاب والمخدرات والأوبئة والجريمة المنظمة وغيرها.
ثم أنّ معظم الشواهد تشير إلى أنّ أثر العولمة يكرس من الخصوصيات الثقافية بالمقدار نفسه، إن لم يكن أكثر، من نشره لقيم عابرة لتلك الخصوصيات. فما توفره العولمة من آليات تواصل وتكنولوجيا هي برسم الاستخدام من قبل أية ثقافة على الأرض، وهو ببساطة أمر غير مسبوق تاريخياً. وفي الحقيقة أنّ المستفيد الأكبر من العولمة هو الثقافات الأقل حضوراً من الثقافة الغربية، حيث وفرت لها وسائل العولمة الاتصالية قدرة على التواصل والإنتاج ما كان لها أن تتوفر عبر الوسائل التقليدية.
ومن جهة أخرى، ليس غريباً أن يربط كثيرون بين فكرة التنوّع الثقافي والنظم والمعتقدات الليبرالية في الغرب، فالفكرة بمضمونها المعاصر نشأت وتطورت في الدول الغربية، واقترنت بمسألة حماية الأقليات وضمان حريات الآخر. ولكن لا يمكن التسليم بصحة اعتبار الليبرالية الحاضن الفكري والسياسي للتنوع الثقافي على نحو مطلق.
وهناك بالتأكيد موقف ليبرالي متعاطف مع هذه الفكرة، ولكن هناك إلى جانب ذلك موقف ليبرالي يعارضه بقوة: لأنّ هناك تضاداً فكرياً كبيراً، في نظر العديدين، بين الليبرالية والالتزام بالتنوع الثقافي. فالليبرالية، خاصة تجلياتها في مرحلة ما بعد الحداثة، تشدد على حرية الأفراد وعلى المساواة فيما بينهم، وهي تجتهد في إزاحة وتفكيك كافة القيود المجتمعية والقانونية والمؤسسية، التي تحد من حرية الأفراد وتقيّد إراداتهم وتعطّل قدراتهم. وإذ تلطّف الليبرالية من مفاعيل الفردية الجامحة، التي تنتزع الفرد من الجماعة وتبعده عن أهله وأصدقائه، فإنها تفعل ذلك عبر تكوين التجمعات الطوعية. فهل تكون مساندة الليبراليين لمثل هذه التجمعات وحرصهم على حريتها هي التعبير عن التزامهم بالتنوع الثقافي؟
قد يكون الذين يرون أنّ الليبرالية هي النظام السياسي الأفضل لتطبيق التنوّع الثقافي على حق، ولكن ليس هناك من مسوّغ للاعتقاد بأنّ النظام الليبرالي وحده يوفر هذه الميزة. إنّ الليبرالية قد تأتي ولكن من دون أن يأتي معها التنوّع الثقافي، إنها عقيدة إنسانية كبرى، ولكنها لا تقدم حلاً لكافة المشاكل التي تعاني منها المجتمعات.
القراءة ما بعد الحداثية لتعدد الثقافات:
مفهوم ما بعد الحداثة يشير مباشرة إلى الحضارة الأمريكية المتشكلة من ثقافات متعددة، كما ترادف مصطلح ما بعد الحداثة مع مصطلح العولمة لعدة مسوّغات، أهمها التزامن بينهما. بينما الثقافة الفرنسية لم تكن في حاجة إلى مصطلح ما بعد الحداثة نظراً للمفهوم الذي كانت تعطيه هي للحداثة. فالحداثة، بالمعنى الفرنسي، أي البودليري النيتشوي، كانت “ما بعد حداثية” على الدوام، على هذا النحو فالحداثيون الفرنسيون كلهم ما بعد حداثيين، بمعنى أنهم لم يفهموا الحداثة كتوقف عند لحظة لها مقوماتها الثابتة، ومعناه أنهم فهموها كحركة انفصال ما تفتأ تتجدد، ومعناه أيضاً أنهم أقحموا البَعدية داخل حركة التحديث ذاتها، فنظروا إلى ما بعد الحداثة على أنها حداثة الحداثة.
إنّ الاختلاف القائم ما بين الحداثة وما بعد الحداثة، الغربيتين، الذي يجعل ما بعد الحداثة تستبدل مفهوم “الإجماع” الحداثي بمفهوم “خرق الإجماع” ما بعد الحداثي، يدفع الثقافة الغربية لإتاحة الفرصة لما يسمى “الثقافات الفرعية” التي تنتجها أقوام غير أوروبية، وأقليات تعيش في المجتمعات الغربية، أو حتى أفراد يكتبون بلغات الغرب الأساسية، لكي يثبتوا حضورهم في هذه الثقافات.
نحو عقد ثقافي في مرحلة ما بعد الحداثة:
تتسبب العولمة، في المجال الثقافي، بحركة مزدوجة ومتناقضة من المجانسة والتشظي، والسؤال هنا هو: كيف نؤكد على مبادئ المشتركات الإنسانية من دون أن ننزلق إلى تأسيس نظام جديد يقوم على هيمنة ثقافة واحدة؟ وهل من الممكن تصور عقد ثقافي بينما شرط الثقافة هو التجاوز المستمر؟ وهل تستطيع الميزة الثقافية أن تؤسس لأخلاقيات الاعتراف بالآخر ولنهج حقيقي لمعرفة متبادلة بين البشر؟
إنّ عقداً ثقافياً ذا طابع إنساني يجب أن يتجنب التعصب من جهة، والانقطاع عن الجذور، من جهة أخرى. ولعلَّ بروز ما يطلق عليه ” المجتمع المدني العالمي ” مصاحباً لنمو وعي كوني يركز على عولمة المشكلات الإنسانية، ويتخطى الحدود التقليدية للدول، ويعبر الجسور بين الثقافات المتنوعة، ما يشير إلى أنّ مفهوماً جديداً كونياً للتقدم تجري الآن صياغته، وتشارك في هذه الصياغة أطراف شتى، محلية وإقليمية وعالمية، بواسطة حوار الثقافات الذي تصاعدت وتيرته في العقد الأخير، حيث تتخذ هذه الصياغة اتجاهات شتى، بل وأصبحت له تطبيقات فعالة.
وهكذا يمكن القول أنّ الإنسانية كلها مشغولة، عبر دروب شتى، في إعادة التفكير في مفهوم التقدم، وإن كانت كل ثقافة إنسانية معاصرة تحاول النبش في جذورها التاريخية للعثور على المعاني الأصلية للفكرة، سعياً وراء الحوار المشترك لصياغة مفهوم كوني لها، بما يتفق مع الطموح المعاصر لعالمية القيم بدون أن يكون في ذلك قضاء علي الخصوصيات الثقافية.
ومن أجل ذلك، فلنجرؤ على توكيد وجود أخلاقيات إنسانية شاملة، هي تلك التي ألهمت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948. فعلى العكس من مزاعم أعداء الحرية والأصوليين من كل حدب وصوب، ليست هذه الأخلاقية نموذجاً غربياً، بل إنها ميزة إنسانية. وهي ميزة كل الشعوب، وكل الأمم، وكل الديانات، لأنه ليس ثمة دين تأسس على إفناء الناس وإلغاء تميّزهم ورفض رؤيتهم للكون والمجتمع. وليس ثمة أي تناقض بين هذه الأخلاق وتنوّع الثقافات، لأنّ احترام هذا التنوّع هو من صلب هذه الإنسانية التي ننادي بها ونتمناها.
إنّ هذا المشترك الإنساني هو موقف فكري وحضاري عميق، يتطلع نحو التصالح والتعايش والاستيعاب والاستفادة من كل المكتسبات الإنسانية التي تقوم على مبادئ متماثلة في جوهرها، ومتحدة في نسقها، وإن اختلفت في طريقة الوصول إليها أو التعبير عنها، كقيم العدل والحرية والتقدم والمساواة والتسامح وحق الحياة الكريمة.
وبذلك سيشهد القرن الواحد والعشرون درجة أكبر من التسامح بين الثقافات، وهو تسامح يقوم على أساس المعرفة والفهم لتلك الثقافات ومبررات وجودها، ومعاني رموزها، والسلوكيات المرتبطة بها، والقيم التي تكمن وراءها. وهو الأمر الذي سيجعل التسامح قيمة من قيم المستقبل، رغم اختلاف النظرة والفكرة والسلوك والمعتقد. وهذا من المؤشرات الهامة على أنّ قيم المستقبل ستكون قيماً إيجابية فاعلة أكثر منها مواقف سلبية انفعالية، حيث سيجري الاهتمام بالمستقبل والنظر إلى الأمام، واحترام قوى التقدم والنجاح والإنجاز أكثر من النظر إلى الوراء وتمجيد الماضي والارتباط به أو الاستكانة والرضا بالأمر الواقع، ومحاولة إيجاد مبررات لقبوله. وإن كان هذا لا يعني التنكّر للتراث الثقافي، وإنما يعني مراجعته وإحياءه من خلال إبراز الجوانب الإيجابية فيه التي تضيف إلى الحضارة الإنسانية.
إنّ حوار الثقافات هو مشروع حياة البشرية ومستقبلها، والمنهج الذي يدفع الشعوب إلى أن تتعاطى مع بعضها بالأسلوب الإنساني الرفيع، القائم على أساس التعارف لا الخصام. والحال أنّ مختلف المنظومات الثقافية العالمية تتحسس الحاجة الموضوعية إلى صياغة وتقنين مقتضيات الكونية، حتى ولو اختلفت، جزئياً، في ضبط معايير ومحددات هذه الكونية. بيد أنّ الاعتراض لا يصل إلى قاعدتها القِيَمِيّة من: تفعيل لحقوق الإنسان، وضمان للحريات العامة، وتكريس لأخلاقيات التسامح، والدفاع عن مبادئ السلم والتضامن الإنساني. وحينذاك يكون حوار الثقافات قد انتقل من كونه طموحاً إلى كونه فرصة تاريخية ومشروعاً إنسانياً وثقافياً يستحق أن يعمل الجميع لأجله.
نقد ما بعد الحداثة:
أثارت ما بعد الحداثة، في أطروحاتها وأفكارها، عاصفة من النقد والرفض أتى من مدارس فكرية مختلفة، بعضها مخلص للحداثة وتراثها. فورثة “مدرسة فرانكفورت” أصروا على إعادة قراءة الحداثة بوصفها مشروعاً لم يكتمل بعد، كما عبر عن ذلك يورغن هابرماس، الذي انتقد أطروحات ما بعد الحداثة وشكك في حاجتنا إليها، وأكد على أننا لا يمكننا أن ننقض الحداثة ونهدمها، بل أن ننقدها من أجل تجاوزها. وهذا لا يعتبر خروجاً على الحداثة أو نفيا لها، وإنما استمرار لمشروعها الذي لم يكتمل، ولهذا نراه يمدح مفاهيمها الأساسية المتمثلة في العقل والإنسان والتنوير.
أما عالم الاجتماع الفرنسي آلان تورين، الذي خصص للموضوع كتاباً كبيراً مهماً تحت عنوان ” نقد الحداثة “، فإنه لم ينقد الحداثة إلا بعد أن استعرض إنجازاتها الإيجابية في الفصول الأولى من الكتاب وكيفية تشكلها على مدار القرون الأربعة المنصرمة. ولم يثنِ على فلسفة ما بعد الحداثة، إذا كانت تعني الانقلاب على الحداثة وتدمير إنجازاتها الرائعة، وقال بما معناه: نعم للنقد الإيجابي للحداثة، ولكن لا وألف لا للنقد السلبي الهدام الذي يطيح بكل شيء.
ويرى د. هشام شرابي، الأستاذ في جامعة “جورج تاون” الأمريكية، أنّ اتجاهي الحداثة وما بعدها خرجا من بوتقة المجتمع الغربي، وقد استنفدت كل معطيات الحداثة، وهم الآن يتحدثون عن ما بعد الحداثة، لكن بالنسبة لنا فنحن العرب، هل في مقدورنا أن نقف وقفة نتساءل فيها عما إذا كان بإمكاننا صياغة حداثتنا الخاصة أو ما بعد حداثتنا الخاصة، وهذا لا يدعو بشكل من الأشكال إلى القطيعة المعرفية مع الغرب.
العرب وما بعد الحداثة وتعدد الثقافات:
مهما كان أمر الحركات الفكرية المختلفة، بما فيها حركة ما بعد الحداثة التي قد لا تعنينا كثيراً في العالم العربي، على اعتبار أننا لم ننخرط في عمق الحداثة أصلاً. نحن أحوج ما نكون إلى ترسيخ القيم العقلانية في بلادنا، من أجل محاربة الجهل والتعصب والاستبداد في الرأي وكل القيم القروسطية التي لا تزال تسيطر علينا أو على قطاعات واسعة من مجتمعاتنا، نحن بحاجة إلى الحداثة والتحديث في كل المجالات.
إنّ المشكلة الملحة المطروحة علينا هي نقد الموروث المتراكم المتحجر والعصبيات القديمة المتأصلة في النفوس، لا نقد الحداثة، على عكس ما هو سائد في الغرب. ونحن بحاجة إلى تنمية العقلانية لا تفكيكها، وإلى ترسيخ الحداثة لا نقدها وتشريحها.
إنّ الحاجة ملحة من أجل إعادة النظر في المقوّمات التي انبنى عليها الخطاب العربي قرناً من الزمن، ليس لإعادة التواصل التبعي مع الفكر الغربي، وإنما للنظر فيه بما يمكن أن يساعدنا في تجديد مقولاتنا التي أصابها التقادم. وتبدو الفرصة مؤاتية بشكل كبير مع الفكر ما بعد الحداثي، فكر الاختلاف والتغاير. وتوظيف المقولات ما بعد الحداثية في نقدنا للمشروع الحداثي سيمكّننا، في رأي الدكتور محمد عابد الجابري، من بناء علاقة صحية ومتوازنة مع المشروع الحداثي نفسه.
إنّ فهمنا لما بعد الحداثة ولتحولاتها الاجتماعية سيساعدنا على فهم العصر، واستيعاب الحداثة نفسها التي نلهث وراءها دون اللحاق بها منذ عقود طويلة. والسؤال اليوم ليس في حاجتنا إليها بقدر ما هو عن مدى رغبتنا في تجاوز دور التابع السلبي، والعمل على المشاركة الجدية والفاعلة في هذا العصر فكراً وبناءً.
وانطلاقاً من المعطيات، الموصوفة أعلاه، ثمة أهمية كبرى لصياغة استراتيجية عربية للحوار والشراكة مع الثقافات الأخرى، مما يستدعي القيام بدور نقدي مزدوج: من جهة، الاستيعاب النقدي لفكر الآخر، بمعنى المتابعة الدقيقة للحوار الفكري العميق الذي يدور في مراكز التفكير العالمية، وفي العواصم الثقافية الكبرى. ومن جهة ثانية، النقد الذاتي للأنا العربية، بما يعنيه ذلك من ضرورة أن نمارس النقد الذاتي لممارساتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عقود مرحلة استقلالاتنا الوطنية على الأقل.
فإذا كان التنوّع العرقي والطائفي والمذهبي هو جزء لا يتجزأ من طبيعة الدولة القومية الحديثة، التي لا تقوم على أسس دينية أو مذهبية وإنما على أساس من المصالح المشتركة المقوننة، فإنّ العالم العربي لم يكن ناجحاً في التعامل مع قضايا التنوّع هذه، وفي كثير من الأحيان أدى الفشل إلى حالات من الحرب الأهلية. مما يؤدي إلى عدة استنتاجات: أولها، أنه لا يجوز إنكار القضية كلها، فالتنوّع والتعدد هو من الحالات الطبيعية، وما لم يتم إدراكها والتعامل معها، أو يتم النظر إليها كنوع من المؤامرات الأجنبية، فإنّ القضية على الأغلب سوف تتحول إلى أزمات سياسية كبرى. وثانيها، أنّ الاعتراف بالتنوّع يعني المعرفة الواسعة بالجماعات المختلفة المكونة للأمة واعتبارها جزءًا من التراث القومي. وثالثها، أنّ وجود المساواة القانونية وحقوق المواطنة شرط ضروري لخلق مناخ للتفاهم بين الجماعات المختلفة، بل وحتى لخلق مناخ للتوافق حول طبيعة النظام السياسي في الأقطار العربية. ورابعها، أنّ الدولة التي تعيش حالة من النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام تكون أكثر استعداداً وقدرة على التعامل مع مشكلات التنوّع، لأنها تخلق هدفاً مشتركاً في تحقيق الرخاء. وخامسها، أنّ الدولة التي تعيش في حالة سلام مع جيرانها، ومع النظام الدولي، تكون في العادة أكثر قدرة على التعامل مع انقساماتها الداخلية، ليس فقط لأنها توفر على نفسها قيام الخصوم الخارجيين استغلال انقساماتها في الصراع، وإنما لأنّ الصراع الخارجي كثيراً ما يكون سبباً في منع التوافق السياسي أو تدميره إذا كان موجوداً. وسادسها، أنّ التنوّع والاختلاف والتعدد والتوافق كلها تعد حالة من حالات الثقافة السياسية غير المعروفة في الدول العربية عموماً، بسبب قصور الفكر القومي في مرحلة والفكر الاشتراكي في مرحلة أخرى، والصراع مع الغرب وإسرائيل في كل المراحل، وكل ذلك يجعل خلق هذه الثقافة ونشرها بوسائل الإعلام والتعليم والتنشئة مسألة ضرورية، للتعامل مع تنوّع العالم من ناحية، والتعامل مع تنوّع الداخل من ناحية أخرى.
إنّ التفكير من داخل المحلي وحده إعادة إنتاج للثقافة دون إبداع وترديد للتراث دون نقد، ومحاولة بلوغ الكوني دون تأمل المحلي تهرّب من مهمة المساهمة في التغيير واكتفاء بترديد الأفكار دون التزام بنشرها في اللغة التي تفهمها الأغلبية ودون ربطها بما تراه الأغلبية قضاياها ومشاكلها. والحداثة النقدية هي التي تقبل هذا الانتماء المزدوج وهذا الجهد المضاعف، المتمثل في تأمل المحلي وسيلة لبلوغ الكوني، وتأمل الكوني وسيلة لإدراك المحلي.
مقاربة أهم مشكلات التعدد الثقافي:
1- خطر النزعات العنصرية وتنميط الثقافة:
ثمة اتجاهات في الغرب تعمل على تعطيل الميل نحو ثقافة عالمية قائمة على التنوّع البشري الخلاق، ومن ذلك فكرة “صراع الحضارات” التي أطلقها صموئيل هنتغتون والتي تتناقض مع ثقافة العولمة. إذ يقول “إنّ الحضارات هي القبائل الإنسانية، وصدام الحضارات هو صراع قبلي على نطاق كوني”. ويذهب إلى تعريف موضوعه بالقول “إنّ الثقافة والهويات الثقافية، والتي هي على المستوى العام هويات حضارية، هي التي تشكل أنماط التماسك والتفسخ والصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة”. ويبشّر بعالم تكون فيه الهويات الثقافية، العرقية والقومية والدينية والحضارية، واضحة، وتصبح “هي المركز الرئيسي، وتتشكل فيه العداوات والتحالفات وسياسات الدول طبقاً لعوامل التقارب أو الاختلاف الثقافي”.
ولا شك أنّ نظرية هنتغتون حول ” صراع الحضارات “، خاصة إذا لاقت رواجاً في أوساط النخب السياسية والثقافية الغربية، تحمل في طياتها احتمالات تزايد ظهور أصوليات تسعى إلى إثارة الشعور بالهوية والانتماء، ومواجهة الآخر، وكأن استمرار ثقافة ما لا يتم إلا بالتهام أو إضعاف الثقافات الأخرى. في حين أنّ العالم أحوج ما يكون إلى حوار الثقافات كأسلوب جديد في التفكير، تفرضه التغيّرات الهائلة في عالم اليوم، إضافة إلى أنه تقليد قديم شهدته البشرية على مر العصور.
وفي الوقت الذي تتجه فيه العديد من الحركات الإسلامية في العالم العربي لمراجعة دعوتها لـ “الدولة الإسلامية” وتبنّي خيار “الدولة المدنية” لكل مواطنيها بغض النظر عن دينهم أو جنسهم أو عرقهم، وفي حين يضغط المجتمع الدولي من أجل دمقرطة المجتمع الفلسطيني، كشرط لإقامة الدولة الفلسطينية الديموقراطية المعادية للعنصرية في منظومة قيمها الثقافية والسياسية وفي دستورها ومؤسساتها، فإنّ إسرائيل تتجه نحو مفهوم عنصري للدولة “إسرائيل دولة الشعب اليهودي”، يتناقض تماماً مع مفاهيم الديموقراطية التي تدّعيها. فقد قال متخصص إسرائيلي في علم السكان ” لقد كنت أعتقد لسذاجتي أنّ نظرية العرق الأرقى اختفت من العالم، لكن يبدو أنها متأصلة بشدة في دولة إسرائيل.. حتى في جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري لم يكن هناك قانون جنسية كما في إسرائيل.. لا يوجد في أي مكان في العالم قانون عنصري مثله، أو مثل قوانين إدارة الأراضي الإسرائيلية والصندوق التأسيسي لإسرائيل.
إنّ الاعتراف بـ “يهودية دولة إسرائيل”، يعني في أهم ما يعنيه، أنّ الأرض الفلسطينية هي ملك لليهود أينما وجدوا، وبالتالي فإنّ من حق كل واحد منهم الهجرة إليها، والاستيطان فيها، في أي وقت يراه مناسباً. كما يعني أنه يحق لإسرائيل أن تقول للفلسطينيين بعد ذلك “هذه دولة يهودية، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يستوطنها ما لم ينتمِ إلى الديانة اليهودية”.
ومن جهة أخرى، فقد ارتبط المفهوم الثقافي للعولمة بفكرة التنميط أو التوحيد الثقافي للعالم، فقد رأت لجنة اليونسكو العالمية للإعداد لمؤتمر السياسات الثقافية من أجل التنمية، التي عقدت اجتماعاتها في استكهولم عام 1998، أنّ التنميط الثقافي يتم باستغلال ثورة وشبكة الاتصالات العالمية وهيكلها الاقتصادي الإنتاجي، المتمثل في شبكات نقل المعلومات والسلع وتحريك رؤوس الأموال. ومن هنا اتخذ المفهوم الثقافي للعولمة بعداً اقتصادياً وإعلامياً، حيث الإعلام هو أداة التوصيل والتأثير بالأفكار الثقافية التي يراد لها الذيوع والانتشار. وبذلك ثمة خطر يهدد ثقافة العولمة، يتمثل في تسليع الثقافة، إذ يخضع الإنتاج الثقافي إلى متطلبات قوانين السوق، أي هاجس الربح، مما قد يفقر الإبداع الفكري والذوق العام، ويسدُّ في المجال أمام المواهب المجددة. إضافة إلى قيامها بعملية تسطيح الوعي، واختراق الهوية الثقافية للأفراد والجماعات والأمم. إنها ثقافة إعلامية، سمعية وبصرية، تصنع الذوق الاستهلاكي اقتصادياً، والرأي العام سياسياً، وتشيد رؤية خاصة للإنسان والمجتمع والتاريخ.
2- تنوّع الأقليات وتداعياته:
قد يكون من الصعب الوصول إلى تعريف موحد للأقلية، نظراً إلى تعدّد أنواع الأقليات بتعدّد وتنوّع الأسس والمبادئ التي تقوم عليها واختلاف العناصر التي تميزها عن بقية سكان المجتمع الذين يؤلفون الأكثرية العددية، سواء أكانت هي عناصر سياسية أو اقتصادية أو لغوية أو دينية أو عرقية تنفرد بها عن كل ما عداها. ولكن بعض علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا المعاصرين يعرّفون الأقلية بأنها “جماعة تختلف في تكوينها العرقي أو الديني أو اللغوي عن بقية سكان المجتمع الذي تعيش فيه، بل وقد تختلف في بعض الحالات عنهم بانتمائها في الأصل إلى جنسية أخرى”.
وعلى أي حال، فإننا حين نتكلم عن الأقليات فإنه ينبغي التفرقة بيــــن ” الأقليات الوطنية ” التي تنتمي منذ عصور طويلة إلى المجتمع الذي تعيش فيه، ولذا تعتبر من مواطنيه الأصليين، وبين “الأقليات الدخيلة” الطارئة على المجتمع والوافدة من الخارج بسبب الهجرات والتحركات السكانية، التي ازدادت حدتها في العقود الأخيرة بشكل خاص نتيجة للتغيّرات السياسية والاقتصادية الهائلة.
وعلى أي حال، ثمة إدراك عام في الوقت الحالي لطبيعة المشاكل التي تواجه الأقليات، حتى في الدول التي تقف من أقلياتها الوطنية أو الدخيلة موقفاً عدائياً وعدوانياً، كما أنّ ثمة وعياً متزايداً بخطورة التجاهل المتعمد وعدم الاعتراف بتلك الأقليات، وما يسببه ذلك من ألم وتمرد على الوضع القائم ورغبة في تغييره بشتى الوسائل بما فيها اللجوء إلى العنف.
وفي المجتمعات الغربية علينا ألا نغفل كون تركيبتها السكانية قد تغيّرت خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وذلك بفعل هجرة أبناء المستعمرات وأبناء الدول الأخرى غير الغربية. فالمجتمع الإنكليزي الخالص تحوّل، في بعض المدن الرئيسة، إلى مجتمع مختلط من الإنكليز والهنود والباكستانيين والأفارقة. ويصدق الأمر نفسه على فرنسا التي لم تعد فرنسية تماماً، إذ هناك الملايين من المسلمين الآتين من المغرب العربي ومن بلدان أخرى مختلفة. ولا شك في أنّ لهذه الأقليات مشكلاتها الخاصة وإرثها الثقافي، وهي ستعبّر عن تلك المشكلات وتستلهم ذلك الإرث من خلال الكتابة والتعبير بلغتها الجديدة.
ويرى بعض المفكرين أنّ التطورات التكنولوجية وازدياد وطأة العولمة جعلا من مفهوم الدولة/الأمة، التي تقوم على التجانس العرقي والثقافي واللغوي والديني، شيئاً من تراث الماضي الذي عفا عليه الزمن، وأنّ عالم اليوم تتنازعه قوتان متضادتان: تعمل إحداهما لتحقيق التقارب والتماسك وإذابة الفوارق والاختلافات، بينما تعمل القوة الأخرى على ترسيخ الاختلافات وإبراز الفوارق وتوكيد الهويات الثقافية الخاصة، والدعوة إلى الاستقلال السياسي والثقافي للأقليات عن مجتمع الدولة/الأمة لإقامة كيانات مستقلة سياسياً وثقافياً، وهو الأمر الذي ترفضه الدولة بطبيعة الحال وترى فيه تهديداً لوجودها كوحدة عضوية، ولكنه يفرض عليها في الوقت ذاته مراجعة سياستها من تلك الأقليات بحثاً عن طريقة تضمن استمرار وحدتها ومكانتها في المجتمع الدولي.
والواقع أنّ معظم الدول تمارس سياسة تعتمد على القهر ضد الأقليات وتلجأ إلى العنف لتنفيذ سياسة الاندماج، ففي دراسة مهمة أصدرها تد جور Ted Gurr عام 1993 تحت عنوان “أقليات في خطر” وجد أنّ هناك 233 جماعة عرقية/ ثقافية تعاني من الاضطهاد والقمع في أكثر من 100 دولة في مختلف القارات، وأنّ بعض تلك الدول كانت تزعم أنّ اتخاذ تلك السياسة هو أفضل وسيلة لتحقيق التجانس المفقود وإقرار مبدأ الاندماج، وترى في ذلك الرفض مبرراً أخلاقيا كافياً للجوء إلى العنف، الذي قد يصل أحياناً إلى حد الإبادة العرقية الجماعية باعتبار الرافضين للاندماج أعداء للمجتمع.
والواقع أنّ الهيئات الدولية المهتمة بمشكلة الأقليات في العالم تعطي أهمية بالغة لمسألة الاندماج، ولكنها تأخذ في الاعتبار، في الوقت نفسه، مسألة التكامل القائم على الحفاظ على الذوات الثقافية المتمايزة والظروف والأوضاع الخاصة بكل حالة على حدة، فالمشكلة معقدة ويصعب الوصول فيها إلى حل واحد ينطبق على كل الحالات وفى كل المجتمعات والثقافات، ولذا فإنّ معالجة وضع الأقليات المتمركزة في مجتمع واحد أو في دولة واحدة لابدَّ أن يختلف عن أسلوب التعامل مع وضع الأقليات المبعثرة أو المنتشرة في عدد من الدول المستقلة.
فليس من الضروري أو المحتم إذن أن يقتضي الاندماج محو وإزالة كل المقوّمات الثقافية الخاصة بجماعات الأقليات، وهو ما بدأت بعض الدول الغربية تعترف به بحيث نجد الآن، من بين مفكريها، من يؤمن بأنّ جهود الاندماج سوف تحقق نتائج باهرة في المجتمعات الأوربية التي تضم أقليات أجنبية عديدة بقدوم عام 2020 بعد ظهور أجيال جديدة، تنشأ على مبدأ التعايش والاعتراف بالآخر وتتقبل مبدأ التعدّد الثقافي كحقيقة واقعية لابدَّ من التسليم بها، بدلاً من النظرة القاصرة التي ترى أنّ التعدّد الثقافي يؤدي إلى الصدام بين الأقليات ونظام الدولة/الأمة الذي يتطلب توافر حد أدنى من التجانس على مختلف المستويات وفي كل المجالات.
وفي الولايات المتحدة الأميركية، وبسبب الزيادة الكبيرة في نسب المهاجرين الجدد القادمين من المكسيك وأميركا الجنوبية من ناحية والقادمين من دول آسيوية من ناحية أخرى، قررت الإدارة الاعتراف بالتعددية في المجتمع الأمريكي، وبحق الأقليات في الاحتفاظ بثقافتها ضمن تنوّع داخل النمط الأميركي، إذ أخذت بعض تجارب كندا واستراليا، وهما الدولتان اللتان مارستا سياسات دعم التنوّع منذ وقت طويل، فأصدرت تشريعات تدفع بأبناء الأقليات، وبخاصة الأقلية السوداء، نحو فرص متميزة في العمل والوظائف والتعليم والصحة وغيرها من تلك التي كان يحتكرها الأميركي الأبيض من أصول أنكلو- سكسونية وعقيدة بروتستانتية.
لقد وصل القرن الحادي والعشرون، ووصلت معه مشكلات استيعاب الغرب للهجرات الواسعة، التي استفادت من العولمة ومتطلبات النمو الاقتصادي في الغرب وسوء الأوضاع في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية ودول شرق أوروبا المتعطشة إلى الغرب وحرياته ووعوده ورخائه. وظهر في الجاليات الإسلامية تياران أساسيان: تيار تقوده أقلية نشطة، ينادي برفض الغرب الذي يعيش فيه، ويدعو لمقاومة ثقافته والانعزال عنها. وتيار غالب يرفض جوانب في ثقافة الغرب ولكنه مستعد للتعامل معها والعيش في ظلها بشرط أن يحتفظ بثقافته، ويطلب من الثقافة المهيمنة، أي ثقافة الأغلبية الأصلية، احترام ثقافته. كما ظهر أيضاً من يريد، أو يتمنى، الانصهار أو الذوبان في الثقافة المهيمنة ولكنه عجز لأسباب كثيرة منها اللون والشكل وربما اللغة وغيرها من مظاهر هوية لا يمكن إخفاؤها.
والمشكلة أنّ الجيلين الثاني والثالث من أبناء المهاجرين، الذين ولدوا ونشأوا في أوطان هجرتهم، وعاشوا أجواءها الثقافية وحرية مطالبها السياسية، وصارت لغاتها لغتهم الأم، مما أعطى لديهم شعوراً كاملاً بالمواطنة، بدون أن يتواكب هذا مع تمتعهم بكل حقوق هذه المواطنة.
3- نحو مقاربة جديدة للهجرة:
أصبح موضوع الهجرة يحظى، في العقود الأخيرة خاصة، بأهمية كبرى ضمن مختلف الدراسات الأكاديمية واللقاءات الدولية، ويشكل محوراً أساسياً للعديد من الاتفاقيات الثنائية والجماعية بين الدول، وقد أسهمت في ذلك التحولات الدولية المتسارعة المرتبطة بعولمة الاقتصاد والسياسة والثقافة والقيم. فقد ذكر تقرير لمنظمة الهجرة العالمية صدر يوم 10 يونيو/حزيران 2003 في جنيف أنّ شخصاً من أصل 35 في العالم هو مهاجر يبحث عن ظروف حياة أفضل. وذكر التقرير أنّ 175 مليوناً من الأشخاص، أي نسبة 3% من سكان العالم، ينطبق عليهم هذا الوضع.
إنّ الهجرة مشكلة من جهة، وفرصة من جهة أخرى، وهي تشكل ظاهرة مجتمعية في بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ورهاناً رئيسياً في العلاقات بين ضفتيه. ففي إطار دولي يتسم بالشك وتشنج الهويات لا بدَّ لأوروبا من التوجه نحو جيرانها في الحوض المتوسط غالباً، لأنّ تسارع الأحداث يظهر دوماً وعلى نحو قاطع أنّ مصير أوروبا لا ينفصل عن مصير جيرانها في الجنوب، فضلاً عن أنّ التعاون الأورو – متوسطي يمثل بالنسبة لها مشروعاً يحمل في ثناياه رؤية سياسية بعيدة المدى تزيد متانة التضامن.
ولعلَّ النموذج الأوروبي خير مثال على إمكانية تحقق هذا الهدف، فإذا كانت القارة الأوروبية لفترات طويلة ضحية المواجهات، وتمكنت اليوم من إعادة توحيد أطرافها، فإنّ تطوراً مماثلاً أصبح ممكناً في علاقات أوروبا مع البلدان المتوسطية الأخرى، إذا رغب الجانبان في العمل معاً بصبر وأناة على بناء منطقة للتعاون والرخاء المشترك.
إنّ عملية إقامة المهاجرين واندماجهم الاجتماعي والسياسي لا تناظر أي نموذج وحيد صالح في كل زمان، بل هناك صيغ متنوعة على قاعدة التبدلات التاريخية التي شهدها العالم منذ بدايات تسعينيات القرن العشرين، الأمر الذي يستدعى بالتالي أجوبة سوسيولوجية مغايرة. والمشكل يُطرح عندما يتعلق الأمر بكتل بشرية كثيفة تملأ الفضاء الأوروبي، وتصبح مطالبة بحقها في الاختلاف الثقافي الذي ينعكس في الملبس والمأكل والعادات وإقامة مراكز العبادة، أي حينما يتعلق الأمر بالمظهر الخارجي لوجود التنوّع الثقافي المقبول نظرياً، ولكنه يستقطب الانتباه بل يحث على التحرك المضاد، على حساب النواميس التي تسيّر الديموقراطية الليبرالية المعمول بها في أوروبا. علماً بأنّ أغلبية عرب المهاجر الغربية مولعون بإبراز خصوصيتهم كي يثبتوا أنّ الغربة لم تفعل فعلها فيهم، وأنهم أوفياء للجذور، ويعيش أغلبهم على هامش الحياة السياسية والثقافية وتحبيذ الانعزال وتجنّب الظهور وحب الانغلاق.
ويتطلب الأمر إذن نشوء ثقافة جديدة، تقبل الأجنبي المستقر، لتحلَّ محل ثقافة البلد ذي اللسان الواحد، والدين الواحد، واللون الواحد. وتطرح الهجرة على الدول الأوربية، عموماً، أن تستعد لتقبّل أمر واقع، يتمثل في التعدد الإثني والثقافي.
إنّ الواقع، الموصوف أعلاه، يتطلب نوعاً من المواطنة الثقافية، التي تعني حق الجماعات الفرعية والأقليات في الاحتفاظ بهويتها الثقافية الخاصة حتى لا يتم احتواؤها ودمجها تماماً في الثقافة العامة الرسمية السائدة في المجتمع، بشرط ألا يترتب على ذلك عدم المشاركة بشكل إيجابي وفعال في مختلف أنشطة الحياة والالتزام التام بالقوانين والقواعد الأساسية المنظمة للحياة العامة في الدولة. وهذا يعني تقبّل مجتمع الدولة لوجود هذه الجماعات المتمايزة ثقافياً، والاعتراف بحقها في الاحتفاظ بمقوّمات ثقافتها الخاصة، وتفهمه للمبادئ التي تقوم عليها تلك الثقافة والقيم التي تكمن وراء مظاهرها الخارجية من سلوكيات وعلاقات قد تختلف اختلافاً جوهرياً عما درج عليه الأهالي الأصليون الذين يؤلفون غالبية السكان.
ويذهب الأستاذ ريناتو روزالدو، أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة ستانفورد الأميركية، وهو الذي صاغ في الأصل تعبير “المواطنة الثقافية”، إلى أنّ جماعات الأقليات التي تعيش في أي مجتمع وتعتبر أعضاءها مواطنين في ذلك المجتمع يمكنها الحصول لأعضائها على حقوقهم العامة، كمواطنين كاملي المواطنة، وعلى اعتراف الدولة والشعب بوجودهم ككيان متمايز داخل الدولة، وذلك عن طريق العمل الجاد من أفراد هذه الأقليات على نشر ملامح وخصائص ومقوّمات ثقافاتهم الخاصة، والحرص على التعبير عنها بقوة ومثابرة وبكل الطرق والوسائل إلى أن يتم “حفرها” وتثبيتها في ذاكرة المجتمع، وبذلك يفرضون ذاتيتهم وهويتهم الخاصة على المجتمع الكبير، بحيث يضطر في آخر الأمر إلى تعديل مواقفه المعارضة ونظرته الرافضة.
والمهم هنا، فيما يتعلق بالمواطنة الثقافية، هو أنّ الاعتراف بهذا التميّز الثقافي وقبوله واحترامه قد يكون عاملاً مؤثراً في إثراء الثقافة الوطنية، كما قد يحلُّ كثيراً من المشكلات الاجتماعية التي تعانيها مجتمعات الغرب في الوقت الحالي من الأعداد المتزايدة التي تفد إليها من الخارج، والتي تنتمي إلى ثقافات مختلفة تريد الاحتفاظ بها إلى جانب تمتعها بحقوق والتزامات المواطنة السياسية.
وفي كل الأحوال، فإنّ المقاربات المحكومة بالهاجس الأمني والتي أكدت الممارسة الميدانية عقمها وعجزها، ينبغي أن تتراجع لتفتح المجال لتدابير ديمقراطية أكثر عمقاً وعقلانية، تعتمد الأخذ بالعدالة الاجتماعية ضمن أهدافها وممارساتها، بالشكل الذي يتيح اندماجاً حقيقياً لهؤلاء المهاجرين، ويسهم في تدبير اختلافاتهم العقائدية والثقافية، ويوفّر لهم الشروط الموضوعية والضمانات اللازمة لتوفير عيش كريم، أسوة بباقي المواطنين الأوروبيين.
ولعل ما طرحه وزير الخارجية الإسباني الأسبق ميغيل أنخيل موراتينوس (صحيفة الحياة اللندنية – 8 أكتوبر/تشرين الأول 2007) عن تفادي التمييز وعدم التسامح تجاه الذين يعتنقون الإسلام، وخلق مناخ من التعايش السليم، الذي يتيح بسهولة ممارسة مختلف العقائد أصبح يمثل اليوم ضرورة ملحة وحاجة أخلاقية لا مناص منها. وخاصة قوله “إنّ المطلوب من القوانين الداخلية للبلدان أن تأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى تشجيع التسامح وملاحقة السلوكيات التمييزية. وعلينا أيضاً أن نولي اهتماماً خاصاً بتنامي عدد المنظمات الإسلامية التي تمارس عملاً نشيطاً وبنّاء في مجتمعاتها”.
وهكذا، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تواجه البشرية خيارات مختلفة: إما إعادة إنتاج نظام الهيمنة القديم تحت شعار النظام العالمي الجديد، أو خلق نظام ما بعد الهيمنة والذي سيستمد مضمونه من البحث عن أرضية مشتركة بين التقاليد المكوّنة للحضارة الإنسانية، من خلال الاعتراف المتبادَل بالتقاليد المميّزة للحضارات الإنسانية المتعددة، وتجاوز نقطة الاعتراف المتبادَل والاتجاه نحو تقبّل التفاعل بين الهويات الثقافية المتعددة والتي تسمح بالتعايش بين مختلف التقاليد الحضارية.
– ملاحظة: تقتضي الأمانة العلمية الإشارة إلى أنّ هذه المقاربة لم يكن من الممكن أن تكون على ما هي عليه إلا بفضل الأعمال القيمة التي سبقتها، إذ أود الإشارة إلى كتابات الأساتذة الأفاضل: جان فرانسوا ليوتار، يورغن هابرماس، آلان تورين، أحمد أبو زيد، برهان غليون، السيد يسين، هاشم صالح، رضوان جودت زيادة، علي حرب، جابر عصفور، هشام شرابي، محمد عابد الجابري.
(*) – محاضرة قُدمت في إطار المؤتمر الثالث والعشرين لـ “منتدى الفكر المعاصر ” حول ” دور المؤسسات العلمية والمجتمع المدني في الحوار المتعدد الثقافات والتبادل المعرفي الأورو – مغاربي”، بدعوة من “مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات” بتونس، في الفترة ما بين 6-8 ديسمبر/ كانون الأول 2007.
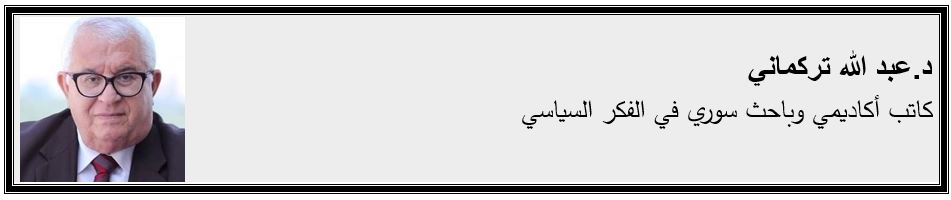
المصدر: سوريا المستقبل

التعليقات مغلقة.