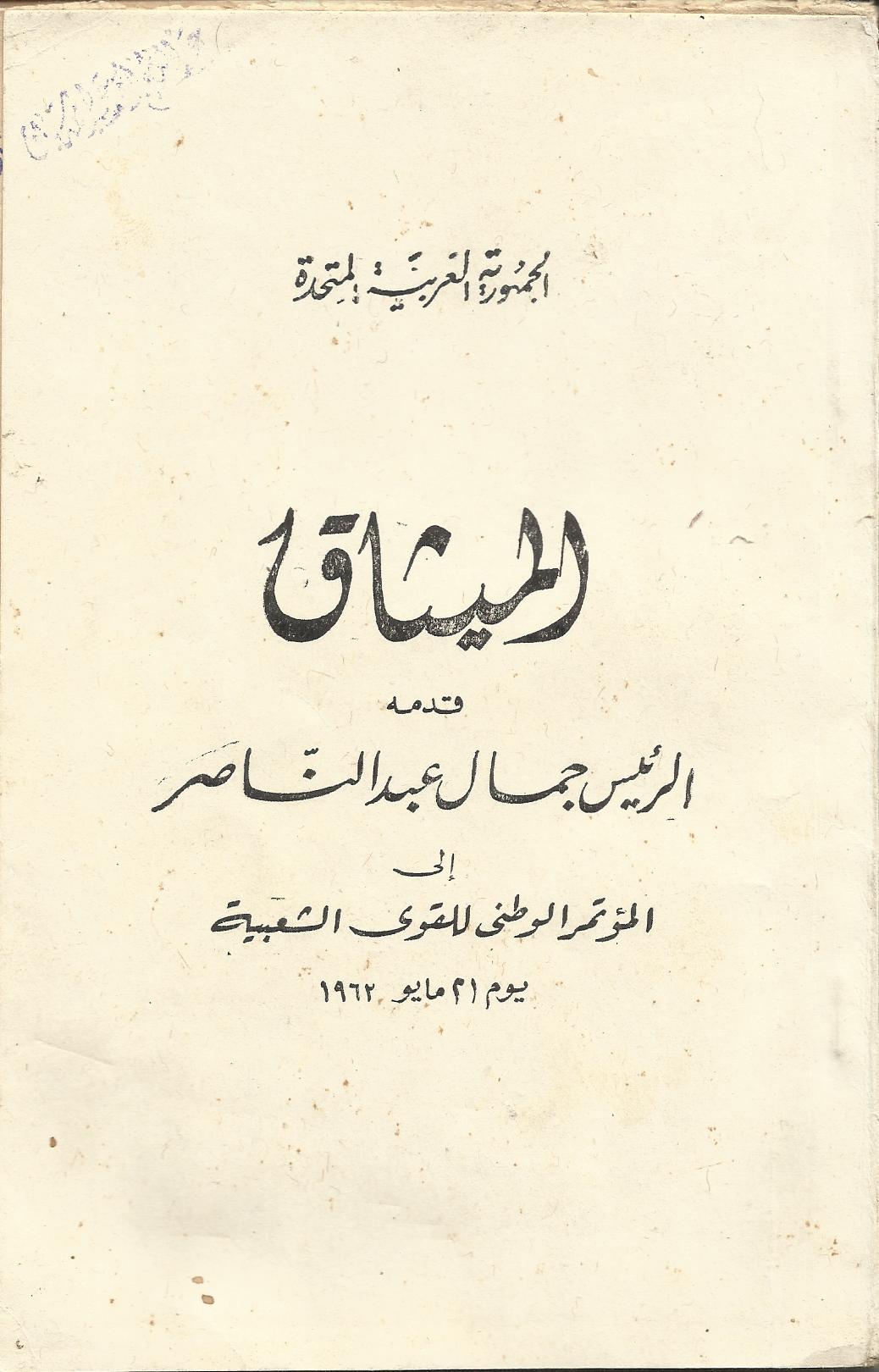
البــاب الـرابـع
درس النكسة:
لقد كانت فترة الخطر الحقيقي على نضال الشعب المصري الطويل؛ هي هذه الفترة الحافلة بالخديعة، ما بين انتكاسة سنة 1919 إلى حين تنبهت القوى الشعبية للخطر الذى يتهددها من منطق المساومة والاستسلام؛ ومن ثم بدأ التأهب النفسي لثورة يوليو سنة 1952.
إن هذه الفترة كانت قادرة؛ لولا صلابة الشعب، ومعدنه الأصيل، أن تحمل البلاد إلى حالة من اليأس، تخنق كل حوافز الرغبة في التغيير، أو تلحق بها الشلل الذى يمنعها من الحركة.
إن هذه الفترة التي يمكن أن ننظر إليها الآن باعتبارها فترة الأزمة الكبرى كانت حافلة بالواجهات المضللة التي تخفى وراءها الأطلال المتهاوية من بقايا ثورة سنة 1919.
لقد كانت القيادات الباقية من ذكريات الثورة مازالت واقفة في المقدمة، ولكن هذه القيادات فقدت كل طاقاتها الثورية، وأسلمت كل الشعارات التي رفعها الشعب سنة 1919 إلى كبار ملاك الأرض الذين كانوا دعامة التنظيمات الحزبية القائمة، وأشركوا فيها بعض الانتهازيين الذين اجتذبتهم عملية تقسيم الغنائم بعد انتكاسة الثورة، ولقد ظهرت في هذا الجو فئات طفيلية.. لقد استطاع هذا الانحراف أن يجذب إلى الجو الحزبي الفاسد جماعات من المثقفين كان في قدرتهم أن يكونوا حراساً على أماني الثورة الحقيقية، لكن الإغراء كان أقوى من مقاومتهم.
كذلك استطاع هذا الانحراف أن يمهد لفئة من الرأسماليين ورثوا – في حقيقة الأمر – نفس دور المغامرين الأجانب في القرن التاسع عشر، بكل سطحيته التي لا تهتم بتطوير الوطن ذاته قدر اهتمامها باستغلال أكبر جزء من ثروته، ونزحها في أقل وقت ممكن.
ثم انتهى المطاف بهذه الأحزاب جميعاً إلى الحد الذى دفعها للارتماء في أحضان القصر تارة، وفى أحضان الاستعمار تارة أخرى. وفى الواقع كان القصر والاستعمار بحكم مصالحهما في صف واحد؛ وإن بدت الخلافات السطحية بينهما في بعض الظروف، لكن الحقيقة الكبرى أن كليهما كان يقف في الصف المعادي لمصالح الشعب، والمضاد لاتجاه التقدم.
إن سلطة الشعب كانت خطراً على أوضاعهما الدخيلة، واتجاه التقدم كان محققاً أن يجرفهما معاً إلى نفس المصير، وفى ذلك الوقت أيضاً كانت هناك واجهة ديمقراطية مضللة؛ استعانت بها الفلول المنهزمة من ثورة 1919 لتخدع بها الشعب عن حقيقة مطالبه.
إن الديمقراطية بالطريقة التي جرت بها ممارستها في مصر تلك الفترة كانت ملهاة مهينة. إن الشعب لم يعد صاحب السلطة؛ وإنما أصبح الشعب أداة في يد السلطة، أو بمعنى أصح ضحية لها. ولم تعد أصوات الجماهير هي التي تقرر خط السير الوطني؛ وإنما أصبحت أصوات الجماهير تساق وفقاً لإرادة السلطات الحاكمة وأصدقائها.
ولقد كان ذلك نتيجة طبيعية لإغفال الجانب الاجتماعي من أسباب ثورة الشعب سنة 19. إن الذى يحتكر رزق الفلاحين والعمال، ويسيطر عليه؛ يقدر بالتبعية أن يحتكر أصواتهم، وأن يسيطر عليهم، ويملى فوقهم إرادته.
إن حرية رغيف الخبز ضمان لابد منه لحرية تذكرة الانتخابات. إن هذه الأزمة العنيفة فتحت أمام سلطات الأسرة المالكة أبواباً جاهد النضال الشعبي طويلاً لكى يسدها، لكن انتكاسة الثورة شجعت الأسرة المالكة على تجاوز كل الحدود، وفى جو الأزمة لم يعد الدستور، الذى رضيت به القيادات الثورية منحة من الدخيل ومنة؛ إلا مجرد قصاصة ورق بهتت عليها الحقوق الشكلية التي كانت قد ألقيت للشعب لينشغل بها ويتلهى.
ولقد استسلمت القيادات التي تصدت للنضال الشعبي أمام سلطة القصر المتزايدة؛ بسبب ضعفها المتزايد، وركعت جميعاً تلتمس الرضا الذى يصل بها إلى مقاعد الحكم، وتخلت بذلك عن الشعب، وأهدرت كل قيمة له؛ ناسية بذلك أنها تتخلى طواعية عن مصدر قوتها الوحيد، ومنبعها الأصلي، وانتهى الأمر إلى حد أنهم هانوا على الشيطان الذين باعوه أرواحهم، فوصل بهم الهوان إلى حد أن تغيير الوزارات أصبح له ثمن معلوم يدفع للقصر ولوسطائه. إن القيادات الوطنية حين تخلع جذورها من التربة الشعبية تحكم على نفسها بالذبول وبالموت.
ولسوف يبقى الوطن زماناً طويلاً يشعر في حلقه بمرارة الذل الذى أحسه في هذه الفترة المتأزمة؛ من جراء استهانة الاستعمار بنضاله استهانة فاقت كل حدود الاحتمال البشرى.
إن الثورة على الاستعمار حق طبيعي لكل الشعوب المستعمرة، لكن الكراهية المرة التي يشعر بها شعبنا تجاه المستعمرين، والتي مازال يشعر بها حتى الآن رغم بعد أسبابها؛ تستمد مبرراتها من هذه الفترة.
إن الاستعمار في هذه الفترة لم يكتف بإرهاب شعوب الأمة العربية كلها؛ وإنما استهان بنضالها وبحقها في الحياة.
إن الاستعمار تنكر لكل عهوده التي قطعها على نفسه خلال الحرب العالمية الأولى، وكانت الأمة العربية تتصور أنها قريبة من يوم الاستقلال ويوم الوحدة.
إن الأمل في الاستقلال تلقى ضربات قاسية؛ فإن البلاد العربية قسمت بين الدول الاستعمارية وفق مطامعها، بل وفق نزواتها، واخترع ساسة الاستعمار كلمات مهينة لتغطية الجريمة التي أقدموا عليها ككلمات الانتداب، والوصاية.
إن قطعة من الأرض العربية في فلسطين قد أعطيت من غير سند من الطبيعة أو التاريخ لحركة عنصرية عدوانية؛ أرادها المستعمر لتكون سوطاً في يده؛ يلهب به ظهر النضال العربي إذا استطاع يوماً أن يتخلص من المهانة، وأن يخرج من الأزمة الطاحنة كما أرادها المستعمر فاصلاً يعوق امتداد الأرض العربية، ويحجز المشرق عن المغرب، ثم أرادها عملية امتصاص مستمرة للجهد الذاتي للأمة العربية؛ تشغلها عن حركة البناء الإيجابي.
إن ذلك كله تم بطريقة تحمل طابعاً استفزازياً؛ لا تقيم وزناً لوجود الأمة العربية أو لكرامتها. إن سخرية القدر من الأمة العربية وصلت إلى حد أن جيوشها التي دخلت فلسطين لتحافظ على الحق العربي فيها؛ كانت تحت القيادة العليا لأحد العملاء الذين اشتراهم الاستعمار بالثمن البخس، بل إن العمليات العسكرية تحت هذه القيادة العليا كانت في يد ضابط إنجليزي؛ يتلقى أوامره من نفس الساسة الذين أعطوا للحركة الصهيونية وعد “بلفور”؛ الذى قامت على أساسه الدولة اليهودية في فلسطين.
إن سنوات طويلة سوف تمضى قبل أن تنسى الأمة العربية مرارة التجربة التي عاشتها في هذه الفترة، محصورة بين الإرهاب والإهانة. إن الأمة العربية خرجت من هذه التجربة بإصرار عميق على كراهية الاستعمار وعلى هزيمته.. إنها خرجت بدرس عظيم الفائدة عن حقيقة أن الاستعمار ليس مجرد نهب لموارد الشعوب؛ وإنما هو عدوان على كرامتها وعلى كبريائها.
إن الشعب المصري بدأ يتأهب لاستئناف دوره التاريخي؛ حتى قبل أن تنتهى الحرب العالمية الثانية، وقبل أن تنزاح الأشباح الكئيبة لدبابات الاحتلال عن مدنه الكبرى.
ولقد عبر الشعب المصري عن نفسه؛ برفضه العنيد أن يشترك في الحرب التي لم تكن في نظره إلا صراعاً على المستعمرات والأسواق، بين العنصرية النازية وبين الاستعمار البريطاني – الفرنسي؛ جرت على البشرية كلها ويلات لا حدود لها من القتل بالجملة والدمار الشامل.
لقد رفض الشعب المصري كل الشعارات التي رفعها المتحاربون أعلاماً فوق رءوسهم ليخدعوا بها الشعوب، وسحب الشعب المصري كله البقايا الباقية من تأييده للذين تعاونوا مع سلطة الاحتلال؛ طمعاً في مكاسب السوق السوداء التي فرضتها الحرب وظلالها القاتمة، وعمت الشباب المصري موجة من السخط والغضب على كل الذين مدوا أيديهم للاحتلال وقبلوا وجوده. ولقد ترددت في مصر ذلك الوقت أصداء طلقات الرصاص، وتجاوبت أصداء انفجارات القنابل، وكثرت التنظيمات السرية بمختلف اتجاهاتها وأساليبها، ولم تكن تلك هي الثورة؛ وإنما كان ذلك هو التمهيد لها.. كانت تلك هي مرحلة الغضب التي تمهد لاحتمالات الثورة.
إن الغضب مرحلة سلبية . إن الثورة عمل إيجابي يستهدف إقامة أوضاع جديدة . إن غضب الشعب المصري الممهد للتغيير بدأ يجاوز النطاق الفردي إلى النطاق الجماعي . إن ثورات الفلاحين ضد استبداد الإقطاع وصلت إلى حد الاشتباك المسلح بين الذين ثاروا على عبودية الأرض وبين سادة الأرض المتحكمين فيها، وفى أقدار الذين ارتبطت حياتهم بها منذ أقدم العصور؛ وإن كانوا منذ أقدم العصور قد حرموا منها. وحريق القاهرة مهما يكن وراءه من تدبير المدبرين كان يمكن إطفاؤه لكن ثورة السخط الشعبي زادته اشتعالاً. إن الفئة المتحكمة في العاصمة لم تكن تشعر باحتياجات الشعب، وكانت غارقة في حياتها المترفة؛ لا تشعر بعذاب الجوع أو آلامه.
إن شرار الغضب أشعل من الحرائق في القاهرة أكثر مما أشعلت يد التدبير الخفية التي بدأت عملية الحريق.
إن الجماهير في القرية وفى المدينة كانت قد عبرت بما فيه الكفاية عن إرادتها الحقيقية مع مطلع السنة الحاسمة في تاريخ مصر؛ سنة 1952.
إن أعظم ما في ثورة 23 يوليو سنة 1952 أن القوات التي خرجت من الجيش لتنفيذها لم تكن هي صانعة الثورة؛ وإنما كانت أداة شعبية لها.
لقد كانت المهمة الكبرى للطلائع الثورية التي تحركت في الجيش تلك الليلة الخالدة؛ هي أنها استولت على الأمور فيه، واختارت له المكان الذى لا مكان له غيره، وهو جانب النضال الشعبي . إنها قامت بعملية تصحيح للأوضاع بالغة الأهمية والخطر في تلك الظروف؛ متحدية بذلك إرادة كل القوى الحاكمة التي أرادت عزل الجيش عن النضال الشعبي .
إن الثورة تفجرت تلك الليلة العظيمة من انضمام الجيش إلى مكانه الطبيعي تحت قيادة الشعب وفى خدمة أمانيه.
إن الجيش في تلك الليلة أعلن ولاءه للنضال الشعبي، ومن ثم فتح الطريق أمام إرادة التغيير. إن انضمام الجيش إلى النضال الشعبي صنع أثرين هائلين في نفس الليلة؛ لقد سلب قوى الاستغلال الداخلي أداتها التي كانت تهدد بها ثورة الشعب؛ كذلك فإنه سلح النضال الشعبي في مواجهة قوى السيطرة الأجنبية المحتلة بدرع من الصلب قادر أن يصد عنه ضربات الخيانة والغدر.
إن الثورة لم تحدث ليلة 23 يوليو؛ ولكن الطريق إليها قد فتح على مصراعيه تلك الليلة العظيمة، ولقد أثبت الوعى الثوري في مصر قدرته على تحمل المسئولية الكبرى التي ألقتها تطورات الظروف عليه.
إن الوعى الثوري استمد من حسه الوطني الصافي قدرته على الرؤية الواضحة البعيدة المدى؛ وبذلك أمكن اجتياز العقبات التي كان يمكن أن تعترض طريق التغيير الثوري في مثل ظروف التجربة التي عاشتها مصر تلك الأيام.
لقد كان يمكن أن يتحول الحدث الكبير الذى جرى ليلة 23 يوليو إلى مجرد تغيير للوزارة القائمة أو لنظام الحكم، وكان يمكن أن يتحول من ناحية أخرى إلى ديكتاتورية عسكرية تضيف إلى التجارب الفاشية تجربة أخرى فاشلة؛ لكن أصالة الوعى الثوري وقوته سيطرت على اتجاهات الأمور، ومنحت جميع العناصر الوطنية إدراكاً لدورها في توجيه النضال الوطني.
إن أصالة هذا الوعى وقوته هي التي فرضت أن يكون الحدث الكبير ليلة 23 يوليو خطوة على طريق تغيير جذري شامل؛ يعيد الأماني الوطنية إلى مجراها الثوري السليم الذى ضاع منها بسبب انتكاسة ثورة سنة 1919؛ كما أن أصالة هذا الوعى وقوته هي التي رفضت تماماً كل احتمالات قيام ديكتاتورية عسكرية، ووضعت القوى الشعبية – وفى طليعتها قوى الفلاحين والعمال – موضع القيادة الفعلية.
كذلك ففي هذه الفترة الدقيقة تمرد الوعى الثوري الأصيل على منطق دعاة الإصلاح، واختار طريق الثورة الشاملة. إن احتياجات الوطن لم تكن تكتفى بترميم البناء القديم المتداعي وصلبه بالقوائم تسنده وإعادة طلائه؛ وإنما كانت احتياجات الوطن تتطلب بناءً جديداً ثابت الأساس، صلباً، شامخاً.
ولقد كانت أكبر حجة ضد منطق دعاة الإصلاح أن البناء القديم انهار أنقاضاً وركاماً في مواجهة التجربة الجديدة. إن سقوط النظام الذى كان سائداً قبل الثورة هذا السقوط الكامل السريع كان يقطع بعدم جدوى محاولات الترميم، لكن سقوط النظام القديم لم يكن هدف التطلع الثوري . إن التطلع الثوري بكل آماله ومثله العليا يهتم بالبناء الجديد أكثر من اهتمامه بالأنقاض التي تداعت.
إن الباب الذى انفتح على مصراعيه ليلة 23 يوليو ظل مفتوحاً لفترة طويلة؛ قبل أن يدخل منه التغيير الحتمي الذى طال انتظاره.
لقد كانت هناك أنقاض النظام القديم وحطامه تسد الطريق، كما كانت هناك رواسب متعفنة من مطامعه البالية المهزومة، وفى نفس الوقت فإن القيادات السياسية التي كانت تتصدر الحياة العامة سقطت كلها تحت أنقاض النظام القديم؛ الذى شاركت فيه جميعها فى انحرافاتها عن الأهداف الأصلية التي كان يجب التزامها في ثورة سنة 19.
لقد كانت جميعها شريكة في سياسة ساوم واستسلم التي صاحبت فترة الأزمة؛ فطبعتها بهذا الطابع المهين، وكانت الأوضاع الطبقية قد أبعدت عناصر كثيرة صالحة للقيادة الفكرية عن صفوف القوى الشعبية المتطلعة للثورة والمطالبة بها. وفى نفس الوقت فإن الطلائع الثورية التي صنعت أحداث ليلة 23 يوليو لم تكن قد أعدت نفسها لتتحمل مسئولية التغيير الثوري الذى تصدت لمقدماته.
لقد فتحت الباب للثورة تحت راية المبادئ الستة المشهورة؛ ولكن هذه المبادئ كانت أعلاماً للثورة وليست أسلوب عمل ثوري ومنهاج تغيير جذري، ولقد كان الأمر من الصعوبة بمكان؛ خصوصاً في جو التغيير العالمي البعيد المدى والعظيم الأثر، لكن الشعب المعلم صانع الحضارة راح يلقن طلائعه أسرار آماله الكبرى، ومضى يحرك المبادئ الستة بالتجربة والخطأ؛ نحو وضوح فكرى يصنع التصميم الهندسي لبناء المجتمع الجديد الذى يريده، وراح الشعب الكادح يكدس مواد البناء، ويكتل جميع القوى الثورية القادرة على الإسهام فيه من صفوف الجماهير الواسعة.
إن الشعب المعلم أراد لطلائعه الثورية أن تنضم إلى صفوف العمل الجماهيري، وأوكل إلى جيشه الوطني مهمة حماية عملية البناء، ثم راح يشرف بوعى وجدارة على التحول الرائد الخلاق نحو الاشتراكية الديمقراطية التعاونية.
يتبع؛ الباب الخامس (عن الديمقراطية السليمة)…

التعليقات مغلقة.