
أحمد مظهر سعدو
في حياة الشعوب، وأيضًا ” من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلًا”. صدق الله العظيم .. والأخ العزيز (أبو محمود) محمد عمر كرداس من هؤلاء الرجال، الذين آلو على أنفسهم ألا يكونوا مطية لنظم القهر والعسف الأسدي، فأمسكوا ناصية الانتفاض والاعتراض على كل ممارسات التغول السلطوي على حيوات الناس، وانبروا عملاً دؤوبًا لا ينقطع، من أجل رفعة الوطن والأمة، وأدركوا بحسهم الصادق أن العمل الوطني لا بد (منجدلاً) ومتداخلاً مع العمل العروبي، حيث تنتمي سورية الوطن والشعب إلى أمة عربية مترامية الأطراف.
لقد عمل الأخ محمد عمر كرداس طيلة حياته على نصرة الوطنية السورية، والعروبة الناصرية التي لم تكن يومًا لديه مجالًا للمساومة أو المداورة، أو التكوم أمام مصالح أنوية شخصية براغماتية، على أبواب السلاطين أو أدوات التشبيح الأسدي.. حيث سلك (أبو محمود) الطريق الصعب والمليء بالأشواك، وراح يشتغل في صفوف المعارضة الوطنية السورية، منذ نعومة أظفاره، فانتمى إلى (الاتحاد الاشتراكي العربي) من أجل سورية حرة أبية، ومن أجل إعادة الوحدة المسروقة من قبل أهل الانفصال، ثم تابع مسيرته ضمن كل الحالات الوطنية في المعارضة، فتعرض للاعتقال كحال كل السوريين المعترضين على القمع الأسدي.
ولقد عمل (أبو محمود) على مدى عمره الذي اقترب من الثمانين عامًا، بكل ما استطاع، من أجل العروبة والعمل القومي، وكان نشيطًا وناشطًا معروفًا على مستوى العالم العربي، وخاصة بين الناصريين العرب. وهو الذي لم يجامل أحدًا من هؤلاء، عندما آثر البعض منهم تأييد إيران/ الملالي وتوابعها من نظام الإجرام الأسدي، أو ميليشيا حزب الله، وكانت بوصلته دائمًا بعد عام ٢٠١١ هي الثورة السورية، ثورة الحرية والكرامة، وأن الوقوف إلى جانبها (حسب رؤيته) هو معيار مصداقية وعروبة أي ناصري أو قومي عربي، وغير ذلك فلا عروبة مع الطغيان الأسدي أو التعاون والمهادنة مع القتلة في حزب الله وإيران بمشروعها الفارسي الخطر على الأمة.
في تركيا وبعد التهجير القسري الذي عاشه وتعرض إليه (أبو محمود) وقبل ذلك في المملكة العربية السعودية، كان همه الأساسي العمل من أجل الوقوف إلى جانب السوريين ضد الطغيان الأسدي، ومن ذلك فقد كانت كل كتاباته في صحيفة (إشراق) أو في موقع (الحرية أولًا) أو في موقع (ملتقى العروبيين) أو موقع (مصير) تركز على أهمية القيام والنهوض من جديد من أجل سورية حرة موحدة بلا آل الأسد، وبدون سلطة الاستبداد، ثم خروج كل الاحتلالات التي أوصلها إليها نظام القمع والعهر الأسدي.
كان يكتب من جوانية قلبه وفكره وعقله، وكان يدرك أن النصر لابد آتٍ لثورة السوريين مهما تكالبت عليهم قوى البغي الروسي والإيراني، أو الأميركي، كما كان مؤمنًا إيمانًا راسخًا بالله وبقدرة الشعوب على التحرر والخروج من عنق الزجاجة، والمضي نحو إقامة دولة الحرية والكرامة دولة المواطنة الحقة، وسيادة القانون الذي تغول عليه آل الاسد.
رحم الله (أبا محمود) المناضل الإنسان، العروبي الوطني، الذي لا يهادن، ولم تنحنِ له هامة. في رحاب الله ورضوانه يا أخا الكفاح ضد الاستبداد.
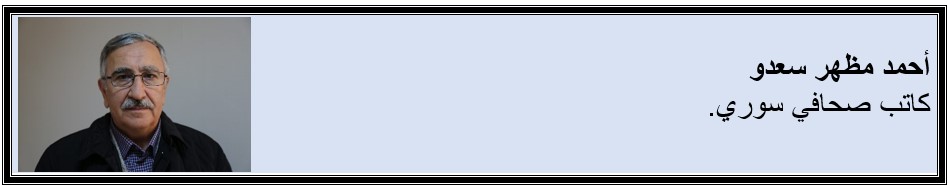

رحمه الله…واسكنه جنان نعيمه.
ولا حول ولاقوة الا بالله
رحمه الله