
معقل زهور عدي
أول ما يلفت النظر في الاعلان كونه موجهًا ليس لأهل الحجاز ولا للعرب ولكن للمسلمين، فهو يستبطن هنا كونه يصدر عن جهة لها مكانتها لدى جميع المسلمين وأعني بذلك شرافة مكة المستأمنين على الحرمين الشريفين في مكة والمدينة , وهو بذلك يشير ضمنا إلى جدارتهم في منافسة الدولة العثمانية التي كانت تعتبر لدى كثير من المسلمين دولة الخلافة الاسلامية وبالتالي لايجوز ” شرعا” الخروج عليها وعصيانها .
ويظهر ذلك التأثير المحدود للأفكار القومية على الأسرة الهاشمية في تلك اللحظة , واختلاط تلك الأفكار بالعناصر الدينية التي يستمد منها الشريف حسين مكانته السياسية .
ينتقل الخطاب بسرعة إلى التذكير باعتراف أمراء مكة ” الأشراف ” بالدولة العثمانية وانضوائهم تحت رايتها بأسلوب يوحي بأن ذلك الاعتراف والتأييد جاء عن قناعة ورضى وليس عن فرض ارادة القوي على الضعيف , وأنهم دافعوا عن الدولة العثمانية حتى ضد أبناء جلدتهم العرب حين أرسلوا جنودهم لقتال التمرد الذي حصل في جنوب الجزيرة في منطقة أبها .
اذن فهم لم يبيتوا العصيان والتآمر على الدولة العثمانية بل قاتلوا من أجل هيبتها وشرفها .
فماذا حصل إذن لإعلان الثورة اليوم ؟
يجيب المنشور بطريقة مباشرة وصريحة :
أنتم الذين تغيرتم , فلم تعد الدولة العثمانية تلك الدولة التي ارتضينا رايتها ودافعنا عنها بالدم .
الدولة العثمانية اليوم تحت قبضة جمعية الإتحاد والترقي ذات التوجه القومي العنصري التركي , وهي تتنكر للاسلام الذي قامت تحت رايته .
هذه الجمعية ذات السياسات المتخبطة الفاشلة التي تسببت في خسارة البلقان وتقويض عظمة الدولة العثمانية , وأخيرا الزج في الدولة في معمعان الحرب العالمية مما وضع الدولة في موقف ” الهلكة ” .
لقد تسببتم في هلاك الكثيرين من مواطني الدولة ورعاياها , وأفقرتم الملايين حتى اضطر الناس إلى بيع أبواب بيوتهم وأسقفها لشراء ما يقتاتون به من الجوع .
ماذا بعد ؟
ثم إنكم تنكرتم للاسلام والشريعة , ودليل ذلك ما كتب في الصحيفة التي تنطق باسمكم من أن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام هي شر السير , على مرأى ومسمع الوزير الأعظم وجميع المسؤولين , ثم أبطلتم حكم الاسلام في ميراث المرأة بإحداث ميراث يعطي الأنثى مثل الذكر , ووحللتم الفطر في رمضان للجنود المقيمين في مكة أو المدينة أو الشام بدعوى أن رفاقهم يقاتلون في حدود الروس !
وقيدتم أيدي السلطان فلم يعد بيده من الأمر شيء حتى تعيين رئيس الكتاب لديه , فكيف يقدر على الاضطلاع بمهام خلافة المسلمين وهو مسلوب الارادة , سجين القصر .
وهنا يتعرض المنشور لنقطة بالغة الحساسية وهي أن الخلافة لم تعد قائمة لانتفاء شرطها وهو امتلاك السلطة والقرار .فكيف تطالبون المسلمين بطاعة خليفة غير موجود ؟
وقد صبرنا على هذه الحالة زمنا حتى تبين تماما أن الدولة أصبحت بيد جمال باشا وأنور باشا وطلعت بيك .
وقد بلغ الظلم حده بإعدام واحد وعشرين من عظماء أفاضل المسلمين ونوابغ العرب منهم الأمير عمر الجزائري والأمير عارف الشهابي وعبد الحميد الزهراوي وشكري بيك العسلي وغيرهم .
وبعد إعدامهم سلبتم أموالهم وأملاكهم وشردتم عوائلهم ونفيتموهم من بلادهم .
ثم أشار المنشور إلى إطلاق القوة العثمانية القنابل التي سقطت بجوار الكعبة ويبدو أن ذلك قد حصل أثناء المواجهة بين الحامية العثمانية في مكة وقوات الشريف حسين .
وقبل أن يصل المنشور إلى نهايته يقول : لذلك كله لن نترك كياننا الديني والقومي ألعوبة بيد الاتحاديين .
أخيرا : يقرر أن ” البلاد ” قد استقلت فعلا استقلالا تاما بعيدا عن أي تدخل أجنبي . ويبدو واضحا أن الاعلان قد صدر بعد الاستيلاء على مكة والمدينة والطائف , بالتالي فهو يعني بالبلاد الحجاز على وجه التحديد وليس شيئا آخر في تلك المرحلة التاريخية .
قد يصدم ذلك الاعلان وماجاء فيه السردية النمطية التي انتشرت مؤخرا في قطاع من الرأي العام في سورية , هذه السردية التي تهمل أن الدولة العثمانية في أواخر عهدها وقبل ثورة الشريف حسين لم تعد دولة الخلافة التي مازالت محل اعتقاد البعض , وعلى النقيض من ذلك فجماعة الاتحاد والترقي هي البيئة الثقافية – السياسية الأصلية التي ولدت منها الأتاتوركية العلمانوية .
لقد انقلبت على يد تلك الجماعة سياسة الدولة العثمانية رأسا على عقب , وأنزلت بالعرب وغيرهم من المظالم ما لايطاق , وزجت بأبنائهم في حروب لم تكن ضرورية وخاسرة .
فكيف لايمكن توقع صدور ردود فعل لذلك النهج الذي لايمت بصلة لنهج الدولة العثمانية السابق ؟
هل يبرر ذلك الثورة ضد الدولة العثمانية أثناء تكالب دول التحالف ضدها وخلال أشد فترات الحرب ؟
هل يبرر ذلك التحالف مع الدولة الاستعمارية الأكبر والأخطر في وقتها أعني بريطانيا ؟
لعل التاريخ اللاحق يعفينا من مشقة البحث عن الأجابة عما سبق .
لم تسفر ثورة الشريف حسين لا عن التحرر ولا عن الاستقلال الحقيقي , بل عن الوقوع فريسة بيد الاستعمار الغربي ثم التقسيم ونكبة فلسطين .
لابد من الاشارة هنا لرأي المفكر والسياسي العروبي الفذ شكيب أرسلان , الذي بالرغم من تفهمه العميق لدواعي التذمر لدى المثقفين العرب لكنه كان يدرك ببصيرة نافذة أن شعار الانفصال عن الدولة العثمانية في تلك اللحظة التاريخية الحرجة لم يكن يعني واقعيا سوى الوقوع فريسة الذئاب الغربية المتربصة , وأن الحل في الكفاح لتحويل الرابطة العثمانية لمايشبه الاتحاد الفدرالي الذي ينصف العرب ولا يكشفهم أمام القوى الاستعمارية الغربية .
لكن التاريخ كان له رأي آخر .
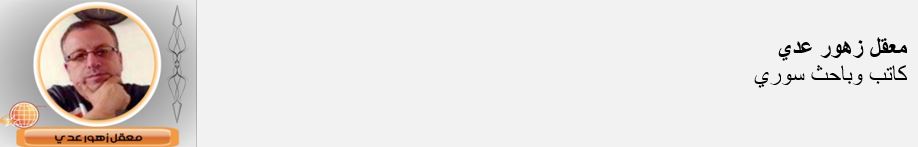

التعليقات مغلقة.