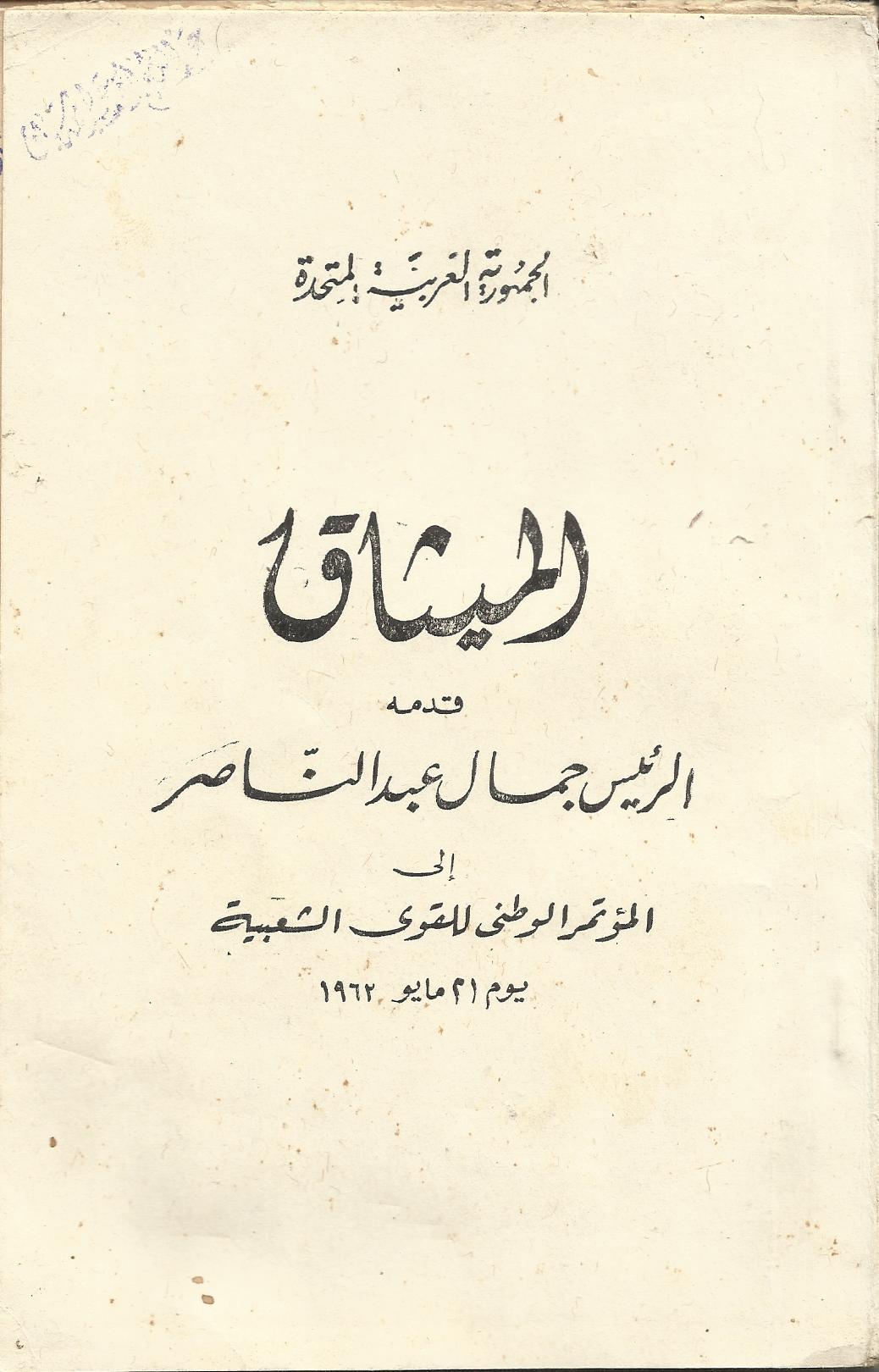
البــاب الخـامـس
عن الديمقراطية السليمة:
إن الثورة بالطبيعة عمل شعبي وتقدمي؛ إنها حركة شعب بأسره يستجمع قواه ليقوم باقتحام عنيد لكل العوائق والموانع التي تعترض طريق حياته كما يتصورها، وكما يريدها؛ كما أنها قفزة عبر مسافة التخلف الاقتصادي والاجتماعي؛ تعويضاً لما فات، ووصولاً إلى الآمال الكبرى؛ التي تبدو خلال المثل الأعلى لما يريده للأجيال القادمة منه.
من هنا فإن العمل الثوري الصادق لا يمكن بغير سمتين أساسيتين:
أولاهما: شعبيته.
والثانية: تقدميته.
إن الثورة ليست عمل فرد؛ وإلا كانت انفعالاً شخصياً يائساً ضد مجتمع بحاله. والثورة ليست عمل فئة واحدة؛ وإلا كانت تصادماً مع الأغلبية، وإنما قيمة الثورة الحقيقية بمدى شعبيتها، بمدى ما تعبر به عن الجماهير الواسعة، وبمدى ما تعبئه من قوى هذه الجماهير لإعادة صنع المستقبل، وبمدى ما يمكن أن توفره لهذه الجماهير من قدرة على فرض إرادتها على الحياة.. والثورة تقدم بالطبيعة.
إن الجماهير لا تطالب بالتغيير ولا تسعى إليه وتفرضه لمجرد التغيير نفسه خلاصاً من الملل؛ وإنما تطلبه وتسعى إليه وتفرضه تحقيقاً لحياة أفضل، تحاول بها أن ترتفع بواقعها إلى مستوى أمانيها.
إن التقدم هو غاية الثورة، والتخلف المادي والاجتماعي هو المفجر الحقيقي لإرادة التغيير، والانتقال بكل قوة وتصميم مما كان قائماً بالفعل إلى ما ينبغي أن يقوم بالأمل.
إن الديمقراطية هي الترجمة الصحيحة لكون الثورة عملاً شعبياً. إن الديمقراطية هي توكيد السيادة للشعب، ووضع السلطة كلها في يده، وتكريسها لتحقيق أهدافه؛ كذلك فإن الاشتراكية هي الترجمة الصحيحة لكون الثورة عملاً تقدمياً.. فإن الاشتراكية هي إقامة مجتمع الكفاية والعدل، مجتمع العمل وتكافؤ الفرصة، مجتمع الإنتاج ومجتمع الخدمات.
إن الديمقراطية والاشتراكية من هذا التصور تصبحان امتداداً واحداً للعمل الثوري . إن الديمقراطية هي الحرية السياسية، والاشتراكية هي الحرية الاجتماعية، ولا يمكن الفصل بين الاثنين.. إنهما جناحا الحرية الحقيقية وبدونهما أو بدون أي منهما لا تستطيع الحرية أن تحلق إلى آفاق الغد المرتقب.
إن عمق الوعى الثوري للشعب المصري، ووضوح الرؤية أمامه بفعل الصدق مع النفس؛ قد مكنه غداة النصر العظيم في معركة السويس من أن يحسن تقدير موقفه.
إن الشعب المصري استطاع وسط مهرجان النصر العظيم أن يدرك أنه لم يحصل على الحرية في معركة السويس؛ وإنما هو في معركة السويس استخلص إرادته لكى يصنع بها الحرية ثورياً.
إن المعركة المجيدة مكنته من أن يكتشف قدراته وإمكانياته؛ وبالتالي أن يوجه هذه القدرات والإمكانيات ثورياً لتحقيق الحرية.
إن النصر ضد الاستعمار بالنسبة لهذا الشعب العظيم لم يكن نهاية المطاف؛ وإنما كان بداية العمل الحقيقي، وكان مجرد مركز أكثر ملاءمة لمواصلة الحرب من أجل الحرية الحقيقية، وضمانها مزدهرة على أرضه إلى الأبد.
إن السؤال الذى طرح نفسه تلقائياً غداة النصر العظيم في السويس؛ هو لمن هذه الإرادة الحرة التي استخلصها الشعب المصري من قلب المعركة الرهيبة؟ وكان الرد التاريخي الذى لا رد غيره؛ هو أن هذه الإرادة لا يمكن أن تكون لغير الشعب، ولا يمكن أن تعمل لغير تحقيق أهدافه.
إن الشعوب لا تستخلص إرادتها من قبضة الغاصب لكى تضعها في متاحف التاريخ؛ وإنما تستخلص الشعوب إرادتها وتدعمها بكل طاقاتها الوطنية لتجعل منها السلطة القادرة على تحقيق مطالبها.
إن هذه المرحلة من النضال هي أخطر المراحل في تجارب الأمم.. إنها النقطة التي انتكست بعدها حركات شعبية كانت تبشر بالأمل في نتائج باهرة، ولكنها نسيت نفسها بعد أول انتصار لها ضد الضغط الخارجي، وتوهمت خطأً أن أهدافها الثورية تحققت؛ ومن ثم تركت الواقع كما هو دون تغيير.. ناسية أن عناصر الاستغلال الداخلي متصلة عن قرب مع قوى الضغط الخارجي؛ فإن الصلة بينهما والتعاون تفرضهما ظروف تبادل المنافع والمصالح على حساب الجماهير.
إن هذه الحركات الشعبية تسلم نفسها بعد ذلك للواجهات الدستورية المخادعة، وتتصور بذلك أن الحرية استوفت حقوقها، لكن هذه الحركات الشعبية تكشف دائماً – وبعد فوات الأوان في كثير من الأحيان – أنها بقصورها عن التغيير الثوري في معناه الاقتصادي سلبت الحرية السياسية ضمانها الحقيقي، ولم تترك لنفسها منها غير مجرد واجهة هشة؛ لا تلبث أن تتحطم وتنهار بفعل التناقض بينها وبين الحقيقة الوطنية.
كذلك ففي هذه المرحلة الخطيرة من النضال الوطني تنتكس حركات شعبية أخرى؛ حين تنهج للتغيير الداخلي نظريات لا تنبع من التجربة الوطنية.
إن التسليم بوجود قوانين طبيعية للعمل الاجتماعي، ليس معناه القبول بالنظريات الجاهزة، والاستغناء بها عن التجربة الوطنية. إن الحلول الحقيقية لمشاكل أي شعب لا يمكن استيرادها من تجارب شعوب غيره، ولا تملك أي حركة شعبية في تصديها لمسئولية العمل الاجتماعي أن تستغنى عن التجربة. إن التجربة الوطنية لا تفترض مقدماً بتخطئة جميع النظريات السابقة عليها، أو تقطع برفض الحلول التي توصل إليها غيرها؛ فإن ذلك تعصب لا تقدر أن تتحمل تبعاته؛ خصوصاً وأن إرادة التغيير الاجتماعي في بداية ممارستها لمسئولياتها تجتاز فترة أشبه بالمراهقة الفكرية؛ تحتاج خلالها إلى كل زاد فكرى، لكنها في حاجة إلى أن تهضم كل زاد تحصل عليه، وأن تمزجه بالعصارات الناتجة من خلاياها الحية.
إنها تحتاج إلى معرفة بما يجرى من حولها لكن حاجتها الكبرى هي إلى ممارسة الحياة على أرضها، وإن تجربة الصواب والخطأ هي في حياة الأمم كشأنها في حياة الأفراد؛ طريق النضوج والوضوح.
ومن ثم فإن الحرية السياسية؛ أي الديمقراطية، ليست هي نقل واجهات دستورية شكلية، كذلك فإن الحرية الاجتماعية؛ أي الاشتراكية، ليست التزاماً بنظريات جامدة لم تخرج من صميم الممارسة والتجربة الوطنية.
إن مصر وقعت بعد الحركة الشعبية الثورية سنة 1919 في الخديعة الكبرى للديمقراطية المزيفة، واستسلمت القيادات الثورية – بعد أول اعتراف من الاستعمار باستقلال مصر – إلى ديمقراطية الواجهات الدستورية التي لا تحتوى على أي مضمون اقتصادي.
إن ذلك لم يكن ضربة شديدة ضد الحرية في صورتها الاجتماعية فقط؛ وإنما ما لبثت الضربة أن وصلت إلى هذه الواجهة السياسية الخارجية ذاتها؛ فإن الاستعمار لم يقم وزناً لكلمة الاستقلال المكتوبة على الورق، ولم يتورع عن تمزيقها في أي وقت وفقاً لمصالحه.. إن ذلك كان أمراً طبيعياً.
إن واجهة الديمقراطية المزيفة لم تكن تمثل إلا ديمقراطية الرجعية؛ والرجعية ليست على استعداد لأن تقطع صلتها بالاستعمار، أو توقف تعاونها معه؛ ولذلك فلقد كان المنطق الطبيعي – بصرف النظر عن الواجهات الخارجية المزيفة – أن نجد الوزارات في عهد ديمقراطية الرجعية، وفى ظل ما كان يسمى بالاستقلال الوطني؛ لا تستطيع أن تعمل إلا بوحى من ممثل الاستعمار الرسمي في مصر، بل إنها في بعض الأحيان لم توجد إلا بمشورته وبأمره، بل وصل الحال في إحدى المرات أنها جاءت إلى الحكم بدباباته.
إن ذلك كله يمزق القناع عن الواجهة المزيفة، ويفضح الخديعة الكبرى في ديمقراطية الرجعية، ويؤكد عن يقين أنه لا معنى للديمقراطية السياسية، أو للحرية في صورتها السياسية، من غير الديمقراطية الاقتصادية أو الحرية في صورتها الاجتماعية.
إنه من الحقائق البديهية التي لا تقبل الجدل أن النظام السياسي في بلد من البلدان ليس إلا انعكاساً مباشراً للأوضاع الاقتصادية السائدة فيه، وتعبيراً دقيقاً للمصالح المتحكمة في هذه الأوضاع الاقتصادية، فإذا كان الإقطاع هو القوة الاقتصادية التي تسود بلداً من البلدان؛ فمن المحقق أن الحرية السياسية في هذا البلد لا يمكن أن تكون غير حرية الإقطاع إنه يتحكم في المصالح الاقتصادية، ويملى الشكل السياسي للدولة ويفرضه خدمة لمصالحه؛ وكذلك الحال عندما تكون القوة الاقتصادية لرأس المال المستغل.
ولقد كانت القوة الاقتصادية في مصر قبل الثورة في يد تحالف بين الإقطاع وبين رأس المال المستغل، وكان محتماً أن تكون الأشكال السياسية بما فيها الأحزاب تعبيراً عن هذه القوة، وواجهة ظاهرة لهذا التحالف بين الإقطاع وبين رأس المال المستغل.
إنه مما يلفت النظر أن بعض الأحزاب في تلك الظروف؛ لم تتورع عن أن ترفع – من غير مواربة – شعار أن الحكم يجب أن يكون لأصحاب المصالح الحقيقية، ولما كان الإقطاع ورأس المال المستغل هما أصحاب المصالح الحقيقية في البلاد وقتها؛ فلقد كان هذا الشعار أكثر من اعتراف ضمني بالمهزلة التي فرضتها القوى المسيطرة على الشعب المصري باسم الديمقراطية.
إن هذا الشعار – على أي حال – مهما بلغت درجة الإيلام فيه؛ كان اعترافاً صريحاً وصادقاً بالحقيقة المرة. إن سيادة الإقطاع المتحالف مع رأس المال المستغل على اقتصاديات الوطن؛ كانت لابد أن تمكن لهما طبيعياً وحتمياً من السيطرة على العمل السياسي فيه، وعلى أشكاله، وعلى ضمان توجيهها لخدمة التحالف بينهما على حساب الجماهير، وإخضاع هذه الجماهير بالخديعة أو بالإرهاب حتى تقبل أو تستسلم.
إن الديمقراطية على هذا الأساس لم تكن إلا ديكتاتورية الرجعية. إن فقدان الحرية الاجتماعية لجماهير الشعب سلب كل قيمة لشكل الحرية السياسية التي كانت تفضلت بها عليها الرجعية المتحكمة؛ حتى لقد صدر دستور سنة 1923 منحة من الملك ومنة منه وتفضلاً. إن البرلمان الذى أقامه هذا الدستور لم يكن حامياً لمصالح الشعب؛ وإنما كان بالطبيعة حارساً للمصالح التي منحت هذا الدستور. وليس من شك أن أصواتاً كثيرة ارتفعت داخل البرلمان تنادى بحقوق الشعب، ولكن هذه النداءات تبددت هباء دون تأثير حقيقي، بل إن الرجعية لم يكن يضيرها أن تفتح متنفساً للسخط الشعبي؛ مادامت تملك جميع صمامات التوجيه، ومادامت بيدها – تحت كل الظروف – أغلبيتها التي تمكن لديكتاتوريتها الطبقية وتحمى امتيازاتها.
إن حق التصويت فقد قيمته حين فقد اتصاله المؤكد بالحق في لقمة العيش . إن حرية التصويت من غير حرية لقمة العيش وضمانها فقدت كل قيمة فيها، وأصبحت خديعة مضللة للشعب. تحت هذه الظروف أصبح حق التصويت أمام ثلاثة احتمالات ليس لها بديل:
في الريف.. كان التصويت إجباراً للفلاح لا يقبل المناقشة، فلم يكن يملك إلا أن يعطى صوته للإقطاعي صاحب الأرض، أو وفق مشيئته، أو يواجه تبعات العصيان؛ وأولاهما: أن يطرد من الأرض التي يعمل فيها بما لا يكاد أن يكفى لسد جوعه.
في الريف والمدينة كان شراء الأصوات يمكن رأس المال المستغل من أن يأتي بأعوانه، أو بمن يضمن ولاءهم لمصالحه.
في الريف والمدينة لم تتورع المصالح الحاكمة في عديد من الظروف أن تلجأ إلى التزوير المكشوف إذا ما أحست بوجود تيارات متعارضة مع إرادتها.
وكانت الشروط التي تجرى تحتها عمليات الانتخاب، وفى مقدمتها اشتراط تأمين نقدى باهظ، تصد جماهير الشعب العامل حتى عن مجرد الاقتراب من لعبة الانتخابات، ولم تكن إلا لعبة في تلك الظروف.
وفى نفس الوقت فإن الجهل الذى فرض على الأغلبية العظمى من الشعب، تحت ضغط الفقر؛ جعل من سرية الاقتراع – وهى أولى الضمانات لحريته – أمراً مستحيلاً أو شبه مستحيل.
إن حرية التنظيم الشعبي التي تسند حرية التمثيل الشعبي فقدت هي الأخرى – بتأثير هذه الظروف – فاعليتها، وعجزت عن التأثير إيجابياً على الأوضاع المفروضة داخل الوطن.
إن ملايين الفلاحين حتى من ملاك الأرض الصغار طحنتهم الإقطاعيات الكبيرة لسادة الأرض المتحكمين في مصيرها، ولم يتمكنوا على الإطلاق من تنظيم أنفسهم داخل تعاونيات تمكنهم من المحافظة على إنتاجية أراضيهم. وبالتالي تعطيهم القدرة على الصمود وعلى إسماع صوتهم للأجهزة المحلية؛ فضلاً عن قصور الحكم في العاصمة؛ كذلك فإن الملايين من العمال الزراعيين عاشوا في ظروف أقرب ما تكون إلى السخرة؛ تحت مستوى من الأجور يهبط كثيراً ليقرب من حد الجوع؛ كما أن عملهم كان يجرى من غير أي ضمان للمستقبل، ولم يكن في طاقتهم إلا أن يعيشوا سنوات حياتهم خلال بؤس الساعات وقسوتها الرهيبة.
كذلك فإن مئات الألوف من عمال الصناعة والتجارة لم تكن في قدرتهم أية طاقة على تحدى إرادة الرأسمالية المتحكمة؛ المتحالفة مع الإقطاع، والمسيطرة على جهاز الدولة وعلى سلطة التشريع، وأصبح العمل سلعة من السلع فى عملية الإنتاج، يشتريها رأس المال المستغل تحت أحسن الشروط موافقة لمصالحه. ولقد واجهت الحركة النقابية التي كان في يدها قيادة هذه الطبقة المناضلة من العمال صعوبات شديدة، حاولت عرقلة طريقها كما حاولت إفسادها.
إن حرية النقد ضاعت في هذه الفترة بضياع حرية الصحافة، ولم يكن الأمر هو مجرد القوانين الصارمة التي وقفت بالمرصاد لحرية النشر، وفرضت بالتشريع محظورات ترتفع على النقد، وتوسعت في هذه المحظورات إلى حد كاد أن يجعل الظلام دامساً وشاملاً . وإنما طبيعة التقدم الآلي في مهنة الصحافة نفسها أحدثت أثراً لا يقل في ضرره عما أحدثته قوانين القمع والكبت.
لقد كان من أثر التقدم الآلي في مهنة الصحافة، واحتياجاتها المتزايدة إلى الآلات الحديثة، وإلى الكميات الهائلة من الورق؛ أن تحولت هذه المهنة العظيمة من كونها عملية رأى إلى أن أصبحت عملية رأسمالية معقدة.
إن الصحافة في هذه الفترة – ومع هذا التطور – لم تكن قادرة على الحياة إلا إذا ساندتها الأحزاب الحاكمة؛ الممثلة لمصالح الإقطاع ورأس المال، أو إذا اعتمدت اعتماداً كلياً على رأس المال المستغل الذى كان يملك الإعلان بحكم ملكيته للصناعة والتجارة.
إن سلطة الدولة والتشريع استعملت أولاً في إخضاع الصحافة للمصالح الحاكمة؛ وذلك عن طريق قوانين النشر الظالمة، وعن طريق الرقابة التي وقفت سداً حائلاً دون الحقيقة؛ كذلك تزايد الخطر على ما تبقى من حرية الصحافة ثانياً بتزايد احتياجات المهنة نفسها لمعدات التقدم الآلي.. ولم يعد في قدرتها إلا أن تخضع لإرادة رأس المال المستغل، وأن تتلقى منه وليس من جماهير الشعب وحيها، واتجاهاتها السياسية والاجتماعية.
إن حرية العلم التي كان في مقدورها أن تفتح طاقات جديدة للأمل؛ تعرضت هي الأخرى لنفس العبث تحت حكم الديمقراطية الرجعية؛ فإن الرجعية الحاكمة كان لابد لها أن تطمئن إلى سيطرة المفاهيم المعبرة عن مصالحها؛ ومن ثم انعكست آثار ذلك على نظم العلم ومناهجه، وأصبحت لا تسمح إلا بشعارات الاستسلام والخضوع.
إن أجيالاً متعاقبة من شباب مصر لقنت أن بلادها لا تصلح للصناعة، ولا تقدر عليها. إن أجيالاً متعاقبة من شباب مصر قرأت تاريخها الوطني على غير حقيقته، وصور لها الأبطال في تاريخها تائهين وراء سحب من الشك والغموض؛ بينما وضعت هالات التمجيد والإكبار من حول الذين خانوا كفاحها. إن أجيالاً متعاقبة من شباب مصر انتظمت في سلك المدارس والجامعات، والهدف من التعليم كله لا يزيد عن إخراج موظفين يعملون للأنظمة القائمة، وتحت قوانينها ولوائحها التي لا تأبه بمصالح الشعب؛ دون أي وعى لضرورة تغييرها من جذورها، وتمزيقها أصلاً وأساساً.
إن تحالف الإقطاع والرجعية الحاكمة لم يكتف بذلك كله، وإنما باشر ضغطه على جماعات كثيرة من المثقفين؛ كان في استطاعتها أن تكون ضمن الطلائع الثائرة؛ فكسر مقاومتها، وفرض عليها إما أن تستسلم لإغراء ما يلقيه إليها من فتات الامتيازات الطبقية، وإما أن تذهب إلى الانزواء والنسيان.
إن عمق الوعى الثوري، وأصالة إرادة الثورة للشعب المصري؛ قد فضحت التزييف المروع في ديمقراطية الرجعية التي حكمت باسم التحالف بين الإقطاع وبين رأس المال المستغل.
إن عمق الوعى وأصالة إرادة الثورة وضعا بنجاح شعار الديمقراطية السليمة ضمن المبادئ الستة، ورسماً من الواقع وبالتجربة، وتطلعاً إلى الأمل؛ معالم ديمقراطية الشعب.. ديمقراطية الشعب العامل كله.
أولاً: إن الديمقراطية السياسية لا يمكن أن تنفصل عن الديمقراطية الاجتماعية. إن المواطن لا تكون له حرية التصويت في الانتخابات إلا إذا توفرت له ضمانات ثلاث:
1- أن يتحرر من الاستغلال فى جميع صوره.
2- أن تكون له الفرصة المتكافئة فى نصيب عادل من الثروة الوطنية.
3- أن يتخلص من كل قلق يبدد أمن المستقبل فى حياته.
بهذه الضمانات الثلاث يملك المواطن حريته السياسية، ويقدر أن يشارك بصوته فى تشكيل سلطة الدولة التي يرتضى حكمها.
ثانياً: إن الديمقراطية السياسية لا يمكن أن تتحقق في ظل سيطرة طبقة من الطبقات. إن الديمقراطية حتى بمعناها الحرفي هي سلطة الشعب؛ سلطة مجموع الشعب وسيادته، والصراع الحتمي والطبيعي بين الطبقات لا يمكن تجاهله أو إنكاره، وإنما ينبغي أن يكون حله سلمياً في إطار الوحدة الوطنية، وعن طريق تذويب الفوارق بين الطبقات. ولقد أثبتت التجربة التي صاحبت بدء العمل الثوري المنظم أنه من المحتم أن تأخذ الثورة على عاتقها تصفية الرجعية، وتجريدها من جميع أسلحتها، ومنعها من أي محاولة للعودة إلى السيطرة على الحكم، وتسخير جهاز الدولة لخدمة مصالحها.
إن ضراوة الصراع الطبقي ودمويته، والأخطار الهائلة التي يمكن أن تحدث نتيجة لذلك؛ هي في الواقع من صنع الرجعية التي لا تريد التنازل عن احتكاراتها، وعن مراكزها الممتازة التي تواصل منها استغلال الجماهير.
إن الرجعية تملك وسائل المقاومة؛ تملك سلطة الدولة، فإذا انتزعت منها لجأت إلى سلطة المال، فإذا انتزع منها لجأت إلى حليفها الطبيعي وهو الاستعمار.
إن الرجعية تتصادم في مصالحها مع مصالح مجموع الشعب؛ بحكم احتكارها لثروته؛ ولهذا فإن سلمية الصراع الطبقي لا يمكن أن تتحقق إلا بتجريد الرجعية – أولاً وقبل كل شيء – من جميع أسلحتها.
إن إزالة هذا التصادم يفتح الطريق للحلول السلمية أمام صراع الطبقات. إن إزالة التصادم لا يزيل المتناقضات بين بقية طبقات الشعب، وإنما هو يفتح المجال لإمكانية حلها سلمياً؛ أي بوسائل العمل الديمقراطي، بينما بقاء التصادم لا يمكن أن يحل بغير الحرب الأهلية، وما تلحقه من أضرار بالوطن؛ في ظروف يشتد فيها الصراع الدولي، وتعنف فيها عواصف الحرب الباردة.
إن تحالف الرجعية ورأس المال المستغل يجب أن يسقط، ولابد أن ينفسح المجال بعد ذلك ديمقراطياً للتفاعل الديمقراطي بين قوى الشعب العاملة؛ الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية.
إن تحالف هذه القوى الممثلة للشعب العامل، هو البديل الشرعي لتحالف الإقطاع مع رأس المال المستغل، وهو القادر على إحلال الديمقراطية السليمة محل ديمقراطية الرجعية.
ثالثاً: إن الوحدة الوطنية التي يصنعها تحالف هذه القوى الممثلة للشعب هي التي تستطيع أن تقيم الاتحاد الاشتراكي العربي؛ ليكون السلطة الممثلة للشعب، والدافعة لإمكانيات الثورة، والحارسة على قيم الديمقراطية السليمة.
إن هذه القوى الشعبية الهائلة المكونة للاتحاد الاشتراكي العربي وإطلاق فعالياتها تحتم أن يتعرض الدستور الجديد للجمهورية العربية المتحدة – عند بحثه لشكل التنظيم السياسي للدولة – لعدة ضمانات لازمة.
1- إن التنظيمات الشعبية والسياسية التي تقوم بالانتخاب الحر المباشر لابد لها أن تمثل بحق وبعدل القوى المكونة للأغلبية؛ وهى القوى التي طال استغلالها، والتي هي صاحبة مصلحة عميقة في الثورة؛ كما أنها بالطبيعة الوعاء الذى يختزن طاقات ثورية دافعة وعميقة بفعل معاناتها للحرمان.
إن ذلك – فضلاً عما فيه من حق وعدل باعتباره تمثيلاً للأغلبية – ضمان أكيد لقوة الدفع الثوري نابعة من مصادرها الطبيعية الأصيلة؛ ومن هنا فإن الدستور الجديد يجب أن يضمن للفلاحين والعمال نصف مقاعد التنظيمات الشعبية والسياسية على جميع مستوياتها، بما فيها المجلس النيابي؛ باعتبارهم أغلبية الشعب؛ كما أنها الأغلبية التي طال حرمانها من حقها الأساسي في صنع مستقبلها وتوجيهه.
2- إن سلطة المجالس الشعبية المنتخبة يجب أن تتأكد باستمرار فوق سلطة أجهزة الدولة التنفيذية؛ فذلك هو الوضع الطبيعي الذى ينظم سيادة الشعب، ثم هو الكفيل بأن يظل الشعب دائماً قائد العمل الوطني، كما أنه الضمان الذى يحمى قوة الاندفاع الثوري من أن تتجمد في تعقيدات الأجهزة الإدارية أو التنفيذية؛ بفعل الإهمال أو الانحراف.
كذلك فإن الحكم المحلى يجب أن ينقل باستمرار وبإلحاح سلطة الدولة تدريجياً إلى أيدى السلطات الشعبية؛ فإنها أقدر على الإحساس بمشاكل الشعب، وأقدر على حسمها.
3- إن الحاجة ماسة إلى خلق جهاز سياسي جديد داخل إطار الاتحاد الاشتراكي العربي؛ يجند العناصر الصالحة للقيادة، وينظم جهودها ويبلور الحوافز الثورية للجماهير، ويتحسس احتياجاتها، ويساعد على إيجاد الحلول الصحيحة لهذه الاحتياجات.
4- إن جماعية القيادة أمر لابد من ضمانه في مرحلة الانطلاق الثوري. إن جماعية القيادة ليست عاصماً من جموح الفرد فحسب، وإنما هي تأكيد للديمقراطية على أعلى المستويات؛ كما أنها في الوقت ذاته ضمان للاستمرار الدائم المتجدد.
رابعاً: إن التنظيمات الشعبية؛ وخصوصاً التنظيمات التعاونية والنقابية، تستطيع أن تقوم بدور مؤثر وفعال في التمكين للديمقراطية السليمة.
إن هذه التنظيمات لابد أن تكون قوى متقدمة في ميادين العمل الوطني الديمقراطي، وإن نمو الحركة التعاونية والنقابية معين لا ينضب للقيادات الواعية التي تلمس بأصابعها مباشرة أعصاب الجماهير، وتشعر بقوة نبضها، ولقد سقط الضغط الذى كان يخنق حرية هذه المنظمات ويشل حركتها.
إن تعاونيات الفلاحين – فضلاً عن دورها الإنتاجي – هي منظمات ديمقراطية قادرة على التعرف على مشاكل الفلاحين، وعلى استكشاف حلولها؛ وكذلك فلقد آن الوقت لكى تقوم نقابات للعمال الزراعيين.
إن نقابات عمال الصناعة والتجارة والخدمات قد توصلت بقوانين يوليو العظيمة إلى مركز طليعي في قيادة النضال الوطني.
إن العمال لم يصبحوا سلعة في عملية الإنتاج، وإنما أصبحت قوى العمل مالكة لعمليات الإنتاج ذاتها، شريكة في إدارتها.. شريكة في أرباحها تحت أوفى الأجور، وأحسن الشروط من ناحية تحديد ساعات العمل.
خامساً: إن النقد والنقد الذاتي من أهم الضمانات للحرية، ولقد كان أخطر ما يعرقل حرية النقد والنقد الذاتي في المنظمات السياسية هو تسلل العناصر الرجعية إليها.
كذلك لقد كانت سيطرة الرجعية على الصحافة؛ بحكم سيطرتها على المصالح الاقتصادية، تسلب حرية الرأي أعظم أدواتها. إن استبعاد الرجعية يسقط ديكتاتورية الطبقة الواحدة، ويفتح الطريق أمام ديمقراطية جميع قوى الشعب الوطنية.
إنه يعطى أوثق الضمانات لحرية الاجتماع، وحرية المناقشة؛ كذلك فإن ملكية الشعب للصحافة؛ التي تحققت بفضل قانون تنظيم الصحافة؛ الذى أكد لها في نفس الوقت استقلالها عن الأجهزة الإدارية للحكم؛ قد انتزع للشعب أعظم أدوات حرية الرأي، ومكن أقوى الضمانات لقدرتها على النقد.
إن الصحافة بملكية الاتحاد الاشتراكي العربي لها.. هذا الاتحاد الممثل لقوى الشعب العاملة؛ قد خلصت من تأثير الطبقة الواحدة الحاكمة؛ كذلك خلصت من تحكم رأس المال فيها، ومن الرقابة غير المنظورة التي كان يفرضها عليها بقوة تحكمه في مواردها.
إن الضمان المحقق لحرية الصحافة هي أن تكون الصحافة للشعب؛ لتكون حريتها بدورها امتداداً لحرية الشعب.
سادساً: إن المفاهيم الثورية الجديدة للديمقراطية السليمة، لابد لها أن تفرض نفسها على الحدود التي تؤثر في تكوين المواطن؛ وفى مقدمتها التعليم والقوانين واللوائح الإدارية.
إن التعليم لم تعد غايته إخراج موظفين للعمل في مكاتب الحكومة؛ ومن هنا فإن مناهج التعليم في جميع الفروع ينبغي أن تعاد دراستها ثورياً؛ لكى يكون هدفها هو تمكين الإنسان الفرد من القدرة على إعادة تشكيل الحياة.
كذلك فإن القوانين لابد أن تعاد صياغتها لتخدم العلاقات الاجتماعية الجديدة التي تقيمها الديمقراطية السياسية؛ تعبيراً عن الديمقراطية الاجتماعية.
كذلك فإن العدل الذى هو حق مقدس لكل مواطن فرد؛ لا يمكن أن يكون سلعه غالية وبعيدة المنال على المواطن. إن العدل لابد أن يصل إلى كل فرد حر، ولابد أن يصل إليه من غير موانع مادية أو تعقيدات إدارية؛ كذلك فإن اللوائح الحكومية يجب أن تتغير تغييراً جذرياً من الأعماق، لقد وضعت كلها أو معظمها في ظلال حكم الطبقة الواحدة، ولابد بأسرع ما يمكن من تحويلها لتكون قادرة على خدمة ديمقراطية الشعب كله.
إن العمل الديمقراطي في هذه المجالات سوف يتيح الفرصة لتنمية ثقافة نابضة بالقيم الجديدة؛ عميقة في إحساسها بالإنسان، صادقة في تعبيرها عنه، قادرة بعد ذلك كله على إضاءة جوانب فكره وحسه، وتحريك طاقات كامنة في أعماقه، خلاقة ومبدعة، ينعكس أثرها بدوره على ممارسته للديمقراطية، وفهمه لأصولها، وكشفه لجوهرها الصافي النقي.
يتبع؛ الباب السادس (في حتمية الحل الإشتراكي)…

التعليقات مغلقة.